الكنز في رؤوسنا

يسرد أدب الخيال العلمي أحداثا خيالية عن ارتياد الفضاء، وعن تحكّم الإنسان في الكون، ويصف أحيانا الكواكب الأخرى، ويجعل الشخصيات الفاعلة كائنات عجائبية. إنّ هذا الأدب لا يثير ملكة الخيال فقط، بل إنّه يدفع القارئ إلى استشراف المستقبل المعرفي عن طريق تصوّر المكتشفات العلمية الممكنة ممّا يجعله يفكّر في فاعلية التطور التقني، وفي جدوى التقدم التكنولوجي من حيث علاقتهما بالقيم الإنسانية.
تتنزل رواية “السرّ الأقصى” للكاتب الفرنسي المعاصر برنارد فيربير ضمن هذا السياق الأدبي العلمي، إذ يستلهم الروائي أفكاره من نظرية في العلوم العصبيّة تعرف بنظرية “نظام المكافأة”. ظهر هذا التصوّر المعرفي سنة 1954 بفضل التجارب المخبرية للباحثين جيمس أولدز وبيتر ميلنر، حيث أثبتا وجود وظائف عصبية تحفّزنا على القيام بسلوك معيّن قصد تحقيق مكافأة ما.
يعني ذلك أنّ الدوافع تقرّبنا من موضوع رغبتنا وتضفي عليه المزيد من الجاذبية وتساعدنا في إنجاز ما نصبو إليه. علاوة على الدور الذي تلعبه في الإثارة وفي التحفيز على الفعل، تعزّز الدوافع عادة الشعور الإيجابي بالذات وتقوّي الإرادة وتحثّ على المثابرة. إنّها تحقّق – حسب تقدير العلماء- تفاعلا عصبيّا مماثلا للوضع الذهني المترتّب عن المتعة الفعلية التي تنجم عن العمل المنجز وعن تحصيل المكافأة في الواقع.
على هذا النحو، يُحدث السعي لتحقيق هدف ما شكلا من أشكال السّعادة، ويعدّ العزم على بلوغ المطالب ونيل الأماني سلوكا تحضيريا يستبق من خلاله الإنسان سلوكات التحقيق والنجاح والنصر.. وتبعا لذلك ستكافئنا عقولنا كلّما فكّرنا بإلحاح في ما نحب عبر تفعيل مسارات الدوائر العصبية المسؤولة عن الابتهاج وستتحوّل أفكارنا وسلوكاتنا المصاحبة لهذه الوضعية إلى معتقدات فكرية وعادات سلوكيّة.
يستهلّ فاربار “السرّ الأقصى” بوصف أحداث مباراة لعبة شطرنج بين الدكتور صاموال فنشار والكمبيوتر ديب بلو 4، وهو كمبيوتر فائق الذكاء ومختص في لعب الشطرنج وقع تطويره في بداية التسعينات من القرن الماضي.
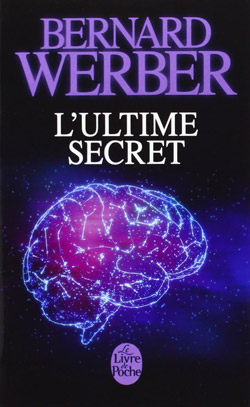
دارت هذه المباراة المشوّقة بقاعة مغطّاة في مدينة كان، ودامت ستّ ساعات وشاهدها جمهور غفير. أمّا نتيجتها، فكانت لصالح الدكتور فنشار الذي شعر بابتهاج شديد وغمره فرح عارم على إثر فوزه، والذي افتخر بانتصاره وسط تصفيق الحاضرين وهو يمسح العرق المتصبّب من جبينه قائلا “أنا سعيد بهذا الفوز وأنا مدين به لطاقة سريّة كامنة.. ليست للكمبيوتر انفعلات نفسية ولا دوافع.. أمّا أنا فقد كنت متحفّزا”.
تبدو الآلات الذكية -نظريا- أقوى من الذوات البشرية وأقدر على الإنجاز منها، وذلك لأنّها مجرّدة من العواطف التي تعكّر صفو المزاج الإنساني، فلا أرواح فيها ولا هي تنفعل فرحا ولا حزنا. لا يمكن أن تكتئب أو أن تصاب بخيبة أمل، ولا هي تفتخر بأيّ شيء ولا تطرح استفسارات ولا مشكلات.. كلّ ذلك يجعلها فاعلة ومجدية، ولكن لا يمكن أن تنتصر على الإنسان الذي تكون الانفعلات بالنسبة إليه -وعلى عكس الآلة- دافعا للفعل وللانتصار، بل إنّها ما به يقدر حتما على تجاوز الصعوبات ويتمكّن من تخطّي الحواجز واختراق الحدود.
بهذا المعنى يكون الإنسان المحفّز قادرا على كل شيء. لا شك أن الدافع الشخصي هو ما جعل أوديسيوس يعبّر البحر المتوسط، فيما جعلت الرغبة الذاتية كريستوف كولومبس يجتاز المحيط الأطلسي.
إنّ التحفيز الذاتي هو ما مكّن أرمسترونغ من السفر في الفضاء للسير على سطح القمر. لذلك يطلب بطل الشطرنج من مشاهديه أن يبحث كلّ واحد منهم في دوافعه الكامنة من خلال طرح الأسئلة التالية على ذاته: ما الذي يدفعني لأن أختار شيئا ما دون آخر؟ ما الذي يجبرني على اتّباع سلوك ما؟ أيّ حافز يعطيني رغبة في بذل جهد ويحوّلني إلى كائن فاعل؟
مهما تطوّر الذكاء الاصطناعي فإنّه لن يضاهي قدرات فكر البشر وما من شيء يعوّض الجانب الحيوي لدينا، أي العواطف والانفعالات والدوافع. بعبارة أخرى أخرى، لا شيء يعادل الذكاء العاطفي لدى الإنسان. لكن يبيّن برنارد فيربير أنّ المشاعر التي تجعلنا فاعلين قد تكون في نفس الوقت سببا لشقائنا وليس أدلّ على ذلك من أنّ فيشنار توفيّ في نفس اليوم الذي انتصر فيه وفي لحظة حميمية مع المرأة الفاتنة وفائقة الجمال التي كان يحبها. في هذا السياق يتقصّى كلّ من الصحافيين لوكراس وإزدور سبب موت فشنار ويتساءلان عما إذا كانت العواطف قاتلة ويعدّدان أثناء بحثهما عن الحقيقة، المحفزات التي تحمل الكائنات البشرية على الفعل وعلى الانفعال.
يعتبر الجوع المحفز الأوّل للحياة الذي جعل الإنسان يحترف الصيد والفلاحة وخدمة الأرض قصد جني خيراتها ومن أجل المحافظة على الوجود. علاوة على الحاجيات البيولوجية الأساسية تكون الرغبة في العيش في رفاهية محرّكة للوعي الإنساني من حيث هي تجعل الناس يعملون على تحسين ظروفهم قصد إيجاد سبل أفضل للعيش، فيقبلون على تحصيل المال لشراء متطلباتهم وإنماء ثرواتهم ويصبح المال في حد ذاته دافعا للعمل وتحقيق المصالح المادية.
كما نجد محفزات أخرى للسلوك ومنها الخوف الذي يدفعنا إلى ابتكار أشياء تبدّده، حيث أنّ هلعنا من الكوارث الطبيعة مثلا كان وراء اختراعنا للتقنيات والآلات المتحكّمة فيها. كذلك مكّنتنا مقاومة الألم من إيجاد الوسائل الممكنة لتخطيه، فالأدوية والمعدات الطبيّة على سبيل المثال ليست سوى نتاج لرغباتنا في معالجة الأوجاع الجسمانية والنفسية.
بالإضافة إلى ذلك يعدّ الغضب باعثا على ردّ الفعل وتغيير الحالة المحتقنة التي نكون عليها أحيانا. تثيرنا الشهوة أيضا وتجعلنا في حالة تحفّز قصوى لتحقيق غرائزنا ورغباتنا الجنسية التي لا تحقق المتعة فقط بل تحافظ على النوع الإنساني برمّته.
يعتبر برنارد فيربير أنّ الإيمان بمقدّس ما هو محفّز أيضا للسلوكات البشرية، لأنّ الأعياد الدينية مثلا تؤكد أنّ الإنسان يتأثّر بمعتقداته ويعمل على ترسيخها. كما لم ينس الكاتب الواجب الاجتماعي الذي يدلّ على انشغالنا بالآخرين ويولّد لدينا الحاجة إلى اعترافهم بنا، وهذا ما يفسّر جلّ أعمالنا التي تسعى في جوهرها إلى نزع الاعتراف منهم حتّى أنّنا نقوم بإنجازات كثيرة لنيل رضا الوالدين، وقد نشعر أحيانا أنّنا مكلّفون بواجبات تجاه العائلة أو الأصدقاء أو الوطن أو الإنسانيّة ككلّ.
أمّا ما يجعلنا نتفانى في أعمالنا، فهو ولعنا بها كالشغف بالكتابة أو بعزف الموسيقى أو الرقص أو الرسم.. وفي الكثير من الأحيان يجعلنا حبّ المغامرة متميّزين ومبدعين.
يتمثّل السرّ الفعلي الذي يمكّننا من تحقيق أهدافنا – كما شرحه الكاتب في الفصل المعنون “الكنز في رؤوسنا”- في القدرة على التحفيز العصبي الذاتي لمراكز الرغبات والمشاعر التي تقود الإنسان للتفكير والتعبير والحركة. بل توجد في دماغه مسارات ذهنية عديدة مجهولة سيؤدي اكتشافها الشخصي حتما إلى بلوغ أفكار طريفة.. إنّ عدد هذه المسارات كبير، وهي متفوّقة من حيث الكمّ على كلّ الصلات بالبرمجيات الرقمية لكمبيوتر ذكي. إنّ فهم الإنسان لعقله وتحكمه فيه سيمكنانه من إدراك ما ظنّه في السابق محالا وسيغيّران حتما ظروف حياته.


