المختصر: أي مستقبل في ظل العولمة

مع استفحال الأزمة المالية، والخوف المتزايد من التغيير المناخي والفقر المتواصل في عدة بلدان، بات الجدل حول العولمة مركزا على أسئلة أكثر راديكالية بخصوص مستقبل الرأسمالية نفسه، فقد بات جليا أن الليبرالية الاقتصادية والسياسية ليست الأقدر على حلّ تلك المشكلات. صحيح أن للعولمة الحالية عدة سوابق، ولكنها فريدة، لأنها تشمل في طياتها أربع شموليات: شموليات الشركات الكبرى، والمالية، والرقمية، والطبيعية، وتتحدد أيضا بوضع المستثمرين المؤسسين الشركات المعولمة موضعَ تنافس عبر مالية السوق. وهذا المسار يفاقم بعض التفاوتات ويقلص أخرى، فهو يساعد على انبثاقات سريعة ولكنه يولد تشظيات. في كتابه الجديد «الشموليات – الانبثاق والتشظي»، يتساءل أستاذ العلوم الاقتصادية بيير نويل جيرو عن سيناريوات المستقبل. هل سيضطرّ الفاعلون الاقتصاديون إلى الارتحال الدائم كي يبقوا قادرين على التنافس؟ ألا تزال الدول تملك دور المعدِّل في هذا التنافس؟ أيّ مستقبل للبلدان الغربية وبلدان جهات العالم المنسية؟
من أجل اقتصاد تشاركي
في هذه المرحلة التي تشهد غلوّ الرأسمالية في شتى مجالات الحياة، يقترح المناضل والناشط بجمعية التسيير الذاتي، بونوا بوريتس، فكرة طريفة. ما دام اليسار قد فشل في تجاوز الرأسمالية عبر الملكية المشتركة لوسائل الإنتاج، أليس من الأجدر أن يعاد النظر في مبدأ الملكية نفسه؟ ومن ثَمّ يطرح فكرة المشترك كنفي لملكية الإنتاج في شتى أشكالها، حيث كل فرد يمكن أن يجد مكانه في المداولة بحسب موقعه تجاه كل وحدة للإنتاج والفضاءات التشاركية التي يساهم فيها، ما يخلق منظومة تضمن الاستقلالية الذاتية والتكافل. ينطلق المؤلف من تحليلٍ أجرته الحركة التعاضدية، حيث يتم تجاوز العرف ولكن رأس المال يستعيد نوعا من النفوذ عند نجاح الشركة، ويذكّر بالملكية المشتركة منذ القرن التاسع عشر، مرورا بتجارب الاتحاد السوفييتي، وإسبانيا في عهد فرانكو، ويوغسلافيا في عهد تيتو، ليبيّن الدوافع الاقتصادية ومآزقها. وفي رأيه أن «الاقتصاد التشاركي» يمكن أن يتحقق بتوسيع المساهمات الاجتماعية التي هي في الأصل تشاركية عائدات. والكتاب في النهاية محاولة جادة لتجاوز الآفاق المعتادة.
ضد البطالة لفك العزلة
ليست البطالة حرمانا من الشغل فقط، بل هي محنة اجتماعية من جرائرها في الغالب عزلة وتهميش. لذلك تحدث علماء الاجتماع عن «تظاهر بعيد الاحتمال» عندما قرر المعطلون عامي 1997 و1998 احتلال المؤسسات وتعطيل نشاطها. غير أن عالمي الاجتماع كزافيي دونزا وفاليري كوهين يفندان تلك الفرضية في كتابهما «عندما يتجند العاطلون». من خلال بحثين إثنوغرافيين أكدا أن مجموعات العاطلين كانت مؤلفة من أشخاص ذات سمات متباينة، وهو ما يفند النظريات القائلة إن الاحتشاد يضع وجها لوجه المناضلين بدافع الضمير والمستفيدين من العمل المشترك. فمن العمل النضالي إلى احتلال مراكز العمل وتناول الكلمة لا يتجلى تقسيم العمل فقط وإنما أيضا توتر دائم يرين على المجموعات ذات المطالب المتناقضة أحيانا، كمطلب الشغل لدى هذا الطرف ومطلب الترفيع في الأجر لدى الطرف الآخر. ويستخلص الباحثان أن التظاهر والاحتشاد ضروريان للعاطلين لأنهما وسيلة لفك العزلة والتهميش وما يتولد عنهما من أمراض.
الإسلام المتعدد

منذ ظهوره
«التاريخ الأكبر للإسلام» كتاب يقدم فكرة شاملة عن الإسلام منذ ظهوره، بطرح كل الأسئلة التي تخامر الأذهان، بدءا بشخصية الرسول، وظروف تدوين القرآن، والعداوة المزمنة بين الشيعة والسنة، وصولا إلى الجماعات الإرهابية وفهمها للجهاد، ومسألة التأويل في الماضي والحاضر. والأسئلة المثارة هنا جوهرية نظرا لاستغلالها في الجدل الراهن من قبل الفرق المتطرفة، حيث يسعى المتزمتون إلى فرض نظرة أحادية أو خاطئة عن ديننا الحنيف، بدعوى العودة إلى الأصول، ويوهمون غير العارفين بدينهم تمام المعرفة، سواء في البلدان العربية الإسلامية أو في المجتمعات الغربية، بأنهم يقودون الضالين إلى مجتمع الطهر. وقد شمل الكتاب مقالات لمجموعة من المتخصصين في الإسلام، عربا وأجانب، أمثال مكرم عباس، وهيب عطا الله، علي بنمخلوف، مالك شبل، حمادي الرديسي، لويزا يوسفي، جون بوين، باسكال بوريزي، فنسان كابدوبوي، باتريك هاني، سيرج لافيت، غابريال مارتنيز غرو وآخرين… (تحت إشراف لوران تيستو) أكدوا فيها أن الإسلام منذ ظهوره حتى الآن لم يكن متماثلا بين جهة وأخرى، وإنما هو دين متعدد.
القطع بين الماضي والمستقبل فنيا وسياسيا
يذهب الرأي العام الفكري إلى القول إننا انتهينا من السرديات الكبرى والحداثة الفنية، والحال أننا لسنا واثقين تماما أننا بدأنا التفكير في ما يغطي هذين اللفظين. لفهم ما يدور في حركات التفتح والانقلابات الفنية التي ترافقه، ينبغي أن نضع في الحسبان البعد المضاعف للزمن. خلف الصورة البسيطة للخط الممدود بين الماضي والمستقبل، ذلك الذي يحمل الوعود والخيبات، ثمة تراتبية أشكال حياة تفصل بين التي لديها متسع من الوقت والتي ليس لديها. في كتابه الجديد «الأزمنة الحديثة: الفن والزمن والسياسة»، يبين الفيلسوف جاك رانسيير كيف يتنزل الصراع ضد تقسيم الوقت هذا في صميم الثورات السياسية والفنية الحديثة، وكيف يعقّد المظهر البالغ البساطة للقطع بين القديم والجديد. لإقامة الدليل على نظريته استعان رانسيير بفيلسوف يؤمن بالعلو والتسامي، وبعاملين في حظائر البناء، وثلاثة سينمائيين وبعض الراقصات لبناء مشهدية عن ذلك القطع.
ولادة الواقع
منذ زمن طويل والفلسفة تروي حكاية محبطة، تقول إن ثمة أنا تبني العالم عبر اللغة والفكر، فيما تبني الأنوات الأخرى الماضي. هذه الحكاية حزينة لأن هذا الموقف الذي يزعم الثورية هو في الواقع محافظ بشكل عميق: بل إنه رجعية خالصة، ونفي لكل حدث. يعلمنا أن لا جديد يمكن أن يصيبنا، سواء في شكل تهديد أو وعد، بدعوى أن العالم كله بداخلنا. في لغة حداثية مبتكرة وبراهين ساخرة ومُرغمة يروي لنا الفيلسوف الإيطالي موريسيو فيرّاريس في كتابه «بروز» حكاية أخرى. الواقع والفكر الذي يعرف ذلك الواقع متأتيان من العالم، عبر مسارات وانفجارات وصدمات وتفاعلات ومقاومات وغيريات لا تنفك عن مفاجأتنا. من البيغ بانغ إلى الأرضة، ومن الإنترنت إلى المسؤولية الأخلاقية، ما يعطينا إياه العالم (أي كل ما هو موجود) يظهر ويتجلى بمعزل عن الأنا وخوفها من الأماكن المغلقة.
ساحات السلطة أم ساحات عامة
على مرّ الأزمنة، حرص الحكام، من يوليوس قيصر ولويس الرابع عشر ونابليون الثالث إلى إسماعيل باشا وهتلر وستالين، على تهيئة ساحات عامة تليق بصورتهم، فهي فضاءات جعلت كي تجسد رؤيتهم السياسية وتعزيز سلطتهم. فتركوا لنا ميادين ملكية، إمبراطورية، قومية، فاشية لا تزال حتى يومنا هذا قائمة في المدن والقرى. ذلك ما تتناوله أستاذة الفلسفة السياسية جويل زاسك في كتابها الجديد «عندما تصبح الساحة عامة»، وتتساءل: إذا كانت تلك غاية الحكام السابقين الذين لا يعترفون إلا بذواتهم ولا يأتمرون إلا بما يمليه عليه فكرهم، فما موقف الحكام في الديمقراطيات الغربية اليوم؟ هل سيطالبون هم أيضا بميادين تليق بمُثلهم وتروّج لأنماط عيشهم؟ والجواب في رأيها بالنفي، مع استثناءات قليلة. الطريف أن هذا السؤال لم يسبق طرحه حتى في أثينا. فمن أين يأتي الخلل؟ وما طبيعة اللاوعي السياسي الذي يجعلنا لا نبصره؟ وأي ميادين في ظل الديمقراطية؟
مديح النزعة المحافظة
لئن كانت النزعة المحافظة طريقة مخصوصة في الوجود، و»مزاجا» يطالب بنصيبه في شتى أنشطة البشر والفنون والموسيقى والآداب والعلوم والدين، والسياسة بطبيعة الحال، فإن الفلسفة السياسية التي استمدت منها اسمها تولدت عن ثورات ثلاث: الثورة الإنكليزية المجيدة عام 1688، والثورة الأميركية التي اكتملت عام 1783، والثورة الفرنسية عام 1789. تاريخ هذا التيار الفكري المنبوذ والمجهول هو ما يقترحه الكاتب والفيلسوف الإنكليزي روجر سكروتن عضو الأكاديمية البريطانية والأستاذ المحاضر بجامعات أوكسفورد وبوسطن وواشنطن، ويعترض على صورة المحافظ النوستالجي، الرجعي الذي يتبدى فكره دائما في حالة حداد، كما يتبدى ذهنه منصرفا بغير انقطاع نحو الماضي، بل يمتدح هذا التيار ليؤكد مدى ما يحويه تراثه من ثراء متعدد الأوجه، اكتسب حقه في الحضور منذ القرن السابع عشر، وأغنى فكر فلاسفة كثر.
سبعة قرون من تاريخ أفريقيا في رواية
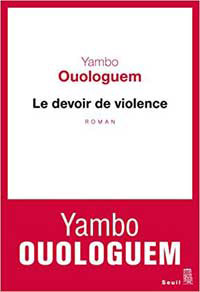
«واجب العنف» للمالي يامبو أولوغوم (1940-2017) رواية كانت سببا في شهرته، حيث كان أول كاتب أفريقي يفوز بجائزة رونودو، وكانت أيضا سببا في انقطاع صوته واعتزاله، فقد اتهم في فرنسا بالسرقة الأدبية، واتهم في بلاده وفي بعض البلدان الأفريقية لتحامله على تاريخها وشعوبها. فآثر الصمت حتى وفاته. الرواية عبارة عن جدارية تراجيدية تمسح تاريخا يمتدّ من القرن الثالث عشر إلى القرن العشرين، عبر تاريخ إمبراطورية متخيلة تدعى ناكِم وآل سيف الذين يحكمونها بغطرسة واستبداد. ومن خلالها يروي تاريخ أفريقيا المجهول، من الداخل، حيث العنف والقتل والمكر وموافقة بعض زعماء القبائل الأفريقية على تجارة الرقيق مقابل عمولات؛ مثلما يسرد بأسلوب ساخر دور أوروبا ومنظومتها الكولونيالية في استعباد شعوب القارة، ويركز على رحلة سبارتاكوس كاسومي، سليل العبيد، وتيهه بحثا عن جذوره. هذه الرواية التي صدرت أول مرة عام 1968، وأعيد نشرها هذه الأيام، تقرأ كعمل أدبي جليل، وكملحمة تنزل صاحبها منزلة الكتّاب الكبار.
كذبة زيمبارو
ظلت «تجربة ستانفورد حول السجن» التي أجراها عالم النفس الأميركي فيليب زيمباردو مثالا علميا ودليلا قاطعا على أثر السجن في نفوس المساجين، وكيف يتحول الإنسان المسالم فيه إلى شخص عدواني عنيف. غير أن عالم الاجتماع الفرنسي تيبو لوتيكسيي أثبت بالدليل في كتابه «حكاية كذبة» أن تلك التجربة كانت أكبر خدعة فكرية في القرن العشرين. ذلك أن التجربة التي أجراها زيمبارو عام 1971 كانت عبارة عن مسرحية رديئة الإخراج، لأن «المساجين» هم طلبة متطوّعون، و»السجن» هو جناح في جامعة ستانفورد، والتجربة التي كان يفترض أن تدوم أسبوعين توقفت بعد ستة أيام، بدعوى أن الحراس (وهم طلبة أيضا) مارسوا عنفا ساديا ضد «المساجين». أما النتائج التي انتهى إليها زيمبارو فكانت محررة مسبقا، والبروتوكول الذي استعمله لا صلة له بالعلم إطلاقا. وبين لوتيكسيي بالوثائق والأدلة الملموسة كيف أن الدافع كان ناتجا عن تنافس أكاديمي، في مرحلة برز فيه الصراع بين الثقافة المضادة والمركب العسكري الصناعي الجامعي.
تحويل الفن إلى سلعة
إنها الحرب، حرب تدور على شتى الأصعدة وتشتد منذ أن صارت موجهة ضد كل ما يستحيل أن نستخلص منه قيمة. عقبها إضفاء القبح على العالم، لأن أول عدوّ، قبل الحلم أو الشغف، كان الجمال الحيّ، الذي يعرف كل شخص مدى تأثيره وإبهاره، مثلما يعرف تمنّعه على الإمساك، كالبرق الخلّب. ولكن بتضافر المال مع نوع من الفن المعاصر يهدف إلى فرض هيمنته دون رد، تحول الفن إلى بضاعة تعتمد على جماليات عامة للتغطية على الطريقة الكارثية لعالم يسير إلى هلاكه، حتى صار القبح والجمال رهانا سياسيا. تلك هي القضية التي تثيرها الكاتبة (السوريالية سابقا) أنّي لو بران في كتاب بعنوان «ما لا ثمن له»، وقد أدانت في كتبها السابقة نجاح رأس المال في تشويه الفن وتحويله إلى سلعة. وتتساءل: حتّامَ نقبل ألّا نرى إلى أي درجة يعمل المال للقضاء على ليلنا الحساس، وجعلنا ننسى المهم، في سعي لاهث لما لا ثمن له؟
الميديا بين مطرقة الحاكم وسندان المال
يحدث أن تسبح الصحافة ضد التيار كما حدث في فرنسا إبان ثورة مايو 68، حيث رفعت معلقات تندد بانحياز وسائل الإعلام للسلطة. في تلك الفترة بالضبط كان يعرض في المكتبات الفرنسية كتاب «الصحافة والسلطة والمال» لجان شويبل (1927-1994) أول رئيس لأول عصبة المحررين في فرنسا، بتقديم للفيلسوف بول ريكور، وهو كتاب يعارض النهج الذي سارت عليه الميديا في ذلك الوقت، وكان شويبل واعيا بتضافر مصالح السلطة الحاكمة ورؤوس المال لقمع كل ما يعكر الصفو، إذ كان عادة ما يقول «أنْ تصمد معناه أنك تخلق، وأن تخلق يعني أنك تصمد». هذا الكتاب أعيد نشره مؤخرا عن دار سوي، بتقديم للصحافي اليساري المشاكس إدوين بلينيل، وقد أكد فيه على ضرورة أن يقرأ الإعلاميون الفرنسيون هذا المصنف كي يستعيدوا شجاعة فقدوها، وصراحة صاروا يعجزون عنها، ويكفوا عن مداعبة السلطان، لأن في ذلك موتهم.




