المختصر
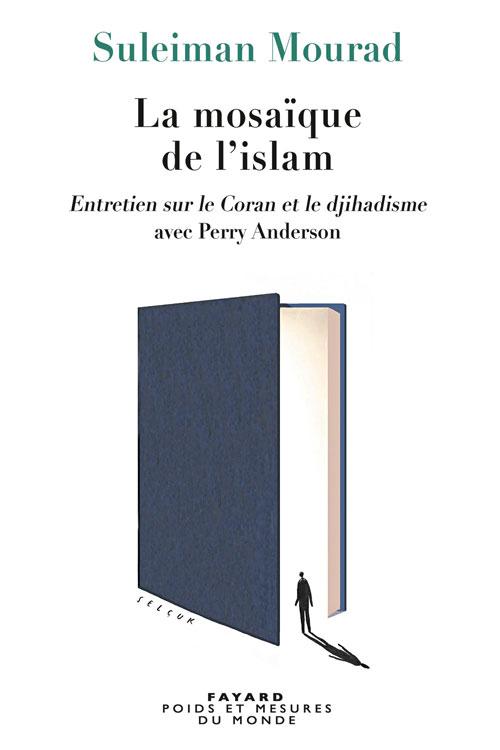
«سلفنة» الأذهان
في كتاب «فسيفساء الإسلام» يبين اللبناني سليمان مراد أستاذ تاريخ الإسلام وحضارته بماساشوست لمحاوره الأمريكي بيري أندرسن أستاذ التاريخ وعلم الاجتماع بكاليفورنيا أن الإسلام ليس واحدا بل متعدد، إذ انقسم منذ ظهوره إلى مذاهب ونحل، مع ما يتبع ذلك من تباين الشعائر، وكيف أن المسلمين بعد صدمة الاستعمار زهدوا في عمومهم في اعتبار الدين حلا لمشاكلهم التنموية والاقتصادية، فأصبح تدينهم معتدلا يمارسونه ممارسة أقرب إلى التقاليد دون تعصب ولا تزمت.
العلاقات المتوترة داخل البيت
بعد نجاح روايتها الأولى «في حديقة الغول»، صدرت للكاتبة المغربية ليلى سليماني رواية جديدة بعنوان «أغنية حلوة» تطرح فيها مشكلة من مشاكل الحياة العصرية، عبر تصوير العلاقات المتوترة بين زوجين عربيين من جه وبين مربية فرنسية يلجآن إليها لرعاية طفليهما من جهة ثانية، بعد أن قررت الزوجة استئناف عملها بمكتب محاماة.
مواطنون من الدرجة الثانية

عرف مجيد شرفي، الذي رأى النور عام 1962 بإحدى ضواحي مدينة تولوز، كمؤلف أغانٍ لفرقة «زبدة» وأحد مغنيها، ثم كمغنّ وممثل، قبل أن ينتقل إلى الكتابة ليروي واقع الحياة في ضواحي المدن الفرنسية كما في عمليه السابقين «دفتر عائلي» و»الجَلد». في روايته الجديدة «جانبي الغولي» (نسبة إلى الاسم القديم لفرنسا) التي دخلت القائمة الأولى لجائزة غونكور، جانب من سيرته الذاتية، عن نجاحه المدرسي الذي شكل نشازا في حي يعتبر إخفاق أبناء المهاجرين قاعدة، عن آماله عقب وصول الاشتراكي فرنسوا ميتران إلى الحكم، وخيباته بعد أن تكشفت التجربة عن هباء أو يكاد، وبالتالي خيبات جيل كامل كان يعقد الأمل على الاشتراكيين لتغيير واقع الضواحي البائس. بأسلوب يجمع بين الجد والهزل، يطرح الكاتب مسألة الهوية وعجز الجمهورية عن إدماج أبنائها، وعن إقحامهم سوق الشغل، فضلا عن الميز الذي لا يزال قائما حتى اليوم، في التعامل مع أبناء المهاجرين واعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية.
متاعب العمل الثاني
«بيست سيلر» أو «الكتاب الأكثر مبيعا» هو عنوان الرواية الثانية للكاتب والصحافي المغربي رضا دليل، وبطلها روائي ينال الشهرة والمجد عن رواية أولى، فينصرف عن الكتابة ليغنم ما يأتي من وراء هذه العمل الذي جعل منه نجما بارزا في سماء الدار البيضاء، حيث تتعدد الدعوات وترتفع المبيعات وتنهال المكاسب، وفي ظنه أن ذلك سيدوم إلى ما لا نهاية، ولكن بعد مضي أعوام يخفت نجمه ويلتفت النقاد إلى سواه، فيضطر إلى الجلوس لإبداع عمل ثان. هذا العمل الثاني سيستعصي عليه، وسيلفي نفسه عاجزا أمام الصفحة البيضاء، لا يدري ما يكتب. وبما أنه قد أصبح في الأثناء ربّ أسرة، فقد صار يشعر أن المخرج الوحيد بالنسبة إليه هو «بيست سيلر» وإلا فالإفلاس على الأبواب. الرواية يمكن أن تقرأ كسيرة ذاتية، فالكاتب صمت أيضا بعد عمل روائي أول، قبل إنجازه هذا العمل الذي نال جائزة لاغاردير التقديرية هذا العام، ويمكن أن تقرأ كنقد اجتماعي لواقع مدينة عملاقة مليئة بالمتناقضات.
الحنين في بلد غريب
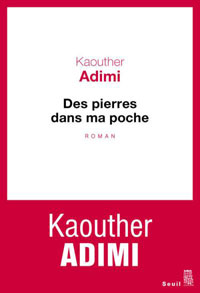
«أحجار في جيبي» للجزائرية كوثر أديمي رواية ثانية بعد «قفا الآخرين» تسرد قصة امرأة في الثلاثين تعيش وتعمل في باريس، وبرغم ما حولها من مغريات كانت غالبا ما تجلس على مقعد جنب امرأة مشرّدة تقبل أحيانا الحديث إليها، عن الحب وآلامه، فيما كانت المرأة الشابة تعدّ أحجارا في جيبها، وتتوارد مع العدّ خواطر تدور في ذهنها، والتزامات لا بدّ من أدائها. كتلك التي ترغمها على الجلوس إلى مكتب وهي تتصنع السعادة في بلد غريب، أو الردّ على مكالمات لا تنتهي من أمها التي تخشى عنوسة ابنتها البعيدة، أو العودة إلى موطنها لحضور زواج أختها مع صورة أولئك الذين يغادرون أوطانهم ولا يعودون. ولكن أعسرها، وأكثرها حضورا في نفسها حد الهوس، هو قبول الغياب الفادح لأصدقاء الطفولة، والتمرد الدائم ضد سلطة جائرة، والحنين الممض إلى مدينتها، الجزائر العاصمة، بألوانها الزاهية وأضوائها التي تعشي الأبصار.
الارتحال إلى الصحراء وتقاليدها
جديد مبارك ولد بيروك الموريتاني المسكون بقصص الصحراء رواية بعنوان «طبل الدموع» عن فتاة يغريها أحدهم ثم يهجرها بعد قضاء وطره، فترغمها أمها على ترك وليدها ومغادرة القرية لاتقاء الفضيحة. تحمل ريحانة في رحيلها طبل القبيلة السحري، هذا الطبل الذي ما كان له أن يغادر القرية ولا أن يدنّس، عسى أن يحميها من الشرور، وتعد نفسها بالعودة إلى ابنها طال الزمان أم قصر. في رحلتها تروي حكايتها الماضية والراهنة، فتتمازج معاناتها بتواتر الفصول، ويتخذ الكاتب تلك الرحلة مطية لوصف الحياة في الصحراء، وعيشة القبائل خارج مضارب البدو القديمة، وكذلك تصوير العادات والتقاليد التي لا تزال سائدة في موريتانيا، كالاسترقاق مثلا. إذ تبدو ريحانة، الهاربة من القرية والقبيلة، باتجاه المدينة، كامرأة تحررت من قيد، هو الإنجاب خارج الزواج، إلى قيد آخر، هو العهر داخل المدينة، الذي يلمّح الكاتب ألا مفر منه لامرأة وحيدة، ليس لها من حامٍ يحميها.
التاريخ بين الحتمية والاحتمال
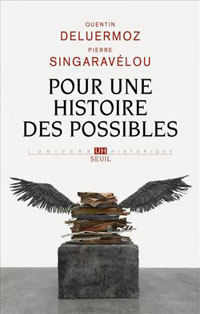
ماذا كان يحدث لو جرى التاريخ أو الحياة مجرى آخر؟ ما نسميه التفكير ضد الوقائعي يتخلل النقاش بعفوية ويغذي فرضيات عن إمكانات ماض لم تتحقق أو وقائع مستقبل لم تقع. نجد ذلك في الأدب مثلما نجده في التأملات السياسية. ماذا كان يحدث لو أن أنف كليوباترا كان أقصر، ولو أن نابليون لم ينهزم في واترلو...؟ في كتاب طريف يجمع بين المعرفة والخيال المستند إلى معطيات تاريخية ثابتة عنوانه «لأجل تاريخ الممكنات» يحلل كنتان دوليرموز الأستاذ المحاضر بجامع باريس 13، المتخصص في التاريخ الاجتماعي والثقافي للقرن التاسع عشر، وبيير سنغارافيلو أستاذ التاريخ المعاصر بالسربون المتخصص في تاريخ الاستعمار في القرنين التاسع عشر والعشرين، الاستعمال ضد الوقائعي، سواء في الأعمال الأدبية أو في الفرضيات الجدلية، للإحاطة بظروف استعمالها استعمالا ملائما في العلوم الاجتماعية، والوقوف على رهانات السببية والحقيقة، والعلاقات بين التاريخ والأدب التخييلي، بين الحتمية والاحتمال.
مَودع الأسرار
جديد الكاتبة والصحافية التونسية المهاجرة فوزية الزوراي رواية بعنوان «جسد أمّي»، بمقدمة دبجها الكاتب الجزائري بوعلام صنصال. تبدأ الرواية منذ أن وقفت الساردة عند رأس أمها وهي مسجاة على سرير بالمستشفى، عارية «أي مكشوفة الشعر» حسب التقاليد البربرية، لتحفر في تاريخها المخفي، وهو تاريخ القبيلة كلها، بوصف المرأة مودع الأسرار وحافظة الذاكرة الجمعية، بفضلها تظل روابط القبيلة ملتحمة. وتكشف للقارئ أن خلف الغنائية التي تمجد الشرق وألوانه وعطوره وحليه وديباجه، وتشدو بأضوائه وصفاء سمائه، مآسيَ كبرى تعيشها النساء، المشدودات إلى تقاليد العصور القديمة، في جوّ يعبق بروائح البخور وصدى الأهازيج، ويتجاور في أرجائه الأحياء والأموات، التمائم والحروز، مثلما تكتشف في النهاية أن يامنة، أمها، كانت متمردة على طريقتها، تعيش عيشة غير التي يظنّها كل من حولها، بمن فيهم زوجها وبناتها.
النقاش كأسلوب حياة
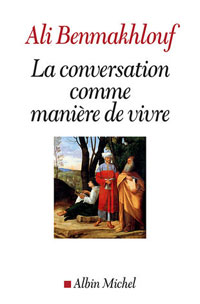
هذا عنوان كتاب جديد للفيلسوف المغربي علي بنمخلوف، يبين فيه أن النقاش يصل الناس بعضهم ببعض عن طريق الكلام. وهذا الرابط يمر عبر الصوت والنفَس والنظرة ووتيرة الصمت والحركات. ويستشهد بمونتاني الذي كان يقول عن التحاور والتناقش: «نحن بصدد كيفية القول، لا مادة القول». وفي رأي الكاتب أن النقاش ليس استدلالا، بل هو كلام في طور الحركة، وليس حكمة جاهزة بقدر ما هو أسلوب حياة. وعلى غرار مونتاني أيضا يستكشف الكاتب الثراء الكامن في الانعطافات والاستطرادات والكلام المتقطع الذي يوقظ الأذهان. ويستقرئ الأدب، من فلوبير إلى سان سيمون ولويس كارول، في نقاش داخلي صامت، مع المؤلف الذي اندثر، والكتاب الذي بين يديه، أو الذي يرقد جنبه، ليستخلص في النهاية أن في النقاش مخاطر، خطر العلاقة التي قد تربط المرء بهذا أو ذاك، وخطر المجهول الذي يحملنا إليه ذلك النقاش، الفكري بالأساس.
قاموس جديد عن المتوسط
«قاموس البحر الأبيض المتوسط» عمل ضخم صدر عن دار آكت سود تحت إشراف متخصصين هم ديونيجي ألبيرا وماريلين كريفيلو ومحمد الطوزي، ويتنظر أن يصدر في طبعته العربية في غضون الشهور القادمة عن مؤسسة الملك عبر العزيز بالدار البيضاء. وهو خلاصة أشغال حديثة تركزت عل المعارف والمناطق والذاكرة والأعلام والممارسات داخل فضاء بالغ الثراء والتعقيد، وجمعت بين العلوم الإنسانية والاجتماعية، وحقول النظر العلمي الراهن. الكتاب يطرح موضوعة المتوسط في إطاره الجغرافي والثقافي والتاريخي، ويستكشف مختلف أوجهه، من الخصائص الجامعة إلى عوامل القطيعة المتواترة. هذا القاموس لا يحمل صبغة قاموسية بل غاية واضعيه أن يكون وسيلة عمل ومحملا للتفكر والتأمل، سواء من طرف الطلاب والباحثين، أو من قبل العاملين في الحقول الثقافية والاقتصادية والسياسية، وحتى من طرف القراء الذين يهمهم مستقبل الفضاء المتوسطي.
إمكانات التمثيل السياسي
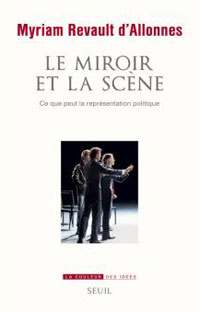
«المرآة والخشبة» كتاب جديد للفيلسوفة الفرنسية ميريام ريفو دالون، تعارض فيه المقاربة التي تقصر مفهوم التمثيل على بعدها التشريعي السياسي، وتعود إلى مصدرين أوليين: الرسم والمسرح، لتسائل الكيفية التي يشتغل بها بشكل خفي هذان العنصران داخل الجدل القائم حول التمثيل السياسي، في قصوره وعدم وتلاؤمه، وتكتشف أن اضطرابات التمثيل السياسي الحديث مرتبطة بطبيعة «كائننا المشترك»، لأن ما يكون متصلا، لا يمكن أن يمنح نفسه بطريقة مفارقة في عدم الالتقاء مع النفس وتجربة الانفصال. ومن ثَمّ فمن الوهم التفكير بأن التمثيل يمكن أن «يصور» الواقع بكيفية شفافة ومناسبة. وإن كان ثمة سبل أخرى أمام المواطنين كي يكونوا ممثَّلين ويظهروا علانية إمكاناتِ طبيعة الرابط التمثيلي، وهي آفاق جديدة تُدرج التمثيلية تحت علامة إعادة التصوير بدل إحالتها على استحالة تصور مشترك لا يني ينفلت.
الآداب والفنون صورة عن جمال العالم
جان ستاروبنسكي هو كاتب وناقد وفيلسوف ما انفك يطرح قضايا يلتقي فيها الأدب والفن بالتنظير والتأمل الفلسفي. في كتابه الجديد «جمال العالم»، الذي يمسح ما يزيد عن ألف وثلاثمائة صفحة، يبدو ستاروبنسكي قارئا فطنا يتقن الجمع بين دقة الوصف وعمق التحليل، وهو يستكشف مناطق جديدة، غير تلك التي عهدناها في عصر الأنوار أو في تاريخ الأفكار الطبية، بل هي مناطق الشعر والفن التشكيلي والموسيقى، ربات إلهام ثلاث تشكل عنده حلقة لم يفارقها أبدا. يحوي الكتاب نحو مائة دراسة كتبها طوال ستين عاما يستشف من خلالها القارئ كيف أن الآداب والفنون تعكس جمال العالم، والناقد، بوصفه قارئا ومشاهدا ومستمعا، يحتفي بمكونات ذلك الجمال، وهذا ليس غريبا على كاتب جعل النقد شكلا من أشكال الفن، عبر هوسه، واختياراته المنهجية، وحرصه على الوضوح والمشاركة. والكاتب إذ يحرص على إظهار ما في الآداب والفنون من جمال إنما يقدم شهادة عن دماثة الوجود الإنساني في مواجهة قوى التدمير، وذلك هو الدرس الذي ما انفك ستاروبنسكي يلقيه على البشرية جمعاء في سائر مؤلفاته.




