الوظيفة الاستبدادية للتراث

ننطلق في هذه المقالة من فكرة مفادها أن التراث أداة قهرية في يد نظام الحكم في المغرب، غرضها تبرير شرعيته الدينية والتاريخية والسياسية، وبالتالي إضفاء الشرعية على وجوده واستمراريته أمام أيّ تمرّد أو عصيان، وبما أن هذه الاستمرارية رهينة في جزء منها بالتراث الذي أضحى وسيلة أيديولوجية تساهم في رضوخ المجتمع للاستبداد الذي يعيشه، هذا من جهة، أما من جهة ثانية فنحن في حاجة إلى إعادة النظر في هذا التراكم الذي يسمّى التراث عبر الشك في هذا التاريخ الذي وصلنا عبر الرواية الرسمية.
لا جدال في أن المجتمع المغربي مثله كمثل جميع المجتمعات العربية، يعيش الاستبداد على كافة المستويات والأصعدة: اقتصاديا وسياسيا وأيديولوجيا، ورغم العلاقة الجدلية التي تربط بين كل المستويات إلا أننا سنقتصر على مستويين أساسيين هما: علاقة الأيديولوجي بالسياسي، وذلك اعتقادا منا أن التراث يمكن أن يصبح موضوعا أو أداة أيديولوجية ينطلق منها النظام السياسي لتأسيس شرعيته السياسية، معتمدا على سرديات هو من قام منذ البداية ببنائها وترسيخها في ذاكرة المجتمع، بهدف العودة إليها دائما لاستعمالها في إخضاع المعارضين له؛ وبالتالي ضمان استمراريته في الحكم.
ففي الفصل الأول من كتاب عبدالله حمودي “الشيخ والمريد: النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثة” يطرح سؤالا محيرا وهو: كيف نفسر موقف أغلبية شعبية خاضعة للحرمان تبدو راضية رغم ذلك؟ وأثناء إجابته على هذا السؤال جمع حمودي بين ثلاثة مفاهيم أساسية: “البيعة” “اللدونية” و “التحكم”، ليؤكد أن المجتمع المغربي باعتباره أمة مسلمة مصغرة، تنصِّب الملك أميرا للمؤمنين، ويعتبر هذا اللّقب الأساس المنيع للسلطة، وهو في الوقت نفسه تحصين يصمد في وجه كل من ينازعه المنصب الأسمى، فأي مضايقة أو انتقاد، ما عدا النصيحة الشرعية، يعتبر خيانة وانتهاكا للمقدسات وهذان المفهومان لا ينفصلان، لأن مهاجمته مخالفة لقانون مقدس ونزع للقداسة عن أسمى وجوه الكيان الإسلامي وركائزه، والله يدعو إلى انتقاء من ترضيه الأمة، ويأمر ألاّ تبقى الأمة دون إمام؛ هذا هو البرهان الرادع لكل عصيان أو تمرد.
نلاحظ أن هذا البرهان مستوحى من التأويل الخاص للسيرة الإسلامية ومن ممارسة خاضعة للبيعة، ولحّ ـ حسب حمودي – مناصرو هذا الكيان القائم باسم الحق المقدس على الخصال الرفيعة للعائلة الملكية وعلى منجزاتها. “فالملك باعتباره ينحدر من سلالة الرسول يشكل في أعين الشعب ‘معجزة’، شغله الشاغل إقامة أمة تسير وفقا لكلام الله، وتؤسس للنظام” لذلك فإن الصورة التي كانت عليها الأمور في المغرب في الماضي تستمر حتى الآن، أما الجديد الذي نراه ونتفق معه هو أن تقديم البيعة وحفل الولاء المرافق لها، ينقلان اليوم في كل العيون والأدمغة بوسائل إعلام ضخمة لا سابق لها. إن طقس الخضوع هذا الذي يقدمه الشعب يحيل على أن الأمير فوق الجميع، ويؤكد الفكرة القائلة بأن النسب الشريف أساس الأمة المغربية وضمان بقائها منذ القرن الثامن عشر مجرد وجهة نظر حديثة.
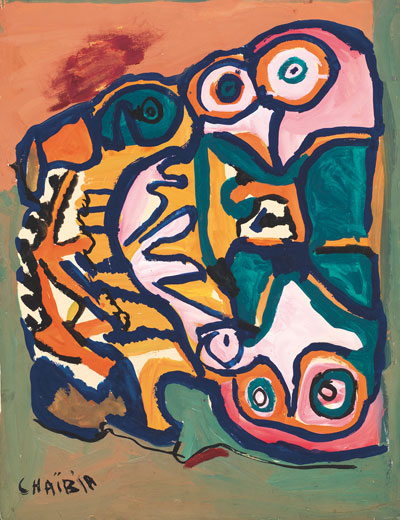
مكننا كمال عبداللطيف من قراءة المتون السلطانية، إذ بيّن في كتابه “في تشريح أصول الاستبداد قراءة في الآداب السلطانية” ملامح السلطة المستبدة السائدة، كما بيّن المسوغات التي تحوّل الشأن الملكي إلى شأن قريب من الشأن الإلهي، فتكون عناية الملك بالعامة والخاصة أي رعايته لرعيته، مماثلة لعناية الله بالعالم.
يتوسل نظام الحكم بالتراث، من أجل ترسيخ العرف الشائع الذي يخدم مصالحه قبل كل شيء، ويعزو سطوة التقاليد من خلال آيات وأحاديث قدموا لها تأويلهم الخاص، إذ يبرزون من خلالها تلك الجوانب التي تؤكد القناعة بأمر الواقع والخضوع للاستبداد، أما الجوانب الثورية في التراث، وجوانب التحرر والإبداع والتغيير، والعدل والكرامة الإنسانية ورفض الطغيان فيسدل عليها ستار كثيف من التعتيم، هكذا يصبح كل ما هو عصري يساعد الإنسان على تحرير ذاته وامتلاكه لزمام مصيره “بدعة”، وكل دعوة إلى العدل والعدالة والكرامة “فتنة“، هكذا يتحول التراث إلى سلاح المتسلط على رقاب المغلوبين، “يخدر النقد” ويخلق “مجتمعا بلا معارض”
إن ما وصلنا من روايات تاريخية والتراث المتعلق بها، لا يمكن الوثوق به دائما، لأن كل هذا الإرث وهذه الروايات تكون روايات أحادية الجانب وربما خاطئة، باعتبارها مجموعة من السرديات عملت السلطة الحاكمة على بنائها وصياغتها في ظروف سياسية معينة، معتمدة في ذلك على “المؤرخ السلطاني” الذي يكتب التاريخ الرسمي، مما يطعن في مقولة “موضوعية المعرفة التاريخية”؛ هكذا تأسست عندنا الرواية الرسمية التي أضحت أداة أيديولوجية وهذا ما يؤكده فالتر بنيامين في أطروحته السادسة عندما يرى أن التعبير تاريخيا عما حدث، لا يعني التعرف عليه كما كان في الواقع، ومن هنا لا يمكننا أن نتحدث عن شيء اسمه “موضوعية المعرفة التاريخية” ولا عن استقلالية المؤرخ وحياده، وفي نفس السياق يقول “إن الخطر الذي يتهدد استمرار التقاليد كما يتهدد أتباعها.. خطر التحول إلى أداة للطبقة الحاكمة يتوجب في كل حقبة محاولة استعادة التراث من جديد من قوى امتثالية التي تسعى إلى قهره“. وأعتقد أن المفهوم الذي يجب أن نتوقف عنده هو مفهوم التراث، الذي يراه بنيامين بمثابة أرضية للصراع بين المنتصرين والمنهزمين؛ فللمنتصرين تراثهم المرتبط بسيرورته القائمة على الاستمرارية التاريخية الذي يستعملونه لصالحهم، وعلى المنهزمين أن “يفرملوا” التاريخ من أجل القيام بثورتهم وهذه هي المسؤولية الملقاة على عاتق “المؤرخ المادي التاريخي” وعليه؛ فإن التراث أداة قهرية في يد المنتصرين لإخضاع المهزومين، من هنا يصل بنيامين إلى الحقيقة التالية: حتى الأموات لن يأمنوا شر العدو إذا انتصر. وهذا العدو لم يتوقف البتة عن الانتصار.
إننا في حاجة إلى نزع القداسة عن هذا التاريخ، عبر مساءلة فرضيات الرواية التاريخية الرسمية، ونقول مدركين بأن أي تأريخ للثقافة هو بالضرورة تأسيس للسيطرة، يقول فالتر بنيامين “إن ما يُنظر إليه كتراث ثقافي هو في جملته من أصل لا يمكن التفكير فيه دون الشعور بالفزع، ولا يدين وجود هذا التراث بوجوده فقط لجهد العباقرة الذين خلقوه، بل أيضا للعمل الجسدي المرهق الذي تحمّله معاصروهم، فلا يمكنه البتة أن يكون وثيقة للحضارة دون أن يكون في الوقت ذاته وثيقة بربرية، وبما أنه ليس حرا من البربرية، فإن سيرورة انتقاله من واحدة إلى أخرى، ليست هي الأخرى حرة من ذلك”، إننا حقا في حاجة إلى فرملة التاريخ وتمشيطه في الاتجاه المعاكس، وعليه فإن التراث ساحة للاحتمالات المفتوحة للخلاص والانعتاق دوما.




