الوعي بالوجود

يقول جوليان هكسلي (إن ظهور الوعي الانساني يعني ظهور الهدف المتطور)، وهذا الهدف المتطور هو دافع مقاومة الإنسان ورفضه لسقوط الموت، من حيث كونه رافض – الموت – لهذه الفكرة أو لا يريد الاعتراف بها.
إن نظام الطبيعة حول الإنسان، حالة متشنجة من الوعي البدائي الساكن، لا تدرك حالة تطور وعي الإنسان وانتقاله من طور الحيوان الخام، إلى الطور الذي يعيشه الآن، وهو طور ما بين الحيوان والإنسان الكامل أو الحقيقي. وطبعاً سيقول قائل، أن حلقة أو طور الإنسان الكامل هذه، هي مجرد افتراض تفاؤلي، مبعثه تطور وعي الإنسان وتقدمه العلمي والتكنولوجي، ونقول هنا أن حلقة التطور هذه مادامت قد بدأت، بهذا الاضطراد الذي نراه، فلا بد لها من طور للاكتمال والتكامل، وفقاً لقوانين الطبيعة وسيرورتها التي بين أيدينا ونعيشها، والتي تدلل على تطور أغلب أحياء الطبيعة الحية، وليس الإنسان وحده. لكن طرفاً من المشكلة يبقى تحت سيطرة وعي الطبيعة الساكن، وهو وقوف هذا الوعي عند نقطة وصول كائناتها لسن النضج، التي لا بد لها من بدء عملية نزول تتبعها، كما يفعل من يبلغ قمة جبل عال، ولا يعود أمامه المزيد ليبلغه، وعليه فلا بد له من معاودة النزول إلى قاعدة الجبل أو الأرض، وهذا ما يحتمه وعي الطبيعة على موجوداتها، إنساناً وحيواناً ونباتات، بل وحتى جمادات، لأن وعي الطبيعة، غير القابل للتطور، أو غير المستوعب لفكرة الوعي التطوري، يحتم عودة جميع موجوداتها إلى رحمها، أو الذوبان فيها، بعد أن أدى الدور الذي رأته أو قرره لها وعيها الساكن، وهذا ما يرفضه وعي الإنسان، الكائن الذي يمتلك قابلية تطوير وعيه، ووعيه المتطور هذا هو الذي يقوده إلى رفض آلية اشتغال وعي الطبيعة المتحجر عند صيغة وعيها البدائي، الذي يحتم انقياد الانسان إلى الموت، كباقي الكائنات، والتحلل والذوبان في التربة، التي تمتص مكوناته لتعيد إنتاجها من جديد.
ورغم أن الانسان قد بلغ مرحلة الوعي المتطور هذه وبنى أسباباً وأهداف واعية لرفض حالة تحجر وعي الطبيعة، على الصعيد الفردي على الأقل (وهنا، أي في حدود الذاتية المحضة، من حيث كون أن كل فرد أو ذات إنسان، تمثل لصاحبها كياناً خاصاً ومستقلاً، يرى عبره فقط قيام العالم الخارجي أو انهياره وتلاشيه، بتلاشي ذاته وكينونته هو، لا ببقاء واستمرار النوع من بعده)، إلا أن الإنسان مازال لم يهتد للطريقة التي تجعل أو تجبر الطبيعة على التكيف مع وعيه المتطور هذا.
ولنقرب هذه الفكرة نقول، إن مكتشف البنسلين، على سبيل المثال، أو مكتشف السيارة أو الكومبيوتر… أو …. أو….. كلهم ماتوا ودفنوا وتحللوا في التربة وعادوا كجزء ذائب، وبلا معالم ذاتية أو كينونة مستقلة، في الطبيعة؛ وهذا يعني أن العالم والطبيعة وجميع موجودات الكون، تموت، بالنسبة إلى الذات الإنسانية بموتها هي، أي أن كل شيء يختفي باختفاء أي كينونة ذاتية كانت تمثل وجود شخص من الأشخاص، بما فيهم كبار العلماء والمكتشفين، الذين مازالت منجزاتهم ماثلة ومستخدمة من قبل البشرية. لكن أين هو نيوتن ولويس باستير ومير كوري وداروين، كأشخاص؟ لقد اختفت ذواتهم من على الأرض ولم يعد لهم ذلك الوجود العياني الذي كان العالم والناس المحيطين بهم يعرفونهم به وعبره. ولو نبشنا الآن قبورهم فربما حتى لن نجد بعض عظامهم، فقد تحلل وجودهم الكياني الذي كانوا يمارسون الحياة عبره وكنا نعرفهم من خلاله، وهذا يعني أن كل هؤلاء العلماء والمكتشفين قد اختفوا وذابوا ولم يعد لهم وجود ذاتي عيني محسوس، رغم بقاء منجزاتهم قيد العمل واستفادة البشرية منها في حياتها اليومية.
ومن بين أهم ما أنتجه الهدف المتطور، هو تأكيده لامتلاك الانسان، لإرادة التفكير وإرادة الفعل، رغم بقاء الحياة على غموضها في التعامل معه، وبصيغة التجاهل الذي يثير الحنق والاستياء، وهذا ما يدفع الإنسان للتفكير بوجود عمق آخر في الحياة مازال لم يدركه، وبسبب عدم إدراكه له فإنه يبحث عنه في عالم ما وراء الطبيعة وخلف جدار المحسوسات، رغم أنه قد أحدث خرقاً عملياً في هذا الجدار، بنزوله على القمر وسباحته في الفضاء الخارجي وإرساله المسابر والسفن الفضائية إلى كواكب أخرى غير القمر.
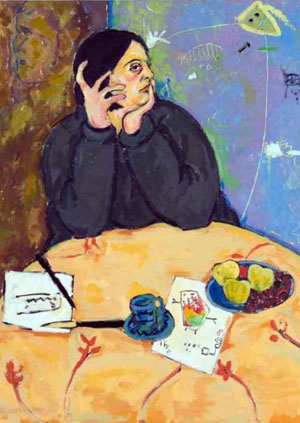
ولكن يبقى الوعي المتطور وما أنتجه من أهداف متطورة، في حدود العارض والتافه، أمام لامبالاة الموت به وبالإنسان ذاته، عندما يسحقه بصيغة تسلطه، في لحظة واحدة.. وهذا يعني أن الموت سلطة تتفيه وتحقير للإنسان ولكل ما وصل إليه من وعي وإنتاج عقلي متميز، فكرياً وعلمياً وثقافياً. وتأتي ضربة الموت في غفلة لتقول للفرد، بسخرية صلفة: اذهب أنت وكلّ جهدك إلى العدم، وكان عليك أن تصدق منذ البداية أنك تافه ولا تساوي شيئاً، مهما فعلت وأنجزت. وهنا يأتي السؤال الذي يثير جنون الإنسان وعجزت الفلسفة عن الإجابة عليه: ماذا كان عليّ أن أفعل غير الذي ضيعت حياتي في فعله؟ هل كان صموئيل بكيت على حق برؤيته النافذة (لا شيء يمكن فعله أو يستحق فعله)؟ أنا ذهبت إلى المدرسة وتعلمت في ظروف قاسية، ثم شقى أمي وأبي لكي أدخل الجامعة وأحصل على إجازة علمية، وها أنا عملت وتزوجت وأنجبت… وبعد كل هذا العناء ها هو الموت يتربص بي على بعد خطوات، هل أنفقت جهدي في المنطقة الخطأ؟ أنا كنت أبحث عن منفذ للهروب من سطحية الحياة وتفاهة النهاية التي تنتظرني، فأين يقبع هذا المنفذ؟ ألم يكن الأجدر بالجامعة أن تدلني عليه، بدل اللغو الذي حشتني به؟ وها أنا الآن، على مسافة ذراع من الموت، وهذا يثبت لي أن كل ما فعلت في حياتي، ليس هو ما كان يجب أن أهدر سنوات تعليمي، بل وعمري كله، من أجل تعلمه.. فماذا كان عليّ أن أفعل إذاً، بدل هدر الوقت وفرصة الوجود في هذه الحياة التي تنتهي بالموت التتفيهي والتحقيّري للذات وكيانها الفاعل؟
إن صيغة ازدواجية الباب الدوار، (الدخول يعني الخروج، إذا لم تتخذ القرار باتجاه أي منهما، في الوقت المناسب)، التي تنتهجها الحياة مع الانسان، تعني من ضمن ما تعنيه، أن المشكلة في النشأة والتركيب الأول، وليست مشكلة ثقافية، رغم أن العارضية الثقافية تلوح في أحد جوانبها، لكنها في الواقع ليست سوى خداع بصر في هذا الجانب، إلا بقدر تحمل بعض المثقفين (الكتّاب) لمسؤولية سحب غير الفلاسفة إلى منطقة إلهاء عرضية، شبيهة بالمنطقة التي حاول همنغواي الروائي (المثقف) سحب نفسه إليها، كنوع من إلهاء النفس عن مواجهة المشكلة (رحلات صيده في الغابات الأفريقية وسفراته المتواصلة لحضور كرنفالات مصارعة الثيران في إسبانيا) قبل أن يواجهه فشل هذه المحاولات وينتحر بتصويب إطلاقة إلى رأسه، من بندقية صيده القديمة، ليعلن لنا أن ليس ثمة طريقة للهروب على الإطلاق. وهذا يعني، من ضمن ما يعنيه، أن الإنسان ليس كائناً سلبياً باختياره الثقافي، كما صرح كولن ولسن، في أكثر من مكان، وفق تفاؤليته الساذجة، وإن المشكلة لا تتعلق بقضية تطوير أدوات السيطرة على الشعور بالسلبية (كون الإنسان كائناً سلبياً بالفطرة)، إنما هي تكمن في محدودية الطبيعة ومعطياتها، كحاضن أساس للوجود، والتي فاقها الإنسان في التطور وبذل الجهد، في حين أنها داومت على سلبيتها وعلى محاربة جهده، والأهم تهميش دوره في المشروع الكوني، من النقطة أو الزاوية التي يراه منها.
والمشكلة أن معظم الأديان جاءت لتقف مع الطبيعة ضد الإنسان، في تهميشه، وعياً وجهداً، بل ولتتفيهه ذاتاً ومشروعاً، وحصره في أضيق دائرة، دائرة عين الدودة الزاحفة على بطنها، بالقول بأن لا عمل ولا غاية لوجود الإنسان غير طاعة الإله، التي لا يحتاجها الإله من الأساس وهو في غنى عنها بذاته. إذن الإنسان يولد ليموت فقط هنا؟
***
الوجود في هيئته التي نعيشها، غير مرضٍ، غير نقي، تلتصق أشياءه بطريقة هلامية وغير نظامية، أي إنها موجودة بذاتها، ولكن ليس لذاتها تماماً، وهذا يشمل الانسان ذاته، ومن هنا يأتي تبدد شعوره بحق الوجود للذات، وهي حالة يقينية، ليس بسبب وجود الموت، بل بسبب نقص في معطيات الحياة من الأساس. أي أن الوجود ولد ناقصاً، وهذا ما شعر به ألدوس هكسلي، وهو تحت تأثير المخدر (إن الذي رآه آدم في صبيحة اليوم الأول من خلقه هو المعجزة، ثم تدريجياً، الوجود العاري). والآن لنا أن نضيف أن ما رآه آدم في يوم موته هو الصدمة الكبرى، فقد فعل كل ما أتيح له، أكل وشرب ومارس الجنس مع حواء وأنجب أولاداً وبناتاً… وها هو يموت ويتحول إلى جثة يجب أن تدفن بعيداً، وهو يتساءل، وهذا هو المهم: ما فائدة أن أكرّر هذا في حياة أخرى، حتى لو كانت أبدية؟ هل تستحق رعشة الجنس، لبضعة ثوان، وطعام يجبرني على التغوط، كل هذا الشقاء الذي عانيت هنا؟ وهكذا تكرر الأمر، منذ تلك اللحظة الافتراضية لبداية الحياة، ولم يتغير سلوكها بالمطلق، وهذا يعني أن نظام الوجود لا يريد بالإنسان خيراً كثيراً، بل إنه يعاديه في أغلب الأحيان.
***
أغلب الوقت، قانون الحياة، قانون الوجود، أو قانون الطبيعة، سمّه ما شئت، يعاملنا كأننا دمى تافهة من القش، وهي – تلك القوانين – لا تتذكر أننا كائنات حية إلا عندما تقرر موتنا، فعندها فقط تتذكر كوننا كائنات حية وتمتلك ما يمكن أن تفقده ليحيلها إلى جثث قابلة للتعفن والاندثار في لجة العدم؛ وهذا يعني، من ضمن ما يعنيه، أن ثمة جانبا عبثيا في جانب القرار العام وقرار التسيير، وهذا الجانب هو المسؤول عن قصور الرؤية التي يُنظر عبرها إلى الإنسان باحتقار وتتفيه لقيمته وحقوقه، وهذا ما يكرّس شعور الإنسان بالضرورة، بأن إرادته وحريته هما موضع التجاذب، بينه وبين الطبيعة، في النهاية. أي إن الأمر ينكشف في النهاية، وخاصة عند دنو الموت، عن كونه صراع إرادات وأن جولة الإنسان، في نهاية المطاف، يجب أن تنتهي بهزيمة إرادته، لأن بقاءه وهو بكامل إرادته إنما يعني تحرره من سطوة “الباب الدوار” وامتلاكه لقرار الخروج إلى ما بعده، هذا المابعد الذي قد يوفر له المزيد من الإرادة والمزيد من التحرر من سطوة الطبيعة البدائية، والمزيد من الإحساس بأنه ليس بيدقاً بيد، استمرت على تحريكه، منذ لحظة ولادته، بلا هدف حقيقي يتعلق بكيانه الذاتي وإرادته التي ترفض الاستسلام لغيبوبة الموت إلى آخر لحظة تسبق حدوث وتحقق فعل الموت.
***
من جهة، وإن لفتها بعض الضبابية، فإن الإنسان لا يكف عن الإيمان باحتمالية أن تؤدي (دورانية) الباب الدوار إلى جانب، ولو شاحب، من الحقيقة، رغم أنه مازال متأرجح اليقين بشأنها، بسبب استمرار تربص الموت به، خلف شباك غرفة نومه، وتركيز عينيه في كيانه. وربما هذا الوضع الخارج عن السيطرة، هو الذي يقف خلف مرارة “توماس إدوارد لورنس”: لا يمكن معرفتها (يقصد الحقيقة). لم تسبب لي رؤاي لها إلا المتاعب، لأنها دحرتني بتفاهة الحياة اليومية، دون أن تقول لي أين أستطيع أن أجد طريقة أخرى للعيش، فأصبحت حياتي بعد ذلك نكتة لا معنى لها. هل يعني هذا أن حياة بلا تهديد الموت، يعني امتلاء الحياة أو عدم تفاهتها؟ على الأقل، فإن حياة بلا موت، تعني توفر المزيد من فرص إغنائها.




