تحرير التاريخ من الشر

ما زال السؤال مطروحاً على البشرية: هل الإنسان خيّر أم شرير؟ هناك من يعتقد بأن الإنسان ذئب لأخيه الإنسان. إذا كان الإنسان يستأنس بعواء الذئب في البرية ويرتعب من صوت إنسان، على قول الشاعر العربي الأحيمر السعدي: “عوى الذئبُ فاستأنستُ بالذئب إذ عوى، وصوَّتَ إنسانٌ فكدتُ أطيرُ”، وإذا كان الإنسان في حقيقته ذئباً لأخيه الإنسان فإن العيش بين البشر أمر مستحيل دون لجم الذئبية فيهم والتي ترتدي أشكالاً متعددة من العنف. لهذا، ولكي يكون التعايش ممكناً بين الناس، فقد صاغ البشر جملة من القيم المشتركة، وصارت مع الأيام جملة من المعايير يتوجب الالتزام بها. فقيم المحبة والإيثار والتعاطف والسلم والأمان والتعاون والصدق والوفاء وما شابه ذلك من قيم، فضلاً عن ذمّ الكذب والخداع والقتل وكل أنواع الإيذاء، كل هذا من أجل الحدّ من الذئبية.
والحق أن الاستسلام لاستمرار الشر الواقعي بكل صوره الواقعية والممكنة، أمر يمنح الشر القدرة على إفساد الحياة المجتمعية والبشرية. ولسنا في حاجة إلى أن نضرب الأمثال عن حضور الشر في عالمنا قديمه وحاضره. بل إن التأمل في حال عالمنا المعاصر شرقاً وغرباً، شمالاً وجنوباً، يخلق من الدهشة ما لم يخطر على بال، فشرقنا العربي غارق في محنة الاقتتال الذي يرتدي ثوب الاقتتال المذهبي، ومن النادر أن تجد مكاناً في العالم لم يشهد حالات عنف أيديولوجي أو قومي أو ديني. والاستسلام لهذا الشر، كما قلنا، لا يليق بالعقل الإنساني، ولهذا فإن العقل لا يني يخوض معركة البحث عن المشترك الإنساني، عن القيم المشتركة، و الدفاع عنها، والسعي لأن تتحول إلى نمط حياة للبشرية.
وإذا كانت الأهداف الكبرى ذات الطابع الإنسانوي بطيئة التحقق، وصعبة، فإن هذا يجب ألاّ ينتج تشاؤماً لدى النخبة والفاعلين الاجتماعيين، بل على العكس، يجب أن نوطّن الإرادة الخيّرة على عدم اليأس و القنوط. والسؤال الحقيقي الذي ما زال سؤالاً ممضّاً: كيف تأتّى أن تصبح الأيديولوجيات، بما هي نتاج العقل، أساساً لتحطيم القيم المشتركة بين الناس؟ وقس على ذلك، كيف صار الدين الممتلئ بالقيم الخيرة أساساً للصراعات بين المختلفين؟ لا شك أن الجواب عن هذا السؤال سهل جداً عند أهل العقل: الصراع على الثروة والرغبة في الهيمنة واحتكار السلطة والعصبيات على أنواعها كل ذلك يقف وراء ما نراه من شر. غير أن هذا الجواب لا يقول لنا شيئاً عن الخطاب الذي يقف وراء هذا الشر. فخطاب القتل أخطر من القتل نفسه. من هنا تبرز أهمية تأسيس خطاب متجاوز للخطابات المؤسسة للوعي الزائف بالحياة. خطاب يصوغ المشترك الإنساني على نحو يكون فيه قادراً على خلق نزوع إنسانوي نحو التعايش بلا خطاب يبرر العنف والقتل والهيمنة والحروب.
النزعة الذئبية والشر الواقعي
أُعرّف الشر: بأنه كل سلوك بشري يقصد إلى إيذاء الآخر وإفساد الحياة وإشاعة السوء في المجتمع، ولهذا فالقهر والإذلال والسرقة والقتل وكل اعتداء على الإنسان مهما كان شكله ومضمونه هو شر. وأخف أنواع الشر هو الشر الفردي، كالسرقة والاعتداء على الملكية وإهانة الفرد والقتل، لأنه من قبيل الشر الذي تضع القوانين حداً له عبر العقوبات الرادعة، بل إن هناك من يعتقد أن أصل الدولة قائم في حاجة البشر إلى سلطة تمنع الأفراد من ارتكاب الشر. والحق لا معنى للدولة أصلاً دون وظيفة مواجهة الشر دون الحفاظ على الحق، وليس باستطاعة أيّ دولة أن تلغي سلوك الشرير إلغاء مطلقاً. أما أسوأ أنواع الشر فهو ذاك الشر الصادر عن مؤسسة منظمة لإنتاجه وممارسته. وأسوأ أنماط مواجهة شر كهذا هو التكيف مع وجوده. لا أتحدث هنا عن الشر الصادر عن عصابات منظمة داخلية أو عابرة للحدود، بل عن ذلك الشر الذي يتخفى وراء أيديولوجيات ظاهرها خير نسبي.
فباسم الموت لأميركا والموت لإسرائيل والموت لليهود تجري عملية استباحة وطن وقتل المئات من أهل اليمن، إن كل الشرور تختبئ وراء شعارات رنانة وباسمها تُرتكب أسوأ أنواع الشر ألا وهو القتل. ولكن التكيف مع الشر شر هو الآخر، وذلك اعتقاداً من المتكيفين مع الشر أنهم يقللون من جرائمه وأخطاره. ولعمري أن أمراً كهذا لا يزيد الشر إلا شراً، ذلك أن أصحاب الشر كلما وجدوا أنفسهم بمأمن من مقاومة شرهم ازدادوا شراً. بل المجتمع نفسه الذي يسكت عن الشر الذي يمارس عليه تكيفاً سيجد نفسه في لحظة لا يستطيع معها تحمل حجم الشر الذي يرزح تحته، ولكن بعد أن يكون الشر قد أنشب أظافره في جسد المجتمع وصار اقتلاعه يتطلب ثمناً باهظاً.
وبالنتيجة نقول إن مقاومة الشر أقل تكلفة بشرية ومادية بكثير من التكيف معه، وما التكيف مع الشر إلا توفير لأسباب جعله حالة مقبولة فيحطم انتشار الشر إذ ذاك عالم القيم الإنسانية، ويصبح كالكلب المسعور والمتروك لنشر سعاره بين الناس. وهناك نوع آخر من الشر المدمر للمعايير والذي بدوره يدمر مؤسسات المجتمع والدولة.
فمن المعروف أن الجامعة والقضاء مؤسستان فاعلتان في إنتاج النخب المحافظة على سيرورة العلم وعلى سيرورة الحق، وليس هناك الآن دولة بالمعنى الدقيق دون وجود هاتين المؤسستين وفق المعايير الأرقى لهما. فحشو الجامعة بكادر لا علاقة له بالعلم والمعرفة والأخلاق الأكاديمية وشيوع ظاهرة الفساد فيها نوع من الشر الذي سيلقي بظله خلال أجيال على مجمل الحياة التعليمية والعلمية والمهنية، لأن الجامعة هي مصنع لإنتاج النخب، والتلاؤم مع شر كهذا يزيد من شر تدمير الصعد التي أشرنا إليها، فالطبيب والمهندس والمدرس و… و… الذين يتخرجون في جامعة جرى فيها تدمير المعايير الجامعية إنما يعودون هم ليمارسوا التدمير مرة أخرى، فالشر لا ينتج إلا الشر. وقس على ذلك القضاء المرتبط أصلاً بالحق والحفاظ عليه وفق القانون، فمن أسوأ الشرور التي يتعرض لها الحق هو فساد أداة تحقيق الحق وتحولها إلى وسيلة لسلب الحق، والحياة مستحيلة من دون أن تكون هناك مؤسسة تحافظ على الحق بكل أشكاله.
والمتأمل بجميع الدول التي شهدت وتشهد الانتفاضات سيجد نفسه أمام دول دمرت فيها السلطات الحاكمة الجامعة والقضاء. وأخيراً لا بد من القول إن قوة المجتمعات وتماسكها وازدهارها رهن بمنع الشر من أن يكون حالاً طبيعية، وأن تقاومه إن هو ظهر بأيّ صورة من الصور، لأن التكيف مع الشر يؤدي إلى الهلاك.
المقدس وحروب الذئاب

حين يتأمل البشر ماضيهم البعيد أو ماضيهم القريب، أو واقعهم المعيش، فإنهم يقيمون مع هذا كله علاقة ما، علاقة ذم أو مدح، علاقة تبنٍّ أو إنكار، علاقة حبّ أو كره، غير أنّ كل هذه العلاقات لا تفضي إلا إلى مواقف، وليس إلى فهم وتفسير وتجاوز. والنقد في حقيقته عملية فهم وتفسير وتجاوز، وهذه مهمة من أعقد المهام وأصعبها من جهة، وهي مهمة تقوم بها نخبة توافرت لديها العدة المعرفية المنهجية من جهة ثانية. كما يتطلب هذا تجاوز القيل النقدي اليومي القائم على المناكفة والذم والذي يحلو لبعض الأقلام أن تمارسه، ويبدو أن ليس باستطاعتها ممارسة سواه.
ففي قراءتنا للخطابات الأيديولوجية العربية التي لم ينج منها مثقف عربي في مرحلة من مراحل حياته، والتي مازال هناك نمط من المثقفين العرب غارقاً فيها، سنجد بأنّ الأيديولوجيات العربية الكبرى، مع كل ما فيها من اختلاف، هي ذات روح دينية واحدة. فعفلق وبكداش وقطب وسعادة الرموز الأربعة الدالة على الأيديولوجيات التي وجدت طريقها إلى الناس وإلى عالم المثقفين بخاصة، ما زالت حاضرة على نحو ما.
من أين تأتّت هذه الروح الدينية التي وسمت هذه الأيديولوجيات آنفة الذكر؟
الجواب هو أن جميع هذه الأيديولوجيات تنطوي على الحقيقي المطلق الكامن فيها والذي أخذ شكل المقدس. فالمقدس في الأيديولوجيا يمنح الأيديولوجيا روحاً دينياً.
الأمة العربية الواحدة ذات الرسالة الخالدة بالنسبة إلى المؤسس وأتباعة فكرة مقدسة، ونافية لأيّ فكرة ما عداها، وبعث الأمة حقيقة لا شك فيها من وجهة نظر أصحابها، في ما فكرة سوريا للسوريين والسوريون أمة تامة هي الفكرة المقدسة لأنها الحقيقة المطلقة عند سعادة. وقس على ذلك فكرة حتمية الانتقال إلى الشيوعية التي ورثها بكداش عن لينين وستالين، ولم تختلف الفكرة الإسلامية – السياسية التي طورها سيد قطب وطبع حركته بها، حيث نعيش عصر الجاهلية الذي يجب تجاوزه بفكرة الحاكمية لله بوصفها فكرة مقدسة مطلقة .
الأيديولوجيات العربية الكبرى، رغم ما فيها من اختلاف، ذات روح دينية واحدة، من عفلق إلى بكداش وقطب وسعادة، وكل هذه الأفكار تعينت بأحزاب أيديولوجية متقاتلة وهي: البعث، والصورة المصرية له في الناصرية، السوري القومي – الاجتماعي، الشيوعي، الإخوان المسلمون.
كان الصراع بين هذه الأحزاب دموياً. لم يكن صراعاً على السلطة فقط، وإنما صراع أفكار مقدسة متناقضة. حسبنا أن نذكر الصراع الدموي بين الشيوعي والبعث في العراق، والصراع بين السوري – القومي والبعث، بين البعث والإخوان المسلمين، وبين الإخوان المسلمين والناصرية.. وهكذا.
لقد حول أصحاب الحقيقة المطلقة أحزابهم إلى ديانات، والأهداف إلى مقدسات، والمقدسات إلى أداة نفي الآخر، بهذا الوعي الديني بالحياة والسياسية يموت الحوار، لأن المقدسات لا تتحاور .
القضية الأخطر تكمن في أنّ جميع هذه الأيديولوجيات ذات وعي – فاشي دكتاتوري بالسلطة كما دللت التجربة التاريخية. لقد حكم البعث بلدين من أهم بلدان العرب، سوريا والعراق، وأقام نظامين دكتاتوريين أمنيين عسكريين مغلفين بمبدأ الحزب الواحد. بل وظهر الصراع على السلطة داخلهما بأبشع صوره. صراع وصل حد إعدام الرفاق للرفاق. لم يتوانَ حكم الأسد من زج الرفاق في السجون لمدة ربع قرن، ليموت بعضهم داخل السجن. ويقال بأن صدام أعدم بيده رفاقه الذين اختلفوا معه عبر الكلام.
ولقد شهد اليمن الجنوبي حرباً بين القبائل الماركسية التي اصطف بعضها مع علي ناصر، وبعضها الآخر مع سالم البيض. وكان أن أعدم الرفاق قبلها سالم ربيع علي.
ففكرة الحاكمية لله التي طرحها سيد قطب، وأصبحت حاضرة في جميع أشكال الأيديولوجيات الدينية من الإخوان إلى داعش، وهي غير قابلة للإصلاح، بل قابلة للتجاوز وإقامة القطيعة معها، إذ لا يمكن أن تقوم دولة على أساس ديني ولا على أساس فكرة الحاكمية لله. ولا يمكن أن تقوم دولة بناء على حكم الحزب الواحد مهما كانت أيديولوجيته.
قس على ذلك موت الفكرة الشيوعية التي لن تعود إلى الحياة مرة أخرى، فالعدالة والإنصاف ما عادا مرتبطين بالدعوة إلى الفكرة الشيوعية. والأمر ينطبق على الرسالة الخالدة والسوريين أمة تامة .
لا يمكن أبداً تجاهل أخطر أنواع المقدسات الأيديولوجية ألا وهي الصهيونية، هذه التي نشأت في أوربا وتتأسس على خطاب ديني عنصري يعود إلى ثلاثة آلاف عام مضت. إذا لا يمكن تفسير العنف المطلق لهذه الأيديولوجيا ألا بوصفها حالة تعود إلى عصر الهمجية.
إنّ استعادة أهداف العرب الدنيوية عبر السياسية المعبرة عن مصالح العرب، مصالح الإنسان العربي في خطاب خالٍ من الأوهام الأيديولوجية ذات الإهاب الديني هي مهمة المفكر المهجوس بحياة العرب ومستقبلهم الآن. أي إن نقد الأيديولوجيات لا يعني الإطاحة بتناول مشكلات الواقع العربي، بل في إعادتها إلى جدل الإمكانية والواقع والاختلاف والحوار والتفكير العقلي.
المشكلة التي نواجه هي أنّ بعض الناس يقاتلون ويُقتلون ويَقتلون ويموتون من أجل أوهامهم، بل ويخربون الحياة.
على العقل أن يعتلي منصة الحياة، واضعاً نصب عينيه الكفاح من أجل الحياة. الحياة فقط، وليس جعل الحياة في خدمة الأوهام.
الغباء العاطفي
يشير مفهوم الذكاء إلى أشكال متعددة من القدرات عند الإنسان، كالقدرة على المحاكمة العقلية، والقدرة على الاكتشاف، والقدرة على التلاؤم، وقد اغتنى هذا المفهوم أكثر بإضافة الذكاء العاطفي.
ويشير الذكاء العاطفي إلى تلك القدرة على التعاطف مع الآخرين، والعلاقات المهذبة والنبيلة تجاههم، والإيثار والاحترام والصداقة والتعاون والنجدة وهي صفات يكتسبها الفرد عبر الثقافة والتعلم. ولا شك أن استعدادات البشر لامتلاك الذكاء العاطفي متفاوت كما هو الذكاء الاجتماعي والذكاء المعرفي والإبداعي.
وعكس هذا كله الغباء العاطفي؛ فالحقد والكره وقتل الآخر والتشفي بعذاباته والفرح بآلامه هو الغباء العاطفي. والغباء العاطفي من أخطر الظواهر على وحدة المجتمع وصحته النفسية والأخلاقية. ويكون هذا الخطر محدوداً إذا ظل في حدود قلة من الأفراد، ولكنه يصبح خطيرا إذا اتسع وانتشر بين الجماعات. لأن الغباء العاطفي يعني موْت الآخر.
النزعة الذئبية والغباء العاطفي
إن السلطة المستبدة هي المدرسة الأهم لتخريج الأغبياء العاطفيين؛ فالعاملون بأجهزتها متخصصون مهرة في الغباء العاطفي ومدرّسون أكفاء في تعليمه. ومنتسبو هذه المدرسة وخريجوها لديهم استعداد فطري لاستيعاب دروس أساتذتهم وقدرة عجيبة على ممارسة مهنتهم، فالعنف الذي يمارسونه على الآخر إذا ما طال به الزمن، وإذا ما طال العدد الأكبر من السكان، فإنه يولد مع الأيام كائنات مشوهة عاطفياً، وعاجزة عن أن تشعر بآلام الآخرين.
وإذا ما ترافق عنف المستبد مع انتشار حال الفقر بين السكان توافر الشرط الأخطر لتلبد العواطف تجاه الآخر. فتظهر عندها عصابات السلب والنهب بل والقتل المعبرة عن الغباء العاطفي.
وتواجه شعوبنا العربية خطر نمط من الغباء العاطفي قلما شهدته من قبل، ألا وهو الغباء العاطفي للجماعات الطائفية المتعصبة والعنفية التي تتكئ على خطاب ديني مشوه، وتخرج كل ما في غبائها العاطفي من حقد على الآخر.
فمشاهد العنف الراهنة من عنف الصهيوني إلى عنف الأصولي إلى عنف الدكتاتور العسكري الريفي يدرك ماذا يعني موْت الآخر وماذا يعني خطر الغباء العاطفي.
ولعمري إن تحصين المجتمع ببث ثقافة التسامح والتعاطف والانتماء والتعاون المعشري بوصفها ثقافة الدولة نفسها أمر في غاية الأهمية، بل إن الذكاء العاطفي ليس معلماً من معالم رقي الفرد فقط، وإنما مظهر من مظاهر الرقي والتقدم الإنساني أيضاً، فانتصار النزعة الإنسانية بكل ما تنطوي عليه من قيم مطابقة هو في نهاية الأمر انتصار الآخر وانتصار الآخر يعني بأنه أصبح قيمة عليا. ولما كان كل إنسان هو أنا وآخر في الوقت نفسه فإنه لا يمكن العيش إلا في عالم تسوده قيم الذكاء العاطفي.
هنا بالذات تبرز أهمية الدولة بوصفها عقداً اجتماعيا، وهي التي تعزز دور الأسرة والمدرسة والإعلام بكل أشكاله والأدب والفن والموسيقى في تعميم قيم الذكاء العاطفي لخلق جيل سويّ لا يكون عرضة في المستقبل لتشويه أصحاب الغباء العاطفي.
النزعة الذئبية والكره
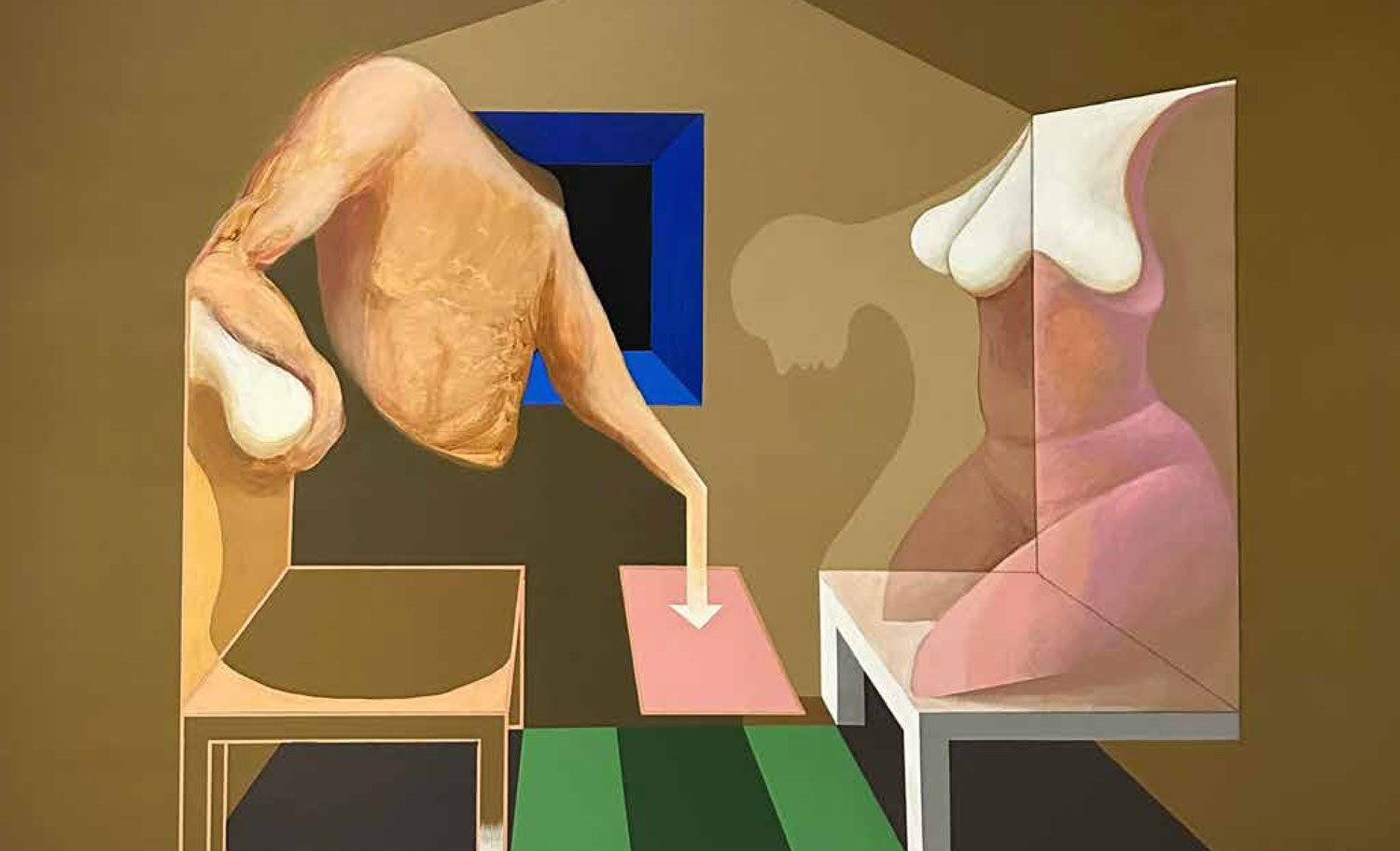
يُعرف الكره بمقت الآخر، فالعداوة والبغضاء متعددة الأسباب ومختلفة في التعبير. إنه نقيض الحب. لا شك بأن الكره، بوصفه نقيض الحب، ليس سوى ثمرة الحب نفسه. فحين أعلن بأني أكره فإني أعلن في الوقت نفسه بأني أحب نقيض ما أكره. فالذي يكره ماهية الدكتاتورية والدكتاتور وطغام الدكتاتور فإنه يحب الحرية واحترام الإنسان، إذاً: للحب أولوية على الكره. والطغام الذين يكرهون المتمرد الحر فهم ينطلقون من حبهم لذواتهم التي لا معنى لها بدون الدكتاتورية. فالإنسان لا يكره إلا ما لا يحب، فكرهه صادر عن حب نقيض ما يكره. وهذا يعني ليس كل حب أمراً محموداً، فالتمييز بين حب وحب تمييز قيمي وأخلاقي، فارتباط الحب بمفهوم الفضيلة يحدد ماهية الحب. وإذا كان الأمر كذلك، وهو كذلك، فإن الحب كينونة عاطفية وعقلية وجمالية وأخلاقية. لكن الثقافة العربية تنطوي على مثلب خطير جدا ألا وهو العداء للأنا وكرهها، ولهذا يعوذ العرب من الضمير المنفصل أنا وتقول العامة “أعوذ بالله من كلمة أنا” ويتعوذون من الأنا كما يتعوذون من الشيطان.
ودعوني أقول لمن يرى الأنا شرا مستطيرا إن الشر في بلادنا كامن في غياب الانا واستبداد النحن والهُم. في غياب الأنا التي تفكر والتي تختار والتي تتحرر والتي تحلم والتي تتمرد. بل إن ألد أعداء الأنا هو الطاغية المستبد الذي يسعى دائما لجعل الناس قطيعا خوفا من الأنا الحر. والقطيعية هي صورة موت الأنا. ولولا هذه القطيعية لما كان هناك حركات أصولية إرهابية، ولما كان هناك عي طائفي متعصب. لولا الأنا لما احتفل الوجود بالثائر الذي أعلن أنه يريد. لو كان هناك انتصار للأنا لكان هناك انتصار للحرية والأحرار. لو كان هناك انتصار للأنا لما كان هناك قطيع يمشي وراء المستبد. لما كان هناك تحطيم لقيمة الإنسان .
وإذا كان بعض الناس يكرهون الأنا لاعتقادهم أنها والأنانية شيء واحد فهم مخطئون. لأن حضور الأنا هو بالضرورة حضور الآخر بوصفه أنا. واعلموا أن انتصار الحرية مستحيل دون انتصار الأنا. لأنك حين تعلن “أنا” تعلن في الوقت نفسه حضور الذات الممتلئة بالوجود. لكن كره الآخر هو عدوان، كره الآخر والتعبير عن هذا الكره بوصفه وعياً زائفاً بالذات وبالانتماء، صار وسيلة وضيعة لتحقيق شهوة الحضور الزائف هو الآخر. وهو تعبير عن القصور العقلي من جهة، وعن الغباء العاطفي من جهة ثانية، وعن الجهل المعرفي من جهة ثالثة. حب انتمائك القومي لا يتأسس على كرهك لقومية أخرى، واعتدادك الطائفي لا معنى له بكرهك لطائفة أخرى، وسعادتك بدينك لا تعني النيل من أديان الآخرين وكرهها. وبحثك عن الحضور لا يمر بكره من يمتلك الحضور والنيل منه. حين أبدع اليوناني فن المسرح، رأى بأن الحياة ليست سوى تراجيديا وكوميديا، وفي ضوء هذه الرؤية قسموا المسرح المعبر عن الحياة إلى مسرح كوميدي هدفه الإضحاك، وبعث السرور في النفس، ومسرح تراجيدي حيث تنتهي المأساة بموت البطل. لكنهم لم يلتفتوا إلى مسرح الوقاحة في الواقع، حيث لا يقوم بطل بمهمة الإضحاك، ولا آخر بمهمة الإبكاء، بل ينتج القرف والتقزز من وجود أبطال الوقاحة الذين يكرهون الفضيلة والإنسان. والحق إن اتحاد الكره بالوقاحة ينجب خطاب العداوة بكل أشكالها، وبخاصة العداوة العنصرية التي هي ذروة الكره الإنساني. ليس هناك سبب وجيه للكره إلا ذاك المتعلق بالشر، والشر هو كل سلوك مقصوده أذية الآخر وسلبه حقه في الحب والحرية والحياة. ولهذا الدكتاتورية شر، والاحتلال شر، والطائفية شر، والاعتداء على الآخر شر، والحسد شر. والأشرار كل من ينتمون إلى هذه الشرور ويمارسونها.
هل تحرير التاريخ من الشر ممكن؟
إذا كان الإنسان في حقيقته ذا طبيعة ذئبة فإنّ العيش بين البشر أمر مستحيل دون لجم الذئبية فيهم، والتي ترتدي أشكالاً متعددة من العنف.
وحتى يكون السلْم والصلح بين الناس ممكنين، فقد صاغ البشر جملة من القيم المشتركة، صارت مع الأيام جملة من المعايير يتوجب الالتزام بها .
الاستسلام لاستمرار الشرّ الواقعي أمر يمنح الشرّ القدرة على إفساد الحياة المجتمعية والبشرية فقيم المحبة والإيثار والتعاطف والسلم والأمان والتعاون والصدق والوفاء وما شابهها، فضلاً عن ذم الكذب والخداع والقتل وكل أنواع الإيذاء، كل هذا من أجل الحد من الذئبية. ولقد اشترك في صياغة هذه القيم بأحكام واضحة حكماء ما قبل الميلاد والفلاسفة والأنبياء، وصيغ بعضها في جملة قوانين ملزمة للسلوك.
لكنّ البشرية لم تبرأ من الذئبية ومظاهرها، فما تزال الحروب منذ نشأة المجتمعات حتى الآن مستمرة، سواء أكانت حروباً أهلية أو حروباً بين الدول، وأيضاً الصراعات على الثروة لم تنته؛ بل أُضيفت إليها الصراعات الناتجة عن المعتقدات والأيديولوجيات النافية لبعضها، وفي الحقيقة؛ إنّ القوة والمصلحة ونزعة الهيمنة والتسلط ما تزال أكثر التعبيرات عن الذئبية البشرية، سواء تعينت هذه الذئبية في سياسات الدول أو في جماعات عنفية، أو في أنظمة مستبدة حاكمة.
والسؤال الحقيقي الذي ما يزال حاضراً: كيف تأتى أن تصبح الأيديولوجيات، بما هي نتاج العقل، أساساً لتحطيم القيم المشتركة بين الناس؟ وقس على ذلك، كيف صار الدين الممتلئ بالقيم الخيرة أساساً للصراعات بين المختلفين؟
لا شكّ في أنّ الجواب عن هذا السؤال سهل جداً عند أهل العقل؛ الصراع على الثروة والرغبة في الهيمنة يقفان وراء ما نراه من شرّ، غير أنّ هذا الجواب لا يقول لنا شيئاً عن الخطاب الذي يقف وراء هذا الشرّ؛ فخطاب القتل أخطر من القتل نفسه.
من هنا تبرز أهمية تأسيس خطاب تاريخي متجاوز للخطابات المؤسسة للوعي الزائف بالحياة، خطاب يصوغ المشترك الإنساني على نحو يكون فيه قادراً على خلق نزوع إنسانوي نحو التعايش، بلا خطاب يبرر العنف والقتل والهيمنة والحروب .
ينطوي الخطاب المؤجج للحروب على سرديات تاريخية تجعل منها ومن نتائجها مصدر عزة قومية، وكتب التاريخ المدرسية مليئة بهذه السرديات.
في المقابل؛ ينطوي التاريخ على وقائع كثيرة تدل على جهود البشر في الوصول إلى التعايش السلمي؛ فالبشرية لا تستطيع العيش انطلاقاً من انفجار الذئبية؛ بل إنّ الحروب، سواء كانت حروباً أهلية أم حروباً بين دول، غالباً ما انتهت بأشكال من الموافقات التي اصطلح على تسميتها “الدساتير” و”المعاهدات”.
وبالتأكيد، إنّ هناك أمثلة لا تحصى في التاريخ عن استعادة السلم بعد الحرب، وتضرب العلاقة الفيتنامية – الأميركية أكبر مثال على ذلك، ولسنا في وارد العودة إلى أسباب هذه الحرب ومساراتها؛ بل يكفي القول إنّها استمرت لفترة من الزمن، وخلّفت من القتل و الدمار في فيتنام ما لم تخلفه أيّ حرب في تاريخ الفيتناميين؛ حيث فقد الفيتناميون بين ثلاثة إلى أربعة ملايين قتيل، وأحرقت مساحات شاسعة من الغابات باستخدام الأسلحة الكيمياوية، فضلاً عن الدمار الذي لحق بالبنية التحتية، والمآسي التي نتجت بعد الحرب عن الفقر والفقد، وأيضاً مقتل ما يقرب من ستين ألف جندي أميركي.
واليوم؛ نشهد علاقة تحالف أميركي – فيتنامي، ورفع الحظر عن تصدير الأسلحة الفتاكة عن فيتنام، وعلاقات اقتصادية ذات منفعة متبادلة؛ فقد زار أوباما فيتنام لوضع اللمسات الأخيرة على المصالحة التاريخية، وفي العام الماضي؛ رست أكبر حاملة طائرات أميركية على السواحل الفيتنامية، وقيل إنّ ذلك كله يأتي من مصلحة مشتركة تجاه الصين، وبمعزل عن الأسباب التي دعت إلى المصالحة الفيتنامية – الأميركية، فإنها مصالحة جاءت بعد سيول من الدماء وركام من الدمار. وقد أثبتت بين أميركا وفيتنام؛ أنّ التحرر من الماضي الذي يبعث على التعصب شرط لتحرير التاريخ من الشرّ.




