تنوع الأجناس وأبعاد الكتابة
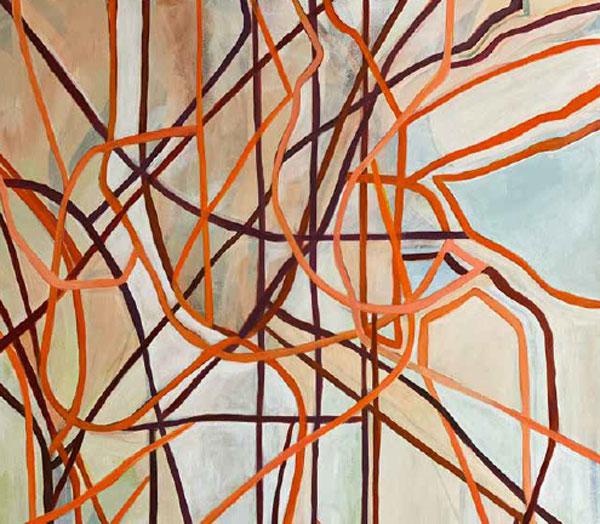
هذا الكتاب الجماعي يضمّ مجموعة من الأبحاث تدور كلها على مدوّنة كاتب تونسي بارز بدأت منشوراته الأدبيّة تظهر في تونس والوطن العربي منذ أواسط الثمانينات، إنّه الأديب أبوبكر العيّادي صاحب التجربة الثرية في شتى الأجناس الأدبية. يقول عنه آدم فتحي أحد شعراء تونس الكبار: ” ظلّ مثابرا على الكتابة يحاول كسر الطوقيْن: البعد والصمت. وها هو ينجح في ذلك منوّعا نشاطه في القصّة والرواية والترجمة وأدب الطفل والأدب الشعبي والكتابة للوسائل السمعيّة البصرية، مثريا مدوّنته بالعمل تلو الآخر، منتزعا احترام النقّاد والقراء. ولعله ما كان ينجح في كل ذلك لولا وفاؤه لميزته الرئيسيّة: “عُريه”، أي صدقه الذي عرف كيف يجعل منه رؤية جماليّة طبعت لغته وأسلوبه، فإذا هما ألصق ما يكونان به من جهة الاقتصاد في “البهرج”.
العيّادي والكتابة في فنون مختلفة
في الحقيقة ليس يسيرًا أن نوجز في تقديم سيرة ثقافية وأدبية مثل سيرة العيّادي، فهو الذي اختار التعليم في بداية حياته المهنية، وعمل في مدارس تونس وليبيا فترة من الزمن، وكان في قلب الحياة الأدبيّة التونسية منذ عقود من خلال إشرافه على الملحق الأدبي لجريدة “الصباح” التونسية، وعلى مجلة “قصص” التي يصدرها نادي القصّة بتونس. وفي منفاه الاختياري بفرنسا منذ 1988، آثر الابتعاد عن التعليم والتفرغ للكتابة والصحافة، حيث داوم النشر في تونس وخارجها، وقد جمع مختارات من مقالاته الأدبية والفكرية في كتب عديدة، نذكر منها: العتق والرق، معارج الفكر، رسائل باريس، نقاط على بعض الحروف، نحن والآخر، في الأدب الروائي، أصداء الساعة…
كما تعاقبت منشوراته السرديّة، فله في القصّة القصيرة: دهاليز الزمن الممتدّ، حكايات آخر الليل، حكاية شعلة، الضّفّة الأخرى، حقائب الترحال، جمر كانون، لعنة الكرسيّ، قرية البهاليل. وفي الرواية: لابس الليل، زمن الدنّوس، مسارب التيه، الرجل العاري، آخر الرعية، ورقات من دفتر الخوف، الرواية قدّس الله سرّها، الانتظار. وفي روايات اليافعين: متاهة الأزمنة، رحلة أمان العنبري، عازف الكمان، الحوت الأزرق، ملكة الرياح. كما ألف للأطفال مجموعة من القصص والمسرحيات والسيناريوهات الإذاعية والتلفزيونية، فاز بعضها بجوائز عربية ومتوسطية، إضافة إلى مؤلفات أخرى بالفرنسية، وضعها للتعريف بالموروث الشفوي التونسي والقصص العربي القديم.
أمّا في الترجمة، فله رصيده زاخر بلغ حتى الآن خمسة وثلاثين عنوانا، شملت قصصا وروايات وكتبا فكرية لكبار الكتاب والمفكرين في العالم، آخرها “محور الذئب – من سيبيريا إلى الهند على خطى الفارّين من الغولاغ ” الذي توّج بجائزة ابن بطوطة لترجمة أدب الرحلة سنة 2023.
قد لا نحتاج إلى مزيد تفصيل القول لنتبيّن أنّ تجربة العيادي الأدبية تجربة ثريّة جدا، من حيث كثرة إصدارتها، ومن حيث تنوع أجناس الكتابة فيها. ولا شكّ في أنّ تاريخ الأدب العربي الحديث والمعاصر لم يحتفظ إلاّ بعدد قليل من الأدباء الذين كتبوا بمثل هذا التنوع في الأجناس والأشكال، وبمثل هذا الرصيد من المنشورات في كل جنس. فليس من اليسير على أيّ كاتب أن يكتب في فنون كثيرة، وأن يطوّر تجربته في كل فن من خلال خوض مغامرة متواصلة في الكتابة والنشر. وليس من اليسير على أيّ كاتب أن يجمع بين الكتابة للكبار والكتابة للأطفال واليافعين، بل أن يخوض مغامرة الكتابة المسرحية الموجهة عبر الخشبة إلى الأجيال الناشئة. وليس من اليسير عند المجرّبين لمعاناة السرد أن ينتقل الكاتب باستمرار بين الأقصوصة والرواية، ويسعى في كلا الجنسيْن إلى أن يتعهّد أدواته الفنية حتى لا يكون التراكم النصّي مجرد تكرار واستنساخ.
المؤلف كاتب مقال
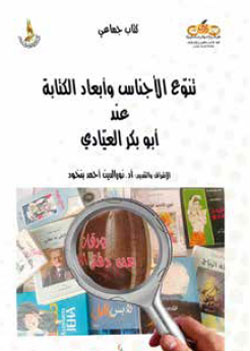
لا شكّ في أنّ عدد الكتب التي أصدرها العيّادي جامعا فيها مقالاته التي كانت قد نشرت في الغالب في دوريّات عربية ينبئ بمقدار اهتمامه بالكتابة في هذا الفنّ ووعيه بقيمته الفنية والثقافية. وكان واعيا أيضا بمنزلة أدب المقالة في مرحلة من مسار الأدب العربي الحديث قبل أن تطغى عليه أجناسٌ أدبيّة أخرى كتابة وقراءة ونقدا، وخاصة الرواية. جاء في مقدّمة كتابه ” هل التاريخ محكمة؟ القراءة دون مقدّمات نظرّية”: “أمّا الكاتب، فيطيب له، في هذه المرحلة التي انصرف فيها السواد الأعظم من الكتاب والشعراء إلى الرواية، أنْ يعود إلى جنس أدبي بلغ أوجه في منتصف القرن الماضي مع مارون عبّود وميخائيل نعيْمة وطه حسيْن وسلامة موسى، هو أدب المقالة، ليناقش بعض القضايا الأدبيّة والفكريّة التي تثار هنا، في فرنسا، وهناك، في موطنه الأصلي، لعلها تجد صدى لدى القارئ الكريم، وتسْهم ولو بقدر ضئيل، في تحريك السواكن.”
والحقيقة أنّ الوعي عند الباحثين العرب بالمقالة جنسا أدبيّا ليس مقاربا لحجم المدوّنة العربيّة في هذا الجنس وتنوع أشكالها الإنشائيّة وموضوعاتها وتجارب كتابها. وآية ذلك أنّ الكتب التي كثيرا ما تعلن عناوينها عن الاهتمام بالأدب العربي الحديث أو النثر الأدبي الحديث أو الأدب والنثر في هذا القطر العربي أو ذاك، من النادر أن تكشف عن وعي أجناسي جليّ بحضور فن المقالة حضورا إبداعيّا لافتا ومتنوّعا ومختلفا. ولعلّ وجها من هذا الإشكال يعود إلى طبيعة هذا الجنس من الكتابة الذي يبدو متخذا، مثل بعض الأجناس الأدبية كالسّيرة والمذكّرات، موقعا على أطراف الدائرة الأدبية، ممّا يجعله معرّضا باستمرار إلى الحشر في دوائر أخرى من الكتابة، كالكتابة التاريخية أو السياسية أو الدينية أو غيرها، وخاصة إذا لم يحرص الكاتب على جمع مقالاته المنشورة في الدوريّات.
كتب أبوبكر العيّادي في هذا الفنّ، مثلما كتب عدد من المبدعين العرب في الشعر والسرد. ومن هؤلاء يمكن أن نذكر: غادة السمّان ونزار قباني ومحمود درويش وجمال الغيطاني وإلياس خوري وغيرهم. ولقد بدأت تجربة الكتابة عنده منذ ثمانينات القرن العشرين لمّا كان يكتب في صحيفة “الصباح” اليوميّة التونسيّة في ركن أسبوعي سمّاه “قطراتٌ من الضوء”. ثمّ تواصلت تجربته أثناء إقامته بفرنسا على صفحات دوريات عربيّة أخرى في المهجر والوطن، مثل جريدة “العرب” ومجلة “الجديد” وصحيفة “أخبار الأدب” وغيرها. وكتب العيّادي الجامعة لمختارات من مقالاته تكشف أنّ هذه المدوّنة المقاليّة متنوّعة الموضوعات، خاضعةٌ نصوصها لمقتضيات النشر في الدوريّات وقيوده المختلفة، متأثرة في طرائق القول بالظروف الثقافية والسياسيّة في الوطن العربي والعالم، وذلك كله ممّا يتصل بالكتابة المقاليّة عامّة. فثمّة من هذه الكتب ما محّض للنظريّة الأدبيّة، ونعني خاصة كتابه “في الأدب الروائي”. وقد تناول فيه إشكاليات عديدة تتصل بالسرد والتخييل والفن الروائي وإنشائيّته وأجناسه الفرعية. ولكنه قد تناول هذه المسائل الأدبية وغيرها في مقالات نشرت في كتب له أخرى، وخاصّة في كتابه “هل التاريخ محكمة؟” ومن مجاميعه المقاليّة ما كان دائرًا على متغيّرات الوضع السياسي التونسي والعربي، وخاصّة مع الانتفاضات الشعبيّة سنة 2011 وما بعدها. وذلك ما دارت عليه نصوص كتابه “العتق والرقّ: مقالات في ثورات الربيع العربي وما تلاها”.
واذا كان من الخصائص الإنشائية للمقالة خطاب المؤلف المباشر إلى القارئ، وطرح القضايا المختلف فيها، وذكر الوقائع، والجدل الصريح في هذه المسألة أو تلك، والاستناد إلى الوثائق أحيانا، والسعي عبر الحجاج بأساليبه المتنوّعة إلى التأثير والحمْل على الاقتناع، فإنّ العيّادي يبدو في هذا الكتاب، أكثر من أيّ كتاب مقاليّ آخر، مقاتلا من أجل الحرّية، قوي الصوت، شديد العزم في فضح الأنظمة السياسية المنهارة، ومنْ تحالف معها من الداخل والخارج، وفضْح من سمّاهم في أحد العناوين “ثوّار الساعة الخامسة والعشرين”، وخاصة قادة الحركات السياسية الدينيّة وأتباعهم، مجادلا مجرّدا الحجّة بعد الحجّة لمناقشة هذه المسألة أو تلك ممّا أثارته هذه الانتفاضات والمواقف منها، وما تأسّس عليها من حكومات وممارسات سياسيّة. ومع أنّ هذه المقالات قد تفاعلت مع المتغيّرات السياسية اليوميّة في الوطن العربي والعالم، وهو ما جعلها تخضع للغة انفعالية أحيانا وردود فعل ومواقف فوريّة، فإنّ الكاتب قد حرص على محاصرة الانفعال بهدوء القول التحليلي، وذهب إلى الجدل المباشر مستعينا بأمثلة من التاريخ للمقارنة، وأقوال لفلاسفة ومفكرين وعلماء النفس والاجتماع وغيرهم، وشواهد نصّية من الشعر والرواية. وهو ما لوّن الكتابة بأساليب أدبيّة وارتفع بالخطاب من جدل المواقف الفورية إلى التفكير في المسألة في أفقها الإنساني المتجاوز لحدود المكان والزمان. وفي مقالات كثيرة أخرى، مال العيّادي إلى علاقة مختلفة مع جمهور القراء العرب، تتباعد عن الصدام المباشر والجدل الساخن، وتتخذ نزعة تثقيفيّة وتنويريّة. وذلك ما نتبيّنه في نصوص كتبٍ له، مثل “معارج الفكر: إطلالة على الثقافة الأجنبية”، و”رسائل باريس: مقالات في الفكر والسياسة”، “أصداء الساعة: قراءات في الفكر الغربي الحديث”، ففي مقالات هذه المجاميع، يبدو العيّادي حريصا على تعريف القارئ العربي بآخر الإصدارات في المجال الفرنسي والغربي عامّة، والقضايا التي أثارتها والمناقشات التي ولدتها في علاقة بمسار الفكر الغربي وتحولاته، وتجدّد إشكالياته بتأثير متغيرات الظروف الجديدة والحوادث التي تعيشها أوروبا والعالم. والعيّادي يبذل جهدا واضحا في تقديم منهجي لأفكار هذا المفكّر أو ذاك، وآراء بعض الموافقين والرافضين، وفي بيان الصلة بين الكتابات الجديدة والأطر الفكرية القديمة والحديثة، في حدود ما تسمح به المقالة والخطاب الصحفي. ولكنّه لا يتردّد في بيان موقفه أو تدقيق فكرة يعرضها ويبيّن حدودها أو تناقضها، كقوله بعد عرْض كتاب عن تاريخ الإرهاب وجذوره الأوربية: “والكاتب هنا، رغم تنبيهه، عند سرْد محاولة اغتيال نابليون، بأنّ المنتصرين هم الذين ينعتون خصومهم وأعداءهم بالإرهابيين، يخْلط بين من يحمل السلاح لدفع الغاصب وتحرير الوطن، وبين من يغتال الأبرياء للتنديد بجوْر حاكم أو تحقيق مأرب شخصي أو فئوي. فالمدافعون عن أهلهم وحرمة ترابهم أو الساعون إلى طرد المحتلّ هم في كل الشرائع مناضلون ومقاومون ومجاهدون…” (معارج الفكر، ص 32).
ومن نافل القول الإشارة إلى أنّ موقف كاتب المقالة لا يقتصر على ضرب من التعليق المباشر، وإنما يتلقّاه القارئ أيضا في طرائق العرض وتزاوج التحليل والسرد، وطرائق الاستشهاد بالنصوص وضروب من الأسئلة تحمل على الشك وتدعو إلى التفكير.
السارد التجريبي
إنّ ما لاحظناه من تنوع فنون الكتابة التي أسهم أبوبكر العيّادي بالإبداع فيها، فأثرى المدوّنة الأدبية العربية بنصوص كثيرة، ليدل على أنّ الكتابة عنده مغامرةٌ مستمرة، تنبني على وعي عميق بضرورتها الإنسانية ومقتضياتها الثقافية والفكرية والفنية. ولا شكّ في أنّ قارئ كتب العيّادي المقالية ومترجماته لعيون الرواية العالمية يدرك إلى أيّ حدّ هو قارئ نهم لما يكتب في الأدب والنظرية الأدبية والاتجاهات الفكرية والفلسفية والتاريخية والتحاليل الاقتصادية والسياسية وغيرها. وهذا الاطلاع المستمرّ على أوجه من حيويّة الفكر الإنساني المعاصر يبني معرفة نامية متوسّعة، ويدعو إلى مزيد من التفكير في الفن والأدب والكتابة موضوعات وطرائق في القول والبناء ومقاصد ووظائف. إنّ مغامرة الكتابة رفضٌ للقواعد المفروضة على التفكير الحرّ، وبحثٌ لا يني عن الشكل الدالّ وطرائق القول المناسب.
بدأت كتابات العيّادي الإبداعية تصدر للجمهور أواسط الثمانينات. وكان الأدب التونسي، قد قطع شوطا، على غرار الأدب العربي كله، في مسار تجريبي يقوم على محاولات متنوّعة في تجديد الأشكال الشعرية والسرديّة. ونحن نجد بعض المحاولات في تحقيب مسار الكتابة القصصية والروائية في تونس وتصنيف اتجاهاتها…
وبصرف النظر عن اختلاف التصنيفات أو تقاربها النسبي أحيانا، وتنوع مقارباتها وزوايا النظر، فإنّ ما يهمّنا، ونحن نحاول أن نتبيّن موقع تجربة أبي بكر العيادي الإبداعية في مسار الكتابة القصصية والروائية التونسية، هو أن نؤكّد في المستهلّ أمرا لا يجد الكثير من الاختلاف حوله، وهو ما قامت به حركة الطليعة أواخر الستينات وبداية السبعينات من تأثير عميق في الكتابة الأدبية التونسية، رغم ما اتسمت به بعض نصوصها الأولى عند روّادها، وخاصة في الشعر، من “مبالغة ” في نظر بعض الدارسين، في نسف المعهود من الكتابة، ومفارقة أحيانا بين شعارات “الثورة” الفنية والمنجز الفني “الثوري”. يقول أبوبكر العيادي في مقال له بعنوان “الطليعة والمؤخّرة” متحدّثا فيه عن حركات الطليعة التي ظهرت في الوطن العربي في الستينات:
” … أفرزت تجاربَ جريئة تقطع مع السائد، وتأمّلا نظريا كان من غاياته التأسيس لذائقة جديدة، ورؤية للفنّ تلائم عصرا لا يني يتسارع […] وقد عدّت إنجازاتها في حينها نخبوية، وهو ما يعني اقتصارها على من أوتي حظًّا من المعرفة، وكأنّ الفنّ يمكن إدراكه دون خلفيّة ثقافيّة ومعرفيّة. ولكن رغم ما اشتمل عليه بعضها من غموض وألغاز ورموز عصيّة على الفهم يحتاج فهمها إلى جهد مخصوص، فقد كان لها فضل الجهد المبذول، وسبق المغامرة، وإباء الركون إلى المنجز، وغنم الفاتحين” (العيّادي، هل التاريخ محكمة؟ القراءة دون مقدّمات نظريّة). لقد استمر الاتجاه التقليدي في الكتابة دون شك طيلة السبعينات وما بعدها، ولكنّ الكتابة القصصية والروائية قد انطلقت باحثة عن لغة سرديّة جديدة ومتجدّدة، وأشكال نصية وطرائق في السرد تكشف من جهة عن طموح إلى كتابة قصصية وروائية عربية متباعدة عن النماذج الغربية المهيمنة، ومعبّرة عن خصوصية الانتماء الحضاري، وتحمل من جهة ثانية وعيا تاريخيا حادا بدور الكاتب العربي والمثقف في مجتمع يعاني قطريّا من الاستبداد السياسي والاستغلال الرأسمالي وما يحيط بهما من طبقات طفيْلية، ويعاني قوميّا من اندحار مستمر أمام حصار “الاستعمار الغربي الجديد” بوسائله الناعمة والخفية حينا، الاقتصادية والسياسية والثقافية، وانكشاف قوته الاستعمارية القديمة حينا آخر، ضربا عسكريا مباشرا للقوى الوطنية، ودعما واضحا وصريحا للكيان الاستيطاني الصهيوني.
يبدو العيّادي بعد تجربة طويلة في كتابة الأقصوصة والرواية أنّه اختار عن وعي وإصرار أن يكتب السرد بلغة عربيّة فصحى معاصرة، تتباعد في الغالب عن تجارب تونسية وعربية رأت أنّ من الضروري أن تكون لغة السرد، وخاصة الحوار بين الشخصيات، منفتحة على اللهجات العربية المحلية في ضرب من الإيمان الصوفي بـ”الصدق الفني”. ولكنّنا مع ذلك لا نعدم عنده في السرد أو الحوار شذرات لهجيّة تبدو لُمَعًا منشدّة، على اختلاف وظائفها النصية، إلى شواغل الكاتب ومقاصده عبر الكتابة في علاقة بواقعه الاجتماعي والسياسي. وتتباعد لغة العيّادي أيضا عن تجارب تونسية اختارت أن تجلب اللغة العربية التراثية إلى الكتابة السردية المعاصرة، كما نجد ذلك عند فرج الحوار والمرحوم صلاح الدين بوجاه في نصوصهما الروائية الأولى، تأثرًا بمحمود المسعدي، رغم أنّ قارئ العيادي لا يغفل عن كون لغته ليست عارية في الغالب من جمال فصاحة عربية، تبدو أحيانا معتقة، ولكنها في الحقيقة متولدة من معرفة عميقة بأسرار اللغة في تاريخها الأدبي والثقافي الطويل. ويبدو ذلك اختيارًا فنيا نابعا من إحساس حادّ بالانتماء. يقول في حوار معه منشور بمجلة “العربي” (العدد 65): “أنا أؤمن بأنّ اللغة هويّة، ومن لا هويّة له لا مستقبل له. وسواء أقمت في باريس أو في غيرها من المدن الأجنبية فلن أبدع إلاّ بلغتي”.
إنّ هذه اللغة السرديّة التي تبدو في ملتقى تجاذب بين الوعي بالهوية والإصرار على إعلان الانتماء من جهة، والوعي بصراعات الواقع المعيش والإنصات إلى أصوات المعذّبين في وطنه وفي كل الأرض من جهة ثانية، قد كانت المجال الرحب لتعدّد الأصوات وأجناس الخطاب، من أكثرها إيغالا في التراث إلى أكثرها التصاقا باليوميّ والشعبي، شعرًا وأمثالا وحكايات وخرافات وأغانيَ وأقوالا سياسية ودينية وأدبية وفنية وفلسفية.
فإذا نظرنا في الأبنية القصصية والروائية وطرائق السرد في مدوّنة العيّادي، تبيّنّا أنّ هذا الكاتب لا تتالى نصوصه السرديّة على وتيرة واحدة. ففي الرواية، يبدو مرة ميّالا إلى السرد الكلاسيكي، من حيث الصوت السردي الذي يتكفل به الراوي الخفي العليم، ومن حيث زمن الخطاب حيث يساير السرد الحكاية من مبتدئها إلى منتهاها، مع ضروب من الارتداد والإضمار، وحيث يسمح للراوي موقعه التبئيري بالانتقال بين الظواهر والبواطن، وإضاءة ما يمور في نفوس الشخصيات من هواجس وأحاديث ذاتية. وهذا ما نتبيّنه في روايات، مثل “لابس الليل” و”زمن الدنوس”. وقد يتحكّم التداعي في البناء الروائي، كما في رواية “ورقات من دفتر الخوف”، فإذا بالراوي الشخصيّة، أو الراوي المشارك، يعيش، وهو يروي بضمير المتكلم، زمنيْن يتداخلان في وعيه فيتداخلان في خطابه السردي، إذ تذهب به بعض أحداث حاضره إلى صور من الماضي فيستعيد باستمرار عبر الذاكرة تفاصيل متفرّقة من حياته وحياة غيره. وكانت رواية “الرجل العاري” أيضا من هذا النمط، بل هي أبلغ في تداعي الأفكار وتوالد الذكريات التي يرحل فيها الراوي الشخصية بضمير المتكلم رحلات مشوشة إلى الماضي، وينتقل عبر الذاكرة من وجه إلى وجه، ومن مكان إلى آخر، وهو لا يغادر ليلته ولا غرفة مكتب أراد أن يكون منبع نص لم يكتب بعد، فلم يفعل غير التنقل بين مشاريع كتابة. وكذلك يفعل الراوي الخفي متحدّثا عن هذه الشخصيّة، كاشفا أغوار نفسها، مرتحلا معها إلى صور متداخلة من ماضيها. ومع هذا التداعي الحرّ الذي بعثر الانتظام المعهود في السرد الكلاسيكي، ومع هذا التناوب بين صوتيْن سرديّيْن، كان التوازي بين فصول قصيرة شعرية وفصول سرديّة، ممّا يجعل القارئ يخرج من القراءة السلبيّة المطمئنّة إلى التفكير في انسجام النص وعلاقات الأصوات وأجناس الخطاب بعضها ببعض، والتفكير مع الكاتبيْن، الداخلي المتخيل والحقيقي صاحب الكتاب، في الكتابة ودواعيها وأبعادها. وقد يقوم الخطاب الروائي على تعدّد الرواة، فتتعدّد الأصوات الراوية بضمير المتكلم، وتتعدّد وجهات النظر في سرد الحكاية، فإذا بمرويّ هذا غير مرويّ ذاك. وهذا ما نتبيّنه في رواية “آخر الرعيّة”.
أمّا العوالم الحكائيّة في نصوص هذه المدوّنة، فليست متجانسة دائما. إنّ عالم الحكاية في رواية العيّادي هو في الغالب عالم واقعي بشخصياته وأحداثه وتحولاته، منفتح على الواقع التونسي، والعربي عامّة، مهموم بتفاصيل الحياة اليوميّة ومعاناة الفئات الاجتماعيّة في المدن الكبرى خاصة، ومعاناة الأفراد والجماعات من تحالف سلطات الاستبداد ورأس المال الطفيْلي المتغوّل. ولكنّ القارئ يكتشف في رواية، مثل “آخر الرعيّة “، كيف يخرج به الكاتب، في مستوى العالم الحكائي، من واقعه المعاصر إلى زمن تاريخي غير محدّد وفضاء اجتماعي وسياسي تبدو علاماته ممحوّة أو غائمة. والقارئ لا يغفل عن كون الكاتب يتباعد في نصّه هذا عن الرواية التاريخية في شكلها التقليدي أو التجديدي، فما البلد “المنفلت من الجغرافيا” كما أعلن الكاتب في إحدى عتبات الرواية، وما الزمن الذي تجتمع فيه الأزمنة التاريخية، ماضي السلطنة والرعيّة وحاضر القنوات التلفزية والقنابل، إلاّ حدود عالم متخيّل لا يستطيع القارئ النبيه إلاّ أن يتبيّن فيه وطنا عربيّا يستمرّ في حاضره الماضي الموغلُ في عصور الاستبداد، والمتجدّدُ مع كل عهد، ويتبيّن فيه عالم الإنسان الذي يكاد لا ييأس ، وهو ينتظر الخروج من زمن الرعيّة إلى زمن المواطن.
أمّا في الأقصوصة، فيبدو أبوبكر العيادي أميل إلى المغامرة، وأكثر جرأة في تنويع أشكال السرديّة. لقد تنقّلت أقاصيص العيادي بين عوالم حكائية مختلفة، فمن عالم الريف، كما في الغالب من أقاصيص مجموعتيْه “حكايات آخر الليل” و”حكاية شعلة”، إلى عالم المدينة الأوربية كما في الكثير من أقاصيص مجموعتي “الضفة الأخرى” و”حقائب الترحال”. ومثّلت مدينة تونس المجال الذي تحرّكت فيه الشخصيات القصصية في مجموعات أخرى. وكانت شخصيات العيادي في هذا المجال أو ذاك شخصيات طحنتها سلطة قاهرة وأدمتها المعاناة والخيبة، سواء تلك الواعية الرافضة أو تلك المسالمة المستسلمة.
لقد كان السرد القصصي عند العيّادي، كما هو أيضا سرده الروائي، منغرسا في واقع اجتماعي وسياسي كثير الشروخ والجروح. ولعلّ أكثر الجروح إيلاما متولدٌ من علاقة السلطة بالأفراد والجماعات. وهو الهمّ الذي لازم العيّادي في الكثير من نصوصه السرديّة. ولذلك كانت صورة بعض الشخصيات أمام السلطة ورموزها، الشرطة والعمدة والصحافة وغيرها، هي صورة المتهم في أمانته ووطنيّته حتى يُثبت براءته. وكانت العلاقة بين الطرفيْن علاقة مواجهة تبدو أحيانا ملحميّة حين تنهض الجموع عن وعي بواقعها وإصرار على التغيير، وتبدو مرّاتٍ كثيرةً ذاهبة بالأفراد إلى حالات من الشعور بالانسحاق والجنون وفقدان الوعي بالكيان الإنساني. هذه الهموم السياسية والاجتماعية تثقل كاهل العيادي المثقف والمواطن من خلال وعيه الحاد بما يجري قطريّا وقوميّا، فتستحيل الكتابة شكلا من مغالبة الاختناق والصمت والبحث عن فضاء، فيه يتنفس وينطق، قبل أن تكون شكلا للبحث عمّن يشاركه الوعي وضرورة التعبير والمواجهة. وقد تجلى ذلك في نصوصه بطرائق متعدّدة.

لقد حرص أبوبكر العيّادي على جماليّة الوضوح. وفي ذلك انسجام مع رؤية جمالية وفكرية وسياسية يتبيّنها القارئ من النصوص نفسها، ولا يكون في حاجة إلى أن يكتشفها من خلال نصوص للكاتب نظريّة موازية، فقد تباعد عن الغموض الذي يقارب الإبهام، وعزف عن الإغراب في بناء فضاء الحكاية وأعمال شخصياتها، وآثر البيان في بناء الخطاب القصصي صوتا سرديّا وطرائق في السرد. ولكنّ جمالية الوضوح لا تعني الانسياق في ضرب من السرد التسجيلي، وسطحيّة النقل المباشر للواقع المرجعي بدعاوى فنية واقعية ذات مرجعيّات أيديولوجيّة. وإنما كان العيّادي في هذه التجربة القصصية الطويلة، كما تتجلى من مختلف المجموعات المنشورة إلى حدّ الآن، منشغلا أيضا بفنّ السرد، وقاعدته الأساسيّة الأولى: كيف يشدّ الراوي المروي له عبر طريف الحكاية وأسلوب سردها، وكان منشغلا بالأقصوصة من حيث هي فنّ وإبداع أدبي له مقتضياته الأجناسيّة دون شكّ، وله آفاق من التوسّع والتنوع والاختلاف. ولذلك تنوّعت طرائق السرد والبناء في نصوص هذه المجموعات، يبدو بعضها أميل إلى البناء الكلاسيكي المألوف، ويبدو الكثير منها مجالا للبحث التجريبي الذي يأنف من القواعد المسطّرة ويجتهد في توليد الشكل المناسب. فبنى الأقصوصة في نصوص كثيرة على أشكال متنوّعة من تعدّد الرواة والأصوات. وأفاد من السرد العربي القديم صوار من بناه السردية، فكان محاكيا لبعضها في توظيف فني ودلالي مخصوص، ومحوّرًا لبعضها الآخر في ضروب من المحاكاة الساخرة من الذات الفردية والجماعية وخطابها ورؤيتها للعالم. وذهب في أقاصيص إلى ألوان من تنويع الضمائر، والبناء المقطعي، والمزاوجة بين الواقعيّ والغرائبيّ، واستدعاء صور من السرد الشفوي في رواته ومجالسه وأسماره وحكاياته وطرائق القول فيه.
إنّ الناظر في مجمل ما أصدره أبوبكر العيّادي حتى الآن من مجموعات قصصية وروايات لا يشكّ في حرص الكاتب على السفر إلى عوالم حكائيّة مختلفة والتنويع في طرائق الكتابة. فمن العسير أن نحقّب مسيرته الإبداعية بحدود فاصلة بين سرد كلاسيكي وسرد تجريبي. بل إنّ نزعته التجريبية لا تضعه في ضرب من التجارب الكتابية المضادّة، أو الموغلة في التجريب حدّ التطرّف، كما فعل بعض القصّاصين أو الروائيين التونسيين، وخاصّة في مبتدأ رحلتهم الإبداعية وطموحهم إلى المخالفة والتميّز وإثبات الذات. لقد كان أبوبكر العيّادي ذا مسار تجريبي معتدل، قوامه التوازن والتناسب بين الكثافة الشكلية والعمق الدلالي والمقروئيّة. ولذلك كانت لغته من الفصحى المعاصرة، بل المطعّمة أحيانا ببعض العبارات من اللهجات العربية، التونسية أو المصرية أو الشاميّة، فلم يغال في الاستفادة من الفصحى العتيقة، رغم جميل معرفته بها، ولم يفضّل بناء نصوصه على أساليب السرد القديم، أو المبالغة في الاقتباس من نصوص التراث، رغم واسع اطلاعه على عيونها. لقد اختار أنْ يضمّن بعض نصوصه الروائيّة، مثل “مسارب التيه” و”آخر الرعيّة”، شواهد من الشعر العربي القديم على لسان الراوي أو الشخصيّة القصصيّة، بل إنّ مقوّما من مقوّمات الخطاب الروائي في “الرجل العاري” يتأسّس على جدليّة السردي والشعري، ويتجلى من خلال التوازي بين مقاطع شعرية ومقاطع سردية، بل التواشج الحكائي بين هذه وتلك، وهذا فضلا عن تضمينات شعرية وبناء النثر السردي نفسه على الشعرية، في ضروب من الإيقاع والتشكيل التصويري. وقد تكون هذه الجدليّة نفسها بين السردي والشعري أكثر تجلّيا في أقاصيص كثيرة من مجموعات العيّادي، بالنظر خاصة إلى قيام إنشائيّة الأقصوصة على الإيجاز والتكثيف. ولعلّ ذلك يرحل بنا إلى ظاهرة أشمل تتصل بعمق التحاور بين الفنّ الأدبي ومختلف الفنون. ولهذه الظاهرة تجليات في مدوّنة العيّادي، ونعني خاصّة هذا الحوار مع السينما في رواية “زمن الدنّوس”، وهذا الحوار مع فنّ الرسم والفنون التشكيلية، وهو ما يتبيّنه القارئ في رواية “آخر الرعيّة”، وكذلك في رواية “الانتظار”، وبعض النصوص القصصية. إنّ حوار النص السردي عند العيّادي مع الفنون قد يقدّره القراء والباحثون بدرجات مختلفة من التجلي والعمق والتأثير في الكتابة السرديّة، ولعلهم لا يغفلون أيضا عن كونه وجها من انعكاس النص السردي على نفسه وشكلا من الخطاب الميتاسردي حيث يتفاعل الخطاب القصصي أو الروائي والخطاب على القصّ. وهذا الخطاب الانعكاسي، إن كان في الحوار مع الفنون غائما أو مخاتلا، فإنّه يبدو جليّا بارزا في ما سمّي بـ”الرواية في الرواية “، حيث تكون الكتابة حدثا من أحداث الحكاية المرويّة، ويحدث التداخل بين القصّة المتخيّلة وقصّة كتابة تلك القصة، ممّا يجعل النص فضاء لالتفات الرواية إلى كينونتها الإنشائية، وتفكير الروائي، وإن بشكل مراوغ وغير مباشر، في السرد وقضاياه، والكتابة وما تطرحه من إشكاليات التولد والتحقّق والتواصل والوظيفة. وهذا ما يتبيّنه القارئ في رواية العيّادي “الرواية قدّس الله سرها”.
الالتزام، أو الصراع مع النفس الأمّارة بالحرية
رغم أنّ هذا المصطلح، “الالتزام “، قد استبعد منذ عقود من مجال الدراسات الأدبية والفنية، بعد أنْ ارتبط طويلا بمذهبيْن في الأدب والفن رائجيْن في أواسط القرن العشرين، “الواقعية الاشتراكيّة” و”الوجوديّة”، فإنّ مدوّنة العيّادي القصصية والروائيّة تكاد تدفع القارئ إلى التفكير فيه. لقد كان منذ كتاباته الإبداعيّة الأولى حاملا هموم شعبه الاجتماعيّة والسياسيّة، مصوّرا معاناة القرى والأرياف، والأحياء القصديرية على هامش المدن الكبرى، والفئات الاجتماعيّة الفقيرة. لقد قامت روايتاه “لابس الليل” و”زمن الدنّوس” على تواصل في العالم الحكائي بشخصيّاته وأمكنته والكثير من تفاصيله، ولعلهما نصّان من ثلاثيّة روائيّة، قد تكتمل بالنص الثالث، فتكون الفترات الفاصلة بين مختلف الأجزاء طويلة، وتكون نصوص كثيرة قد كتبت ونشرت بين الثاني والثالث، مثلما كان الأمر بين الأول (تاريخ الكتابة 1980 – 1989، والنشر/ تونس 2000) والثاني (تاريخ الانتهاء من الكتابة 2010، والنشر: تونس 2011). وفضلا عمّا يدلّ عليه ذلك من حرص عند الكاتب على التأنّي في الكتابة ومراجعة مستمرة وتمهّل في التخطيط والإنجاز، فإنّنا نتبيّن، إذا ما اكتفينا بالنصيْن المنشوريْن، بعض خصائص المشروع الروائي الذي سعى إلى تحقيقه أبوبكر العيّادي من خلالهما. وهو كتابة مدينة تونس سرديّا. ولا نعني بذلك مجرّد ذكر أسماء الأحياء أو الشوارع والأماكن الشهيرة حتى تكون إطارًا مكانيا للحكاية المتخيّلة، وإنّما سرد حياة المدينة، وخاصّة في أحيائها الشعبيّة، وتصوير المعاناة اليوميّة التي يعيشها الأفراد والأسر في أوضاع مأساويّة من الفقر والبطالة وقهر السلطة وهيمنة مجموعات من المنحرفين على الأجساد والنفوس ومعاركهم في الشوارع الخلفية وداخل السجون، وعلاقة ذلك كله بتحولات اقتصاديّة واجتماعيّة في تونس أواخر الستينات وبداية السبعينات، ونشأة فئات جديدة من أثرياء النشاط الاقتصادي الطفيْلي والإجرام المنظم.
وقد انطلق أبوبكر العيّادي من وضعيّة المهاجر التي يعيشها ليكشف، وخاصّة في مجموعتيْه “الضفة الأخرى” و”حقائب الترحال”، آلام البعد والاستلاب وتخلخل الهويّة، ويوميات البحث عن الرزق والجوع والتشرد وعدوان العنصريّة وإذلالها للإنسان العربي والأفريقي. وكان انشغاله بهذا الوضع أيضا في نصوص روائيّة، مثل “الرجل العاري” و”مسارب التيه”. وفي هذه النصوص وتلك، كان سرْد ما يعيشه الإنسان من معاناة وقهر داخل الوطن وخارجه مؤسّسا على معرفة عميقة بتفاصيل الحياة التونسيّة في مداراتها المتعدّدة، ومؤسّسا على وعي سياسي حادّ بأنّ الاستبداد الجديد قد واصل ما صنعه الاستعمار القديم. فالدولة الوطنيّة سرعان ما تحوّلت أجهزتها الأمنيّة والإداريّة وأجهزة الحزب الوحيد الحاكم إلى أدوات للتلاعب بحياة المواطنين، وخدمة أصحاب النفوذ وفئات من الأثرياء الجدد، وخنق الحريات والتنكيل بكل صوت معارض.
لا يستطيع القارئ المتابع لمدوّنة العيادي القصصية والروائيّة أن يغْفل عن هذا الوعي السياسي الحاد الذي يختفي بدرجات مختلفة وراء النصوص في تعدّدها الأجناسي والأسلوبي وتنوع شخصياتها وعوالمها الحكائية. ولا يغفل أيضا عمّا يعيشه الكاتب من صراع مستمرّ، فالكتابة السرديّة، كما هو الأمر في كلّ فن، تنازع بين المعنى وطرائق القول، وقد تشهد في مثل هذه الظروف مغالبة بين ما يُراد أن يقال وما يمكن أن يقال. هذا الصراع عند العيّادي بين ما يمليه الوعي من فعل كتابي وما يقتضيه الفنّ من أسلوب وطرائق في محاورة الواقع المرجعي قد تجلى في مختلف النصوص القصصية والروائيّة. ولذلك يكاد يقترب في بعض الأقاصيص من الخطاب السياسي المباشر على ألسنة الشخصيات أو الرواة فضحا للاستبداد وأعوانه، وللاستغلال والقهر الاجتماعي. ويكاد السرد يستحيل تسجيليا وتوثيقيّا تنفتح فيه الحكاية المتخيّلة على فترة تاريخية معروفة بأحداثها ووقائعها وشخصياتها وخطاباتها، ويلتصق فيه الراوي بالمؤلف حدّ الاندماج، وذلك ما نراه في رواية “ورقات من دفتر الخوف”، وهي مواكبةٌ في بعض فصولها تخييلا وكتابة لما حدث في تونس منذ 14 جانفي (يناير) 2011 وهروب رئيس الدولة. ولكنّ الروائي يغالب النزعة التسجيلية والتوثيقية والخطاب الانتقادي المباشر في هذه الرواية وفي غيرها عبر ضروب من التبعيد الفني. فكان العيّادي ميّالا باستمرار إلى تنويع الأبنية النصّية والأشكال السرديّة، وتعدّد الأصوات الساردة في ضروب من التناوب أو التأطير والتفرع الحكائي حينا، أو التداعي وتداخل الأصوات والأزمنة حينا آخر، واستغلال ثراء اللهجات العامية في ألفاظها وصورها وأمثالها، والانعطاف أحيانا إلى بلاغة الفصحى المعتقة وطرائق السرد التراثي، وتوظيف المحاكاة الساخرة وأساليب الإضحاك، وغيرها من أساليب البحث عن الشكل الدالّ. ولعلّ رواية “آخر الرعيّة” من أبرز الأدلة الناطقة في المدوّنة بصراع الكاتب مع الواقع السياسي التونسي والعربي عامّة، فقد كانت طبعتها الأولى في باريس عام 2000، والناطقة أيضا بالصراع في ذات الكاتب بين رغبة الكشف والفضح، وما يراه من مقتضيات الفنّ وطرائقه في إضاءة الواقع الإنساني.




