رفيق الطيور التي لازمته من بيته الشامي إلى قبره الفرنسي
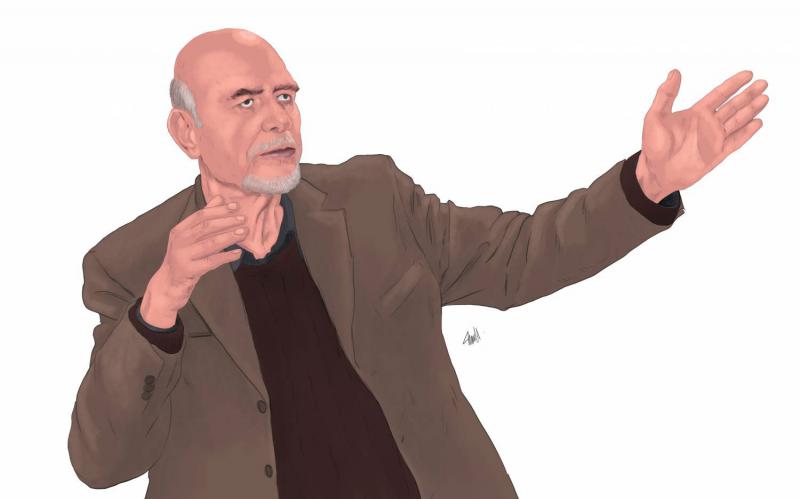
باريس- لخيري الذهبي حضور خاص، لا مثيل له بين الكتاب السوريين والعرب، لا هو ذاك الحضور الصادم المشاكس، ولا الباهت الخافت معدوم التأثير. كان الموقع الذي احتله على خارطة الكتاب السوريين من صنع يديه، أنجزه بالكثير من العناء والتجربة الإنسانية قبل الجلوس إلى طاولة الكتابة والتدوين على الورق الأبيض.
متأفّفٌ ونزق، لكن لطيف العبارة والتصورات، رافض للواقع البليد الجامد، إنما ينطلق منه -لا من خارجه- للانتفاض عليه وتغييره. بدا ذلك عتيقاً لدى الذهبي، من قبل أن تكون لدى السوريين ظواهر صوتية تزعم أنها حققت منجزات على مستوى النص والصورة والسرد، ومن قبل أن يهيمن عليهم من دفع بهم اليسار الشيوعي والبعث السلطوي ليكونوا واجهة الرواية السورية وعلامتها، كحنا مينه والجيل الذي جاء بعده ولا يزال ناعور الإنتاج هذا دائراً بحرب ومن دون حرب، بموهبة أو من دون موهبة، وباتحاد كتاب يكرّس هذا الاسم أو ذاك لاعتبارات غير إبداعية، أو بروابط أدبية مشتتة لا تغني ولا تسمن من جوع.
ذهب المكان
استمد من مدينته عبقرية السرد طويل النفس، وأمدته دمشق بالمزيد من الزخرف منذ أن تفتح وعيه في حاراتها القديمة، وكان لحي القنوات وساروجة والسور وما وراءه من أسرار أن تفعل بوعي الذهبي ما لم تستطع التيارات السياسية والفكرية فعله، وجد نفسه طبيعياً في مكانه الطبيعي، وسرعان ما عاد من مصر التي رحل إليها للدراسة إلى الشام التي لم يغادرها بعد ذلك إلا قسراً.
شخصية الحكواتي التي تفتن أهل دمشق ومن خلالها يتفاعلون مع التاريخ واللغة والأفكار، لم تسحر الذهبي، إنما سحره ما رآه في مصر من قوة حضور الرواية، بينما كان الكتاب العرب يصارعون طواحين الهواء شعراً دون أن يصلوا إلى مستوى شعرية نزار قباني وشعبيته الساحقة.
اختار الذهبي ملكوتاً آخر، كان للبسطاء فيه عالمٌ من البهجة والحنين، البؤس واليوميات، والكثير من التوغل في أعماق الشخصيات، نفسياً وروحياً. وكان جريئاً في روايته تلك “ملكوت البسطاء” منذ البداية، مطالع السبعينات، حيث الحلاق والعامل والفلاح والكادح وتلك السلسلة الطويلة العريضة من القوالب التي كان على الذهبي التخلص منها وعدم الوقوع في إسارها.
كان التاريخ هو السيد من جديد، وهو الأول والآخر في كل عمل يريد أن يربط اللحظة بالقراء، وكان لدمشق زمن التحول من العصر العثماني إلى الدولة المستقلة، أو لنقل إلى الدولة، وتلك مشكلة الذهبي التي رافقته من البداية إلى لحظة رحيله قبل أسابيع في فرنسا؛ كيف يمكن أن تتشكّل في الشرق دولة؟ ومتى؟
بوسع عشاق المدنية من أمثالنا الاكتفاء بقوة حواضر مثل دمشق وبغداد والقاهرة، للقول إن المدنية باقية ومنها سوف تنشأ الدولة العربية التي لا يحكمها العقل الشيخ ولا الجندي، بل تؤسس فيها هياكل متقدمة تتسق مع طموحات البشرية كلها من أجل المستقبل، لكن الذهبي لم يكن قادراً على الاكتفاء بدمشق أو بغيرها، بل كان يشكو من غياب المشروع التحديثي العربي في كل شأن من شؤون الحياة، من الكتابة إلى السياسة إلى الحرب.
والحرب عرفها الذهبي جيداً، ووقع في الأسر جراءها. وستجد يومياته التي دونها عن فترات الأسر في كتابه “من دمشق إلى حيفا – 300 يوم في إسرائيل”، حيث يروي ابن العشرين عاماً ونيف كيف عاش تلك المغامرة في سجون العدو لعشر أشهر، ثم في مطار بن غوريون وقبل ذلك وبعده.
لم يكن في كتابته نحيب المستضعفين ولا متاجرة المرتزقة بآلامهم، كان آلة وعي تتنقل من الماضي إلى اللحظة وتصف بلاده وناسها بالكثير من الحرفة العالية الممزوجة بالشجن. ولا بأس أن يكون كل كتاب للروائي جزءاً من حياته، بدلاً من خديعة الخيال إن كان ضعيفاً، فالواقع أكثر إثارة من الخيال لمن يراه جيداً بعينين صافيتين.
حصل على جائزة “أدب الأطفال” الأولى مبكراً، وكانت أولى المرات التي سطع فيها اسمه، قبل أن يسهم في تحرير وإدارة المجلات الثقافية التي تصدرها وزارة الثقافة واتحاد الكتاب العرب.
أستاذ اللغة العربية الذي درّس من سيصبحون لاحقاً علماء مشاهير وسياسيين حادي المزاج، في الشمال السوري حيث مدينة الحسكة، هناك رأى الذهبي السوريين على حقيقتهم، وعرف مثلما عرف من قبله العلامة محمد كرد علي كيف تشكّلت تلك المنطقة وكيف غزاها اللاجئون من كل حدب وصوب، لتصبح اليوم تحت احتلال قوى تريد أن تؤسس فيها كياناً عرقياً يقضمها عن سوريا الأم. كتب عنهم الذهبي آنذاك أنهم “مهاجرون مذعورون” قدموا من وراء الحدود، ليعيشوا بين العرب والسريان المسيحيين في مثلث سيصبح مثلث موت بعد عقود حين ستحكمه قوى التطرف والظلام ثم تهيمن عليه قوى ظلام من نوع آخر.
يقع الذهبي في الأسر بعد أن يتم فرزه كضابط ضمن فوج الأمم المتحدة التي تراقب اتفاقية فصل القوات على الجبهة السورية – الإسرائيلية، وهناك سيكون عليه أن يواجه ما فكّر فيه من قبل، وما سيفكر فيه لاحقاً، حول العديد من القضايا؛ الحق والحق التاريخي، الحرب والسلام، الآخر وصورته في الوعي العام.
ستمرّ سنوات طويلة قبل أن يتجه إلى كتابة السيناريو بطريقة الروائي ومستواه، لا بالرخيص من المخيلة والحوارات، بل من “ليالي عربية” التي استنزل فيها من سماوات شهرزاد تشعبات الحكايات وسراديبها، وحين عاد تم منحه وسام الشجاعة والشرف الذي تمنحه الجمهورية العربية السورية من الدرجة الممتازة.
كان يرى أن الكتابة رغم أنها تستقي من التاريخ، إلا أنها تبقى فعلاً مضاداً له، حسب تعبيره. والتاريخ عنده هو “تلك الرواية الجمعية التي اتفق عليها المنتصرون وفرضت على من تلاهم، وتبناها من اتبعهم، تبنوها إلى درجة العبادة والتقديس. أما في عصرنا الحديث فصراع الإنسان مع ذاته ومع عالمه المحيط جعل وعيه يطور أساليب سردية غاية في المهارة والإبداع، جعلت وتجعل من كل فرد (منتصرا) بينه وبين نفسه على القدر، ويحق له بالتالي أن يروي للآخرين تاريخه كما يراه، وكانت بالتالي الرواية كفن سردي، توثيقي، تخييلي، مواز للحقيقة، وربما مجاور لها”. وبذلك كان يؤسس لفهم جديد للأدب لا يقوم على اعتباره مرآة للواقع ولا صورته الموازية، إنما ضديته للتاريخ تجعله قادراً على تحريك التاريخ ذاته، والتأثير فيه تأثيراً عميقاً وديناميكياً.
التحولات

بثلاثية التحولات، “حسيبة” و”فياض” و”هشام”، وبأعماله الأخرى صنع الذهبي لغته الخاصة، فرادته وعالمه الذي يعترف بأنه لم يختر له مكانه، استشهد مرة بمقولة نجيب محفوظ حين سُئل: كيف استطعتَ بناء هذه الهندسة الرائعة والمحكمة لروايتك؟ فقال: لا تنسَ أني حفيد أولئك المهندسين العظام الذين صنعوا الأهرامات.
هي عمارة إذاً التي ينظر إليها الذهبي والجيل الروائي الذي ينتمي إليه، الجيل العابر للأزمنة، تبنى فيها الحكايات وفق هندسة دقيقة، متأثرة بالسلالات المعمارية الحضارية التي سبقتها، في الأدب كما في الحجارة.
أما هو فقد استعار البيت الشامي ليكون مسرحه، دون أن يكون فلكلوريا ممسوخاً، تصبح بركة الماء والأسماء وشجرة التين عناصر فيه لها كياناتها وحواراتها وتأثيرها.
وفي مكان مثل هذا تكون المرأة مركزاً وجوهراً أساسياً تدور من حوله القصص، تبتعد وتقترب ثم تدور من جديد، كما يدور طفل في أرض ديار بيت شامي حول بركة الماء ذات الإنشاد الذهبي حسب تعبير نزار الذي شبّه الصوت بالمعدن في مرة نادرة في الشعر الحديث.
ذلك الخرير العميق، قاد الذهبي إلى صدامات مع السلطة التي قامت بسحب جواز سفره ومنعه من مغادرة البلاد، وطردته من عمله في الإذاعة والتلفزيون، إثر مواقف اتخذها للمطالبة بالحرية والديمقراطية. وبقي مستقلاً سياسياً، عروبي التوجّه مخلصاً لما علّمته إياه عاصمة الأمويين.
كائنات صغيرة

رافقت الذهبي أينما ترحّل كائناته الصغيرة ذات الريش، طيور شغف بها وراقب لحظاتها، الكناري والحسون…، ونباتات الزينة المعرّشة على الجدار، ومع تعلقه بها لم يتخل عن تأملاته حول القفص ومعانيه في ملامحها، بعضها ألف العبودية، مثلما يقول، منذ مئات السنين، وبعضها الآخر يبقى يقاوم القضبان مهما جرى الاهتمام به والاعتناء بطعامه وشرابه.
في إحدى رواياته رسم عصفوراً هجيناً، ناتجاً عن الحسون والكناري، وصف ذلك في حوار أجرته معه الكاتبة والصحافية السورية تهامة الجندي، سمّاه “البذون”، وقال إنه “عصفور لديه مفاجأة الحسون وقوة الكناري، ولكنه للأسف عقيم كالبغل، وهذه هي عقوبة الطبيعة على الزيجات الفاسدة. لقد تحدثت عن هذا الزواج الفاسد بين الحسون والكناري، وكنت أقصد أن أتحدث عن ثقافتنا المعاصرة البندوقة الهجينة التي لم تتخذ قرارها بعد في أن تكون حسونًا أو كنارًا، وكان فياض أحد أشكال هذا البندوق الذي انتهى منبوذًا”.
غادر الذهبي دمشق سوريا بعد عام 2012 مترحلاً إلى مصر من جديد، ثم إلى الإمارات، ومنها إلى الأردن، وأخيراً حط رحاله في فرنسا التي مات فيها، أما منجزه وهو الذي ولد في دمشق أواسط أربعينات القرن العشرين، فلم يُقرأ بعدُ كما يليق به أن يُقرأ، رغم أن الملايين من المتابعين شاهدوه على الشاشة، واطلعوا عليه في كتبه المطبوعة، وكأن القدر اشترط أن يرفع إليه صاحبه، ويدع للقراء تراثاً كبيراً خلقه بمزاج خاص، وبلذعة طويلة المذاق، حافلة بالمعرفة والهدوء والعبارات ذات البصمات النادرة.




