سرير بروكرست العربي
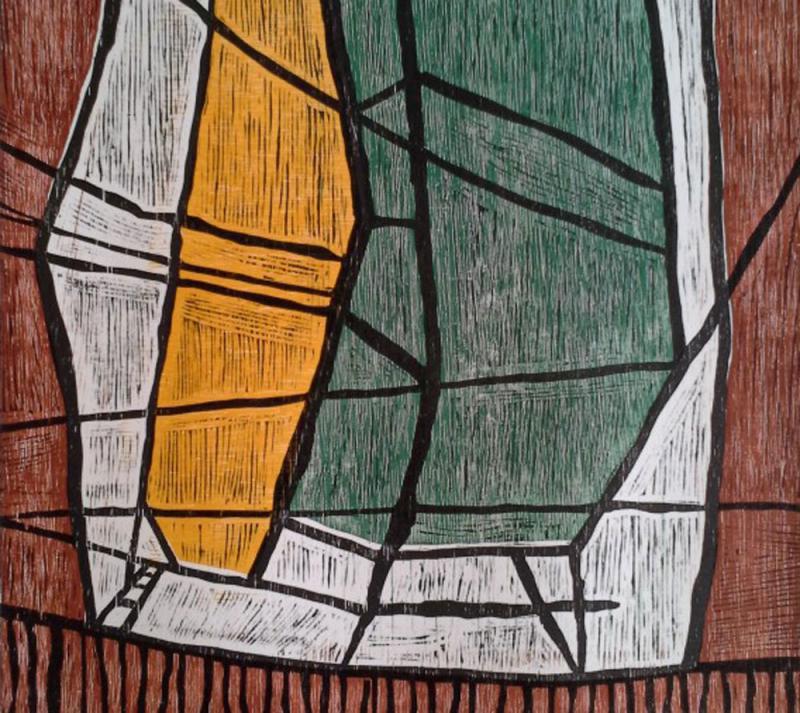
من مفارقات الشعرية العربية الحديثة أن زمن صعودها في خمسينات وستينات القرن العشرين ترافق مع صعود التيارات الأيديولوجية، القومية والماركسية وهيمنتها على الحياة الثقافية العربية، حتى تحول رموز هذه الأيديولوجيات في المشهد الشعري الحديث إلى كهنة وحراس لهذه الأيديولوجيات داخل هذه المشهد الذي بدا محكوما بسلطة مرجعياتها الفكرية على المستوى الجمالي بدءا من مفهوم الالتزام وحتى نظرية الانعكاس وعلم الجمال الماركسي. لقد كانت حاجة الأحزاب السياسية في تلك المرحلة إلى شعراء يتمثلون أطروحاتها ورؤاها في تجاربهم وإلى مبشرين بها عاملا هاما في صعود العديد من الشعراء والأفكار والرؤى والمفاهيم التي تمثل التعبير الكلي عن الوعي الاجتماعي والشعور بالمسؤولية الاجتماعية تجاه قضايا الحياة والإنسان والتاريخ. لذلك كان من الطبيعي سيادة مفهوم حرية الشاعر التي ترتبط بهذه المسؤولية وتعبّر عن موقفها الاجتماعي من قضايا العصر. وكما كان لتلك الأيديولوجيات شعراؤها كان لها أيضا نقادها وهو ما سنتطرق إليه لاحقا.
إن هذه العلاقة الملتبسة بين الأيديولوجيا والأدب عموما والشعر على وجه الخصوص ظلت موضوع جدل ما زال مستمرا حتى وقتنا الحاضر وإن كان على نحو أخف نظرا للتحولات التي طرأت على واقع الأيديولوجيا بعد سقوط الأحزاب والكيانات السياسية التي كان يتغذى منها الأدب الملتزم ويفرض من خلالها حضوره وقيمه الفكرية والجمالية على الحياة الشعرية العربية. لكن هذا الصعود الكبير لهذه التيار الشعري سرعان ما تعرض لأول صدمة مع هزيمة العرب في حرب حزيران المروعة عام 1967 ثم جاء سقوط الاتحاد السوفياتي المدوي عام 1992 ليشكل الضربة العنيفة لتلك المفاهيم ولعلاقة الأدب والأيديولوجيا، ما جعل منظري علم الجمال الماركسي وسواهم يختفون من المشهد الأدبي وتختفي معهم مساطيرهم النقدية التي كانوا يقيسون به الأدباء بها في ضوء مرجعياتهم الاجتماعية التي كانوا يعكسونها من خلال مدى التزامهم بهذه المفاهيم والرؤى في أدبهم شعرا أو رواية أو قصة.
إن دراسة تاريخ هذه العلاقة وظواهرها في الشعرية العربية التي سادت في تلك المرحلة تستدعي العودة إلى دراسة العوامل والأسباب التي أدت إلى ظهور حركة الشعر العربي الحديث وعلاقتها بالتحولات الفكرية والسياسية والاجتماعية التي كانت تشهدها الحياة العربية في ظل صعود التيارات الأيديولوجية وهيمنتها على الحياة الثقافية العربية، الأمر الذي جعل ظاهرة التبشير بالمستقبل والبعث والولادة الجديدة والانبعاث تغدو إحدى العلامات البارزة التي تدل على هذه العلاقة الوثيقة بين الأيديولوجيا والشعر العربي الحديث كما ظهر ذلك من خلال مجموعة من الرموز الأسطورية التي استدعاها هؤلاء الشعراء وجعلوا منها أدوات للتعبير عن هذه الرؤى المستقبلية الواعدة بنهوض الأمة وقيامتها.
لقد جاءت ولادة الحداثة الشعرية على يد روادها المعروفين في النصف الثاني من أربعينات القرن مترافقة مع مرحلة التحولات السياسية والاجتماعية التي كان يشهدها الوطن العربي آنذاك، وقد حاول عدد غير قليل من الدارسين والنقاد العرب تحديد الأسباب الموضوعية التي أدت إلى ظهور هذه الحداثة، لكن أغلب هذه الدراسات ظلت مخلصة لمرجعياتها الفكرية والأيديولوجية في إبراز دور هذا الأثر الحاسم أو ذاك في ظهور مشروع هذه الحداثة وتطوره، في حين أن قراءة موضوعية ومنهجية تظهر تضافر جملة من العوامل الاجتماعية والسياسية والثقافية والتاريخية في هذه الولادة التي كانت مخاضاتها الصعبة تجسيدا حيا لعلاقة الفكر والحداثة بواقع تقليدي تهيمن عليه الثقافة التقليدية في تلك المرحلة. لقد كان التحرر من الاستعمار وبداية ظهور الدولة الوطنية في العديد من الأقطار العربية وما خلّفه ذلك من صعود لقوى اجتماعية محددة ومن حراك سياسي وفكري استدعته هذه التحولات السياسية والاجتماعية في مرحلة مواراة. لكن هذه الحداثة الشعرية التي بدأت تبلور مفهومها وأشكال تعبيرها الجمالي في اللغة والرؤية إلى العالم كانت تتويجا لمرحلة طويلة من التحولات التي أخذت تطال الشكل والمضمون في هذه الشعرية نتيجة علاقة التفاعل التي كانت تشهدها على صعيد علاقتها بالشعر والثقافة الغربيين. حتى إن البعض يرد هذه الحداثة الشعرية إلى هذا التأثير الذي مارسه الشعر الغربي ممثلا بالشعر الإنكليزي الحديث تحديدا.

إن العلاقة بين صعود الأيديولوجيات القومية الماركسية وشعراء الحداثة الشعرية العربية بدا واضحا من خلال انتساب الأغلبية من شعراء هذه الحداثة بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الأحزاب التي كانت تمثل هذه الأيديولوجيات لكن اللافت أن حضور البعد السياسي في هذه التجارب كان يتقدم دائما على مسألة الشكل بل إن نقاد هذه الأيديولوجيات وسدنتها كانوا يقدمون موضوع الالتزام السياسي والاجتماعي أو المضمون على قضية الشكل، الأمر الذي جعل المعركة التي احتدمت في نهاية الخمسينات على صفحات مجلتي “شعر” و”الآداب” اللبنانيتين بين شعراء قصيدة النثر وشعراء قصيدة التفعيلة تتخذ في خلفياتها بعدا أيديولوجيا على الرغم من الاختلاف الظاهر على شكل هذه الحداثة الشعرية بين التيار الليبرالي والتيار القومي والماركسي حيث كان موضوع الوظيفة الاجتماعية للشعر في صلب هذه المعركة. إن تمويل وكالة المخابرات المركزية الأميركية لمجلة “شعر” والذي كشف عنه لاحقا يدل على المضمون الحقيقي لهذه المعركة التي كانت امتدادا بصورة مباشرة للصراع الدائر في العالم بين الرأسمالية العالمية والمعسكر الاشتراكي. إن جناية الأيديولوجيا على هذه الحداثة أنها عومت مفهوم المضمون في هذه التجربة على الشكل أو بمعنى آخر حاولت أن تجعل وظيفة شكل الكتابة الشعرية الحديثة خادما لمضمون القصيدة ما اعتبره شعراء قصيدة النثر مصادرة وانتقاصا من حرية المخيلة والذات الشعرية في مغامرتها الشعرية والجمالية.
إن أولى مظاهر الحضور الطاغي للأيديولوجيا ومرجعياتها الجمالية تجلّى عند شعراء هذه الحداثة في سيادة مفهوم الرؤية الكونية في تجاربهم، حيث حاول شعراء هذه القصيدة أن يوحدوا بين الألم والأمل الإنساني في رؤاهم التي تجاوزت في بعدها الإنساني باعتبار أن قضية الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية تشكل أساس الكفاح الوجودي والسياسي للإنسانية كلها. لقد كانت هذه الرؤية الشعرية التي حاولت أن تضفي على نفسها طابعا شموليا بمثابة المعادل الموضوعي ثقافيا للرؤية الشمولية التي كانت تنطوي عليها هذه الأيديولوجيا الماركسية بصورة خاصة، في حين أن كل أيديولوجيا هي مصادرة لحرية المخيلة الشعرية وأنا الشاعر في الكشف والاكتشاف ومغامرة الكتابة المسكون بالقلق الإبداعي الذي لا يهدأ. إن قراءة تاريخ الشعرية العربية الحديثة في رؤاها وانكساراتها هي تتويج لصعود هذه الأيديولوجيات وانكساراتها، فمن سيادة رموز الميثولوجيا الشرقية الدالة على البعث والولادة الجديدة والخصاب كما تجلى ذلك في رموز عشتار وأدونيس وتموز وإليعازر، كانت هناك رموز التاريخ العربي كالأندلس وسمرقند ودمشق وعبدالرحمن الداخل وقرطبة وأبي ذر الغفاري والحسين وسواهم لتأكيد معنى الهزيمة والظلم الذي تعيشه الأمة في واقعها الراهن. إن قراءة البعد الرمزي والدلالي للرموز الأسطورية والتاريخية في هذه الشعرية العربية لا يمكن أن تتحقق بمعزل عن قراءة هذه العلاقة الوطيدة بين الأيديولوجيا والشعر في صعوده وهبوطه خلال خمسينات القرن الماضي وستيناته.
المظهر الآخر لهذه العلاقة تجلى في تلك الرومانسية الحالمة كونيا التي سيطرت على أغلب هذه التجارب، وقد كان لرموز هذه الأيديولوجيات وسدنتها في الثقافة العربية دور كبير في تكريس ظواهر وأسماء وتجارب شعرية، تستلهم في رؤاها وموقفها من الواقع والحياة والعصر منظومة القيم والأفكار التي تبشر بها تلك الأيديولوجيات، وهو ما نجده عند بعض هؤلاء الشعراء في محاولة منح بعض الرموز الدينية والتاريخية دلالات معاصرة تعكس هذه الرؤى والدلالات الجديدة. إن هذه الرؤية الرومانسية الحالمة التي طغت على تجارب شعراء تلك المرحلة هي انعكاس للتصورات والرؤى التي كانت تبشر بها هذه الأيديولوجيا ولذلك كان من الطبيعي أن تهيمن هذه التجارب مستفيدة من المناخ الفكري والسياسي الذي كان يسود آنذاك ويسهم في تكوين المزاج العام خاصة عند جيل الشباب الطامح الذي كانت تغريه كثيرا ما تقدمه الأيديولوجيا من رؤى طوباوية عن الثورة والمستقبل والحياة. إن سلطة الأيديولوجيا على العديد من شعراء تلك الحداثة تجاوزت في بعدها الثقافي الشعر إلى نقده كما ظهر ذلك جليا في أغلب النقد السائد آنذاك لكون يلبي حاجات سياسية للأنظمة والأحزاب التي كانت تهيمن على الثقافة وتطبعها بطابعها الخاص. فمن كتاب “الأدب والأيديولوجيا” لمحمود أمين العالم إلى كتاب “الأدب والأيديولوجيا في سوريا” لأبي علي ياسين ونبيل سليمان. لقد كان هذا النقد الذي يشبه كثيرا سرير بروكرست مجرد محاكمة أيديولوجية للشعر ما جعل هذا النقد يمارس وصايته الفكرية والسياسية عليه وعلى شعرائه. إن هذه القراءات النقدية بغض النظر عن كونها تحاول أن تلوي عنق القصيدة لصالح الوظيفة الاجتماعية التي تحددها الأيديولوجيا هي امتداد لوصاية السياسة على الإبداع والثقافة، ما جعل تلك القراءات النقدية تعلي سلطة المرجعية الخارجية على حساب الشعر وبالتالي تسجن المخيلة الشعرية والشاعر في قمقم الأفكار والاشتراطات التي تحددها الأيديولوجيا بوصفها الناظم والمرجع للإبداع الفني.
إن الحداثة الشعرية العربية التي ظهرت على يد روادها والتي كانت في جزء مهم منها تحت تأثير الشعر الإنكليزي على هؤلاء الرواد سرعان ما اصطدمت بالأيديولوجيا، وتعد علاقة الشاعر العراقي بدر شاكر السياب المضطربة مع الحزب الشيوعي وخلافه معه هو التجسيد الواضح لمحاولة فرض سلطة الأيديولوجيا على الشعر وعدم قبول الشاعر بالخضوع لهذه الوصاية التي تصادر مخيلة الشاعر وحرية الإبداع التي يصعب تأطيرها وإيقاف اندفاعها. إن التحولات العاصفة التي شهدها العالم في نهايات القرن الماضي والفراغ الذي خلفه غياب هذه الأيديولوجيات ومعها غياب الحامل الاجتماعي جعل الثقافة العربية عموما والشعر خصوصا يمرّ بمرحلة من الضياع وفوضى الكتابة ناجمة عن محاولة الشعراء الجدد القطيعة مع التراث الشعري ورموزه دون أن تتبلور لديهم مرجعية بديلة أو محاولة واعية لملء هذا الفراغ وتكوين وعي شعري مغاير باستثناء تلك الترجمات البائسة ومحولا ت الاستنساخ والاستسلال التي تنمّ عن الجهل وعدم الرغبة في الاجتهاد والبحث وتطوير الوعي الشعري والجمالي والعلاقة مع اللغة باعتبارها الحامل وأداة القول والتشكيل، ولعل عوامل وأسباب كثيرة تقف في خلفية هذا المشهد الذي ما زال يواصل انحداره وكأنه انعكاس لصورة الواقع العربي المتردي في حاضره الحزين.




