كثير من الجنس قليل من اكتشاف الذات

غالبية أفلام المراهقين أو تلك التي تتعامل مع شخصيات يُفترض أنها في عمر المراهقة في السينما العربية، تتعامل بالطبع مع ذكور أو إناث مغايري الجنس، يبحثون دائما عن الحب والحرية والجنس، واكتشاف أجسادهم مع الجنس الآخر. يكون هناك أيضا خط شبه مستمر لتسلّط الأهل؛ خاصة الأب، وإن كانت ثورة المراهق ضد السلطة البطريركية الممثلة في الأب لا تجد لها متنفسا بصورة عميقة كما ينبغي، بل يصبح الأمر تسطيحيا للغاية بعلاقة الولد بأبيه وغالبا ما تُصور علاقة الابنة الملتبسة بأبيها مبنية على حبها لفتى يدفعها إلى هذا التمرد ولو بصورة غير مباشرة؛ فهي تتمرد لمجرد تواجدها معه. عادة ما تُصور أيضا علاقة المراهق بالمخدرات والخمر على أنها أحد أسباب التمرُّد دون تصوير حالة حقيقية لسيكولوجية التجريب لدى المراهق، والدافع وراء تعاطيه لمخدر ما أو أول مرة يذوق فيها الكحول.
أفلام المراهقة في السينما العالمية تتخذ حيّزا كبيرا من الاكتشافات والثيمات، ما بين الجنسانية وقصة البلوغ coming-of-age، والحب الأول والثورة والصراع مع سلطة الأهل والاغتراب وبين الضيق والقلق اللذين من الطبيعي أن يشعر بهما المراهق في هذه المرحلة العمرية الهشة؛ إضافة بالطبع إلى أفلام الرعب والاستحواذ والكوميديا، والأفلام التي تدور في المدارس، بحيث تكون هناك مساحة ثرية للصراع واكتشاف الشغف والشبق وأيضا للعنف.
أما في السينما العربية فغالبا ما يتم حصر قصة البلوغ في اكتشاف المراهق أو المراهقة للجنسانية، والشغف بالجنس الآخر، أو التعرض لسلطة الأهل والمؤسسة؛ سواء المدرسة، أو البيت، أو الدولة في أحيان قليلة. وإن كانت هناك بعض الاستثناءات التي تتعمق ولو عن طريق شخصية ثانوية في سيكولوجية المراهق، وما تمثله هذه المرحلة الفارقة في حياة الإنسان.
الفتى المراهق ما بين الذكورة والحرب
إحدى المعالجات الهامة والمتعمقة في التعامل مع المراهقين في السينما تُنسب إلى يوسف شاهين من خلال فيلم السيرة الذاتية الأشهر “إسكندرية ليه؟”، حيث يحيى شكري مراد المراهق الشهير وشلة أصدقائه؛ ما بين طموح يحيى السينمائي وعلاقته بأصدقائه، والطبقية التي تغلّف علاقة أهله بمن حولهم، وتخبطه في مصر أثناء الحرب العالمية الثانية، ما بين رغبته في الظهور كبطل أمام أصدقائه ولامبالاته بالأحداث السياسية المحيطة به، سجل شاهين شخصية درامية حقيقية ومقنعة لمراهق يتخبط في كل شيء، من أول شغفه بالسينما وحتى علاقته بأهله وظل يحيى شكري مراد من أهم الشخصيات الذكورية المراهقة التي تم رسمها على الشاشة، وقد يعود هذا لأن شاهين كان يعبّر عن نفسه في المقام الأول، عن طريق أفلام السيرة الذاتية التي يسرد بها انعكاس رؤيته لنفسه من الصِغر وحتى الكِبر.
وفي فيلم مثل “عودة الابن الضال” تتجلى فكرة تمرد المراهقة على السلطة البطريركية الممثلة في الأب الذكوري المتحكم من خلال عائلة المدبولي، ونهاية رب العائلة طلبة على يد ابنه علي الذي بات ينتظر عودته بعد غياب. منح شاهين المراهقين تفيدة وإبراهيم الأمل، وجعلهما الناجيين الوحيدين من المذبحة العائلية المولودرامية، ونسج من قصة بلوغهما منذ بداية مغادرتهما المدرسة وحتى مغادرتهما القرية الملعونة رحلة بلوغ شديدة الحساسية، متضمنة القبلة الأولى والتي يتعثر إبراهيم ويقع من شدة جمالها في مشهد قلما تجد مثله في السينما العربية، ويذكّرك بقبلة الطفلين فادا وتوماس في فيلم “فتاتي” الأميركي الشهير، والذي انتشر بين جيل التسعينات بالفيلم “الذي يموت ماكيولاي كالكين في نهايته”.
إحدى العادات غير الحميدة هي تصوير المثلية الجنسية دوما في السينما العربية كنتاج عن حادث اعتداء جنسي على الطفل في الصغر، وإن اختلفت طريقة المعالجة لأثر الحادث في ما بعد؛ أحد أهم الأفلام التي عالجت أثر العنف الجنسي على الطفل وتبعات المسكوت عنه في المجتمعات الذكورية التي تبالغ في الاحتفاء بالذكورة مما يدفع الرجال إلى قمع الاعتداءات والعنف الذي تعرضوا له صغارا لئلا يظهروا بمظهر الضعفاء هو “ريح السد” للمخرج التونسي نوري بوزيد والذي قام بكتابة السيناريو والحوار للفيلم أيضا. يكمن جمال الفيلم في الطريقة التي يتعامل بها مع تبعات الاعتداء الجنسي على الذكر في مجتمع شرقي؛ من خلال التضاد ما بين مراسم الزفاف التقليدي في تونس لشاب يُدعى هاشمي، ومعاناة هذا الشاب من الاعتداء الجنسي الذي وقع عليه في طفولته/مراهقته المبكرة من قبل النجار “الأسطى” الذي كان يتمرن على يديه هو وصديقه فرفات؛ فالتناقض ما بين المغالاة في الاحتفاء بالزواج والذي من خلاله يعلن الذكر الشرقي عن رجولته والمعاناة التي يعانيها نفس الذكر بسبب كتمانه لسرّ يؤرق رجولته المنتظرة على فراش الزوجية.
قد ينبثق هذا من وعي بوزيد الزائد بالبطل الذكر العربي؛ وهذا من خلال كلامه المنشور في الورقة البحثية بعنوان “الواقعية الجديدة في السينما العربية: سينما الوعي بالهزيمة” عام 1995، والتي يوضح من خلالها تسليطه الضوء على أبطاله الذكور المأزومين، التائهين والمشتتين ما بين أزمات تصيبهم فتهز قناعاتهم من الأعماق. وقام عزيز كريشان بتحليل أفلام بوزيد الأوائل، ومنها “ريح السد” من منطلق أزمة النسب المتأصلة في المجتمع التونسي والتي تنبع من تمرُّد الشباب والمراهقين على آبائهم الأصليين كما فعل هاشمي مع والده في “ريح السد”، بل إن مشهد البداية الذي يصور عملية ذبح دجاجة بالتفصيل، ضمن احتفالات العُرس ما هو إلا إسقاط على موت براءة هاشمي مع أول تجربة جنسية في حياته، وهي تجربة الاعتداء من قبل الأسطى الذي يعمل لديه هو وصديقه فرفات.
وعلى صعيد آخر، يأخذ الاعتداء الجنسي على طفل وسيلة أيضا لمثليته الجنسية في فيلم “أسرار عائلية” للمخرج هاني فوزي، لكن الصورة التي يتم تصوير المراهق المثلي بها تأخذ صورة فجة ركيكة، معتمدة على القالب الجاهز للمثلي الذي يتمتع بصفات نسائية تقليدية تصب في خانة التقييم الجندري الجاهز لما هو “ذكوري” وما هو “نسائي” وبدا تشبّع الممثل محمد مهران بطريقة الأداء الكلاسيكية على مدار الفيلم، وليس بجديد على السينما المصرية تقييم الشخصيات الذكورية إلى الذكر الأكثر اقترابا من حلم الذكورة الشرقي، والشخصية المائعة الرقيقة والتي تثير النفور وغالبا تمثل مصدر الفيلين في الفيلم ولو بشكل كوميدي؛ وعلى سبيل المثال فلوسي ابن طنط فكيهة يبدو وقد ترك أثرا واضحا على شخصية مروان/نور التي يؤديها محمد مهران في “أسرار عائلية”. ومع خلو الشخصية من الأبعاد التي يمكن قياس العمق عليها بالمقارنة بين الشخصيات المثلية والشخصيات مغايرة الجنس في الفيلم، يبدو الاعتداء الجنسي صورة ممجوجة، رخيصة، ووسيلة لتبرير المثلية الجنسية في محاولة لكسب تعاطف الجماهير المحافظة مع شخصية مروان/نور.
طبقا لرواية فجر يعقوب، الناقد السينمائي الفلسطيني، فإن فيلم “أحلام المدينة” لمحمد ملص يصور دمشق الخمسينات تنمو وتكبر من خلال عيني طفل يمر بقصة البلوغ الشهيرة؛ وجهة النظر هي الطفل/المراهق وهي نظرة قلما طرحتها السينما العربية باستثناء فيلم مثل “بحب السيما” مثلا، ومن خلال الطفل الذي لا يمر بمرحلة البلوغ بقدر ما نرى انعكاس رؤيته على أفعال الكبار من حوله، لتصبح للمشاهد رؤية أكثر طزاجة لأفعال الكبار من حوله. وفي “أحلام المدينة” يبدو ساكني دمشق أبطال مسرحية، يقبع ديب مراقبا للأحداث التي تدور على خشبتها من حوله، مجبرا على خوض مسرح الحياة مبكرا.
في الفيلمين، تظهر السينما العربية معاناة المراهق مع الحياة في المدينة العربية القاسية، والتي تجبر كليهما على النضج مبكرا سواء النضج الجنسي في “ريح السد” أو بالتعرض لقسوة الحياة والعيش في “أحلام المدينة”، وفي الأخير بالذات يصور ملص رحلة الطفل ديب من البراءة التي لازمته في مدينته القنيطرة إلى المدينة الواسعة التي ترزح تحت وطأة القلاقل السياسية، وإن كان الفيلم يعنى أكثر بتصوير المدينة وانعكاس الطفل ديب عليها برحلة بلوغه، لا العكس. للأسف ينتهي الفيلمان بالعنف كدلالة على وصول الأشخاص الرئيسيين للنضج وعبورهم من الطفولة إلى أعتاب المراهقة الذكورية، فيعتدي ديب على الرجل الذي غرّر بأمه ويقتل فرفات الأسطى الذي اعتدى عليه صغيرا؛ مما يوضح أن العنف جزء من المنظومة التي ينشأ عليها المراهق، وهو وسيلته الوحيدة لعبور نفق البلوغ، حتى يصبح رجلا ناضجا.
ويتجلى نضج تعامل السينما العربية مع قصة البلوغ من خلال فيلم زياد الدويري “بيروت الغربية”، حيث أن المراهقين الرئيسيين يلهوان وسط الحرب الأهلية اللبنانية دون استيعاب حقيقي لعمق مأساتها، ومع الغوص في عمق السرد تبدأ الحقيقة بالتكشف رويدا رويدا للمراهقين طارق وعمر، ويكبران رغما عنهما وخصوصا عندما تصبح الحرب أكثر من مجرد وسيلة للتهرّب من المدرسة. تعامل الدويري مع شخصيتي طارق وعمر يبدو شديد السلاسة، من خلال استخدامهما للغة حوار حقيقية غير منمقة، بحيث يتداخل السباب والغناء والمزاح لتصنع حالة حقيقية مقبولة لدى المشاهد من قصة لمراهقين يستمتعان بوقتهما حتى تحت وطأة الحرب.
على العكس من التجارب السابقة، بالرغم من أن شيرين دعيبس تجعل من شخصية منى المرأة الفلسطينية المهاجرة إلى أميركا محور فيلمها “أميركا”، إلا أنها، وبوعي من تجربتها الشخصية كمراهقة فلسطينية تنمو في بيئة مغايرة، استطاعت رسم الفوارق ما بين شخصيتي المراهقين فادي وسلمى اللذين يتعرضان سويا للنظرة العدائية التي طالت جميع العرب المهاجرين إلى أميركا ما بعد أحداث 11 سبتمبر 2001.
قد يكون اهتمام دعيبس بتسليط الضوء على امرأة في منتصف العمر بدلا من المراهق أو المراهقة هو ما منح الفيلم صبغة حقيقية ومسحة من الاتساق مع الواقع المغمور بالتفاؤل بصرف النظر عن سوداويته؛ مما دفع الناقد إبراهيم العريس إلى تشبيه الجو العام للفيلم بأفلام السينما الأميركية المستقلة الحديثة مثل “مس سنشاين” لجوناثان دايتون وفاليري فاريس وأفلام ألكساندر باين التي تسخر من المجتمع الأميركي المعاصر دون إرهاقها بالنظرة الجدية التي قد تقلل من قيمتها الفنية والإبداعية. في “أميركا” صنعت دعيبس جوا مماثلا للبيئة التي نشأت فيها، لكنها لم تهتم برسم شخصية فتاة مراهقة، بقدر ما اهتمت بتصوير المراهقة العربية لشخصية المهاجر العربي في أرض معادية لوجوده وانتمائه، وإن كانت الخفة التي طرحت بها دعيبس قضيتها هي ما حملت صورة المراهق فيها صبغة ثانوية على خلفية الموضوع الأشمل والأعم وهو المواطن العربي بصفة عامة وعلاقته بالمكان؛ سواء الأرض المحتلة في فلسطين أو البيئة الأميركية المعادية للعرب ما بعد 11 سبتمبر 2001.
المراهق والدين: طرح الأسئلة وتفصيل الأجوبة
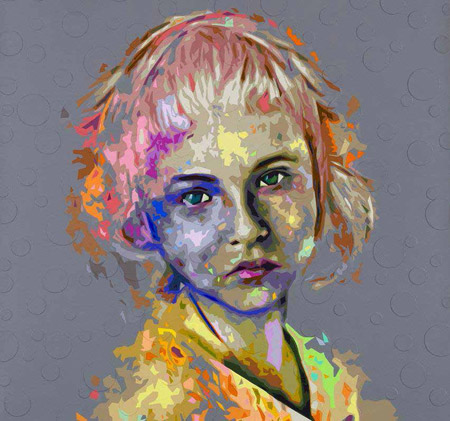
على صعيد آخر، اهتم فيلم أوقات فراغ بالجنسانية لشخصياته الذكورية بالذات، لكنه أيضا حاول التعامل بصراحة وجرأة مع نظرة المراهقين للدين؛ تخبّط شخصية منّة ما بين رغبتها في الحجاب وولعها بارتداء المايوه واستخدامها للدين لتصل إلى ما تبغي من مصالح شخصية، فهي تستخدم الدين لتضغط على حبيبها ليتقدم لخطبتها وترتدي الحجاب لتداري على فضيحة تداول صورة تظهر مفاتن جسدها، وترتدي الحجاب بعد أن تنتهي قصتها مع حبيبها حازم نهاية مأساوية ربما لتقترن بحبيب آخر، وعلى صعيد آخر فهو يظهر محاولة المراهقين، وخاصة عمرو الشخصية المتزنة نسبيا، للتدين مع تعلقهم بما يرونها حياة دنيوية غارقة في الملذات، خاصة بعد موت صديقهم في حادث سيارة مما يزعزع ثقتهم في أنفسهم، فيهربون للدين أملا في النجاة من مصير مماثل، وإن كانوا في قرارة أنفسهم لا يرون في الدين ما يجذبهم، ويتمنون لو كانت الحياة ممكنة دونه؛ الطزاجة والنضج اللذان خرج بهما “أوقات فراغ” نبعا من أنه التجربة الأولى لمؤلفه عمر جمال والذي استوحاه من الواقع المحيط به، وبعيدا عن الإخراج الضعيف وعدم احتواء الفيلم على أي مشاهد جريئة قد ترفع من قيمة المحتوى الجريء إلا أنها تجربة هامة وتستحق الإشادة النقدية وحققت نجاحا جماهيريا هائلا لأنها لمست وترا بالتشابه عند معظم مشاهديها من المراهقين، سواء الصبيان أو البنات.
يُحسب للفيلم أيضا استخدام عمرو خالد الداعية الشاب كرمز للتديُّن السطحي المُطعم بنظريات التنمية البشرية التي تبيع الهواء في زجاجات للمراهقين بحيث تجعلهم يعتمدون على الشيخ أو الداعية بصورة لا تجعلهم يستطيعون الحياة دونه، وفي نفس الوقت، لا يجدون السلام المنشود الذي يبحثون عنه، في وقت كان لزاما فيه على الكبار أن يخبروهم بأن لا حلول نهائية ولا خلاص.
يلعب الدين دورا محوريا في فيلم “ماروك” للمغربية ليلى مراكشي، بحيث نشاهد تعامل المراهقين المغربيين مع الدين، وكيف يتحول الدين من مجرد قصة هامشية في حياة الطبقة المغربية المخملية، إلى قضية يتشاجر عليها الجميع، بحيث تتراجع قصة الحب بين ريتا المسلمة ويوري اليهودي لتعرية كريمة المجتمع المغربي والذي قد ينتفض لمجرد تلاقي مراهقين من دينين مختلفين بينما يترك مراهقوه ينعمون بجميع ما تحرّمه نفس هذه الأديان بعينها، فينتفض المسلمون واليهود الغير ممارسين لأديانهم لمجرد أن صبيا وصبية من المعسكرين المختلفين وقعا في حب بعضهما البعض.
بصورة شديدة الركاكة أيضا، يتناول فيلم “بالألوان الطبيعية” السلطة الذكورية البطريركية من خلال مناجاة المراهق يوسف لربه، وقصة بلوغه من المراهقة للشباب، بينما يحاول أن يجد مكانا لنفسه بين الفن الذي يحرمه دينه، والحب الذي تاه في دروبه ما بين الفتاة التي أحبها فقط لتتجه للتطرف، والمرأة التي أغوته ولم يجد معها وسيلة للوصول إلى السلام الذي كان ينشده. في هذا الفيلم، يقلب أسامة فوزي المنضدة، فيضع المراهق مكان المراهقة؛ فيصبح يوسف هو الهدف الواقع بين شقي الرحى؛ وبمقارنة يوسف بجميلة نجد أنهما تبادلا الأدوار في كل من “مذكرات مراهقة” و”بالألوان الطبيعية”، فبينما يفقد يوسف عذريته على يد حبيبته إلهام التي تتخلى عنه في ما بعد، وتتم غوايته على يد ليلى المعيدة الفاشلة التي تستغل موهبته لأغراضها الشخصية، تفقد جميلة عذريتها على يد رؤوف الذي يتخلى عنها ويتم الإيقاع بها على يد هيثم الذي يستغل براءتها ويغتصبها تنكيلا بها لرفضها الانصياع له.
الفتاة المراهقة: جسد وثورة من أجل الحبيب
الفتاة مراهقة في السينما العربية أسوأ حالا من نظيرها المراهق، فغالبا ما يتم تصويرها على أنها الفتاة شديدة الجمال، وتُمثل قصة بلوغها في اكتشاف الجنس الآخر سواء بممارسة الجنس أو باكتشاف جسمها وتفاعل الآخرين من حولها معه؛ كشخصية منة شلبي في فيلم “الساحر” مثلا، والتي مع تسليط الضوء على فكرة بلوغ الفتاة وما يترتب عليه من تغييرات فسيولوجية وهرمونية، إلا أن الموضوع يتم حصره في انجذابها لصبيين من عالمين مختلفين؛ حازم وحمودة، وعلاقتها المعقدة بوالدها تنحصر في عدم مقدرته التعامل وأنوثتها الفائرة.
وقد تغفر الطبقة التي تنتمي إليها الفتاة المراهقة نور عدم اعتناء الفيلم بأي أبعاد أكثر عمقا لشخصيتها وقصة بلوغها، لكن الأمر يتكرر وبشدة في أكثر من فيلم. من أول “مراهقات” ماجدة الصباحي حيث ثورتها تتلخص في تسلّط أمها وأخيها، وخلاصها يأتي على يد فارس الأحلام الجميل الوسيم، و”مذكرات مراهقة” لإيناس الدغيدي، حيث المراهقة الحالمة تفقد براءتها على أيدي الرجال الذئاب، ما بين الحبيب رؤوف الذي يغرر بها، والصديق هيثم الذي يستغل سذاجتها ويغتصبها، فتُنتهك شعوريا وجسديا، وتتحطم سحابة أحلامها الوردية على واقع الرجال فيه عُصبة متوحشة لا تأبه لمشاعر النساء ولا لأجسادهن.
في الأفلام المصرية بالذات، دائما ما يتم تسليط الضوء على المراهقة الجميلة ومعاناتها مع جمالها وأنوثتها التي تفور مع مشاعرها في قصة بلوغها، وتؤدي دوما دور المراهقة ممثلة أكبر سنا، شديدة الجمال والجنسانية، سواء شادية في “التلميذة” أو نادية لطفي في “مذكرات تلميذة” أو هند رستم في “الجسد”. ودائما ما تتضمن القصة فتى وغدا يغرر بالمراهقة الجميلة، وحبيبا مثاليا أو متخاذلا ينفصل عن حبيبته ويعود بعد أن يفوت الأوان. أفلام المراهقات التي تتضمن فتيات في أدوار البطولة نادرا ما تخرج عن حيز قصة بلوغ الفتاة الجنسية، وتفتّحها على الحياة من خلال علاقتها بالجنس الآخر.
وفي السينما التونسية، يهتم فيلم مثل “صمت القصور” لمفيدة تلاتلي بقصة بلوغ عليا ونضجها المبكر في القصر الذي تعمل فيه والدتها طباخة وراقصة ومطربة بل وجارية لأحد أبناء الأسرة الحاكمة التونسية، فتعي مبكرا ميزان القوى وتفهم لعبة الجنس في تحديد الأدوار داخل القصر الذي يمثل مرآة مصغرة للحياة. تبدو الأحداث السياسية هي الأخرى عباءة مخملية تُنسج عليها العلاقات الإنسانية، والانتهاكات النسائية، وتُصور عليا المراهقة الصغيرة كمثال لمقاومة المرأة ودورها في مجتمع طبقي ذكوري لا يلقي بالا لابنة الحرام ولا لأمها، وكما أوضحت الناقدة خيرية البشلاوي في تحليلها لفيلم “صمت القصور” بقولها هو فيلم “يطوي عالما نسويا يموج بالمعاناة والعبودية والأمنيات المجهضة، والآمال البعيدة في عالم صامت أو محافظ”.
ومن نسوية تلاتلي إلى “الباب المفتوح” حيث رواية لطيفة الزيات الشهيرة تتحول إلى أيقونة نسوية تتداولها الفتيات، وتعالج المراهقة بصورة أكثر شمولا من مجرد فتاة تبحث عن الهروب من سلطة الأب الذكورية عن طريق المشاعر، بقصة بلوغ شديدة العمق لفتاة تحاول أن تجد ماهية “الحرية” وهل هي مجرد علاقة عاطفية مع ابن الخالة، أم انبهار بالحبيب الثائر، أم الانجراف في طوفان التقاليد، حتى تجد المراهقة ليلى نفسها تنضج وتنساق في ركاب الثورة، وتجد حريتها في الالتحام بالجماهير والهروب من أسر الطبقة المتوسطة المحافظة بتقاليد زواجها وترتيب الأدوار الجندرية فيها. يُعتبر تعامل تلاتلي مع النسوية من منطلق جنسي ونسائي بحت، بينما اضطلعت لطيفة الزيات ومن ورائها هنري بركات، مخرجا “الباب المفتوح” في التعامل مع قصة بلوغ المراهقة ليلى وتحررها من أسر التقاليد الاجتماعية والسلطة البطريركية، على النهج السياسي والقومي البحت، بحيث تم تدعيم النظرة للمراهقين كإحدى القوى التي ينبغي على الدولة ضمّها إلى كتائبها، والاستفادة من مشاعرها الجياشة في دفع عجلة النماء. تصبح الفتاة المراهقة من منظور الزيات وبركات سلاحا سياسيا واجتماعيا، وقصة الحب أكثر من مجرد وسيلة لاكتشاف الكيفية التي تتحرر بها الفتاة من قيود المجتمع والرقابة الداخلية التي تفرضها على نفسها بنفسها.
والنسوية أيضا هي ما دفع ليلى بوزيد لرسم شخصية فرح في “على حلة عيني” المراهقة المتمردة على طبقتها وحياتها، وإن كانت ثورتها الكبرى ليست على كلية الطب التي تمنت والدتها أن تلحقها بها، ولا لأجل حبيبها، بل ثورة على البلد الذي حاولت بفنها أن تكون جزءا من انتفاضته ضد القمع والدكتاتورية. أما الجسد والجنسانية فقد مثلا المحرك الرئيسي لقصة بلوغ لينا في فيلم دانيال عربيد الواعد “معارك حب”، حيث تضعنا المخرجة من وراء الكاميرا لنشاهد العائلة اللبنانية من منظور لينا ابنة الـ12، وتفتحها جنسيا على يد الخادمة سهام، بينما الحرب اللبنانية الأهلية كالعادة على خلفية الأحداث الفردية، بحيث تحرك ضغوط الحرب وصعوبة المعيشة التفاعل بين الشخصيات. والمثير في فيلم عربيد، أنها تظهر تفتح المراهقة جنسيا لا عن طريقها، بل عن طريق تأملها لحياة الخادمة سهام المنفتحة جنسيا، ووعيها بجسدها وشبقها، بينما كان اختيار المخرجة للممثلة التي أدت دور المراهقة لينا شديد الحساسية والذكاء، نظرا لملامحها العادية، وملاءمتها للشريحة العمرية التي تمثلها على الشاشة، بعكس الأفلام المصرية في أغلب الأوقات، والتي تختار الممثلات الفاتنات لأداء أدوار المراهقات.
ثيمات المراهقة في السينما المصرية
حاولت الكثير من الأفلام المصرية تحديدا اللعب على ثيمة “إلى أستاذي، مع حبي” من بطولة سيدني بواتييه وإخراج جيمس كلافيل، حيث المدرّس الذي يقتحم بيئة معادية في مدرسة متمثلة في إدارة متحجرة وطلبة متمردين، ويقوم بتقويم سلوكياتهم وتفهم دوافعهم، وينتهي الفيلم غالبا وقد تم إنقاذ هؤلاء الطلبة على يد المدرس النبيل؛ والأمثلة على ذلك كثيرة من فيلم “مدرستي الحسناء”، حيث تقود هند رستم فصلا تقوم بأدوار معظم طلابه مجموعة من الممثلين الذين تخطوا العشرينات، وفيلم “الأبالسة” والذي يقوم فيه فريد شوقي بدور مدرس موسيقى مرهف في أسوأ كاستينغ شهدته السينما، خاصة عندما تتطور الأحداث لتقع نورا في حبه، أو فيلم “مدرسة المشاغبين” والذي قام بمحاكاة المسرحية الناجحة بصورة فجة شديدة الركاكة، أو “ديسكو ديسكو” الفيلم الذي أثار ضجة حين تم عرضه لأنه كالعادة اشتمل على خفايا المراهقين وعالم المنحرفين والذي قامت المخرجة إيناس الدغيدي للأسف بتسطيحه وتحويله إلى مجموعة من الرقصات والاستعراضات المبتذلة والتي حاولت بها محاكاة ما تتخيل أن المراهقين يقومون به في هذه الأماكن.
ظهرت أيضا في السبعينات والثمانينات مجموعة من الأفلام التي تزخر بشخصيات المراهقين والذين تنحصر أدوارهم في الفتاة التي يُغرر بها أو تود ارتداء مايوه مع رفض أهلها لذلك، الفتى المنحرف الذي يتحرش بالخادمة أو يشرب الخمر والسجائر دون علم أهله، العلاقات الجنسية بين المراهق والمراهقة وانعكاس هذا على الأسرة ورمز الاستقامة في الفيلم سواء مدرس – خادمة – أحد أفراد العائلة..إلخ، مما سطح فكرة المراهق وأحالها إلى قالب جاهز يمكن أن يصنعه المخرج والمؤلف ليخرجا بطبخة تثير استحسان المشاهدين وإن كانت لا تدفعهم للتفكير أو تميل إلى التدريب.
الملاحظ في الكثير من الأفلام السالف ذكرها أن من بين صانعيها من لم يقترب من عالم المراهقين من قريب أو من بعيد، وكان تصويرهم له بناء على تخيّلهم لما يمكن أن يتصرف به المراهق أو المراهقة، وبدا الفارق واضحا في الأفلام التي اعتنى مخرجوها ومخرجاتها باختيار الموضوعات والممثلين، وتلك التي تعاملت مع المراهق كثيمة أكثر منها كيانا إنسانيا هشا له أبعاد مختلفة تنبع من كونه لوحة صالحة لترسم الدنيا عليها معالم المستقبل العربي، ما بين دول تئن تحت وطأة الحرب، وأخرى تنعم لأول مرة بالاستقلال عن الاستعمار الأجنبي.




