ما زلتُ أقفز بين الغرف

للشّاعرة رائحةُ نهر
يجري في الغابةِ
حاملًا أيّامها اليابسة.
للمرأةِ رائحةُ الموتِ
الذي يأتي قبل الأوان
ويحملُ ركّابًا إضافيّين
في عودته.
ما نفعُ الكلماتِ للطيور
ما نفعُ سنوات
أرضعتني فيها الحياة
حليبها المرّ
كريحٍ تنقلُ أشلاء الشّجر؟
ثمة طرقٌ كثيرة نحكي بها
كيف وُلدنا في أمكنةٍ
لا تحبّ النّساء.
ثمة وجوهٌ عديدة للموتِ،
حلقٌ تسدّه غصّة
أو شربُ الكثيرِ
من الحزن والألم والضّحكِ
والبكاء والماء والهواء،
والرّجاء المزمنُ
في أن تغدو الكلمات حيّة
لتجد طُرقًا كثيرة لترحل
وطريقةً واحدة لتُكتب.
****
بلا كللٍ
درّبتُ يدي
لتكتُبَ هذه القصّة
ذرعتُ بها الشّوارع والأزقّة
لاكمتُ بها الجدران والأبوابَ
ودفعتها من النّوافذ
لتسقُط وتعود
صاعدةً الأدراج بسُرعة.
لأجلها تعلّمتُ الكتابةَ
مثل الذي قُذف في البحر
ليُجيد السّباحة.
بيأس الغرقى
يحرّك ساعديه وساقيهِ
طالما لم يقل له أحدٌ
إنّ التّلويح قاتلُه
وإنّ الماء يمكن أن يحمله
فيجرّبهما معًا
“التّجربة معيار الحقيقة”.
أدخلتني أمّي المطبخ بيد مشغولة بالأسئلة:
من أين أفصلُ جذوعَ الدّجاج؟
كم من الزّيت أحتاج لتغطِس البطاطس؟
ما من أحدٍ ليُجيب،
بينما الأفواه الجائعة كثيرة.
لم يعلّمني أحدٌ كيف أُغطّس آلامي في الورقة
ولا أغرق،
أو كيف أمنع الكلماتِ
من أن تحمل قلبي في انهمارها.
لم يعلمني أحد
كيف أنزع فتيل الذّكرياتِ
وألقيها على الورقِ
مثل وحوشٍ
تزحف داخلي
بدأبِ منشارٍ
تقاوم يدي العارية.
لا أعرف كيف أقود الشّعر
الذي أتنفّس
لنَعود إلى الوراءِ من حيث مرّت الحياة
أو أحمِّلهُ همّ مجيئي
من مدينةٍ صغيرة
في مكان ناءٍ
يلفُّ الجبال سبعَ مرّاتٍ
جبلًا
جبلًا
على هذه الجبال
علّمتني أمّي لغةً لا تُكتب،
لغة النّساء والحبّ والرّغبة والحلمِ
والاشتهاءِ والرّكضِ في الجبال والسّهول،
وتسريح الشُّعور عند سَطح بئرٍ
تُردّد الرّيح بين جدرانه
صدى الأغاني القديمة.
أنا المنحدرةُ من سلسلةٍ طويلة من نساء لم يُهَدهَدنَ
وصَدى الهدهدة كان يُسمع بوضوح في طُرقهنّ.
لا وقت لأحد ليُهدهد أحدًا
ثمّة نساءٌ يركضن لأيّام كثيرةٍ
وما من حضنٍ يأوين إليه.
كانت الجدّةُ تلتقط البنات الآتيات من رحمِ أمي، مثلما تتلقّفُ مواليد القطط.
“صبرًا جميلًا”، يقول جدّي.. “سيأتيك الله بالولد مرّات أخرى”.
كان هناك طفلان أصغر منّي، والآخرون كانوا أكبر، فلم أنعم بحصتي من الأحضان والقُبل.
بصمت، كنت أتفرّجُ على الذين وضعوني في علبة النّساء:
“وُلدتِ لتكوني زوجة طيّبة”.
أبٌ يحرمني من المدرسة، أمٌّ تدفعني إلى المطبخ: “لا، بدّ للمرأة أن تتعلّم الخياطة، أن ترقّع جوارب الزّوج والأولاد”.
لا عتبات ولا أبواب
وعمري آنئذ، عشرة أعوام.
لا أملكُ غير روحٍ واحدةٍ
مُدّ يدكَ
انتشِلها
لينزلق قلبي إلى الحياة.
آه،
عشرةُ جروحٍ، ومتُّ.
متُّ مثلما يموت سائر النّاس. يُغمضون أعينهم ويلتقطون آخر أنفاسِهم.
يدخلون عالم العَتمة من دون احتجاج، ويدور شريط حياتهم أمام أعينهم.
تخيفهم للمرّة الأخيرة الأشياء الضّائعة.
مثلهم رأيتُ ندوبًا تمرُّ ببطء مثل توليف سيّءٍ لفيلمٍ
أَبطَأَ المخرج المَشاهِد فيه تاركًا اللّحظاتِ تمرُّ.
نفدَ البُكاء ولم تنفدِ الحسرات. حملتُ نفسي وهربتُ بحثًا عن أفق وصدرٍ واسع، ويد تكسر العلبة.
تركتُ الجدران المدهونَة بالغَضبِ
تركتُ رماد عينَي أبي المطفأتين
تركتُ كلّ شيء كأنّني ذاهبة إلى عالم آخر.
أشيائي هنا لا تعني أحدًا هناك.
توقّعتُ بيتًا آخر، أو ما يشبه البيت،
لكن، ماذا في الشّوارع غير الذّئاب والكلاب والقطط والقمامة؟
في الصّباح التّالي،
طرقتُ الباب
بخزيِ جنديٍّ
قلبه لم تَعجنه المعارك.
في المطبخ وضعتُ سكّينًا على بطني لأواجه أمّي:
“لا يسألني أحدٌ أين كنتُ”.
كنت أعرف أنّهم سيرفعون الجُدران،
وأنّني لن أنجو.
وئيدة مرّت الخمس سنواتٍ التي تلت
في سجنٍ واسع
بجدران صمّاءَ
وغرف فارغة
أضيءُ مصابيحَها
أتنقّل فيها من عامٍ إلى آخرَ
بين ازدحام المدن وسكينة الجبال وسحر الجزر الخفيّةِ
أصعدُ إلى الغرفة في الطّابق الثّاني، وأعيشُ حياة الرّهبان
أنزل إلى الطّابق تحت الأرضي المتَّسِع أمامي
وأرقص في حلبة حياة أخرى.
الغرف فارغة للآخرين، ومُمتلئة بالأحلام لأيّامي.
حيواتٌ كثيرة عشتُها خلف الجدران
“أليسًا” دون أرنب أو جورب.
خططت طرقًا سرّيّة أخفيتُها في جيوب الفساتين
سافرت مع الرّجل الوحيد الذي أحببت،
بعد أن صنعته وسمّيته مثل صنمٍ قرشيٍّ
ومنحته حياة وقصصًا وحبًّا
دحرجت السّلالم تُجاهه.
هل يقدر على حملِ اسمه وصفاته من حُلمٍ إلى آخر؟
هل أتغيّر، بين حُلمين،
كهاربة من العدالة، تُغيّر وجوهها وأسماءها وألوانها وتاريخها وأحزانها؟
أكثر من امرأةٍ واحدة أنا أمام المرآةِ
وفي الغرف، هل كنتُ أنا نفسي؟
في التّاسعة عشرة هربتُ، بطرق أقلّ مأسوية.
حدَث الأمر ببساطة رغم أن ملِكًا حَكم أربعين عاما توفّي قبل الموعد بشهر واحد،
إلّا أنّ الضّحية ذهبت إلى المذبح بقلبٍ ميّت، ولم يكن من إشارة أكبر في يد الكون.
مات الملك هباءً،
ثم متُّ ثانيةً.
متُّ تمامًا
مثلما يموت أيٌّ كان.
وجلست على قبري:
اقفزي من النّافذة إذا كان الله قد منحكِ الضّوء
اركضي
ولا تلتفتي إلى الوراء.
هكذا بدأت أركض في الشوارع التي خبّأتُها في جيوبي.
ولم أصل بعد..
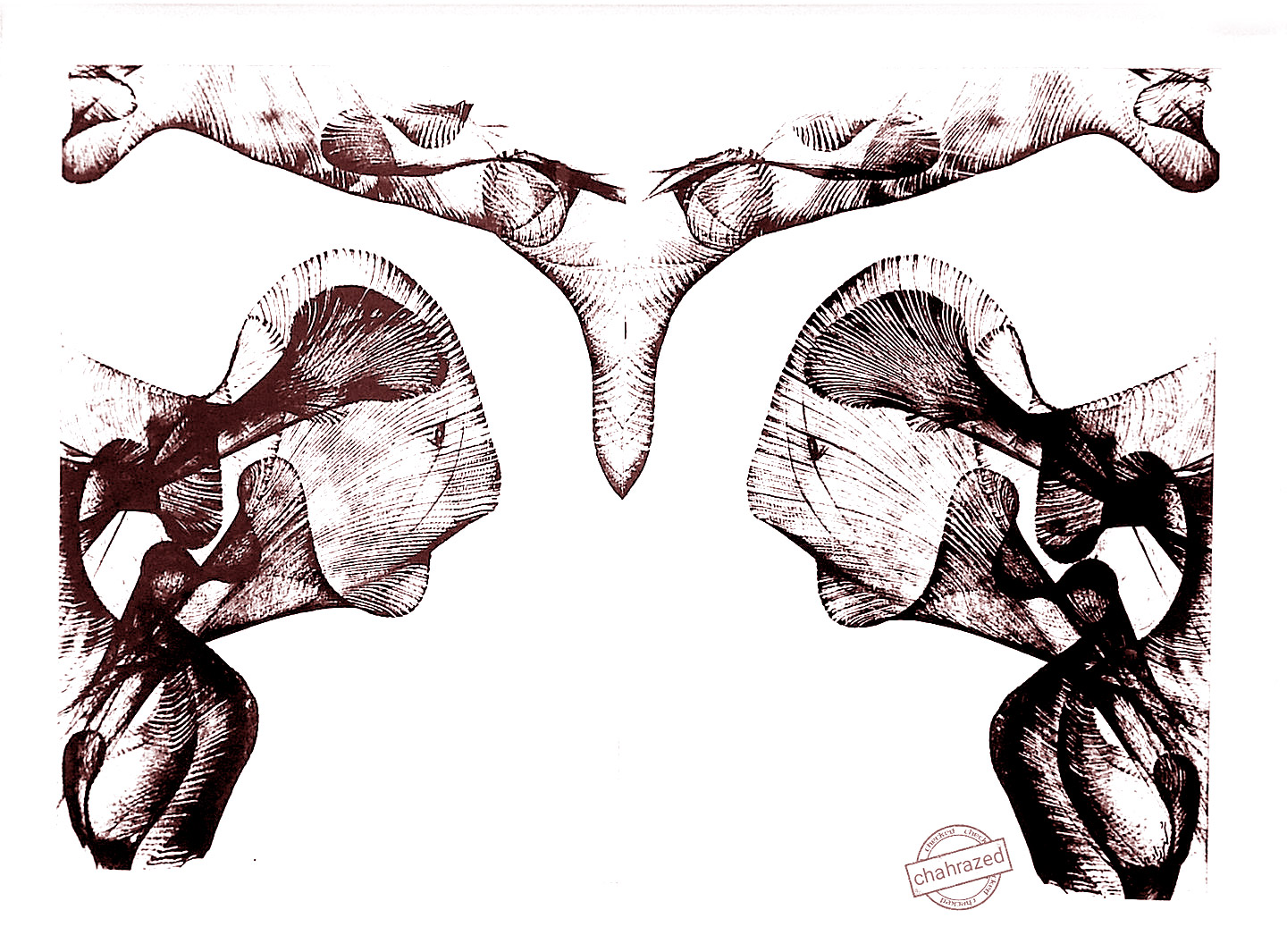
****
الآن، كلّ ما أقوله
يمكن أن يغيّر الواقع
ولن يتغيّر ما فيهِ
أبدًا
بعيدًا عن اللّواتي
حاولن أن يخترعنَ طرقًا خفيّة
وأبوابًا تُفتح بقبّعاتٍ، وأنفاقًا هوائية يقفزن فيها ويختفين..
أنزلقُ
من حياةٍ إلى أخرى
ولا أعيش إلّا مرّةً واحدة.
مثل ساحرات
صدّقن أنّ التّعاويذ تجلب الحبيب
وتُبعد الأعداء
وما من أجنحة على أكتافهنّ
أو عيون خلف رؤوسهنّ
ولا مكانس تطير
أحتملُ الأمل.
ليست لهن الحياةُ السّابقة على المجيء
وبدلًا من نحتِ الطّرق والعربات
يتفرّغن لفكّ مزاليج الأبواب والنّوافذِ
وتتسلّق عيونهنَّ الجدرانَ
نحو السّموات الشّاسعة للاحتمالات.
مثلهنّ عرفتُ طريقي
قبل أن آتي
وما زلتُ أهجرُ رطوبة الجدران
لأجل مباهجِ العراء
وأقفز بين الغرف.




