ميزان السّاعة
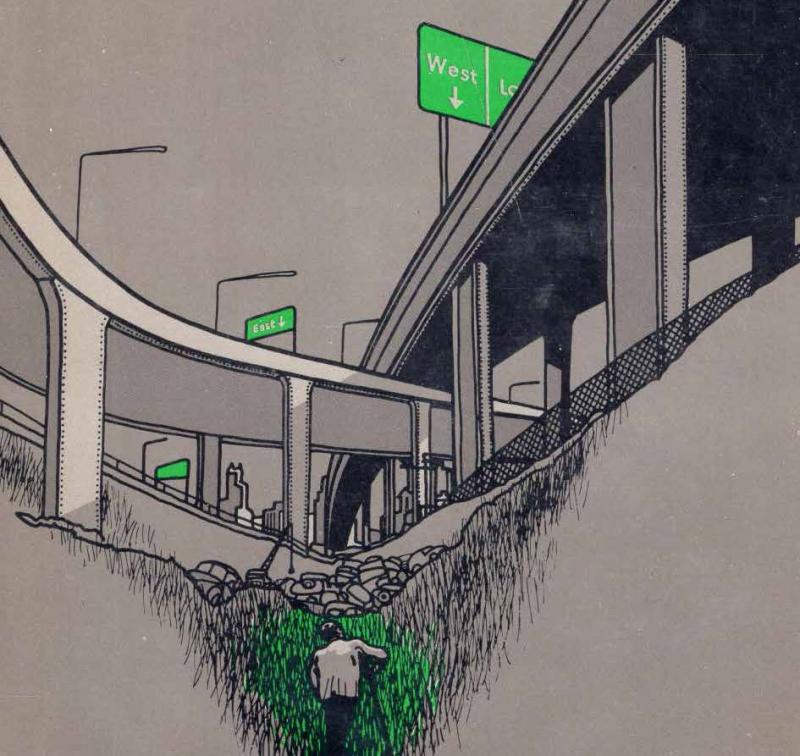
لم أكن وزوجتي نشاهد المسرحية باهتمام، حين لاحظت الكبوة للمرّة الأولى.
كنت مستلقياً قبالة المدفئة أحلّ الكلمات المتقاطعة، متفكّراً بهدوء بالكلمة في الخانة 17 عمودي (“يشار إليه بالساعات القديمة – 5 + 5 أحرف”) في حين انهمكت هيلين بخياطة حاشية ثوب قديم. عندما نظرت أخيراً إلى التلفزيون كان الممثل الثالث، وهو شاب أجشّ الصوت قويّ البنية مربّع الفك غليظ الرقبة، يتقدّم بصورة رجولية على طرف الشاشة. كانت مسرحية “أبنائي، أبنائي” وهي إحدى المسرحيات الميلودرامية التي تعرضها القناة الثانية مساء الخميس خلال أشهر الشتاء، وقد مضت ساعة على عرضها؛ وقد وصلنا إلى نقطة الكبوة تلك في لحظة ما من الفصل الثالث، المشهد الثالث، عندما يعلم المزارع المسنّ أنّ أولاده ما عادوا يحترمونه. لا بدّ من أنّ المسرحية بأسرها كانت مسجّلة، وقد بدا من الطريف للغاية العودة ربع ساعة بالزمن، من المونولوغ الحزين للرجل إلى مشهد المواجهة حينما يقوم الابن الأكبر بالضرب على صدره مستدعياً الرموز العظيمة. في مكان ما، لا بدّ من أنّ ثمة مهندس إرسال سيخسر وظيفته بسبب هذه الغلطة.
قلت لهيلين: “لقد تداخلت البكرات لديهم، هنا حيث بدأنا بالمشاهدة”.
نظرت إلى الشاشة: “أحقاً؟ لم أكن أشاهد. انقر على الجهاز”.
“تريّثي وسترين. بعد قليل سيبدأون بالاعتذار”.
حدّقت هيلين بالشاشة: “لا أظنّ أننا رأينا هذا المشهد، إنّي واثقة تماماً من ذلك”.
هززت كتفي وعدت إلى العمود السابع عشر رأسي، مفكّراً دونما تركيز بالساعات الرمليّة والشمسيّة والمائيّة. كان المشهد لا يزال مستمرّاً؛ أصرّ الشيخ على موقفه، وأخذ يصرخ بيأس بين اللفت: “أماه”. لا بدّ من أنّ الأستوديو قرّر إعادة عرض المشهد والتظاهر بأنّ أحداً لم يلاحظ الخلل. ومع ذلك فهم متأخّرون ربع ساعة عن موعد البرمجة.
بعد عشر دقائق تكرّر الأمر.
جلست مستقيماً، وقلت ببطء: “هذا غريب، ألم يتنبّهوا بعد للمشكلة؟ لا يعقل أن يكونوا جميعاً نائمين”.
حوّلت هيلين نظرها نحوي من سلة الإبر: “ما الخطب؟ أثمة خلل ما في التلفزيون؟”.
“ظننتك تشاهدين. قلت لك إننا رأينا هذا من قبل. إنهم يعيدونه الآن للمرّة الثالثة”.
أصرّت: “هذا غير صحيح، إنني واثقة من أنهم لا يفعلون ذلك. لا بدّ من أنك قرأت الكتاب”.
“العياذ بالله”، قلت ورحت أحدّق بالشاشة. في أيّ لحظة، سيظهر مذيع كان منكبّاً على تناول شطيرة، ويغمغم معتذراً للمشاهدين. لستُ واحداً من أولئك الذين يهرعون إلى هواتفهم كلما أساء مذيع لفظ “علم الأرصاد الجوية”، لكنني عرفت هذه المرّة أنّ آلاف المشاهدين سيشعرون أنّ من واجبهم إغراق القناة بالاتصالات طوال الليل. وسيكون الحادث ضربة حظ لأيّ ممثل كوميديّ صاعد يظهر الآن على شاشة قناة منافسة.
“أتمانعين إن غيّرتُ البرنامج، لأرى إن كان يُعرض شيء آخر؟”.
“لا تفعل. هذا أهم مشهد في المسرحية. سوف تفسده”.
“عزيزتي، أنت لا تشاهدين حتى. سأعود له بسرعة، أعدك بذلك”.
على القناة الخامسة كانت هناك مائدة مستديرة تضمّ ثلاثة أساتذة جامعيين وفتاة استعراض، وكانوا جميعاً يحدّقون بإناء رومانيّ، بينما يثرثر مقدّم البرنامج بصوته الرصين الشبيه بصوت محاضري جامعة أوكسفورد حول الحظّ والخيارات وما شابه ذلك. وقد بدا الأساتذة الجامعيون مرتبكين، أما الفتاة فبدا أنها تعرف بالضبط ما في داخل الإناء لكنها لا تجرؤ على تسميته.
أما أستوديو القناة التاسعة فكان يضجّ بالضحك بينما المذيع يمنح سيارة رياضية لامرأة ضخمة تعتمر قبعة عريضة. وقد أشاحت المرأة بعصبية وجهها عن الكاميرا وأخذت تنظر بذهول إلى السيارة. فتح مقدّم البرنامج باب السيارة لها وكنت أتساءل ما إذا كانت ستهمّ في ركوبها حين قاطعت هيلين حبل أفكاري: “هاري، لا تكن فظاً. إنك تعبث فحسب”.
عدت إلى المسرحية على القناة الثانية. لا يزال المشهد الختامي نفسه.
“شاهديه الآن”.
كانت عادة ما تتابع العرض في الإعادة الثالثة.
“ضعي من يدك هذه الإبرة، هذا الأمر يوتّرني. يا إلهي لقد حفظتُ المشهد عن ظهر قلب”.
“صه! ألا يمكنك التوقّف عن الكلام؟”.
أشعلت سيجارة واستلقيت على الكنبة، ورحت أنتظر. يجب أن يكون الاعتذار، على أقلّ تقدير، مهيباً. عرضان وهميان مقابل مائة باوند لكلّ دقيقة يساويان مبلغاً محترماً من مال الإعلانات الذي خسرته القناة.
شارف المشهد على الانتهاء؛ أطرق الشيخ ناظراً إلى جزمته، وكان وقت الغسق تقريباً.
وها نحن نعود من حيث بدأنا.
هببت واقفاً وصرخت صرخة قوية جعلت بعض الغبش يزول عن الشاشة: “مستحيل! هذا لا يعقل”.
حافظت هيلين على هدوئها: “لم أكن أعرف أنك تحبّ هذا النوع من المسرحيات، لم تكن تعجبك بالمرّة”، ألقت نظرة سريعة على الشاشة ثم عادت إلى الخياطة.
نظرت إليها بارتياب. لو حدث هذا قبل مليون سنة، لخرجت مولولاً من الكهف وألقيت نفسي بسرور تحت أوّل ديناصور أصادفه. لكنّ الزمن لم يقلّل على أيّ حال من المخاطر التي تحيق بالزوج الجسور.
شرحت لها بأناة أداري بها انزعاجي: “حبيبتي، ما لم تلاحظي ذلك، فإنهم يعيدون هذا المشهد للمرّة الرابعة”.
قالت هيلين متشكّكة: “الرابعة؟ هل يكررّونه؟”.
تخيّلت أستوديو يعجّ بالمذيعين والفنيين الغائبين عن الوعي فوق الميكروفونات والصمّامات الإلكترونية، بينما يقوم جهاز عرض آلي بإعادة البكرة نفسها مرّة بعد مرّة. أمر غريب لكنه بعيد الاحتمال. كان ثمة مراقبون ونقاد ووكلاء أدبيون ورعاة إعلانيون وبكلّ تأكيد ثمة أيضاً كاتب العمل نفسه الذي يزن بدقّة كلّ دقيقة وكلّ سطر. لا بدّ من أنه سيكون لدى هؤلاء جميعاً الكثير ليقولوه في صحف الغد.
قالت هيلين: “اهداً وكفّ عن التململ، أفقدتَ أعصابك؟”.
كنت مشغولاً بالبحث خلف الوسائد المحيطة بي وتحت الكنبة على طول السجادة.
“سيجارتي، لا بدّ من أنني رميتها في المدفئة، لا أظنّ أنني أوقعتها”.
عدت إلى الشاشة وقلبت القناة إلى برنامج الجوائز، ولاحظت أنّ الساعة هي التاسعة وثلاث دقائق، وقرّرت العودة إلى القناة الثانية عند التاسعة وخمس عشرة دقيقة. عندما يعرضون تفسيراً لما جرى، فسأرغب في سماعه.
قالت هيلين: “حسبتك مستمتعاً بالمسرحية، لماذا حوّلت عنها؟”.
رددت عليها بالتجهم المعتاد في شقّتنا وأسندت ظهري على الوسائد.
كانت المرأة الضخمة ما زالت أمام الكاميرات، تشقّ طريقها عبر سلسلة متصاعدة من الأسئلة المتعلّقة بفنّ الطبخ. وكان الجمهور هادئاً لكنّ التوتر بدأ يتزايد. في النهاية أجابت عن سؤال الجائزة الكبرى وهدر الجمهور قافزاً عن المقاعد كالمجانين. قادها المضيف إلى سيارة رياضية أخرى على الطرف المقابل من المسرح.
قلت لهيلين: “ستمتلك أسطولاً منها عما قريب”، فأشاحت بيديها وبصورة غريبة أخفضت حافة قبعتها، مبتسمة بعصبية وحرج.
كانت بادرة مألوفة بصورة غريبة.
قفزت واقفاً وعدت إلى القناة الخامسة. كان الجالسون إلى الطاولة المستديرة ما زالوا يحملقون في الإناء. ثم بدأت أدرك ما الذي يحدث.
البرامج الثلاث تعيد نفسها.
خاطبت هيلين وظهري مدار لها: “هلا أحضرت لي كأساً من الويسكي بالصودا؟”.
“ما الأمر؟ أثمة تصلّب في ظهرك؟”.
“بسرعة، بسرعة!”، فرقعت بأصابعي.
“مهلاً”، نهضت وذهبت إلى خزانة المشروبات.
تفقّدت الوقت ووجدت أنها التاسعة واثنتا عشرة دقيقة. ثم عدت إلى المسرحية وركّزت على الشاشة.
عادت هيلين ووضعت شيئاً ما على طرف المنضدة.
“تفضّل. أأنت على ما يرام؟”.
حين حصلت الكبوة مجدّداً ظننت أنني جاهز لها، لكنّ المفاجأة كان من شأنها أن تفقدني صوابي. وجدت نفسي ممدّداً أرضاً بجوار الكنبة. وكان أوّل ما فعلته أنني سعيت لتناول كأس الويسكي.
“أين وضعته؟”.
“ما هو؟”.
“كأس الويسكي. لقد أحضرته لي قبل دقيقتين. كان على المنضدة”.
أجابتني بلطف: “لقد كنت تحلم”. ثم عادت إلى مشاهدة المسرحية.
ذهبت إلى المطبخ ووجدت القنينة. ملأتُ كأساً ولاحظت أنّ الساعة المعلّقة فوق مغسلة المطبخ تشير إلى التاسعة وسبع دقائق. كانت عادة ما تكون متأخّرة بمقدار ساعة. لكنّ ساعة معصمي أشارت إلى التاسعة وخمس دقائق، وهي دائماً دقيقة. أما الساعة فوق المدفئة في الردهة فأشارت إلى التوقيت نفسه.
قبل أن أستسلم للقلق، عليّ التيقّن مما يجري.
فتح لي مولفايني، جارنا في الطابق الأعلى، الباب حين قرعت.
“مرحباً بارتلي. أتريد فتّاحة نبيذ؟”.
“لا، لا… ما الوقت الصحيح؟ ساعاتنا جنّ جنونها”.
نظر إلى معصمه، وقال: “قرابة التاسعة وعشر دقائق”.
“أهي التاسعة أم العاشرة؟”.
نظر ثانية إلى معصمه. “لا بدّ من أنها التاسعة، ما الخطب؟”.
“لا أعرف ما إذا كنت أفقد…”.
توقّفت عن الكلام بينما حدجني مولفايني بحيرة. خلف ظهره سمعت عاصفة من التصفيق قطعها صوت المذيع الفصيح.
“كم مضى على هذا العرض؟”.
“إنه يعرض منذ نحو عشرين دقيقة. ألستَ تشاهده؟”.
“لا”، وسألته بشكل عرضيّ: “أثمة خطب في جهازك؟”.
هزّ رأسه بالنفي: “أبداً، لماذا؟”.
“جهازي يجري كالمسعور. على أيّ حال شكراً لك”.
“حسناً”.
نظر إليّ بينما أهبط السلالم ورفع كتفيه في حيرة وهو يوصد الباب.
عدت إلى ردهة البيت، رفعت سمّاعة الهاتف وطلبت رقماً.
“مرحباً طوم؟”.
كان طوم فارنولد يحتلّ المكتب المجاور لي في العمل.
“طوم، أنا هاري، ما الوقت لديك؟”.
“وقت عودة الليبراليين إلى الحكم”.
“لا جدياً”.
“فلنر. إنها التاسعة وعشر دقائق. بالمناسبة هل وجدت المخللات التي تركتها لك في خزانتك؟”.
“أجل، شكراً. اسمع طوم، أغرب الأمور تحدث هنا. كنا نشاهد مسرحية ديلر على القناة الثانية عندما…”.
“إنني أشاهدها الآن. عجّل”.
“فعلاً؟ حسناً، كيف تفسّر مسألة التكرار هذه؟ والطريقة التي تعلق فيها الساعة بين التاسعة والتاسعة والربع”.
قال طوم ضاحكاً: “لا أعرف، أقترح عليك أن تخرج إلى الشارع وتهزّ المبنى قليلاً”.
مددت يدي إلى الكأس التي كنت قد وضعتها للتو على المنضدة، متسائلاً كيف أشرح لـ… في اللحظة التالية وجدت نفسي على الكنبة مجدّداً. كنت أحمل الصحيفة وأنظر إلى العمود 17 رأسي في شبكة الكلمات المتقاطعة. وكان جزء من عقلي يفكّر في الساعات القديمة.
استجمعت تركيزي للخروج من تلك الحالة ونظرت إلى هيلين التي ما زالت جالسة تحيك بصمت. كانت المسرحية التي باتت مألوفة للغاية تتكرّر أما الساعة على رفّ الموقد فأشارت إلى دقيقة واحدة بعد التاسعة.
عدت إلى الردهة وخابرت طوم مجدّداً، محاولاً تمالك نفسي. على نحو ما، بدأت أفهم كيف أنّ جزءاً من الزمن يدور حول نفسه في دائرة، وأنا في وسط تلك الدائرة.
سـألته ما إن رفع السماعة: “طوم، هل اتصلتُ بك قبل خمس دقائق؟”.
“من يتكلم؟”.
“هذا هاري. هاري بارتلي، عذراً طوم”. صمت وأعدت صياغة السؤال، محاولاً أن يبدو واضحاً: “طوم، هل اتصلت بي قبل نحو خمس دقائق؟ لدينا مشكلة صغيرة في الخط هنا”.
“لا لم أتصل، لم يكن أنا. بالمناسبة هل وجدت المخللات التي تركتها لك في الخزانة؟”.
قلت: “شكراً جزيلاً لك”، وقد بدأ الذعر يستبدّ بي، ثم أضفت: “هل تشاهد المسرحية يا طوم؟”.
“أجل، أظنّ أنني سأعود لمتابعتها. أراك”.

عدت إلى المطبخ وأنعمت النظر إلى وجهي في المرآة. كان ثمة صدع يشق المرآة إلى نصفين مبعداً نصف وجهي بمقدار ثلاث بوصات تحت النصف الآخر، ولكن ما عدا ذلك لم أرَ أيّ أثر للاعتلال العقلي. كانت نظراتي ثابتة، ونبض قلبي لا يتجاوز السبعين، ولا تشنّجات أو تعرّق بارد. بدا كلّ شيء حولي صلباً وحقيقياً بحيث يستحيل أن يكون حلماً.
تريّثت دقيقة ثم عدت إلى غرفة المعيشة وجلست على الكنبة. كانت هيلين تشاهد المسرحية.
ملت إلى الأمام وقلبت القناة. أعتمت الصورة واهتزّت.
“هاري إنني أشاهد! لا تطفئه”.
اقتربت منها قائلاً: “اسمعيني حبيبتي…”، وأضفت محاولاً الحفاظ على تماسك صوتي: “اسمعيني رجاء. بانتباه شديد. الأمر مهم”.
أجفلت، ووضعت من يدها إبرة الخياطة واحتضنت يدي.
“لسبب ما لا أعرف كنهه، يبدو أننا في نوع من فخّ زمني دائري، ندور وندور فحسب. أنت لا تدركين ذلك وأنا لا أستطيع العثور على شخص آخر أيضاً”.
حملقت بي بذهول: “هاري، ما الذي…”.
أصررت، ممسكاً كتفيها: “اسمعيني يا هيلين! خلال الساعتين الماضيتين، هناك جزء من الوقت، نحو 15 دقيقة يكرّر نفسه. العقارب عالقة بين التاسعة والتاسعة والربع. تلك المسرحية التي تشاهدينها كانت…”.
ابتسمت بعجز: “هاري حبيبي، أنت سخيف. الآن شغّل التلفزيون مجدّداً”.
استسلمت.
بعدما أعدت تشغيل التلفزيون، تنقّلت بين كلّ القنوات الأخرى لأرى إن كان قد تغيّر شيء.
ما زال الجالسون حول الطاولة المستديرة يحملقون في الإناء الروماني، والمرأة السمينة فازت بالسيارة الرياضية، والشيخ المزارع يهذي. والقناة الأولى ما زالت تعرض برامج بي بي سي المعادة التي تُقدّم ساعتين كلّ ليلتين، كان ثمة صحافيان يجريان مقابلة مع عبقري في العلوم يظهر في البرامج التعليمية الشعبية.
“أيّ تأثير سنشهده لانفجارات الغاز الشديدة تلك، يصعب القول حتى الآن. إلا أنه بكلّ تأكيد ليس ثمة ما يدعو للقلق. ذلك العباب له كتلة، وأحسب أننا نستطيع توقّع الكثير من التأثيرات البصرية الغريبة بينما ينعكس ضوء الشمس مرتدّاً عنها بفعل الجاذبية”.
راح يحرّك مجموعة من كرات السلوليد الملوّنة التي تجري داخل حلقات معدنيّة، ويعبث بحوض من الفقاعات موضوع قبالة مرآة على الطاولة.
سأله أحد الصحافيين: “ماذا عن العلاقة بين الضوء والزمن؟ لو كنت أتذكّر معرفتي بالنسبية فإنهما مرتبطان بصورة وثيقة ببعضهما البعض. أأنتَ متأكّد أننا لن نحتاج جميعاً إلى إضافة عقرب آخر إلى ساعاتنا؟”.
ابتسم العبقري: “أحسب أننا سنتمكّن من تدبير أمورنا دون الحاجة إلى ذلك. الوقت معقّد للغاية، لكنني أؤكّد لك أنّ عقارب الساعات لن تعود فجأة إلى الوراء أو تتحرّك جانبياً”.
ظللتُ أصغي إليه حتى بدأت هيلين بالتأفّف. عدت إلى المسرحية وذهبت إلى الردهة. لم يكن الأحمق يعرف ما يقول. ما لم أفهمه هو لماذا أنا الشخص الوحيد الذي ينتبه إلى ما يجري. لو استطعت الإتيان بطوم إلى هنا لربما استطعت إقناعه.
رفعت السمّاعة ونظرت إلى ساعة معصمي.
التاسعة وثلاث عشرة دقيقة.
بينما يردّ طوم سيكون حان أوان الكبوة التالية. لم أستسغ فكرة أن أُحمَل وأُرمى على الكنبة، وإن كان ذلك غير مؤلم. وضعت السمّاعة من يدي وذهبت إلى الردهة.
كانت قفزة العودة أسلس مما توقعت. لم أتنبّه لأيّ شيء، ولا حتى أقلّ اهتزازٍ. كان ثمة عبارة عالقة في رأسي: الأزمنة القديمة.
كانت الصحيفة مجدّداً في حضني، مطوية حول الكلمات المتقاطعة. نظرت عبر الأدلة.
17 عمودي: تشير إليه الساعات القديمة؟ 5+5 أحرف.
لا بدّ من أنني حللت اللغز في لاوعيي.
تذكّرت أنني كنت أعتزم الاتصال بطوم.
بادرته ما إن رفع الخط: “مرحبا، طوم؟ معك هاري”.
“هل وجدتَ المخللات التي تركتها لك في الخزانة؟”.
“أجل، شكراً جزيلاً طوم، أيمكنك زيارتي الليلة؟ عذراً على طلب ذلك في هذا الوقت المتأخّر، لكنّ المسألة عاجلة فعلاً”.
“أجل بكلّ تأكيد، ما المشكلة؟”.
“سأخبرك حين تصل. هل ستأتي في أسرع وقت؟”.
“طبعاً. سأنطلق الآن. هل هيلين بخير؟”.
“أجل إنها بخير. شكراً مجدّداً”.
ذهبت إلى المطبخ وجلبت من الخزانة قنينة جين وكأسين. فسيحتاج إلى شرب كأس حين يسمع ما سأقوله له.
ثم أدركتُ أنه لن يصل البتة. فسيتطلبه الوصول من إيرلز كورت إلى مايدا فالي نصف ساعة على الأقلّ ولن يصل على الأرجح أبعد من ماربل آرك.
ملأت كأسي من قنينة الويسكي التي لا يظهر قاعها وحاولت وضع خطة للتحرّك.
كانت الخطوة الأولى تتمثّل في الوصول إلى شخص مثلي استعاد وعيه بالعودات السابقة. لا بدّ من وجود أشخاص آخرين عالقين في أقفاص الربع ساعة الأخيرة والذين يسألون أنفسهم بيأس كيف يمكنهم الخروج. يمكنني أن أبدأ بالاتصال بكلّ من أعرفه ثم أتصل بأشخاص عشوائيين مستعيناً بدليل الهاتف. لكنْ ماذا سنفعل في حال عثرنا على بعضنا البعض بالفعل؟ في الحقيقة لم يكن هناك ما يمكن توقّعه عدا الجلوس وانتظار أن ينتهي الأمر بصورة تلقائية. عرفت على الأقلّ أنني لن أظلّ أدور إلى ما لا نهاية. ما إن تُستنفد تلك الغيمات أو أياً يكن اسمها، فسنتمكّن من الخروج من الدائرة.
حتى ذلك الحين لديّ مخزون لا ينضب من الويسكي ينتظرني في القنينة نصف الملآنة في المغسلة، وإن كانت هناك مشكلة وحيدة طبعاً: لن أتمكّن أبداً من الثمالة.
فكّرت في بعض الاحتمالات الأخرى، متسائلاً كيف أحظى بسجلّ دائم لما يجري حين خطرت ببالي فكرة.
حملت دليل الهاتف واستخرجت رقم محطّة “كي بي سي تي” في القناة التاسعة.
ردّت عليّ موظفة الاستقبال. وبعد أن فاوضتها لنحو دقيقتين، أقنعتها بأن تصلني بأحد المنتجين.
بادرته قائلاً: “مرحباً، هل سؤال الجائزة الكبرى في برنامج الليلة معروف لأيّ فرد من الجمهور في الأستوديو؟”.
“لا، قطعاً لا”.
“فهمت، بدافع الفضول فقط، هل أنت تعرف الجواب؟”.
أجاب: “لا، جميع أسئلة حلقة الليلة لا يعرفها سوى المنتج الرئيسي والسيّد فيليب سوسون من سلسلة فنادق سافوي. إنه سرّ محروس بعناية”.
“شكراً لك، لو كنت تحمل ورقة فسأعطيك جواب سؤال الجائزة الكبرى: عدّد قائمة الطعام الكاملة في حفل تتويج الملكة التي أقيمت في قاعة غيلدهول في يونيو 1953”.
سمعت همهمات منخفضة ثم سمعت صوت شخص آخر.
“من يتكلم؟”.
“السيّد إتش آر بارتلي، 129ب ساتون كورت رود، أن دبليو..”.
قبل أن أتمكّن من إنهاء العنوان وجدت نفسي وقد عدت ثانية إلى غرفة المعيشة.
كانت الكبوة قد سيطرت عليّ. لكنْ بدلاً من أن أجد نفسي ممدّداً على الكنبة، كنت واقفاً، متكئاً بمرفقي على المدفئة، ناظراً إلى الصحيفة.
كانت عيناي شاخصتين نحو الكلمات المتقاطعة، وقبل أن أبعدها عن ناظري وأبدأ بالتفكير باتصالي بالأستوديو لاحظت شيئاً على مقربة كاد يطيحني أرضاً.
الخانة 17 عمودي قد ملئت.
حملت الصحيفة وعرضتها على هيلين.
“هل حللت أنت هذه الكلمة؟ 17 عمودي؟”.
“لا، لا أنظر حتى إلى الكلمات المتقاطعة”.
الساعة على رفّ الموقد لفتت نظري، ونسيت موضوع الاستوديو والحيل التي يمكنني لعبها مع زمن الآخرين.
كانت الساعة تشير إلى التاسعة وثلاث دقائق.
الدوامة تتسارع إذن. ظننت أنّ قفزة العودة جاءت أبكر مما توقعت. على الأقلّ بواقع دقيقتين أبكر، نحو الساعة 9:13.
ولم تكن الفترة الفاصلة بين القفزات الزمنية تقصر فحسب، لكنْ مع انحناء القوس إلى الداخل على نفسه، كان يكشف عن التيار الزمني الحقيقي، ذلك التيار الذي عثرت فيه ذاتي الأخرى، دون علمي، على حلّ الأحجية، نهضت واقتربت من رفّ الموقد، وملأت الخانة 17 عمودي.
جلستُ على الكنبة وجعلت أحملق في الساعة.
للمرّة الأولى في تلك الأمسية كانت هيلين تتصفّح مجلة. كانت سلة الإبر بعيدة عنها في الرفّ السفلي من المكتبة.
سألتني: “أما زلت تريد مشاهدة هذا؟ ليس مهماً كثيراً”.
أدرت القناة على لعبة الطاولة المستديرة. كان الأساتذة الجامعيون الثلاثة وفتاة الاستعراض ما زالوا يلعبون لعبة الإناء.
على القناة الأولى كان العبقري جالساً إلى طاولة مع نماذجه.
“… أمر يقلق. هذه الدوامات لها كتلة وأعتقد أننا نستطيع توقّع العديد من المؤثرات البصرية الغريبة عندما يكون الضوء…”، أطفأت التلفزيون.
حدثت الكبوة التالية عند التاسعة وإحدى عشرة دقيقة. كنت في لحظة ما، غادرت رفّ الموقد، وعدت إلى الكنبة وأشعلت سيجارة.
كانت الساعة التاسعة وأربع دقائق. كانت هيلين قد فتحت نوافذ الشرفة ووقفت تنظر إلى الشارع.
وجدت التلفزيون مضاء مجدّداً ففصلت القابس تماماً. رميت السيجارة في المدفئة؛ وبما أنني لا أذكر إشعالها، فقد شعرت أنّ طعمها مثل طعم سيجارة دخّنها شخص آخر.
اقترحت هيلين: “هاري، أترغب في نزهة؟ سيكون الجوّ لطيفاً في الحديقة”.
كلّ قفزة إلى الوراء، تقدّم نقطة انطلاق جديدة. لو خرجت معها الآن ومشينا إلى نهاية الشارع، ففي القفزة التالية سنكون كلانا في غرفة المعيشة من جديد، لكننا سنكون قد قرّرنا الذهاب بالسيارة إلى الحانة على الأرجح، بدلاً من الحديقة.
“هاري؟”.
“ماذا، المعذرة”.
“أأنت نائم يا ملاكي؟ أترغب في نزهة؟ سوف تنعشك”.
“حسناً، اذهبي وأحضري معطفك”.
“هل ستشعر بدفء كاف بهذه الملابس؟”.
دخلت إلى غرفة النوم.
مشيت في أرجاء الردهة وأقنعت نفسي أنني مستيقظ. الظلال، الشعور الصلب بالكراسي، كلّ شيء حقيقي للغاية فلا يعقل أن يكون حلماً.
إنها التاسعة وثماني دقائق. عادة تستغرق هيلين عشر دقائق لارتداء معطفها.
جاءت الكبوة مباشرة تقريباً.
التاسعة وستّ دقائق.
ما زلت على الكنبة بينما هيلين تنحني وتحمل سلة الإبر.
هذه المرّة، أخيراً، كان التلفزيون مطفأ.
سألتني: “أمعك أيّ مال؟”.
تحسّست جيبي: “أجل، كم تريدين؟”.
نظرت إليّ: “حسناً، كم تدفع عادة لقاء الأشربة؟ سوف نحتسي كأسين فحسب”.
“نحن ذاهبان إلى الحانة أليس كذلك؟”.
اقتربت مني: “أأنت على ما يرام حبيبي؟ تبدو منهكاً للغاية، هل هذا القميص ضيّق جداً؟”.
نهضت قائلاً: “هيلين، يجب أن أحاول أن أشرح لك أمراً. لا أعرف لماذا يحدث، له علاقة بدوّامات الغاز المنبعثة من الشمس”.
رمقتني هيلين بقلق وقد فغرت فاهها: “هاري، ما الأمر؟”.
أكّدت لها: “أنا بخير.. المسألة أنّ كلّ شيء يحدث بسرعة شديدة فحسب، ولا أعتقد أنه بقي الكثير من الوقت”.
ظللتُ أحدّق بالساعة وتتبعت هيلين نظراتي واقتربت من رفّ الموقد. وبينما ظلت شاخصة نحوي، نقلت الساعة من موضعها على الرفّ وسمعت البندول يتحرّك.
“لا، لا”. صرخت وأخذتها منها وأعدتها إلى مكانها على الرفّ.
قفزنا عائدين إلى التاسعة وسبع دقائق.
هيلين في حجرة النوم. تبقّت لديّ دقيقة فقط.
نادت: “هاري حبيبي، أتريد ذلك، أم لا؟”.
كنتُ واقفاً عند نافذة الردهة، أهمهم شيئاً ما.
كنت بعيداً عما تفعله ذاتي الحقيقية في الإطار الزمني العادي. هيلين التي تحادثني الآن ليست إلا طيفاً.
كنت أنا، وليس هيلين أو سواها، من يركب هذه الدوامة.
وقفزة أخرى!
9:07-9:15
هيلين واقفة بالباب.
“نزولاً إلى الـ.. الـ”، كنت أقول.
نظرت هيلين إليّ، متجمّدة. بقي كسر من الدقيقة.
بدأت أمشي نحوها، أمشي نحو.. وو..ها… ثم خرجت مثل شخص يندفع من باب دوّار. وإذا بي ممدّد على الكنبة، ألم قوي يمتدّ من أعلى رأسي إلى أذني اليمنى إلى رقبتي.
نظرت إلى الوقت: 9:45. سمعت هيلين تتحرّك في غرفة الطعام. ظللتُ مستلقياً، محاولاً جعل الغرفة من حولي تستقرّ، وفي بضع دقائق دخلت هيلين تحمل صينية وكأسين.
سألتني وهي تجهّز كوباً من المسكّن: “كيف حالك الآن؟”
شربت الكوب.
“ماذا جرى لي؟ هل انهرت؟”.
“ليس تماماً. كنت تشاهد المسرحية. ظننت أنك تبدو ضجراً فاقترحت أن نخرج لاحتساء شراب. وقد أصابك نوع من النوبة”.
وقفت ببطء ودلّكت رقبتي: “يا إلهي، أنا لم أحلم هذا كله! لا يعقل أن يكون حلماً”.
“ما كان الأمر؟”.
“نوع من دوّامة جنونية”، كان الألم يعتصر رقبتي بينما أتكلم. اتجهت إلى التلفزيون وشغّلته قائلاً: “يصعب شرح ذلك بصورة متماسكة. لقد كان الوقت.. “، أجفلت حين عاودني الألم.
“اجلس واسترح، سوف آتي وأنضمّ إليك. أترغب في شراب”.
“شكراً لك، كأس كبيرة من الويسكي”.
نظرت إلى التلفزيون. على القناة الأولى العد التنازلي لبدء العرض، وعرض موسيقي على القناة الثانية، وملعب مضاء في القناة الخامسة، وبرنامج منوّعات على التاسعة. لم يكن من أثر على أيّ قناة لمسرحية ديلر أو للعبة الطاولة المستديرة.
أحضرت هيلين الشراب وجلست معي على الكنبة.
شرحت لها، وأنا أدلّك عنقي: “بدأ الأمر أثناء مشاهدتنا المسرحية”.
“صه، لا ترهق نفسك الآن. استرخ فحسب”.
وضعت يدي على كتف هيلين ونظرت إلى السقف، مصغياً إلى الصوت الآتي من برنامج المنوّعات. استعدت ذكرى كلّ جولة، متسائلاً ما إذا كان ذلك كله مجرّد منام.
بعد عشر دقائق قالت هيلين: “لم أعتبره برنامجاً عظيماً، وها هم يعيدونه، يا إلهي”.
سألتها: “من هم؟”، ورأيت الضوء المنبعث من الشاشة يومض على وجهها.
“فريق الأكروبات. الأخوة لا أعرف ماذا. أحدهم زلّت قدمه. كيف تشعر؟”.
“بخير”، استدرت ونظرت إلى الشاشة.
كان ثلاثة أو أربعة لاعبي أكروبات يرتدون سراويل ضيّقة وكنزات على شكل الحرف V، يقومون بحركات موازنة بسيطة متسلّقين أجساد بعضهم البعض. ثم شرعوا في حركة أكثر تعقيداً، رامين فتاة ترتدي جلد فهد في الهواء، فتجاوب الجمهور بتصفيق حاد. ظننت أنّ أداءهم متوسّط الجودة.
راح اثنان منهم يقومان بما يبدو عرضاً للقدرة على التحمّل، ضاغطين على جسدي واحدهما الآخر مثل ثورين، ورقبتاهما وأرجلهما متشابكة، حتى انخفض أحدهما ببطء إلى الأرض.
قالت هيلين: “لماذا يواصلون فعل ذلك؟ لقد أعادوها مرّتين حتى الآن”.
قلت: “لا أعتقد أنهم فعلوا ذلك، هذه حركة مختلفة قليلاً”.
ارتعش الرجل الواقف في محور الأجساد المتراكبة، وتداعت عضلاته الضخمة، وكلّ الأجساد تداعت ثم تفرّقت.
قالت هيلين: “سقطوا هنا المرّة الماضية”.
رددت بسرعة: “لا، لا، تلك كانت رأسية، هذه المرّة هم يتمدّدون أفقياً”.
قالت: “لم تكن منتبهاً”، ومالت إلى الأمام، مردفة: “حسناً ما الذي ينوون عليه. إنهم يكرّرون ذلك للمرّة الثالثة”.
كانت حركة جديدة بالكامل بالنسبة إليّ لكنني لم أرغب في الجدال.
جلست مستقيماً ونظرت إلى الساعة.
العاشرة وخمس دقائق.
أحطتها بذراعي: “حبيبتي، تشبّثي جيّداً”.
“ماذا تقصد؟”.
“إنها الدوّامة. وأنت تتولّين القيادة”.
1956


