وعي الذات في ثورة “الفردانية“

تؤسس جائحة كوفيد – 19 لثورة ذهنية وإدراكية؛ لعلها الأكثر أهمية وعمقا بعد وعي السلطة والحق الإلهي والطبقي المصاحب للثورة الزراعية، ثم وعي المجتمعات والدولة المركزية المصاحب للثورة الصناعية. واليوم فإن الفرد ينهض بديلا أو شريكا فاعلا للجماعات والدول في المسؤولية وتنظيم الموارد والأعمال والسياسات والتشريعات، وإذا شئنا أن نُرَمِّزَ هذه المرحلة أو “نؤسطرها” فإنها ترويض الـ”لفياثان” بدلا من عبادته، ثم الخضوع له.
تقول الأسطورة إن الوحش الهائل “لفياثان” كان يحمي المدينة مقابل أن يقدم له أهلها كل يوم دماغ طفل، وهي ترمز إلى مرحلة الحق الإلهي للسلطة وتقديم القرابين والقبول لها بأن تملك كل شيء، ففي الحاجة إلى الاستقرار في القرى والمدن تشكلت الحاجة إلى السلطة السياسية، ثم حين تطورت وتعقدت المعارف والمؤسسات؛ تشكلت الإمبراطوريات والممالك الكبرى على أساس الالتزام والضرائب مقابل السلام والأمن والاستقرار والرفاه، وفي الترميز الأسطوري، فقد غامر أحد أبناء المدينة بتقديم دماغ خروف بدلا من تقديم دماغ ابنه؛ كانت لحظة وعي فردي بأن الحياة لا تساوي شيئا بعد تقديم الابن قربانا للوحش، ولعلها أيضا إدراك بأن الوحش ليس إلها، وأن ما يحتاجه ليس سوى اللحم سواء كان لحم خروف أو إنسان، وبدأ أهل المدينة يقدمون للوحش (السُّلطة) الخراف (المال) بدلا من القرابين البشرية (العبودية)، وهكذا نشأ العقد الاجتماعي بين الفرد والجماعة؛ الخضوع للنظام والقوانين وتقديم الضرائب مقابل السلام والرفاه.
لكننا اليوم نكتشف أن “لفياثان” غير قادر على حمايتنا، ولا يستحق الخراف (الضرائب) التي نقدمها، إنه يتحول إلى كائن أليف يخدم الفرد والجماعة في أعمالها ومصالحها ويتبعها، فالدول والسلطات جميعها؛ الكبيرة والصغيرة والغنية والفقيرة والمتقدمة والمتخلفة، لم تعد قادرة على فعل شيء في مواجهة الوباء بغير التزام وسلوك فردي؛ المطارات والأسواق والأعمال والمدارس والجامعات، وكل ما لدينا ونملكه معرض للتبخر والانقراض، ولا تملك السلطات والجماعات والمؤسسات والخبرات والمهن المتقدمة أن تفعل شيئا، وفي المقابل فإن “الإنسان” بما هو فرد حر مستقل هو الضامن العقد الاجتماعي، لكنها ويا للهول ثورة تفوق الوصف والاستيعاب! النضال لأجل الفردانية يتحول إلى انتصار يفوق حلم المناضلين، والفردية نفسها التي كانت آفة أو شرا لا بد منه تتحول إلى فضيلة!
فبعد لحظات من النشوة ندرك (يجب أن ندرك) أنه في صعود الفرد والفردانية وانحسار الدور الاجتماعي والاخلاقي للدول والمجتمعات نواجه أزمة كبرى تفوق أزمة الهيمنة والوصاية والأبوية والتنظيم والتنميط الجماعي؛ فالفرد الذي خضع للجماعة قرونا طويلة يحدث له اليوم مثل قصة “الدرويش” الذي أمضى أربعين عاما يسير في الطرقات والمدن والبوادي باحثا عن اسم الله الأعظم، وفجأة لقيه طفل في طريقه فقال له: أنت اسم الله الأعظم، لكنه حين عرف اسم الله لم يعد يعرف ماذا يفعل، فلم يكن يفعل من قبل سوى البحث. هو اليوم لا يفعل سوى البحث عن الطفل الذي اختفى بعد أن أخبره بالحقيقة الضخمة والهائلة! هكذا فإن الفرد الذي يظل يناضل في مواجهة التنظيم والتنميط الاجتماعيين والأخلاقيين لم يعد يعرف ماذا يفعل وكيف يفكر ويميز وحده من غير مرجعية دينية أو مجتمعية بين الصواب والخطأ وبين القبيح والحسن. وهكذا أيضا يمكن تقدير أو فهم وتفسير الأزمات الاجتماعية والسلوكية الجديدة.
في مواجهة الوباء اشتعلت حملات التوعية بالخطر والسلامة، إذ بدا واضحاً أن الفرد هو حجر الزاوية في نجاح عمليات الوقاية، لكن كان محيراً عجز معظم الناس عن إدراك الخطر على أنفسهم وأسرهم، وفشلهم في حماية أنفسهم بسبب فقدانهم للحذر والوعي الأساسي بالحياة، فالفرد الذي صار هو الضامن للعقد الاجتماعي والأخلاقي، لم يكن معترفاً به كياناً مستقلاً ومتفرداً، ولكنه كان جزءاً من المجموع، ولم يكن سوى عضو في جماعة اجتماعية أو طبقية، ولم يكن يستمد وجوده إلا بالانتماء إليها والمشاركة فيها وبحمايتها ورعايتها، ولم تفطن برامج الثقافة والتعليم والتنشئة والعمل؛ كما الهويات والعلاقات الاجتماعية والانتماءات إلى الفرد بما هو عالم بذاته، ويعرف فرداً متميزاً، وأما الانتماءات المتعددة والمختلفة فهي إضافات إلى الفرد، وهي يجب أن تكون قابلة للتغير والزوال، وليس ثابتاً منها إلا الفرد! واليوم حين كنا في حاجة إلى الفرد الفاعل والمسؤول والقادر وحده مستقلاً بذاته وجدناه على نحو غالب هشا؛ لا يدرك الحياة ولا المخاطر ولا الجمال ولا القبح، والحال أن أزمة الفرد هي نفسها التي كانت سبباً في نجاح جماعات التطرف والكراهية المنتسبة إلى الدين والقوميات والأيديولوجيات المتطرفة في اختراق الجماعات واجتذاب المؤيدين والأنصار، لكن ولسوء الحظ لم يكن ممكناً إقناع مخططي السياسات الاجتماعية بأهمية الفرد في مواجهة الكراهية والعنف! وأما في مواجهة الوباء فإنه يتشكل اليوم إجماع على أهمية الفرد ودوره في المواجهة.
وكما نتساءل ببداهة وشعور بالصدمة عن إحجام الفرد في كثير من الأحيان عن حماية نفسه، بل وسلوكه سلوكاً خطيراً على صحته وذويه ومن حوله، فإن السؤال نفسه قائم عن سبب مخاطرة الفرد بحياته لأجل المشاركة في جماعات خارجة على الدين والقوانين والمجتمعات؟ إنه ببساطة “المعنى” الذي يعتقد المؤيدون للجماعات أنهم يحصلون عليه، وإنه لمن المحيّر كيف تجتذب هذه الجماعات الباحثين عن المعنى برغم أنها لا تقدم المعنى! لكنها الحيرة نفسها أيضاً التي تجتذب الشباب إلى جماعات تعمل وتفكر ضد نفسها، بل وتجعلهم يخاطرون بالخروج على القانون وإيذاء أنفسهم. والحال أن قضية الانسياق في كل أشكالها وتطبيقاتها تعكس الخواء!
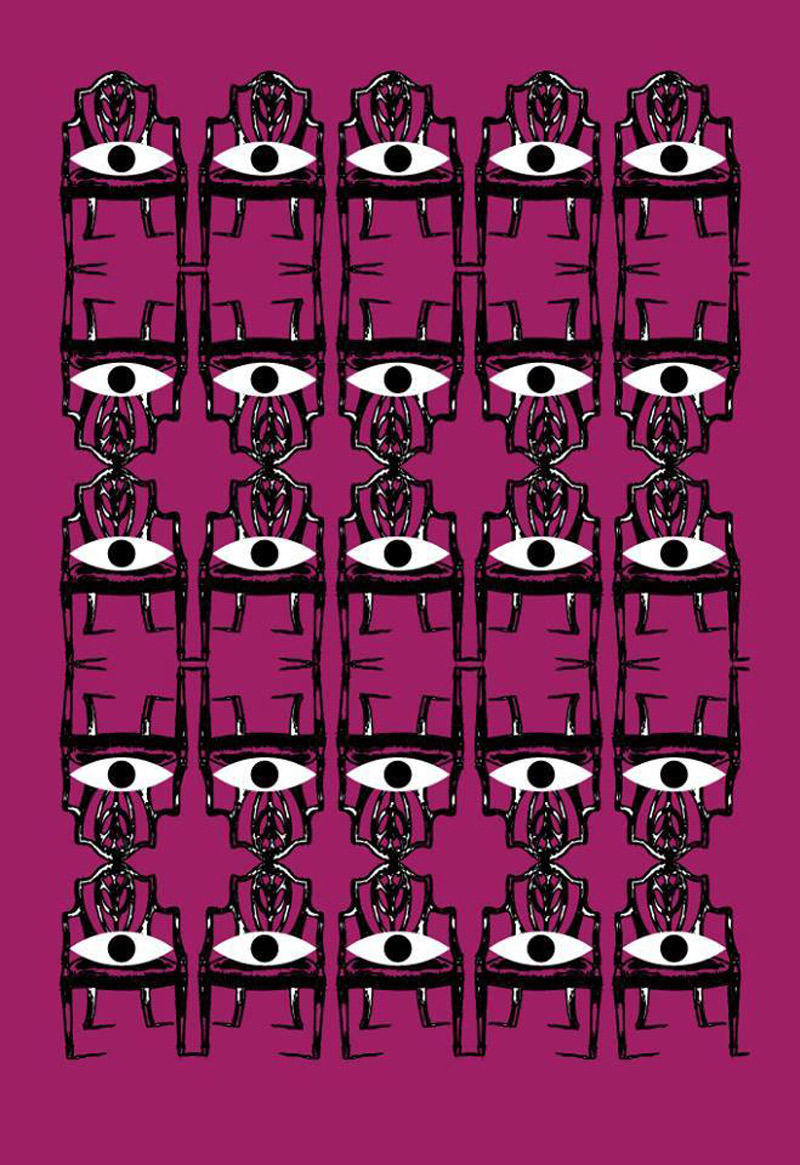
“الناجون من الكارثة” يفكرون بإلحاح كيف نكون أمم الفرد المستقل المبدع، والقادر على أن يعتمد على نفسه، ويحمي نفسه بنفسه، ويعمل بنفسه لنفسه، ويعلّم نفسه بنفسه، ويداوي نفسه بنفسه، وأن يستمد أهميته وسعادته من ذاته وليس من خارجها. هكذا فإننا نواجه من غير مقدمات كافية أو صلة معقولة بالماضي أسئلة كبرى! نحتاج إلى تأمل طويل لملاحظة التحول أو التشوه الذي أصاب الإنسان على نحو متراكم بفعل التنشئة الاجتماعية والسلسلة الطويلة المتراكمة من الشرائع والمنظومات الدينية المؤسسية، كيف يستعيد ذاته وينعتق من كل هذا الركام ويكون في الوقت نفسه أقدر على تحقيق السلام وحماية وتطوير العقد الاجتماعي؟ كيف يحلّ الضمير محل الدين والمجتمع في التنظيم الاجتماعي والأخلاقي والسياسي والبناء الإيجابي للعلاقات الاجتماعية؟ كيف ينظم الناس أنفسهم ومصالحهم من غير جماعات ومؤسسات تنظيمية واجتماعية، أو ليكن السؤال كيف تعمل المنظمات الاجتماعية الجديدة في ظل قيم الفردية؟
لقد أنشأت الحضارة الإنسانية بمركزية الدين ثم الدولة والمجتمع منظومة من القيم والأخلاق مليئة بضدها، صحيح أن منظومة القلاع والهياكل (السلطة والجماعة) أنشأت المدن والشرائع والتنظيمات القانونية، وحسّنت الحياة إلى مستويات مدهشة، لكننا في حاجة اليوم لنعرف ماذا أصاب الفرد من تشوه، وما الذي يجب التخلص منه أو التمسك به، فكثير ممّا كان يبدو خلقا جميلا صار رذيلة يجب التخلص منها، كانت القلاع والهياكل تحمي حياة الناس وتقدم المعرفة أيضا، أو تنظم الحصول عليها، لكن الإنسان الفرد في مقابل الحياة والمعرفة تحول إلى تابع بلا ملاءمة حقيقية أو جميلة لما يريده بالفعل وما يحتاج إليه وما يحب أن يكون عليه!
وحولت السلطات والمؤسسات الدينية توق الإنسان إلى الارتقاء والمعرفة والمعنى والجدوى إلى جموع منظمة تمضي في حماس وصدق وذكاء إلى النشوة بدلا من المعنى، والترفيه بدلا من المعرفة، وإلى النظر إلى الذات بدلا من الكون، والاكتفاء بالانتماء بدلا من الغايات والجدوى، وصناعة الوهم بدلا من الحكمة، وتحويل الثقة والفضول والمغامرة إلى قرابين تمضي راضية إلى الموت.
أصبح ذكاء الفرد وتفرّده عبئا على المؤسسات الاجتماعية والسياسية، فلا تستطيع أن تظل فردا كما أنت، لأنك لا تقدر على الانتماء والمشاركة إذا لم تشبه الجموع المنتظمة والمتشابهة والمتحمّسة على نحو يجعلك مختلفا أو خارجا عن السياق وربما مجنونا، فيتحول لأجل أن يبقى ويتقدم إلى أبله متسول، ويتخلى عن براءته الفطرية لينشئ استجابات وتكيفات تلقائية مع القيم التنظيمية السائدة والمعدّة لأجل الطاعة والولاء أكثر مما هي للإبداع والانسجام.
وفيما يحسبه تحايلا ذكيا للتوفيق بين انتمائه وحكمته المستقلة يحول صدقه ونزاهته إلى وهم وتُقْيَةٍ، ويحسب أنه قادر على التظاهر بالانتماء وهو متفرد، أو أنه يسير في رحلتين متوازيتين؛ رحلة الذات ورحلة الجماعة، لكنه أنشأ قيما مطورة من البلاهة والندم ليحمل نفسه على الانتماء والتكفير في الوقت نفسه عن خطيئته، وكان ذلك أفضل وأهمّ ما حصلت عليه المؤسسات والنخب السياسية والدينية، إذ يتحول إلى كائن متوقع ومنسجم.
هكذا تمضي متوالية تشكيل الفرد لذاته، فيحمي مصالحه مع الجماعة المهيمنة بالتظاهر، ويحمي ذاته بالتخلي عن الكرامة، ويدرك على نحو لا يريد أن يعترف به أنه لن يحصل على متع الحياة في ظل هذه القلاع والهياكل إلا بالكذب واحتقار الذات، وحين يطلب منه أن يعمل ويواجه مخالفا ضميره وفكرته عن الحياة والكون يستعين بالكراهية، فإذا كانت الإساءة والظلم خطأ فإنه يصير يعتقد أن هؤلاء الذين يغشهم أو يظلمهم لا يستحقون العدل والعطف، يصبح العدل يخص الجماعة وليس قيمة حياتية مطلقة ومستقلة! فيكون بذلك قادرا على المشاركة في سياسات الكراهية والظلم والتمييز؛ وفي الوقت نفسه يكون محبّا للحياة وأسرته وأطفاله ومواطنيه وجماعته!
وأخيرا تجد أنك لن تكون قادرا على العمل مع القلعة والهيكل وأنت أنت، ولن تحظى بالسلام وأنت غير قادر على أن تكون غير أنت، فلا تعود تعرف ذاتك إلا بالجماعة، ولا حيلة لك سوى التفاهة والخواء، وقد تحصل على متعة عابرة رديئة أو على وعد بالنعيم المقيم بعد الموت!
لكنها ثورة (الفردانية) واعدة بالمغامرة والإيجابية وعصر إنساني جديد، فليس أجمل من هذه المساواة الصاعدة، فعندما تصلني رسالة “أنستغرام” على الموبايل بأن سارا وآدم وناسا وناشيونال جيوغرافيك ووزارة الخارجية البريطانية قد أدرجوا في صفحاتهم صورا جديدة؛ يتملكني شعور عميق بالدهشة أن الطفلة سارا والعامل آدم يملكان الفرصة نفسها على قدم المساواة مع والدول الكبرى والمؤسسات العملاقة!
الفرد وحده مستقلا يساهم على نحو رئيسي في صياغة وتوجيه المنصات الإعلامية والتجارية والخدماتية والتعليمية المختلفة، وفي تحديد وجهة المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فالعالم اليوم أو في الغد القريب يصوغه “المؤثرون”، وهذا “المؤثر”، قد يكون طفلاً يدرج أعماله في “يوتيوب” أو قارئ مهتم باقتصاد المعرفة؛ يبحث عن الوجهات الجديدة للثورة الصناعية الرابعة من الشبكة السحابية أو الطابعات ثلاثية الأبعاد، أو طالب علم مجتهد يبحث في الصحة والغذاء أو في سياسات وأخبار العالم، أو مدوّن ناشط يحاول التأثير في الاستهلاك أو البيئة أو الخدمات الأساسية في محيطه الذي يعيش فيه، أو شاعر ينتج “الخيال” والصور الفنية الجميلة، أو مثقف يحاول أن يجعل معرفته رسالة للناس، أو معلم يحاول أن يوفر أفضل خدمة تعليمية لتلاميذه، أو مشجع للرياضة يحاول أن يصل ناديه إلى أفضل النتائج، هؤلاء يشاركون، على قدر كبير من المساواة، مع وزارات الثقافة والتعليم والبنوك وشركات الاتصالات والنوادي والصحف ومحطات التلفزيون وشركات الإنتاج الدرامي والسينمائي وصانعي القمصان والأحذية ومصمّمي السيارات والأجهزة، إنهم معا يفكرون في تواصل وتوازن عملي لأجل عالمهم الذي يسعون لتحقيقه، وينشئون تنظيماً اجتماعياً وأخلاقياً، ويرسّخون القيم والأفكار المنظمة للأعمال والأسواق والعلاقات الاجتماعية، هذه المليارات من المتواصلين مع الشبكة في كل مكان؛ من الأطفال والشباب والكهول والرجال والنساء، كما الشركات والحكومات والجيوش والأجهزة الأمنية والاستخبارية والمؤسسات التعليمية والإرشادية والمنظمات الاجتماعية، والقراصنة والفضوليون والبائعون المتجولون؛ يفكرون معاً وينشئون عالماً جديداً وقيماً جديدة، ويغامرون معاً بكل ما تعني المغامرة من إثارة وفوضى وخوف وطموح وسموّ وأهواء ومصالح وأفكار ولهفة، ولا يملك أحد اليقين أو الصواب.. ليس لدينا في هذه المغامرة سوى الخيال والنية الحسنة.




