الديمقراطية المكارثية

سيحتمُّ توالي وقائع «انفجار الهُوِيَّات” وتطوراته المُتَسَارعة في مجتمعات أَطْلَقَ عليها التَّاريخُ الحَقُّ، باسم الحضارة الإنسانيَّة الزَّاهرة، اسم «العالم العربي”، على الباحثينَ وعلى الرَّاغبين من النَّاس في فهم حقيقة ما يجري، الآن، في العالم، أَلَّا يُغْفِلُوا، أبداً، تلك الواقعة التَّأسيسيَّة، المتمثلة في تفجير برجي التجارة في سبتمبر 2001، وأنْ يتطرَّقوا بتركيزٍ وإمعانٍ، وفي سياقات قرائيَّة تحليلية، استقرائيَّة واستنباطيَّة، مُتَغَايرة، إلى جذورها العميقة، وتأثيراتها المتشعِّبة، وعواقبها متعدِّدة الاتجاهات، وعقابيلها الفادحة التي تأخذُ الإنسانَ إلى نقيضه فيما هي تؤسِّسُ، في الوقتِ نفسه، الدَّوافعَ والمُحفِّزات الضروريَّة لشروع الإنسانيين من البشر في حراكٍ حيويٍّ يُفضي إلى إحداث التغيير اللازم في مجرى تاريخهم الإنسانيِّ الذي لا يؤولُ إلى نهايةٍ أبداً.
نص العالم الراهن وثنائية الخير والشر
كانت القوى والكيانات الكونيَّة المُهيمنة قد شرعت في كتابة «نص العالم الرَّاهن” منذُ زمن يسبق بعقود لحظة انتهاء الحرب الباردة المقترنة، تلازماً، بانهيار النِّظام العالمي المؤسِّس على قوتينِ عُظْمَيَينِ تقودُ كُلَّاً منهما المصالحُ الإمبراطوريةُ الكونيَّةُ الخاصَّةُ بها، وتُمْلِي عليها الاستراتيجيات والسياسات والأولويات وآليات إنجازها وإنفاذها وفرضها على أمم العالم وشعوبه ودوله.
ومن المنطقي أنْ تكونَ كتابة هذا النَّص، أي «نص العالم الرَّاهن”، قد تلازمت مع تطوُّر مجريات الصِّراع، بَارِدَاً أو مُتَحَفِّزاً أو مُلْتَهِبَاً، بين تلكما القوَّتين العظميين اللَّتين احتفظتا بعظمتهما وسيادتهما وسلطة سلاحهما الفاتك، وظلَّتا تشكلان قطبين متعادلين من حيث القوَّة العسكرية والجيوسياسية، على الأقل، بحيثُ انحكمت علاقاتهما، على مدار ما يربو على سبعة عقود، بمخاوفَ مُتَبَادَلةٍ يحكمها منطق الرَّدع التَّوازني القائم على توفُّر إمكانية إيقاع «التَّدمير المُتبادل المُؤكَّد”، وذلك على تعدُّد آليات إعمال هذا المنطق، وتنوُّع تمظهراته وتجلياته وإملاءاته التي فُرِضَتْ من قبل هاتين القوَّتين العظميين على العالم بأسره مُنذُ انتهاء الحرب العالمية الثَّانية مباشرةً وحتَّى انهيار إحدى هاتين القوَّتين، أي «الاتحاد السوفييتي ومنظومته”، وانفراد القوَّة الثَّانية، أي «الولايات المتّحدة الأميركيَّة ومنظومتها”، بالتَّحَكُم، شبه المُطلق في ثروات العالم ومُقدَّراته ومصائر شعوبه!
مع انهيار الاتحاد السوفييتي، أحكمت الولايات المتحدة الأميركيَّة قبضة هيمنتها الطَّاغية على العالم، شعوباً وبلداناً وثرواتٍ ومُقدَّراتٍ وكياناتٍ سياسيَّةً ودولاً، وذلك عبر أشكال متنوِّعة من السيطرة شبه المُطلقة التي يُجسِّدها إمعانٌ غير مسبوق في فرض أولوياتٍ واستراتيجياتٍ وتنفيذِ خططٍ عمليَّة وبرامج عمل ظلَّت محكومةً بمنطق المصلحة الذَّاتيَّة المكارثيِّ؛ أي منطق «من ليس معي فهو ضِدِّي” الذي تَغَطَّى، في هذا الزَّمن، بقناع الديمقراطيةِ وحقوق الإنسان، وارتدى زيَّ الدِّفاع عن المبادئ والقيم الإنسانيّة؛ كالعدالة والحرِّية والإخاء والمساواة والحرِّيات والحقوق الإنسانيَّة الأساسيّة، وفي مقدِّمتها حقُّ الإنسان في الحياة، والعيش الكريم، وحقُّ الشُّعوب في الحريَّة والاستقلال والسِّيادة وتقرير المصير!
ويُمْكِنُنَا، في ضوء هذه الحقيقة التي باتت ماثلة للعيان، أنْ ننضمَّ إلى الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا في إشاراته الكاشفة عن الأوهام السياسية التي كان للتَّفجير المزدوج، أو التَّفجير الثلاثيِّ المتزامن، الذي وَقَعَ في الحادي عشر من سبتمبر 2001 في قلب الولايات المتحدة الأميركيَّة، أنْ يُفْصِحَ عن رسوخها في الوعي الاستبدادي المتعالي الذي يحكمُ تصرفات القوَّة الإمبراطورية الأعظم، ولا سيما منها وَهْمُ التصنيف السَّطحي والتَّعسُّفي، المستند إلى سلطة القوَّة المطلقة والسيادة الكُلِّية والاستبداد والجشع والمصالح الأنانيَّة والهوى، لدول العالم ما بين «دول مارقة”، و”محور شَرّ” و”دول ملتزمة” و”محور خير”، وذلك على نحو جعلت فيه «أميركا” من نفسها «رأس محور الخير”، وذروة تجلِّيه الوجودي المُنير، ومن العدو الذي توَّجَ «التَّفجيرُ الثلاثيُّ المتزامنُ” اكتمالَ صُنْعِهِ، وحدَّد «لحظة الصِّفر” للشُّروع في إطلاق النَّار عليه، «رأسَ محور الشَّر” وقعر تجسُّداته الإرهابيَّة التَّوحُّشيَّة كالحة السَّواد. ولم يكن هذا العدو إلا «الإسلام”، وإلا «العروبة” المقرونة، لزوماً، بالإسلام القَاعِديِّ الدَّاعِشيِّ الذي تمَّ تصنيعهُ وإكسابه صورةً ماهويَّةً، وهُويَّة دعائيَّة تجعلان الانتصار عليه ممكناً، فيما هُما تُسَوِّغان محاربته، واستئصال جذوره العميقة إنقاذاً للإنسانيَّة من نقيضها الإرهابيِّ الفادح!
تأكَّد تماماً أنَّ ذلك المبدأ المكارثي الْمُشْبَعِ بـ”الديمقراطية الأميركيَّة”، والمُركَّز في مقولة «من ليس معي فهو ضِدِّي»، أو في مقولة «من لا يُشبهني فهو نقيضي»، هو وحده الذي يحكمُ استراتيجيات تلك القُوَّة الأعظم
غير أنَّ واقع الحال لا يُشيرُ إلى أنَّ الذي تجري مُحاربته من قبل أميركا وحلفائها هو «الإسلام القاعدي الدَّاعشي المتطرِّف”، وامتداداته وانشطاراته المتوالية حسب المُقتضى، وإنِّما تتخذُ الحرب المُعلنة على هذا «الإسلام الإرهابيِّ”، دريئةً زائفةً لترسيخ حضور نوعٍ آخر، أو أنواع أخرى، من الإرهاب الشَّرس المُقنَّع بأيديولوجيات دينيِّة وعنصرية مصطنعة وسرديات إثنيَّة وقوميَّة وطائفيَّة ومذهبيَّة مُلَفَّقة لا يسُهم تفجير صواعق انفجاراتها المتوالية في بلاد العرب، وفي الشَّرق الأوسط ومحيطه الواسع بأسره، في الانتصار لشيء، أو تحقيق أمرٍ، سوى استراتيجيَّة الرَّأسماليَّة الاستعماريَّة المتوحَّشة، تلك المتساوقة، في تواشج وثيق العُرى، وفي تطابقٍ منقطع النَّظير، مع «الخطَّة الصُّهيونيَّة للشَّرق الأوسط” التي كان البروفيسور إسرائيل شاحاك، في حوالي العام 1982 الذي نُشِرت في غضونه، قد ترجمها تحت هذا العنوان إلى الإنكليزيَّة، وذلك عن الوثيقة التي أعدَّها «عوديد ينون” في ثمانينات القرن الماضي، تحت عنوان «استراتيجيَّة لإسرائيل في ثمانينات التِّسعمائة وألف”.
ميلادي غريغوري وأيلولي أَميركي
اقترنت، على نحو أو آخر ومن دون أدنى ريب أو ظل شك، ساعةُ صِفر إطلاق جحيم الفوضى التي قيل إنها ستكون «خلَّاقَةً” تُعِيدُ تشكيلَ العالم العربي المُتَهَتِّك في مجرى إعادة تشكيل الشَّرق الأوسط الذي لم يَعُدْ شرقاً مُنِيراً يتباهى، أو يُمْكِنُ لهُ أنْ يُفَكِّرَ، للحظةٍ، في أنْ يتباهى، بأنوار شموسه القديمة؛ اقترنت ساعةُ الصِّفر هَذِهِ بتفجير مبنىً في مقر وزارة الدِّفاع الأميركية الـ”بنتاغون”، الكائن في مدينة أرلينغتون في ولاية فيرجينيا، وذلك عقب وقتٍ قصيرٍ من تفحير «بُرْجَي مركز التِّجارة العالميَّة التَّوأمين” في مدينة نيويورك الأميركية التي فيها تتخذُ «هَيْئَةُ الأُمم المُتَّحَدَة” مُسْتَقْرَّاً لِمَقَّرَها الدَّائم الرَّئيس، وهو التَّفجيرُ المزدوج المتزامنُ مع تفجير مبنى مكتب تنفيذي قديم ملحق بالبيت الأبيض الأميركي يُعْرَفُ باسم «مَقَرِّ آيزنهاور”!
ويبدو جَلِيَّاً، أنَّ العالمَ، مع وقوع هذا التَّفجير المزدوج المتزامن، أو الثلاثي المتزامن، ومع توالي تداول عبارة «ما قبل الحادي عشر من سبتمبر 2001 وما بعده”، ومع رسوخ حضور هذه العبارة في جميع اللُّغات والكتابات، وفي أدق تفاصيل الحياة اليومية لشعوب العالم وبلدانه ومؤسساته، قد وجدَ نفسه إزاء مقترحٍ قد يبدو، للوهلة الأولى، غامضاً بعض الشَّيءِ أو مجازيَّاً إلى حدٍّ بعيد، إذْ لم يُصرَّح به بجلاءٍ ساطع حتَّى اللحظة، وهو مُقترحٌ يتعلَّقُ بإحلال تقويم زمنيٍّ «أيلوليّ أميركيّ” جديد محلَّ التَّقويم الزَّمنيِّ «الميلادي الغريغوري” الذي شرعت الإنسانيَّة في استخدامه مقروناً بتاريخ ميلاد السَّيد المسيح؛ رسول المحبَّة والسَّلام!
وفي واقع الحال، فإنَّ العَالمَ لا يَخْلُوَ من مُؤَشِّراتٍ واقعيَّةٍ وملموسةٍ تدلُّ، ضمن أمور أخرى ذات صِلةٍ وثيقة، على تسارع عمليات التَّحضير لاعتماد هذا التَّقويم الأيلوليِّ الأميركيِّ الجديد، وذلك بَعْدَ أنْ تمَّ إطْلَاقَهُ، على نحوٍ أو آخَر، وبعدَ أنْ توالت عملياتُ تكريس مُعطياتٍ وممارساتٍ تُسَوِّغُ الشروعَ في إنفاذه، وفرضه على العَالم بأسره، بوصفه تقويماً لعدِّ سنيِّ أزمنة هذا العالم المُعَولَمْ، تلكَ التي دشَّنَتْ الشُّروعَ في عَدِّهَا أسطورةٌ مُتراكبةٌ تَصُوغُ سَرْدِيَّةً رأسماليَّةً منزوعةَ الإنسانيَّة، تبدأُ من «نهاية التاريخ” الذي زعمت هذه الرَّأَسِمَاليَّة الشَّرسةُ أنْ عُلوَّهَا الشَّاهقَ قَدْ أَنْهَاهُ، لتزعمَ لنفسها قدرةً على فتح نافدةٍ، أو كُوَّة في بابٍ، قَدْ يُطلُّ البشرُ من أيّ منهما على «ما بعد التَّاريخ”، هذا الذي يبدو أنَّه رديفٌ مُلازمٌ لـ”ما بعدَ الإنسانيَّة”،؛ أي هذا الـ”ما بعد” الذي لن يكونَ، وفقَ ما تَقُوُلُهُ وقَائِعُهُ التي تُلْغِي الإنسانيَّةَ وتُعَتِّمُ وجهَ الحياة، إلا قرينَ التَّوحُّش المُنْفَلِت من كُلِّ عقالٍ إنسانيٍّ حصيف؛ أي قرينَ ما قبلَ الزَّمنِ الإنسانيِّ؛ أي قرينَ زمن الكائن البشريِّ الوحش الذي لمَّا يكنْ قد تَأَنْسَنَ بَعْدُ ليبتكرَ الحضارةَ، ويفتحَ أبوابَ الحياة الإنسانيَّة على الحياة!
وما هذا المقترحُ، في الحقيقة الملموسة بتواتر باهظٍ في كلِّ حيِّز حياتيٍّ ونِطَاقٍ كَونيٍّ ومجال، إلا جعل الحَادي عشر من سبتمبر 2001 مبتدءاً لتقويم أيلوليّ أمريكيّ جديدٍ يحلُّ محلَّ التقويمِ الميلاديِّ الغريغوريِّ القديم، أو أيِّ تقويم آخر عرفته الحضارة الإنسانية منذُ بدئها، وعلى امتداد توالي أزمنتها التاريخيّة، وعبر تعدُّد منابعها، ومصادر تكوينها، وأماكن انبثاقاتها، ومساحات حضورها، وعلاقاتها التَّفاعليَّة الرَّحبة، المتحقِّقة، في تناوبٍ تفاعليٍّ وتراكميٍّ منفتحٍ وخلَّاق، بين أمم العالم وشعوبه جميعاً، عبر ثقافاتهم الإنسانيَّة مُتنوِّعة المساحات والمدارات، ومتعدِّدة الآفاق الإبداعية والتَّمثُّلات الرَّمزية، ومُتَغَايرةِ التَّصوُّرات التَّأمُّليَّة والأفكار التَّأسيسيَّة، ومتباينة الرُّؤى فيما يتَّصلُ بآفاق الحياة، ومستقبل الكون، وإنسانيَّة العالم!
سيحتمُّ توالي وقائع «انفجار الهُوِيَّات” وتطوراته المُتَسَارعة في مجتمعات أَطْلَقَ عليها التَّاريخُ الحَقُّ، باسم الحضارة الإنسانيَّة الزَّاهرة، اسم «العالم العربي”، على الباحثينَ وعلى الرَّاغبين من النَّاس في فهم حقيقة ما يجري، الآن، في العالم، أَلَّا يُغْفِلُوا، أبداً، تلك الواقعة التَّأسيسيَّة، المتمثلة في تفجير برجي التجارة في سبتمبر 2001، وأنْ يتطرَّقوا بتركيزٍ وإمعانٍ، وفي سياقات قرائيَّة تحليلية، استقرائيَّة واستنباطيَّة، مُتَغَايرة، إلى جذورها العميقة، وتأثيراتها المتشعِّبة، وعواقبها متعدِّدة الاتجاهات، وعقابيلها الفادحة التي تأخذُ الإنسانَ إلى نقيضه فيما هي تؤسِّسُ، في الوقتِ نفسه، الدَّوافعَ والمُحفِّزات الضروريَّة لشروع الإنسانيين من البشر في حراكٍ حيويٍّ يُفضي إلى إحداث التغيير اللازم في مجرى تاريخهم الإنسانيِّ الذي لا يؤولُ إلى نهايةٍ أبداً.
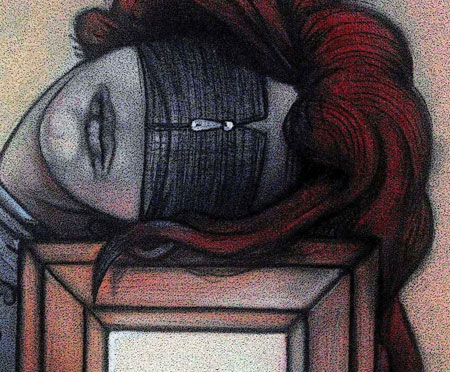
لوحة: وليد نظامي
الديمقراطيَّة المكارثيَّة وتصنيف العالم
مع انكشاف الوجه المكارثي المُطلق لمسألة تصنيف دول العالم ما بين «دول مارقة”، و”محور شرِّ” و”دول ملتزمة” و”محور خير”، وهو التَّصنيف الذي انفردت القوَّة الأعظم في تقرير إدراج أيٍّ من الدِّول، أو الكيانات السياسيَّة، أو المجموعات البشريَّة، أو أتباع الأيديولوجيات ومعتنقي الأديان، تحت أيٍّ من محوريه، وذلك بموجب «حِكْمَة قوَّتها”، و”كُلِّية سيادتها”، وتعالي منطقها المُتعالي على كُلِّ منطق، وسموِّ قانونها الخاص على كُلِّ قانون دوليٍّ أو إنسانيٍّ أو أمميٍّ، تأكَّد تماماً أنَّ ذلك المبدأ المكارثي الْمُشْبَعِ بـ”الديمقراطية الأميركيَّة”، والمُركَّز في مقولة «من ليس معي فهو ضِدِّي»، أو في مقولة «من لا يُشبهني فهو نقيضي»، هو وحده الذي يحكمُ استراتيجيات تلك القُوَّة الأعظم، ويُحدِّد مواقفها وممارساتها وتصرفاتها وتصوراتها، وطرائق تحكُّمها في العالم، وأساليب وآلياتِ قَبْضِهَا شِبْهِ المُطْلق على ثرواته وموارده ومُقدراتِه ومصائر قاطنيه من النَّاس!
وإزاء هذه الحقيقة السَّاطعة، فإننا لا نملكُ، ضمن استنباطات وخلاصات أُخرى ذات صِلة بما يجري أو بما لا يجري في بلاد العرب والشَّرق الأوسط عموماً، ترفَ إنكار أو تجاهل الصِّلة التشابكية الوثيقة التي تربطُ ما بين «التَّفجير الثلاثي المتزامن” الذي أُوْقِعَ في الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة في الحادي عشر من سبتمبر 2001، و”الانفجارات المتوالية” التي يتصاعدُ إشعالُ صواعقها في «بلاد العرب” مقرونةً بـ”بلاد الإسلام” التي حُمِّلت وحْدَهَا، زوراً وتلفيقاً واصطناعاً لعدوٍّ تُمْكِنُ هزيمته، المسؤوليةً الكاملة عن ذاك «التَّفجير الثُّلاثي المُتزامن” الذي قيلَ إنَّهُ قد خَدَشَ كرامةَ، أو صَعَقَ جبروتَ، القوَّة الأعلى والأعظم في هذا الكون.
ولقد تبيَّنَ، مع توالي ظهور الأدلة والبراهين والمعطيات المُوَثَّقة، والمؤصَّلة فكرياً ومنطقياً عبر تحليلات موضوعية شاملة وعميقة لصيرورة الوقائع والأحداث وتعاقب العلل والمعلولات، التي تُؤكِّد عمق الصِّلات ذات الامتداد الزَّمني والرُّسوخ الوظيفيِّ، المُحفَّز بأيديولوجيات مُصطنعة، أو بوعودٍ سياسيَّة زائفة، أو بتشابك مصالح، أو بتجنيدٍ استئجاريٍّ ارتزاقي، تبيَّنَ لكلِّ من يُعْمِلُ عَقْلَهُ من النَّاس أنَّ الترابط الوظائفيّ الأداتيّ الوثيق بين صُنَّاع «التَّفجير الثلاثي المُتزامن” الحقيقيينَ، أولئك المُتَسَبَّبِينَ في وقوعه، والمُخططين له، ومُستدرجي إحداثة، والمُستفيدين منه، من جهة، وصُنَّاع «انفجار الشَّرق” ومُحفِّزي تواليه وتعمُّقه وتوسُّعه وتمديد مساحاته وآماده عبر «تفجير الهُويَّات” وغيره من التَّفجيرات، من جهة أخرى، إنَّما هو ترابطٌ ثابتٌ وراسخٌ طالما أرادَ لهُ صُنَّاعهُ وموظِّفوهُ والمستثمرون فيه أنْ يبقى كذلك!
لم يكن هذا التَّرابطُ، ولا يُمكنُ لعاقل أنْ يتصوَّرَ أنْ يكونَ، مُجَرَّدَ نتيجةٍ أعقبت التَّفجيرَ الثلاثيَّ الذي أدَّى إلى انهيار بُرْجَي التِّجارة العالميَّة التَّوأمين وتصديع مبنيين في مقرَّي البنتاغون والبيت الأبيض، أو مجرَّدَ ردَّة فعلٍ تأسَّست على الحاجة الماسَّة إلى الرَّد عليه لاستعادة ماء الوجه، وإنَّما هو ترابطٌ قائمٌ منذ ما قبل الحادي عشر من سبتمبر 2001 وما بعده، وعلى امتداد ما بين الما قبل والما بعد من أزمنة ترجع إلى ما يربو على نصف قرنٍ من الزَّمن أو يزيد.
ومن المنطقي ألا نتوقَّع لهذه العلاقة الوظيفيَّة الأداتية التَّرابطية الوثيقة، القائمة على كتابة المصالح المُشتركة بين أطرافها على حساب حقوق آخريهم من الأمم والشُّعوب، والرَّاسخة في توالي عقود الأزمنة الاستعماريَّة والاستبداديَّة، وفي تعدُّد مواقع الأمكنة على خارطة الشَّرق، أنْ تنقطعَ على المدى القريب، أو أنْ تخضعَ لأيّ نوعٍ من التَّعديل أو التَّخلِّي من قبل أيٍّ من أطرافها، قبل أنْ تُنجزَ غاياتها المرجوَّة، وتحقِّق الأهداف القصوى التي من أجلها أوجِدتْ وتُوبعت ورُسِّخت على مدى أزمنة وعقود.
وإنَّ كانَ لما أبصرتهُ وما لا تزالُ تبصرهُ عيوننا، ولما قرأته وما لا تزالُ تقرأهُ بصائرُنا، في مرايا الجحيم الأرضي المُشتعل في هذا الشرق الدَّامي، وفي محيطه العريض، ولا سيما في سوريا ولبنان وفلسطين والعراق واليمن وليبيا، أن يُؤكِّد شيئاً، فإنَّه يُؤكِّد أنَّ هذه العلاقة الوظيفيَّة الأداتية الترابطية الوثيقة بين صُنَّاع التَّفجير، ومُشعلي صواعق الانفجارات، ستظلُّ علاقةً مفتوحةً على التمدَّد في الزَّمان وعلى الرُّسُوخ في المكان طالما ظلَّت مصلحةُ القوَّة الأعظم وقواها الظَّاهرة والخفيَّة، و”حكمتها” الثَّابتة والمُتحوِّلة، و”قُوَّتها المُستبدَّة” و”سيادتها الكُلِّية” منقطعة النَّظير في كل وضعٍ وحال، تستوجبُ استمرارها وتوسيع دورها التَّفجيري في الزَّمان والمكان.




