امرأة وواقع جديدان

واجهت الرواية النسوية العربية عموما، والسودانية خصوصا، إشكاليات عدة منذ مرحلة التأسيس، لا تبدأ بالتهميش الذي لاقته على مستوى التلقي، أو حتى النشر، حيث تأخرت نتاجات المرأة عن صنوها الرجل وإنما أيضا واجهت قضايا مُلحّة تتصل بالتعليم ودور المرأة في المجتمع، اختبرت بها ذاتها، وقدرتها على الصمود في المواجهة. واللافت أن الرواية النسوية السودانية تخلصت من تهمة اللصيقة بكتابة المرأة عموما، والتي تصفها بأنها “كتابة الجسد”، حيث تعدد القضايا الحيوية التي طرحتها المتون الروائية. تطمح هذه القراءة إلى تسليط الضوء – ولو قليلا – على الكتابة النسوية في السودان، وإظهار خصوصيتها التي وضعتها على جادة مدونة السرد العربي والعالمي كما فعلت بعض الكاتبات مثل ليلى أبوالعلا التي تكتب باللغة الإنكليزية.
غابت الرواية السودانية عن مدونة السّرد العربيّة لفترات طويلة، لأسباب لا مجال لحصرها هنا. وكذلك غابت كتابات المرأة السودانية كثيرا عن المشهد الإبداعي العربي. ولا نعرف هل كان هذا الغياب عن عمد أم لا! العجيب في الأمر أن معظم الدراسات النقدية التي تناولت الكتابة النسوية العربية، أسقطت منجز المرأة السودانية الكتابي.
تهميش وإقصاء
للتدليل على التعنت المشار إليه يكفي الإشارة إلى كتاب “100 عام من الرواية النسائية العربية 1899-1999″ لبثينة شعبان. فقد تناولت فيه كتابات قطاع عريض من الكاتبات العربيات، لكن لم تتطرق – ولو بالإشارة – لأي تمثيلات لكتابات المرأة السودانية. وتكرّر الأمر في كتاب الناقد نزيه أبونضال، “تمرد الأنثى: في رواية المرأة العربية وببلوغرافيا في الرواية النسوية العربية (1885 -2004)”. فقد قدّم المؤلف تمثيلات للكتابة النسوية من كافة الأقطار العربية، مستثنيا السودان. وهذا الإغفال والتهميش يضعان تساؤلات من قبيل: لماذا أُسقطت الرواية النسوية السودانية؟ أو هل الشرائط التي وضعت في الكتابين كمعوّل للاختيار لم تنطبق على الرواية النسوية السودانية؟ العجيب أن نزيه أبونضال في الببلوغرافيا التي ذيل بها كتابه أشار إلى خمس كاتبات من السودان دون أن يتطرق لنصوصهن بالتحليل. والكاتبات هن: آمال عباس العجيب (روايتان: عود الكبريت، الجواد والسيف المكسور، د.ت، وهذا للأسف خطأ كبير، حيث هذان العملان لا ينتميان لجنس الرواية، فالأصل أن آمال العجيب هي صحافية رائدة، وقد وصفها نجيب محفوظ بأنها السودانية الواعية، وما كتبته عبارة عن حكايات اجتماعية، نُشرت متفرقة في الصحف، ثم جمعت تحت إطار قصصي مجازًا) وبثينة خضر مكي (أغنية النار، د.ت) وبشرى هباني (مسرة 1989) (والحقيقة أن الدكتور بشرى هباني رجل وليس امرأة كما زعم نزيه أبونضال، وله العديد من القصص منها: الصديقان، وإعدام بحر، البحث، برميل القمامة، محاكمة دانيال بوت، وابن الشيخ، بالإضافة له مسلسل إذاعي بعنوان للقمر وجهان) وزينب بليل (الاختيار، 1984) وملكة الدار عبدالله (الفراغ العريض، 1970)، وملكة الفاضل عمر (الجدران القاسية، 1999).
بصفة عامة دخل الفن الروائي إلى السودان بفعل حركة التواصل مع مصر. والمتأمّل لمسيرة الرواية السودانية منذ مرحلة البدايات، يكتشف أولا، أن ثمة رابطا بين نشأة الصحافة والكتابة. فالصحافة كانت نافذة مهمة للكتابة في تلك الفترة المبكرة. وثانيا، أن نتاجات المرأة لم تنفصل أو حتى تأخرت عن نتاجات رديفها الرجل المُبكرة. فثمة مَن يرى أن كتابات المرأة في السودان، كانت سبّاقة أو تواكبت مع كتابة الرجل وإن كانت تأخرت نسبيّا في النشر.
تعدّ رواية “الفراغ العريض” 1970، للكاتبة ملكة الدار محمد عبدالله (1920 – 1969)، من الروايات الرائدة على مستوى الكتابة فقد كتبت الرواية أوائل الخمسينات، وصدرت في عام 1970 متأخّرة عن زمن كتابتها قرابة العقدين. وهذا التاريخ السبّاق يؤكّد شيئيْن؛ الأوّل أن المرأة بدأت مُبكرا تُدرك الانتقاص من ذاتها عبر أفعال ذكورية تحصرها في دور الخادمة، والتابعة… إلخ؛ ومن ثمّ اتجهت إلى التعبير عن الاحتجاج على هذه الممارسات الذكورية والاعتداد بذاتها، والدفاع عن قضاياها مبكرا، وبالاعتماد على صوتها الخاص.
لذا وعت المرأة لدورها في تسليط الضوء على قضايا الواقع الاجتماعي، وعلى قضايا المرأة خصوصا. وثانيا أن روح الكتابة والقضايا التي انشغلت بها الكاتبات في السودان لم تنفصل عن ذات القضايا التي كانت محور الكتابة في العالم العربي من مشرقه إلى مغربه. وهو ما يُعزِّزُ بأن السودان لم يكن مُنفصلا ثقافيا عن العالم العربي، بل كان متلاحما، حتى في القضايا الجوهرية التي تناولها الكُتّاب أو الكاتبات على حدّ السواء؛ كقضايا الهجرة، والرأي وحرية التعبير وكذلك الكتابة عن المهمشين في المجتمع، وإن كانت بصيغة سودانية محلية.
بدايات وانقطاعات
ومع هذه البداية المبكرة، إلا أنّ ثمّة فترات انقطاع في الكتابة النسوية، أشبه بحالة سبات طويل. وهو الأمر الذي يدفع بالتساؤل عن أسباب انقطاع كتابات المرأة، وخفوت صوتها الروائي – تحديدا – في فترة الخمسينات، باستثناء كتابات تنتمي إلى القصة القصيرة. كما هو ظاهر في كتابات القاصة آمال عباس العجيب، والقاصة آمنة أحمد المعروفة بآمنة بنت وهب، والقاصة سلمى أحمد البشير.
واستمرت الندرة في الكتابة النسوية – تحديدا- طيلة سنوات الخمسينات إلى الثمانينات من القرن الماضي، حيث حدثت طفرة عالية مقارنة بالعقود السّابقة، فظهرت كتابات روائية لأسماء كثيرة كـ: زينب بليل في “الاختيار” و”كش ملك” و”نبات الصبار”، وبثينة خضر مكي في “أغنية النار” و”صهيل النهر” و”حجول من شوك”، وملكة الفاضل في “جدران قاسية”، و”في مكان ما”، وكذلك نائلة فزع في “الموت في زمن العشق”.
أما مرحلة التحوّل فتبدأ من زمن التسعينات وصولا الى الألفية الثالثة. وفيها زاد التراكم الكمي، وتنوّعت أسئلة المتون الروائية وأشكالها الجمالية. اللافت أن بعض الكتابات لم تتخلص من موضوعات البدايات وطرائق الكتابة الكلاسيكيّة أيضا. وهذا لا يقتصر على الرعيل الأوّل من الكاتبات، بل يمتد الأمر إلى جيل ما بعد الألفية كما في نموذج “الملكة وصبي الأفيون” 2019، لسارة عبدالمنعم.
ومن الكاتبات اللاتي يدرجهن النقاد في مرحلة التحول؛ عايدة عبدالوهاب في “ضحك من قلب الجنوب”، وغادة عمر الشيخ في “قطرات متناثرة”، وليلى أبوالعلا في “المئذنة” و”المترجمة” و”حارة المغنى”، و”منزل في مكان آخر”، ونفيسة الشرقاوي أم أحمد (حيث أصدرت مجموعات قصصية منها “شموع تحترق”، و”عادت الغربة”، و”تباشير”، و”همسات الوجدان”، و”كان الحديث همسا” و”خلجات”)، وأميمة عبدالله في “ذاكرة مشلولة” و”أماديرا”، وهبة عوض في “امرأة بين العقل والقلب”، ورانيا مأمون في “فلاش أخضر” و”ابن الشمس″، وسارة فضل في “رسائل من فيكتوريا”، وشامة ميرغني في “موانع الزمن وجوزيف ملاح البنات”.
رواية “الفراغ العريض” 1970، للكاتبة ملكة الدار محمد عبدالله (1920 – 1969)، من الروايات الرائدة على مستوى الكتابة فقد كتبت الرواية أوائل الخمسينات، وصدرت في عام 1970 متأخّرة عن زمن كتابتها قرابة العقدين. وهذا التاريخ السبّاق يؤكّد شيئيْن؛ الأوّل أن المرأة بدأت مُبكرا تُدرك الانتقاص من ذاتها عبر أفعال ذكورية تحصرها في دور الخادمة، والتابعة… إلخ؛ ومن ثمّ اتجهت إلى التعبير عن الاحتجاج على هذه الممارسات الذكورية والاعتداد بذاتها، والدفاع عن قضاياها مبكرا، وبالاعتماد على صوتها الخاص
ومع الألفية الجديدة ظهرت أسماء مثل سارة حمزة الجاك والتي قدمت العديد من الأعمال تجمع بين القصة والرواية مثل «صلوات خلاسية، وخيانتئذ، وكمبا والسوس» وتماست كتابتها مع قضايا الواقع الاجتماعي السّوداني، وهناك أيضا آن الصافي في أكثر من عمل “فُلك الغواية”، و”جميل نادوند”، 2014، و”توالي”، 2015 و”قافية الراوي”، 2015 و”كما روح”، 2016، و”إنه هو”، 2017. وإشراقة مصطفى حامد، وهي شاعرة وكاتبة ومترجمة لها العديد من الأعمال مثل “أنثى الأنهار.. من سيرة الجرح والملح والعزيمة”، 2015، و”الدانوب يعرفني.. الوجهُ الآخر لسيرة الأنهار”، 2017. وهناك ليلى صلاح في “الغابة السرية.. وقائع من حكاية الوجع والجنون”، وسوزان الكاشف “إيرات” و”توابيت عائمة” وإيمان المازري في “حياة” 2017 و”هويتي الأخرى” 2018.
جاءت كتابات المرأة على اختلاف زمنيتها، أشبه بمحاولات “للرد على الإقصاء والغبن الذي مُورس على المرأة في مجمل العلاقات النفسية والأخلاقية” كما تقول نجاة إدريس إسماعيل. فالكتابات أظهرت أن ثمة انتهاكا مَقيتا مورس على جسد المرأة. وجسّدت سارة حمزة الجاك في “خيانتئذ” لهذا عبر شخصية فضيلة عيسى عبدالرحمن، حيث تآمر الجميع عليها، بسبب نفوذ عائلة السيد عمر الإمام، فصدر حكم القاضي عليها بأن تُشنق في وضع مقلوب “رأسها إلى أسفل، وجسدها إلى أعلى، في وضع مقلوب بحيث أن يكون رأسها بين ثدييها المتدليين، وتكون جميعا بين ذراعيها المعلقتين، وتنفتح ساقاها كزاوية منفرجة، عارية بلا ثياب” (الرواية، ص 15).
وتمثّل الانتهاك الأعظم للمرأة في الغبن وسلبها حقوقها لمجرد الاختلاف الأيديولوجي، كما في نموذج سماح بطلة “خيانتئذ”، التي تُمنع من استلام خطاب تعيينها كمساعدة مدرس في الجامعة لأنها من غير “الموالين للحزب الحاكم” وتنتمي إلى ذوي الآراء المناهضة للنظام، إلى جانب تسليط الضوء على هذه الانتهاكات التي تعرّضت لها المرأة.
كان ثمة اهتمام بقضايا السياسة وانعكاس تأخّر المسار الديمقراطي على الواقع السوداني بكل جوانبه، كما عبرت بثينة خضر مكيّ في “أغنية النار“. فصورة المرأة التي قدمتها، لم تكن تلك المجضهة أو الكسيرة. وإنما المرأة الواعية بذاتها وباستقلالها، ورغبتها في البحث عن صوتها الخاص بالكتابة. بصفة عامة تشير الدكتورة سعاد مسكين في كتابها “خزانة شهر زاد – الأنواع السردية في ألف ليلة وليلة” إلى “حكاية الساردة الأنثى وتموقعها داخل البنية السردية السودانية” وفي نفس الوقت أشارت إلى “أن السرد النسوي السوداني يحتاج مراجعة، ومع استثناء الاحتراف الكتابي المتمثل في تجربة ‘ليلى أبوالعلا'”.
الحلم بامرأة جديدة
ما القضايا التي ناقشتها الكتابة النّسوية السُّودانية؟ وهل كانت الكتابة النسوية تَسعى للحلم بامرأة جديدة، تلاحق حركة التغيرات في المجتمع، أم أن رهانها خاب بسبب تغلغل الذكورية في بنية المجتمع السوداني من جانب ووقوف السلطة بمفهومها الحقيقي وأيضا بمعناها الأيديولوجي من جانب آخر كحاجزين ضد تطلعاتها وآمالها؟
في الحقيقة الإجابة عن مثل هذه الأسئلة تتطلب قراءة وافية وتتبعا لكافة الكتابات النسوية على امتداد تاريخ الكتابة. وأيضا تتبع مراحل التحوّل والتغيير في بنية المجتمع، وانعكاساتها على الحراك الأدبي. وهذا الرصد سيكشف عن صورة المرأة كما جسّدتها المرويات النسوية من جانب وتحليل العلاقة بين الاطراد الكمي على النتاجات النسوية، والتمثّل لتقنيات جديدة على مستوى الكيف، من جانب ثان.
لذا، تسعى هذه المقاربة النقدية وفقا لطموحها الأكبر، إلى الإجابة عن هذه الأسئلة، عبر اختبار وفحص قطاع من قطاعات الرواية السودانية ألا وهو “السرد النسوي السوداني”، تمتد من الجيل الأول وصولا إلى جيل الألفية الجديدة. واعتمدت الدراسة على مبدأ الانتخاب والفرز للنصوص، لكل ما يتصل بموضوع الدراسة. فالتزمت تنحية ما هو مكرّر على مستوى الموضوعات، واستبعاد الضعيف. آملة في الوصول إلى رؤية شبه شمولية، لا حصرية، تهدف في نهاية المطاف، إلى إبراز ملامح وخصوصية هذه المدونة السردية، من جانب ومن جانب ثان إبراز كيف استفادت هذه المدونة السّردية أولا من الميراث العريض في كتابة المرأة في السودان، وغيرها. وهو ما كان بمثابة المؤنس والداعم لها في رحلتها الكتابية. وثانيا في تجاوز هذا الميراث على مستوى الكتابة وفي استحضار تقنياتها الجديدة التي تتلاءم مع روح العصر الحداثية، والتطورات العالمية للرواية والكتابة بصفة عامة.
تتأتى الكتابة النّسوية السودانية من حيز سوسيولوجي (اجتماعي – سياسي). يعني بالتعبير عن طموحات الكاتبات ورؤاهن للعالم. وهو ما أنتج “موجة ثالثة” في الرواية السودانية على حد تعبير منصور الصويم. وقد اصطدمت هذه الكتابات بقمع الأنظمة الدكتاتورية تارة والدينية تارة أخرى. ومن ثمّ طرحت الرواية أسبابا جديدة للهجرة ليس بسبب العمل كما كان سابقا، وإنما بسبب أن الأوطان لفظت أبناءها، لتوحش آليات وأدوات أجهزتها القمعية بتعبير ألتوسير. فكانت الهجرة أشبه برحلات الموت في “توابيت عائمة”، بغرض تحقيق الأحلام والتحرّر من الخوف الذي هو قاهر الأحلام فـ”الموت هو الموت…. في الغابة أو في عرض البحر أو في بطن الصحراء” (ص 34)؛ علّ الأحلام كما تمنت الساردة أن “تعبر بكم إلى حياة الحياة، الحياة ولا شيء غيرها”.
كما يمكن القول مع أحمد عوض خضر في ورقته التي قدّمها في المؤتمر العلمي السابع للرواية المصاحب لجائزة الطيب صالح للإبداع الروائي إنه كان ثمة وعي حقيقي “بقضايا النوع الاجتماعي عبر الكتابة الروائية للمرأة السودانية وكيف تتكوّن ذاكرة النص أو الكتابة بهذه المفاهيم لدى المرأة السودانية”، كما يشير إلى “أن الخطاب الروائي النسوي لم يكتف بالنظر إلي وضع المرأة وصورتها في المجتمع السوداني فحسب؛ بل يمكن لنا أن نشير إلي أن هذا الخطاب هو منشور ضدّ القهر ونوع من التمرد على الثقافة الذكورية فقد تجاوز الخطاب الروائي النسوي عبء هذه الوظيفة، ولم تعد الكتابة مجرد صرخة احتجاج ضد حرمان المرأة من حقوقها في التعليم أو العمل، أو دعوة للتمرد على القيم المجتمعية التقليدية”، أو حتى بأنهن يطرحن قضايا ذات طابع سيري أو قضايا شخصية حول الحب والزواج والأطفال والأسرة.
ومن ثم تخلصت الرواية في رحلة صعودها من الصورة النمطيّة المتكلّسىة للمرأة المنكسرة الموجوعة من خيانات الرجل، وصارت قوية لا تقف عند هذه الانكسارات، بل تجاوزت طعنات وخيانات الرجال، كما فعلت دارية بطلة رواية “الغابة السرية” لليلى صلاح. فالبطلة التي عادت إلى السودان، بعد اكتشاف خيانة زوجها لها، تفتح عبر أناتها ورويها غابتها السرية، والإخفاقات التي مُنيت بها. واستطاعت أن تكتشف ذاتها وتعيد علاقتها بالسودان الأرض والوطن.
قوة المرأة التي بدأت تتضح ملامحها في مرويات متعددة أخذت ثيمة تمرد المرأة والذي يصل إلى العصيان من أجل إعلان حبها كما فعلت عفاف في رواية “ابن الشمس” وقد تحولت إلى “نمرة شرسة، وهي تدافع عن حبها. فهربت مع الشاب الذي تحبه، ثم تزوجته عن طريق المحكمة غصبا عن أهلها الذين رفضوه عندما تقدم لها” (ص 124)، وإن كانت هذه الصورة نادرة، إلا أن هذه الندرة لا تلغي تحقّقها.
ثمّة فترات انقطاع في الكتابة النسوية، أشبه بحالة سبات طويل. وهو الأمر الذي يدفع بالتساؤل عن أسباب انقطاع كتابات المرأة، وخفوت صوتها الروائي – تحديدا – في فترة الخمسينات، باستثناء كتابات تنتمي إلى القصة القصيرة. كما هو ظاهر في كتابات القاصة آمال عباس العجيب، والقاصة آمنة أحمد المعروفة بآمنة بنت وهب، والقاصة سلمى أحمد البشير. واستمرت الندرة في الكتابة النسوية – تحديدا- طيلة سنوات الخمسينات إلى الثمانينات من القرن الماضي، حيث حدثت طفرة عالية مقارنة بالعقود السّابقة
إن التحول الخطير في صورة المرأة المتصالحة والمروِّضة والمتمردة، يكمن في صورة المرأة النمرة، التي تقتص لشرفها من الذكورية، دون أن تـأبه بالعقاب. وهذه الصورة نلمحها في شخصية فضيلة محمد عيسى في رواية “خيانتئذ“. فعمر الإمام الذي هام بها وهي من غير طبقته، وتحايل لمواقعتها عبر وضع المخدر لها، فما أن اكتشفت ما فعل بها، حتى قررت الانتقام منه. فغافلته ظنّا منه أنه خدرها كما يفعل في كل مرة، لكنها استطاعت أن تقطع قضيبه. وبقدر ما كان الأمر فاجعا، كان إشارة على قوة المرأة التي صارت عليها عبر هذا المشهد “مات عمر الإمام وقضيبه بيد فضيلة” (ص 131).
وهذا الفعل يعد تطورا لافتا في هذه العلاقة الأبوية التي وصل مداها إلى فصل مكان الرجال عن النساء في البيت “لأن الاختلاط حرام“. ولا ننسى أن كتابات المرأة تحرّرت من الانشغال بذاتها أو ما يتمحور حول المرأة في إطارها العام. ونحت منحى آخر حيث شملت من جملة اهتمامها لقضايا الواقع، وتعقيداته، قضايا الهجرة والاغتراب في الكثير من المرويات. وقد جاءت باعتبار الهجرة هي الملاذ والجنة، بل بما تواجه المغترب من إكراهات وضغوط، وعنصرية مقيتة، على نحو ما فعلت سوزان كاشف في “توابيت عائمة”، وليلى أبوالعلا في “منزل في مكان آخر”. وتعرض ليلى أبوالعلا عبر ثلاث عشرة حكاية، للكثير من المشكلات والمخاوف التي تواجه المغتربين، خاصة وهم قادمون من بلاد المشرق في بلاد المغرب. كما تشير إلى حالة الضياع والتشتت التي يبدو عليها المهاجرون. كما تسرد عن علاقات الانحراف على مستوى الذكور والإناث. وهو ما يبيّن أثر قلق عدم الانتماء وثقافة الخواء.
تتشكل ملامح جديدة للمدينة عبر هذه المرويات. قد تبدو في صورة نقيضة لتلك التي كانتها أم درمان في “الفراغ العريض“، بل توصف بالمتضائلة الجمال كما في “أغنية النار” (1999) مقارنة بـ”الترف الجمالي وكرنفالات الفرح المجنون بعشق الطبيعة الثرية الرائعة” (ص 30)، في الريف اللندني والمدينة بشوارعها المتلاصقة والمزحمة.
وأحيانا في صورة المدينة القابضة على روح أبنائها، وأشبه بالجدران العالية، كما عند ملكة الفاضل. فالمدينة عبارة عن “شوارع صامتة ووجوه متجهمة وحر لافح يضفي على الوجوه المزيد من الضيق والملل” (ص 130). وكذلك في صورة تلك المتسخة الشوارع، والبائسة كما في “ابن الشمس″، إلى صورة المدينة المنفرة والطاردة، كما رسمتها سوزان كاشف للخرطوم في “توابيت عائمة” حيث بدت المدينة “ليست قاسية الملامح فقط، فهي شديدة البأس أيضا؛ فشمسها اللاهبة تكاد تغلي مخي وأنا عاجزة عن أي رد فعل تجاه ذلك. وجوه كالحة مهزومة، هدها الفقر والمرض. ترهلت المدينة، ملأ الفقر أغلب البيوت التي كانت آمنة، تفشت البطالة وأصبحت كغول يخيف الشباب من الخريجين الذين لا علاقة لهم بالسلطة التي كانت تستأثر بكل شيء”. (ص 52).
هذا التحوّل يشي بالصورة الأقسى والأنكى على النفس كما في “المدينة الفاسدة” على نحو ما نرى في “خيانتئذ” لسارة الجاك. فالكاتبة تصور العالم السفلي، المسكوت عنه؛ حيث تجّار المخدرات وحفلات الدعارة، وصولا إلى المتاجرة بالحيوانات المنوية.
ويزداد المشهد رعبا بتصوير الأفلام الإباحية التي تنتشر في سوق السينما في هذه الجزيرة، وصولا إلى الصورة المرعبة، بعدما اكتست ملامحها بهوية جديدة جعلت منها أشبه بمدينة الخوف. فصار الخوف من البوح بالعزف على العود، غالبا على الشخصيات، حتى ولو لم يكن في السودان نفسه. كما حدث مع والد عواطف وزوجها في القاهرة فـ”كانا يعزفان العود في ليالي سمرهما السرية جدّا في القاهرة” ولكن ما إن “تذكرها أحدهما كمنولوج داخلي يرتجف من أن ينكشف سرها” (ص 17) بسبب ما صبغت به المدينة من أيديولوجيا دينية متشدّدة.
الغريب أن هذه الأيديولوجيا لم تمنع الفساد أو الفجور حيث العالم السفلي الذي يجتمع فيه رجال ونساء من كافة الطبقات الاجتماعية “لا يحبون الالتزام الاجتماعي” فينشدون الجزيرة “يبحثون عن حرية لا مكان لها إلا في أذهانهم وخيالاتهم المريضة” (ص 30)؛ لذا يلتزمون بقوانين الجزيرة، من قبل أن تطأها أقدامهم. حالة السوء التي تفشت في المدينة، جعلت منها مدينة لافظة لأبنائها. فما أن يجدوا البديل حتى يقرروا عدم العودة كما حالة صلاح في الجدران القاسية، عندما سافر إلى الدولة الخليجيّة للعمل، فما أن يصله خطاب أبيه ويحثّه على العودة يقول في مرارة “لا يا أبي، فأنت وأمي وأخواتي وأهلي، ستظلون الواحة التي ألجأ إليها كلما اشتدّ قيظ مشاعري، ولكن أنا نفسي لم أعد نفسى. أنا ذلك الغريب في بلدي”. وإن كانت ثمة نغمة تكشف هذا الشتات بين الهنا والهناك “نحن نتفرق بإهمال، في منزل هنا، ودار هناك” وهذا الشتات لا يمنع اللوذ بتراب الوطن “نحن في بياتنا الشتوي، نستدفئ بتراب الأرض”. (ص 100).
منذ رواية “الفراغ العريض” (1970) لملكة الدار محمد، وجل الكتابات النسوية السودانية مشغولة بالواقع الاجتماعيّ القاهر، وعراك المرأة من أجل الظفر بحقوقها، علاوة على رصد التحولات الاجتماعية والفكرية والسياسية في المجتمع السوداني. كما أولت اهتماما في أحد جوانبها بقضايا ذات أهمية، على مستوى التكوين الثقافي السوداني، طفت على السطح بإلحاحٍ – وإن كان مُبكّرا – على نحو الاهتمام بقضايا التعليم، وتحرّر المرأة، وانخراطها في قضايا وطنها، كالتحرر والسعى إلى الاستقلال.
وفي مرحلة لاحقة كانت الرواية تعبيرا عن وعى المرأة بذاتها، وانعكاس هذه الذات في الكتابة. فركزت الروايات – في الكثير منها – على دور المرأة المتعلّمة. وقدمت صورة لهذا النموذج الفاعل وإن كان مجهضا بفعل الوصايا الذكورية، على نحو شخصية منى بطلة رواية “الفراغ العريض” ونموذج فاطمة بطلة رواية” الجدران القاسية” التي رفض أعمامها استكمال تعليمها، وأصروا على تزويجها بابن عمها. كما تمثلت لوضعية المرأة في فترة الاستعمار، فلم تغفل ملكة الدار لوضعية المرأة الريفية المزرية في حُقبة الاستعمار.
بطلة الرواية، منى (التي تتقاطع مع شخصية المؤلفة ملكة الدار في الكثير من جوانبها) تُمارس وظيفة تعليمية. وعبر هذه الشخصية استطاعت المؤلفة أن تقدم مشكلة وجودية مرتبطة بالأنثى وتصوُّرها لذاتها ولواقعها وللثقافة السائدة المكرسة للسلطة الأبوية وتأثيرها السلبي على واقع المرأة (إرغام منى على الزواج من سيد وهي لا تحبه) ومستقبلها برفض سيد استكمال سارة لتعليمها. أحال هذا الواقع القاهر شخصية سارة لأن تتخبط في فراغها الداخلي.
الغريب أن القضايا التي طرحتها الكاتبة مبكرا، مازالت مطروقة وتُناقش في كافة المحافل الدولية والمحلية، التي تتعلّق بالمرأة ووجودها، وهو ما ليس مقتصرا على السودان وحده، بل هو قاسم مشترك في كافة الأقطار العربية. وهي رؤية مبكرة لطبيعة دور المرأة في المجتمع. فمع التغيرات التي حدثت في المجتمع السوداني إلا أن التحولات لم تكن بالمعنى المرجوء والمنشود. فقد كانت سلطة الرجل وإرادته هي الحاكمة، في مقابل انصياع المرأة له. فبطلتها “منى” صبية قروية ونازحة إلى المدينة.
وقد سعت المؤلفة من خلال بطلتها منى إلى تعرية بنية الذكورة في المجتمع السوداني، وفداحة تأثيرها على أفراد المجتمع. فالأب غائب عن البيت للعمل في التجارة، ولم يبق منه سوى الذكرى فكما تقول البطلة لصديقتها “لم يعد الأب بعد رغم مضي ثماني سنوات على فراقه لنا وهو يا صديقتي يتراءى لي دائمًا” (ص 6).
أما سلطة الأب المفتقدة، فتنتقل إلى أهله حيث ترتحل البنت وأمها إلى أم درمان لتعيش مع جدّها وأعمامها وأبنائهم. وينوط بهم عقابها كما حدث مع سيّد الذي ضربها ضربا مُبرحا، حينما اكتشف علاقة أخته سارة بصديقه صلاح، بعدما وجد الهدية فـ”هجم عليها وهوى بكفه على صدغها يصفعها مرة ومرة حتى سقطت على الأرض فتركها ليتحول الى أختيه يصفعهما ويضربهما بيديه ورجليه، ويقذف ثلاثتهن بكل ما تصل إليه يداه” (ص 25).
وعندما تشتكي منى لأمها تبررّ فعلته بأن سّيدا هو الحامي بما يتملكه من صفات تجعل المرأة مُنصاعة له. فمع أنه لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره إلّا أنه “يفيض حيوية ويفيض جرأة واعتدادا. إذا تكلّم تعمّد الجدّ والعبوس، وإذا تحرّك أظهر الشدّة والخيلاء. يحاول دائما أن تبدو على وجهه الصرامة والحزم”. يمتلك من الصفات التي تجعله الحاكم والنساء تنصاع له، فهو “الحفيد البكر، والولد الأوحد الذي تفخر به الأسرة وتنتظر على يديه خير المستقبل وعزته”. ومن ثمّ يهيئه الوضع الاجتماعي المفرط في ذكوريته لهذا الدور بوصفه حاميا للمرأة، ويمتلك سلطات حتى لو تعارضت مع رغبات الأنثى.
فيسعى سيد عقابا لأخته لحرمانها من الدخول إلى كلية المعلمات، فكما تقول الدكتورة ناهد محمد الحسن، هذا السيّد يتقدّم بصرامة لمعاقبة شقيقته لتجرّأها على الشعور بالحب فيحرمها من حلمها بدخول كليّة المعلّمات، الذي عكفت سنوات للحصول عليه. وحسمت الجدّة النقاش بقولها “إنّ سيّدا أعطى كلمة رجل، وهي أنّه لو التحقت سارّة بالمعهد أو بأيّ مدرسة بعد اليوم ليخرجن من هذه الديار ويقطع كلّ صلة له بهذه المدينة، ومن أنتن حتى نضحّي بسيّد من أجل إرضاءكن؟ إنكن مجتمعات لا تساوين قلامة من ظفره” (ص 21).
في الحقيقة، قدمت المؤلفة في صورة بطلتها منى نموذجا للشخصية المتصالحة وأيضا المتماسكة بعيدا عن التمرد، وأيضا المتوازنة نفسيّا على الرغم من غياب الأب. ويشير النور عثمان أبكر إلى أن طقس التضحية بالأب المتوازي بالغياب، حيث طبيعة بطلات قصص ملكة الدار يغلب عليها عنصر البطلة المرأة التي لا عائل لها إما بموت وإما هجرة. ويفسر هذا الأمر بأنه بمثابة محاولة من ملكة الدار “لتحقيق السعي الروحي لبطلاتها حيث تتراخى قبضة الأبوية.. كما هو رغبة لاواعية في غياب السلطة الذكورية التي تقف حجر عثرة أمام تطور المرأة وحريتها”.
وتماشيا مع هذه الصورة المثال للشخصية المرأة البطلة سعت المؤلفة إلى الترويض الوجداني لذاتها لتتقبّل السّيد ابن عمها الذي ترفضه، ولكن قُهرت وأجبرت عليه. فوفقا لقول الأب تعقيبا على مبررات رفضها بأنه أخوها من جانب، ومن جانب ثان فهي لا تستطيع أن تتحمل تصرفاته، إلا أن الأب يرفض أسباب الرفض قائلا “لا أولا ولا ثانيا، لقد انتهى الأمر وارتضيناه كلنا، وليس هناك من الرجال من يعرف قدرك ويحفظ حقوقك مثل ابن عمك سيد” (الرواية، ص 76).

يأتي رفض الأب لعمل ابنته، كمؤشر يكشف عن الذكورية المتفشيّة في الأسرة، والتي ظهرت في أكثر من موقف. كموقف سيد السابق وهو متعلّم، رافض لدخول أخته الجامعة. وفي مرحلة لاحقة يرفض الأب بعد عودته فكرة عمل ابنته منى مدرّسة، فمن وجهة نظره فإن عملها “منقصة وذل وتهاون بحق الأسرة وبسمعة الرجال”. ومن جانب ثان فإن رضوخ منى لقرار الزواج يوحي بدلالة إيجابية على رفض فكرة التمرّد أو الخروج عن نسق الجماعة.
اللافت أن غالبية نساء البيت كما صورتهن الكاتبة ملتزمات بواجباتهن المحددة سلفا. فزوجة عمها عمر الجميلة نعيمة ابنة خالته ترضخ لسلطة البيت بعد أن تركها زوجها ليتزوج أخرى تنجب له أطفالا. فلم تبق لها سوى خدمة الأسرة دون تذمُّر. تعدّ لهم الطعام والشراب، كما أنها تقوم على خدمة أمه (خالتها) “في تفانٍ وإخلاص تداري ما تلقى من عذاب الصبر وجحيم الغيرة وراء ذلك الرضاء الذي يبدو على وجهها الوسيم القسيم” (ص، 10). وبالمثل فإن الخدمة موزّعة على نساء الدار فـ”هذي عليها الديوان تنظفه وترتّب فرشه وتملأ جراره، وتلك عليها الحوش تكنسه والأزيار تملؤها، والثانية تعد الشاي والقهوة وتحملها إلى مَن بالدار. والأواني تغسلها، وتقوم بترتيبها، وإذا فرغن من ذلك اجتمعن على ملابس سيد وملابسهن يغسلنها ويرتبنها”.
هذه الصورة السلبية تعكس الصورة المثالية لشخصية المرأة السودانية كما يريدها المجتمع. أما صورة المرأة المتمردة فتتوازى مع الساقطة في نظر المجتمع، على نحو ما وسمت سعدية. المفارقة حقّا أن نظرة منى المثقفة تساوت مع نظرة المجتمع في رغبة سعدية في تحرّر ذاتها بتأكيد حريتها عبر الخروج على نسق المجتمع. وهي تلك النظرة الازدواجية التي ستقع فيها رجاء المثقفة في رواية “أغنية النار” فتتسامح رجاء مع مغامرات أخيها التي يفعلها ويحكي لها عنها. وفي الوقت ذاته لا تقبل بزواج شرعي لزوجها عاصم.
الجدير بالذكر أن هذه الصورة السلبية للمرأة لم يعد لها مثيل في ما بعد، فمثلا رانيا المأمون تقدّم في “ابن الشمس″ نموذجا للمرأة اللعوب التي تخون زوجها المغترب. وهي في الأصل تشير إلى أضرار اغتراب الأزواج للعمل. فشخصية محاسن التي تنجرف في علاقة جنسيّة مع جمال، تصل إلى حد الإدمان، نموذج لإدانة اغتراب الرجل وترك أسرته حتى ولو كان من أجل العمل.
النموذج الثاني الذي قدمته المأمون، هو شخصية ناهد، التي تمرّدت على قرار الأسرة بزواجها من عثمان ابن عمها، وأعلنت في تحدّ أمام الجميع (أبيها وأمها وأبيه) “… أنا ما عاوزاك، أمي وأبوي عاوزين أعرسك، لكن أنا ما عاوزاك، لأني بحس بيك زي أخوي” (ابن الشمس، ص 131)، وفي مرحلة لاحقة عندما تبدأ التحديات والأشواك تظهر في طريق علاقتهما تقول تعليقا على سؤال جمال لها، “تفتكري أبوكي وأمك ح يعملوا شنو” قالت بثقة: “دي حياتي وأنا حرّة فيها، وأنا كلمتك قبل كدا إني مستعدة أحارب الدنيا كلها عشانك، حتى لو أهلي رفضوا، وحتى نفوني أنا ما ح أتنازل عنك. أنا متوقعة إنو يحصل دا وإنهم يرفضوا، لكن ما ح أستسلم، أبدا ما ح أستسلم” (الرواية، ص 236). وهذا التهديد لم يكن في الهواء بل كادت أن تنفذه، وتتحدى الأسرة بالزواج من الشماشي، بعد رفض الأب له وضربه وطرده من المطعم، لولا تدخّل محاسن وفضح علاقتها به.
وبالمثل تقدم بثينة خضر مكي في “أغنية النار”، نموذجا للمرأة المتحرّرة، سواء في علاقتها كما بدت رجاء، وهي تنساق وراء حبّها لمحمود، والعيش على ذكرى هذا الحب بعد رحيله المفاجئ، ثم تمرّد هذه المرأة على بطريركية الرجل عندما تكتشف أن زوجها عاصم قد تزوج من سمية، فتطلب الطلاق، وتعود إلى السودان، ساعية للبحث عن ذاتها بالكتابة.
الغريب أن هذه الصورة المتحرّرة على مستوى الفكر التي بدت بها رجاء بطلة الرواية، تكررت بصورة أكثر واقعية، عبر شخصية سُندس ابنة أخيها وابنتها بالتبني. فسندس كانت ترتدي الملابس القصيرة “بلوزة مشجرة وتنورة بيضاء سادة ترتفع فوق ركبتها وتكشف عن ساقيها الجميلتين” (ص، 143). فبدت “كأنها ذاهبة إلى نادي التنس″، وهو ما رفضته الأم، بأنها تخشى على سيقانها من العيون المتربّصة والعطشى. وعندما رفضت سندس هذا التقييد، برّرت الأم دفاعها بأن “بنات الناس لسن جميلات مثلك ولا سيقانهن حلوة مثل سيقانك وأنا أخاف على ابنتي من عيون الناس الوقحة والحاسدة أيضا” (ص، 144). لكن بعدما حكت لها الأم عن أمها الحقيقية “رجاء” الإثيوبية، وطلب الأم الحقيقية رؤية ابنتها قبل وفاتها، يحدث التغيير.
بالفعل تسافران لزيارتها في المستشفى، وبعد الزيارة تموت الأم. وعند العودة إلى السودان، تدخل سندس في نوبة حزن عميقة، ثم يحدث التحوّل في شخصية سندس الفتاة المرحة. فكما تروي رجاء “لم تعد سندس أبدا إلى طبيعتها المرحة اللاهية.. بدأت طباعها تتغير. أصحبت تميل إلى الصمت وإبداء الوقار والاحتشام المبالغ فيه… وكأن تجربة الأشهر الماضية قد أضافت إلى عمرها عشرات السنين. كانت تداوم على الصلاة وقراءة القرآن يوميّا، صباحا ومساء. وصارت تصوم يومين من كل أسبوع. كنت ألاحظ عناء العبادة والسهر واضحا على وجهها وبدتها، ولكنني التزمت الصمت التام وتركتها لخياراتها، وقناعاتها الذاتية”. ثم يحدث التطور الأكبر بعد أن أخبرت أمها برغبتها “في ارتداء الزي الشرعيّ، واستبدال كافة ملابسها بأخرى… فضفاضة” (ص 166).
اللافت أن ثمّة تناقضا في استخدام الحرية. فالأم كانت ترتبط بعلاقة عشق مع محمود وهي تحت إطار علاقة زوجية مع عاصم. وراحت في لندن تختلس الفرص للقائه. وقد وصل في بعضها إلى حضنها أمام الناس، وتقبيل يدها وجبهتها وفي بعضها لثم خدها. هي ذاتها الأم التي تثور عندما تكتشف علاقة الزوج بسمية، مع أنها في إطار شرعي وهو الزواج، وليس على نحو ما كانت عليه. صورة المرأة التي قدمتها بثينة خضر تأتي مناقضة لامرأة الواقع، فهذه الرفاهية والحرية اللتان تمتعت بهما شخصيات رواية أغنية النار، لا وجود لهما على أرض الواقع، ومن ثم فإما أن المؤلفة كانت تقدم صورة لنساء وواقع تحلم به. وإما أنها قدمت صورة مزيّفة عن واقع السودان الذي نعرفه جيدا، فلا يمكن أن ترتدي الفتاة البنطلون فما بالك بملابس قصيرة.
عين على الهامش
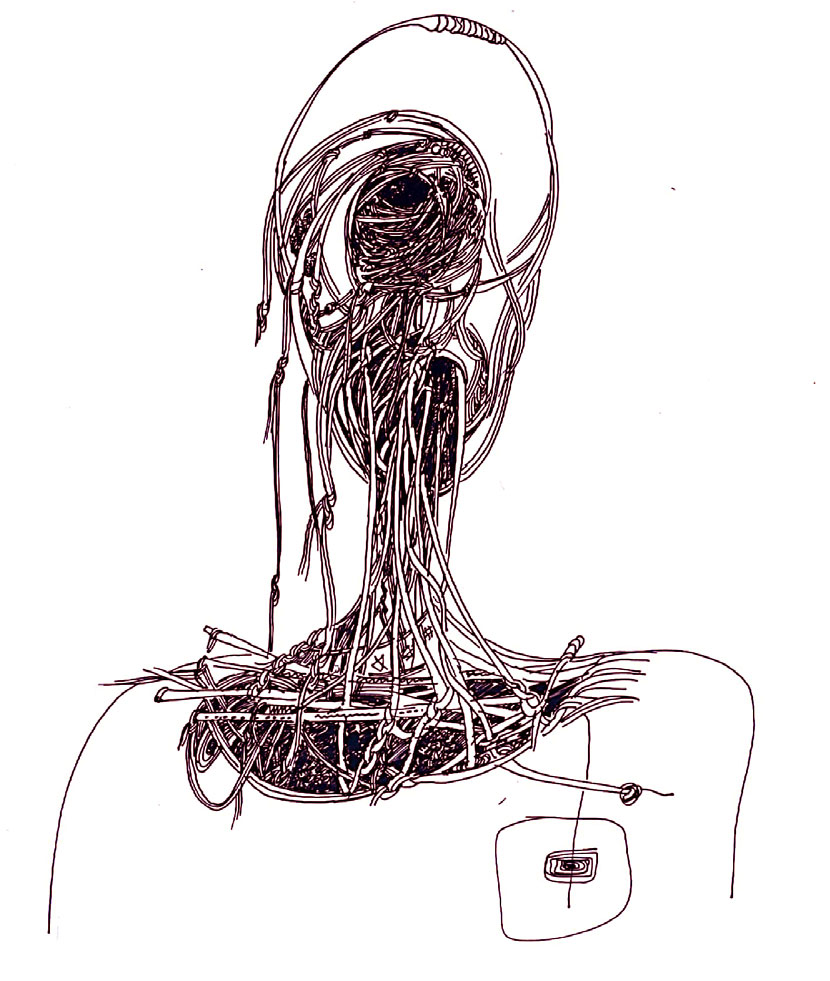
لا تقف تجربة المرأة السودانية على قضايا أنثوية مُتعلّقة بذاتها أو وضعيتها داخل المجتمع السوداني فقط. وإنما ثمّة تماس حقيقي مع مشكلات الواقع الراهن، وأزماته التي هي نتاج سياسات خاطئة. فترصّد الرواية النسوية السودانية لعوالم المهمّشين سواء المعتقلين كما في رواية ملكة الفاضل عمر “الجدران القاسية”، أو عالم أولاد الشوارع كما عند رانيا المأمون في “ابن الشمس″ (2013). وكذلك ترصّد لهؤلاء المصابين بالأمراض الفتاكة والتي تنخر المجتمع كالسوس على نحو ما أسمته سارة حمزة الجاك في رواية حملت ذات الاسم ذاته “السوس″.
وعبر هذه الرؤية تخطو الكاتبة ملكة الفاضل عمر خطوة مهمة، حيث تتبنى قضايا إنسانية ملحة عبر روايتها “الجدران القاسية”. فتقتحم عالم السجون، وما يدور بداخلها من تعذيب بوسائل بشعة يأبى العقل أن يصدقها، كما حدث مع صلاح وما تعرّض له من أبشع صنوف التعذيب على يد معتقليه، وجلاده تمساح.
فتستعرض الساردة لما تفننوا فيه من تعذيب؛ بدني ونفسي، وهو ما لا يتحمله بدن، كأن “تعذبه مخلوقات من نوع آخر كالخفافيش التي لا تظهر إلا ليلا”، أو بإرغامه على “الحبو على شظايا الزجاج المكسور”. وقد وصل مداها إلى قهر الضحية بأن “يُجبر على شرب الماء من علبة صلصة قديمة حادة الحواف”، أو إيهامه بأنه سيقتل نفسه، بعدما فشلوا في استجوابه والعثور على اعتراف منه، فتمّ تهديده بأن يلقي بنفسه في البئر العميقة، وما إن أقدم بعد تردّد وخوف من ذي قبل حتى اكتشف أن “ما ظنه بئرا لم يكن سوى حفرة لا يزيد عمقها عن بضعة أقدام” (ص، 43). فقد كان التعذيب يستهدف عقله. بهذا تقدم المؤلفة تجربة روائية عن عالم المسجونين، وما يتعرضون له من تعذيب.
اللافت أن الساردة ساوت بين زبانية التعذيب والمعذبين، فكلاهما يقيم في سجنه الخاص “حيث يعيشون في عزلة من ضميرهم وإنسانهم.. وعُزلة من عالم الناس الطبيعيين”. ومن ثمّ يَصْدُقُ عليهم الوصف بأنهم مُنْبّتون. والرواية تعد من التجارب النسائية النادرة في هذا المجال. فالكاتبة أقدمت على هذه الخطوة ليس امتثالا لرغبة التعبير عن تجربة عاشتها كإحدى المعتقلات (وهو ما لم يحدث على مستوى الواقع). وإنما جاءت تعاطفا مع المعتقلين الذين يخرجون من السجون مشوّهين نفسيّا وبدنيّا. وهو ما يؤكّد أن الرواية تجربة إنسانية في المقام الأوّل.
كما قدمت مرويات المرأة صورة مغايرة للوطن عن تلك التي كانت تراهن عليها ملكة الدار في روايتها “الفراغ العريض”. وهي صورة أشبه بـ”الحلم والوعد في المستقبل”. نفس الصورة تتكرر عند بثينة خضر مكيّ في “أغنية النار” بوطن يتسع للجميع. وهو الأمر الذي جعل من سندس ترفض أن يكون له بديل آخر حتى لو كانت تلك الجنة التي وعدها بها أبوها في كندا. وقد يكون أشبه بوطن الاختيار كما هو عند زينب بليل في “الاختيار”، حيث الأمل معقود “بناصية التعليم المجاني الذي سيصهر الطبقات” كما تقول ناهد محمد حسن. وإن كانت تختزل الصورة بالنهاية في الوطن السجن كما في “الجدران القاسية” لملكة الفاضل عمر تارة. وتارة أخرى في وطن التوابيت كما في رواية “توابيت عائمة” لسوزان كاشف.
أهمّ ما قدمته الكاتبة هو تجربة الاعتقال في إشارة إلى الالتفاف على مسار الديمقراطية، فيُلْقَى بالمحامي صلاح محمد أحمد، بعد أن اعتقله زوار الفجر من بيته في “غرفة لم يميّز فيها شيئا بسبب الظلام الحالك”. وهو الذي “أشد ما يكره الجدران” منذ أن كان صغيرا. الغريب أن صلاح لا ينتمي إلى تنظيم سياسي أو حتى صاحب مواقف مُعارضة، جريرته التي أسقطته في يد زبانية التعذيب هي أنه منذ أن تخرّج لا ينحاز إلا لقضايا الإنسان، وقلمه يراه “السلاح الأمثل للدفاع عن الحرية والعدالة”.
ظل سؤال، كيف حدث ما حدث؟، السؤال الأبرز الذي طارد صلاح وهو داخل هذه الجدران الصمّاء، وإن كان بلا إجابة! كما استطاع أن يروّض نفسه، ويستغني عن كل ما اعتاده في الماضي؛ الشاي، والاستحمام، والجلباب الأبيض وكذلك الطعام وإن اكتفى بالقليل منه. تكيّف مع كافة الأوضاع التي حلّت به “إلا هذه الجدران الصماء. لقد فشل في التسليم بها كواقع فرض عليه فرضا، وبات مجرد النظر إليها يكفي لتشتعل أعماقه غضبا” (ص، 39)، كما أن في هذه الغرفة أبى طيف زينب البقاء فيها، وقد كان الونيس له في وحدته لكن لا غرابة “فطيف تلك الهالة النورانية المحببة ما عرف أقبية الظلام ولا دهاليز الأذى” كما خاطبها في وحدته وحبسه.
في الحقيقة، لم يكن ثمّة اتهام محدّد ضدّ صلاح، فقط كان القبض عليه بمثابة ابتزاز من رجال الأمن، للوشاية ببعض الأسماء، خاصة بعض الشخصيات التي ترافع عنها صلاح من معتقلي الرأي والمعارضين، لكن أثناء التحقيق يكتشف أنه مراقب، وأن الكثير من المعلومات عن حياته وعلاقته بمن يرتبط بهم سواء أقارب أو موظفين لديه، بحوزة رجال الأمن.
يكتشف صلاح أن داخل المعتقل “لا توجد خصوصيات” كما قال الطيب له “فكل ما يخصك هو ملك لنا نحن”. كما أن التعذيب الذي تُمارسه أجهزة الدولة، وفقا لرأي الزعيم، ليس لمجرد العقاب وإنما “وسيلة للحفاظ على أمن الوطن ولو كان خصومنا في وضعنا هذا للجأوا إليه” (ص، 48). كما تقدّم الكاتبة صورة متناقضة لزبانية التعذيب، فزوج عزة الطيّب وهو رائد بجهاز الأمن، يشعر بتأنيب ضمير عندما يعود إلى البيت وابنه حمادة يتعلق به باحثا عن الحلوى التي نسيها “حيث اليوم كان حافلا بأحداث شغلت كل وقته فنسي الحلوى”، وتارة ثانية يفزع عندما يرى إظفر زوجته يُخلع بسبب جرحه، ومن ثم تسأله الزوجة: “تُرى كيف يحتمل الناس قلع أظافرهم في التعذيب؟ ده ألم فظيع″ (ص، 60) بل تحتار أكثر من رقته في تعامله مع أبنائه في البيت، وهو المكلّف بالتعذيب.
في تجربة رانيا المأمون الروائية ثمّة التفاتة إلى عالم المهمّشين، أو ما يطلق عليهم الشماسة (أو الشماشة) في السودان، فتوقف روايتها “ابن الشمس″ الصادرة عن دار العين بالقاهرة، على تجربة المشرّدين وواقعهم ومآلهم المأساوي في المدنية التي فيها “يأكل القوي الضعيف” (ص، 111)، وعالمهم الذي مثل “طاحونة تطحن كل مَن يدخل إليها دون رحمة” (ص، 136). وهو ما ينتهي بجمال في نهاية الرواية إلى رقم جثة مجهولة الهوية في المشرحة لا أحد يعلم ماذا يكون مصيرها.
تسعى هذه المقاربة النقدية وفقا لطموحها الأكبر، إلى الإجابة عن هذه الأسئلة، عبر اختبار وفحص قطاع من قطاعات الرواية السودانية ألا وهو “السرد النسوي السوداني”، تمتد من الجيل الأول وصولا إلى جيل الألفية الجديدة. واعتمدت الدراسة على مبدأ الانتخاب والفرز للنصوص، لكل ما يتصل بموضوع الدراسة. فالتزمت تنحية ما هو مكرّر على مستوى الموضوعات، واستبعاد الضعيف. آملة في الوصول إلى رؤية شبه شمولية، لا حصرية، تهدف في نهاية المطاف، إلى إبراز ملامح وخصوصية هذه المدونة السردية
أهمية رواية رانيا المأمون أنها تقدم الظاهرة بعين أنثى، على عكس التجارب السابقة. الجميل حقّا أن تعامل الكاتبة مع الظاهرة يتجاوز التعاطف إلى اعتبارها إدانة للمجتمع والظرف الاقتصادي والحروب والصراعات الإقليمية، فهم “خلاصة من خلاصات الحروب الأهلية والتدهور الاقتصادي والاجتماعي في السودان. هم ثمرة النهب المستمر للثروات وتكدسها في أيدي قلة مترفة تعيش حياة قصور السلاطين وترفهم ورفاهيتهم، وفي المقابل تفتك الأمراض والأوبئة بالسواد الأعظم من الشعب الذي يُعاني معاناة لا تخطر على بال أحد.”
ومن ثم يصير هؤلاء المشردون ضحايا استبدادية السلطة بكافة ممثليها، فـ”الحكومة جيش من الكدايس (القطط) الجعانة” (ص، 135)، وبعبارة أحد الحضور الذين شهدوا جريمة قتل الرجل في مقهى المك إن “الحصل دا كله بسبب الحكومة..أيوه، الحكومة دي ما خلّت للناس جنبة يرقدوا عليها، كرّهتهم في عيشتهم وشغلهم وخلّت الواحد مننا دايمًا زهجان وصاري وشه، لحدى وما وشوشونا اتكرفست وبقت زي الصرمة القديمة، يا أخوانا لو الحكومة دي كانت حكومة عادلة ما كنا وصلنا للحالة البطالة دي، نقتِّل في بعضنا، ونسرق من بعضنا….” (ص، 31). وقد ظهر نتاج هذه السياسة باديّا في الصور المزرية التي كانت عليها الشخصيات في المقهى؛ حيث الملابس مهترئة ومتسخة، والوجوه عابسة نافرة، والمشاكل تثار على أتفه الأسباب كهزيمة في مباراة.
تبدأ الرواية بكرم صاحب الأربعين ربيعا، الذي كان “مزاجه عدميّا” ويلعن “عمله على الدوام، ويحمّله مسؤولية عُري أيامه ويباسها” (ص، 13). يعمل حارسا للجثث وهي المهنة التي أورثها له أبوه بعد موته. وهو ما اضطره إلى ترك الدراسة مجبرا، وإن كان عزم في نفسه مواصلتها في العام الذي يليه، ولم يفعل. ثم تتحرّر الحكاية لتحكي عن المشرديْن جمال وإبراهومه، وإن كانت تتقاطع مع فواصل من حياة كرم، وتحولاتها بعد حبه لسامية، والتي تراجع الموت أمام حبه لها، وأصبح باهتا ومتلاشيّا مثل أثر الخطوط على الدرب الرملي، ثم خيانتها له بزواجها من الثري القادم من الخليح. ثم تتبع الرواية رحلة تشرد جمال وإبراهومه في الشوارع والطرقات، والنكسات التي منيا بها في رحلة خوضهما للحياة.
الشخصيات المشردة؛ جمال وإبراهومه وأبوزيد وآدامو، وكتى ويعقوب وجمعة، في الأصل مقهورة من واقعها، فمجلسها على “الأرض المبلطة بالإسمنت” (ص، 155) وملابسها هي “التراب ذاته” كما أن اليومية التي تتحصل عليها “لا تكفي”، ومن ثم تعتمد في طعامها على “الخطف لا الشراء” فأمام مدخل السينما تقف بائعات التسالي الفول المدمس والنبق، ولا حرفة لهم سوى – كما يقول جمال- أن “نخطف ونجري وتلاحقنا لعناتهن، وسبباهن وشتائمهن” (ص، 52).
كما تقدم الكاتبة سيرة حافلة بالوجع لمصير ابن الشمس جمال، وحكاية تشرّده التي بدأت منذ طفولته، وتنقّله على أعمال عديدة كصبي في مقهى سالم، ثم بائع للترمس لصالح المرأة في السوق الصغير، وصولا إلى عمله في مطعم عم محجوب. وأثناء رصدها لهذه الرحلة المأساوية التي تنتهي بفاجعة موته، هناك ترصّد لعالم مواز من الفقر والضنك، يعيشه السودان، وكأن المدينة أهداب التحديث لم تصلها أو تمسها، فالشوارع مليئة بالحفر، والسيارات قديمة متهالكة تحتاج إلى من يدفعها، وأحوال الناس المعيشية بائسة ومزرية ومن ثم يختلقون المشاكل بسهولة.
يبدو مسار الشخصيتين جمال وإبراهومه واحدا. الفارق أن إبراهومه عرف طريقه، وارتبط بفتاة من طبقته نبقة بنت حوّاية بائعة الشاي. تنتمي هي الأخرى إلى طبقة مسحوقة تسكن حي الحلة، وإن كان بدافع الحب غرّر بها، وهو ما كاد يكلفه حياته، بعد أن حملت منه الفتاة دون زواج شرعي. ومع رحلة التشرد يستقر بزواجه منها. أما جمال فنظرا لاصطدامه بطبقة أعلى منه، يطرد من عمله ويسجن فداء لصديقه، ويتم تعذيبه. يحدث الاصطدام الحقيقي بمجرد أنه فكر في الاقتراب من هذه الطبقة، بعد أن أعلن حبه لناهد بنت عم محجوب، وقد دخل به “دربا جديدا، مليئا بالأشواك والصعوبات والحواجز والجمر” (ص، 253).
ومع التغيرات التي طرأت عليهما حتى أن “أبوزيد” لم يعرف جمال عندما التقاه بعد مقتل المعلم سالم، ومازحه: “مالك بقيت تشبه أولاد الناس كده؟ سرقت ليك خزنة سمينة ولا شنو” (ص، 223)، إلا أن الماضي لم يُنسَ. فالحقيقة كما عبر عنها عمَّ محجوب أنهم “أولاد شوارع وأولاد حرام” (ص، 240). وبعد طردهم من البيت وتهديد محجوب لهم بالبوليس، يُدرك جمال أنه بالفعل تجاوز منطقته وهو يجري وراء شهوته، وأنه طرق أبواب طبقة “ترفضك حياة وموتا” كما وجه خطابه لذاته.
تتضافر عوامل كثيرة للقهر ليس فقط بسبب السلطة، أو الطبقية، وإنما سببها – أيضا – أفراد المجتمع. فالدافع من وراء سرقة جمال لقدر الفول، كان ليأسه من حالة الرفض التي جوبه بها، وهو يطلب الطعام من بائعات الأكل في السوق. وقد توسّل جمال بكافة السبل، إلا أن طلبه قوبل بالرفض مرة والمنع والمطاردة مرات عديدة. فكانت حالة الجوع والحيرة والأبواب المغلقة، سببا للسرقة. كما تتطرق الرواية إلى ما يتعرض له المهمّشون من استغلال وتحرش جنسي كما حدث مع “أبوزيد” وعلاقته المشبوهة بسالم صاحب المقهى، الذي يصيبه بعاهة بعد أن دهس بسيارته قدمه، وتنصّل من دفع حقوقه في ما بعد.
إعادة تركيب

بداية، نستطيع أن نقول باطمئنان إن وضع المرأة السودانية لم يختلف عن وضع المرأة العربية. فكلاهما جزء من تراتبيّة قمعية شمولية، كانت المرأة إحدى ضحاياها. ومن ثمّ بذلت المرأة جهدا وإن اختلف من مكان إلى آخر للظفر بحقوقها الأساسية كالتعليم والزواج وصولا إلى حقها السياسي.
الشيء الثاني الذي أكدت عليه الدراسة أن الكتابة النسوية لم تختلف في هاجسها وقضاياها التي طرحتها عن الرواية السودانية التي يكتبها الرجال بصفة عامة. وأيضا في استعارتها للتقنيات الروائية. فثمة مشتركات بعضها مشدود إلى تراث الرواية نفسه. حيث هيمنة الراوي الأنا في الكثير من الكتابات، حتى بدأت أقرب إلى الكتابة السيرية. فقد تمّ تمرير الكثير من التجارب الذاتية لبعض الكاتبات داخل المتون الروائية، على نحو ما نرى في “الفراغ العريض” لملكة الدار. فشخصية منى تكاد تتقاطع في الكثير منها مع شخصية ملك نفسها. وبالمثل بثينة خضر، مررت ذاتها الكاتبة في رواية “أغنية النار”. وعلى نفس الشيء صارت رواية “إيرات” لسوزان كاشف، حيث مررت تجربة الهجرة والاغتراب داخل الرواية، وهي ذات التجربة التي مرت بها الكاتبة، بعد لجوئها إلى لندن.
وهناك من الكاتبات مَن مرّرن سيرة غيرية على نحو ما فعلت الكاتبة ليلى أبوالعلا في روايتها “حارة المغنى… ولّى المساء”، فقد زاوجت بين الخيال والواقع، وإن غلب عليها السّرد السيري، حيث تناولت سيرة عمّها الشاعر الغنائي الراحل “حسن عوض أبوالعلا” وقد ارتبط اسمه بتأليف الكثير من الأغنيات التي تغنَّى بها عدد من المطربين السودانيين، فسردت عبر حكايتها تفاصيل حياته، وصولا إلى محنته بعد أن تعرض لحادث مأساوي في الإسكندرية بعد أن ارتطمت رأسه بصخرة أثناء ممارسته رياضة الغطس، فأصيب بشلل تام، وظلت آثار الحادثة ملازمة له حتى تاريخ وفاته في عام 1962.
كما تردّدت داخل الخطاب الروائي النسوي، ثيمات وأساليب جاءت في بعضها قديمة كالاعتماد على الحوارات بصفة مطلقة كما فعلت ملكة الفاضل في “الجدران القاسية” وإن كانت طبيعة التحقيقات التي أجريت مع صلاح بوصفه متهما، هي التي دفعت إلى غلبة الحوارات على السرد. وبالمثل غلب التداعي الحر في الكثير من الأعمال، حيث راحت الشخصيات تجتر ماضيها، وتستدعي إخفاقاتها وأيضا تسرد مأساتها، وهو ما جعل العمل يزاوج بين الغنائية والدرامية كما ظهر بصورة واضحة في “ابن الشمس″.
لم تقدّم لنا الرواية النسوية صورة لرجل مشوّهٍ، أو حتى صورة سلبية له مقابل صورة مثالية للمرأة. بل على العكس تماما جاءت صورة الرجل وفقا لسياق ثقافي ساهم إلى حد كبير في تشكيله. ومن ثم كانت شخصيته حاملة لأنساق البيئة والجماعة التي ينتمي إليها. لذا رأينا صورة السيد، الحامي المحمّل بميراث مفاهيم جماعية في نظرته للمرأة التي يجب حمايتها من الرجل حتى ولو أدّى هذا إلى حرمانها من التعليم (سارة في الفراغ العريض، وفاطمة في الجدران القاسية)، أو بممارسة حقها في العمل (منى في الفراغ العريض)، أو الجور على حقها كي لا يطال صورة الرجل الدنس (فضيلة في رواية خيانتئذ).
مالت بعض الروايات إلى شعرنة السرد حيث تم توظيف الطاقة القصوى للغة الشعرية لإدماجها في السرد. كما في نص “فُلك الغواية” لآن الصافي، فلغة السرد تميل إلى اللغة الشعرية بدلالاتها الرمزية واستعاراتها وجمالياتها الخاصة. كما تتضمن مقاطع شعرية، وإن طغى عليها النفس الصوفي والرمز. نفس الشيء نراه في “خيانتئذ” لسارة حمزة الجاك، ولنتأمل هذا المقطع: “تسلقت أهدابك القوية المتراصة هذه، سوادها أعانني على التخفي من بؤبؤ عينيك، متلصصة كنت على من يقبع داخل هذه العيون العسلية الآخاذة التي تسلب القلوب، للأمانة كانت المساحة ضيقة لكنني تسللت، وجدت رمال بنية تحيط بواحة عسل نقي، كادت أنفاسي تنقطع ويدركني العطش لولا ارتشافي رشفتين من عسل الواحة” (ص، 43) وتارة أخرى والسارد يصف بحر القلزم “طاب له المقام بين فخذيها المتباعدين بفجور غراء فرعاء مصقول عوارضها، لا تمشي لأن حياتها تنقضي إن غادرته”.
يتردد شريط لغوي حافل باللغة المحلية الدارجة، في الكثير من النصوص، وهو ما يشي بالانغماس في المحلية، وكأنه مسعى حثيث للحفاظ على الهوية السودانية من الاندثار عبر هذه اللغة المحلية، ووصف الأزياء والعادات، والطقوس الغرائبية كحفلات الزار وغيرها التي تطرّد في الكثير من النصوص.
ثمة استعارة من الكاتبات لتقنيات حديثة كالحوارية وتعدّد الأصوات، وتشظي الحدث، داخل بعض النصوص الجديدة، في تمثّل واعٍ لطرائق الكتابة الجديدة، وآليات السرد التي أفرزتها نظرية الرواية، فقد وظفت بعض الكاتبات الكثير من هذه التقنيات، وإن كان تعامل بعض الكتابات مع هذه التقنيات، تعامل المبتدئ على نحو ما نرى في رواية سارة عبدالمنعم “الملكة وصبى الأفيون” (2019) وهو ما يكشف عن هشاشة التجربة، فالكاتبة تعتمد أساليب سردية قديمة، حيث الإسهاب في الوصف، واللغة المتكلفة والحوارات الزائدة. فلنتأمل مثلا: “ولدت بلقيس في لحظة رحيل أمها سعاد. غادر أبوها البلاد. نشأت في دلال جدها إبراهيم، وعناد جدتها فاطمة. كانت طفلة شقية، وذكية، وعنيدة، وحزينة. اختبرت الحزن بسؤال أرهق طفولتها: “لماذا تركتني أمي وذهبت للسماء؟!” وكانت كلمات جدتها توقظ أحزانها لتتفاقم كلما صرخت بها “يوم أسود ذاك الذي سميت به بلقيس″. غير أن جدها لم يكن يرى فيها غير تلك الملكة الساحرة”. (ص، 18).
كما ثمة كاتبات مارسن لعبة تفتّت النهاية على وحدات النص، فبدت أشبه باستهلال للسرد، إلا أن الفكرة استمرت في معظم الوحدات، وقد كان غرضها إظهار الظلم الذي وقعت فيه شخصية فضيلة، في رواية خيانتئذ، إلا أن الإلحاح أضعف الهدف، وأصاب القارئ بالفتور، وتجاوزها إلى الوحدة الجديدة.
لم تبعد الروايات عن حاضرها، بل كانت ملتبسة به، متشابكة مع أزماته وصراعاته ومتغيراته التي انعكست على المجتمع، ومن ثمّ لا نجد ارتدادات للماضي أو أزمنة قديمة؛ حيث الحاضر هو البارز والطاغي، وإن كان ثمة ارتدادات زمنية فلا تتجاوز التاريخ الشخصي للبطل، باستثناء رواية “خيانتئذ” التي ارتد الزمن نسبيّا إلى الماضي حيث حقبة التاريخ الإسلامي، والسيطرة على ميناء سواكن وقصة زواج هارون الرشيد من ابنة سواكن. ما عدا ذلك فالحاضر هو المهيمن. الغريب أن المستقبل بأحلامه ورؤاه غائب تماما، كأن فقدان الثقة في الحاضر، خيّب الآمال في المستقبل. وهو ما ينصّ عن خيبة مطلقة في الحاضر.




