تغريد خارج السرب
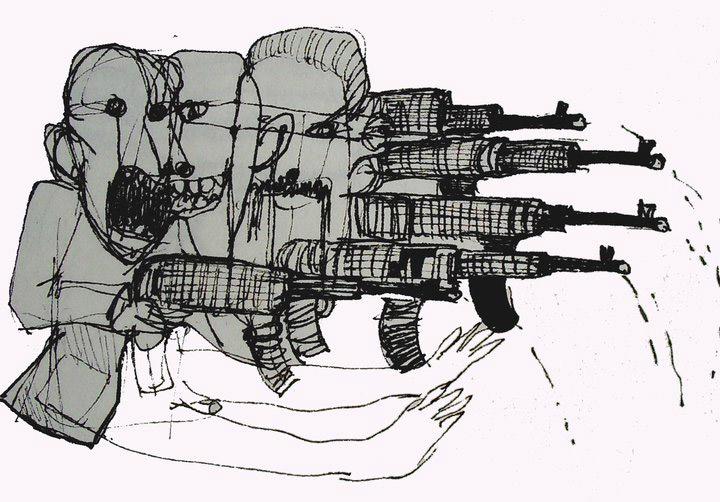
من المناسب الإشارة إلى أن الرواية البوليسية شأنها شأن كل منتج تجاري له قيمة استهلاكية أكثر مما له قيمة إبداعية واعتبارية أخرى. فهي تقرأ في جلسة واحدة أو جلستين على الأكثر، وتُنسى بعد فترة قصيرة من معرفة حلِّ عُقْدَة الجريمة ووصول المحقق إلى الجاني والقبض عليه.
وتعتمد الرواية البوليسية بناء تركيبياً معقداً يتم تفريقه في فصول ومشاهد بقلم كاتب متمرّس بهذا النوع من الكتابة، معتمداً على ثلاثية متكررة (الجريمة وتفاصيل حدوثها ــ التحقيق وما يتضمنه من ملابسات ــ وحل ألغاز الجريمة والقبض على الجاني).
وهي عادة تكتب لقارئ مرفّه لا يعاني من بحث عن حلول لمشاكل اجتماعية يعاني منها كفرد يومياً، وتنطبق مواصفات القارئ المرفّه في وطننا العربي على فئة قليلة من المجتمع، وتضاف إليها فئة المراهقين كمرفّهين من نوع آخر يعيشون على مكابدات الأب والأم والعائلة. وهم في العادة لا شأن لهم بما يحصل في العالم الواقعي من حولهم من منغصات الفقر وفقدان الحرية وقلة الفرص المتاحة للحياة الاجتماعية الكريمة إلا فيما ندر.
لغة بلا فخامة
الكاتب العربي الذي يبحث عادة عن مجد أدبي في كتابة راوية وقصة ومسرحية وقصيدة، من خلال لغة فخمة، محملة بأفكار فلسفية معمقة، والبحث النفسي الجاد في المشاعر الإنسانية يجعله كل ذلك مبتعداً عن فكرة كتابة رواية بوليسية، لأنه يجدها لا تليق بالمقام الذي ينوي إشادته لنفسه بين الكتاب في العالم.
وبالرغم من أن معظم الكتاب العرب قرأوا الكثير من هذا النوع من القصص والروايات في فتوتهم المبكرة، وأعجبوا بها غاية الإعجاب، وتبادلوها مع غيرهم من الكتاب لكنهم في قرارة أنفسهم يرون أن لغتها بلا فخامة، فهي مكتوبة بلغة صحفية، مؤدية لتوصيل الحدث فقط، ولا قيمة جمالية فيها، ولا تترك أثراً طويلاً في ذاكرة القارئ.
ولذلك فقد كتب نجيب محفوظ روايته” اللص والكلاب” بالرغم من ثيمتها البوليسية، وانطباق مواصفات الرواية البوليسية عليها (الجريمة ــ التحقيق، الذي لا يدور في غرف ضباط الشرطة بل بما تنشره الصحافة من أخبار المجرم ــ والبحث عنه كسفَّاح مؤدلج، ومحاصرته وقتله) بلغة أدبية تؤاخي بين اللغة الصحفية ولغة الأدب بما يحمله الإرث الأدبي العربي من ثيمات الوصف ورسم الشخصيات وقراءة الوعي وكتابة الحوار الفكري المعمق حول فكرة الجريمة والأدلجة السياسية التي تربط بين توزيع الثروات في المجتمع وطرق استعادتها بالعمل الفردي الفوضوي أو بالثورة الجماعية للذين سُلبتْ فرصهم في الحياة الكريمة وبالمفردات المتعارف عليها في المجتمع الذي تسود فيه طبقة على أخرى في المجتمع، فتوظف القانون والجيش والشرطة لحماية مصالحها وحماية أفرادها من بطش أولئك المُستلَبين.
أجاثا كريستي
لسنا هنا بصدد تحليل ما كُتب في”اللص والكلاب” بل في وصف الحالة الناجحة التي يستطيع من خلالها الكاتب العربي كتابة رواية بوليسية ويحتفظ بفكرته المعنوية عن نفسه بأنه كاتب عربي مرموق، وليس كاتباً لجنس آخر لا يمتّ إلى الأثر الأدبي العربي بصلة، بل يعود بحيثياته إلى نوع من الكتابة القصصية التي كتبها قبله كتاب غربيون كإدغار آلان بو وكتابته لرواية “جرائم شارع مورغ” (العام 1841) والكاتب الأيرلندي برام ستوكر بروايته “دراكولا” (العام 1847) والبرازيلي باولو كويلوب “الخيميائي” (1947)، ودوروثي سايرز (1957) ودان بروان بـ”شفرة دافنشي” (1964) وأجاثا كريستي في العديد من رواياتها المشهورة كـ”جريمة في قطار الشرق السريع″ (1934)، و”جريمة في بلاد الرافدين” (1936) و”موت فوق النيل” (1937). وتعدّ كريستي الكاتبة الأولى في العالم لهذا النوع من الأدب الروائي الذي بدأت بكتابته منذ العام 1920 وحتى وفاتها في يناير العام 1976.
ازدهار الرواية والقصة البوليسية في العالم الغربي يعود إلى أنه متناغم مع حياة الناس هناك، وشجّع على ذلك نوع الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي يعيشها الفرد الغربي.
صعوبات الكتابة
تختلف الظروف التي يعيشها الفرد العربي في بلدانه من نواح عديدة من بينها حياة الكفاف التي يعيشها أغلب محبي القراءة، وبحثهم عن الكتاب المفيد إفادة فكرية وذوقية، وعدم اختيار المسلّي الذي لا يُغني ملكاتهم الفكرية واللغوية. إضافة إلى ذلك اتّقاء الكُتَّاب والمعنيون بالرواية البوليسية للشرور المحتملة من الشرطة والأجهزة الأمنية في حالة نقدهم لها من خلال نسيج العمل الروائي المقترح.
فهناك الكثير من الشكوك والمضايقات التي يتعرض لها أيّ كاتب عربي ينوي معرفة ما يدور في مراكز الشرطة والمراكز الأمنية من أساليب تحقيق، أو لمن يحاول منهم معرفة قصص المسجونين أو أحوالهم قبل ارتكاب جرائمهم وما يفكرون به في سجونهم.
وتختلف كذلك وسائل التحقيق لدى المحقق الغربي مع المتهمين عمّا يفعله المحقق العربي مع المتهم المعروض أمامه من وسائل قهر وتعذيب وحرمان من أبسط الحقوق في الفترة التي لا يزال فيها المعتقل متهماً فقط ولم يثبت عليه الجرم بعد.
وبالرغم من العوائق التي ذكرناها والتي لا تساعد الكاتب العربي في كتابة رواية أو قصة بوليسية إلا أن بعض الكتاب العرب استطاعوا أن يخوضوا التجربة من خلال قلب المعادلة وجعلها في صالحهم وذلك من خلال عدم التعرض للأجهزة الأمنية، وما يتعرض له المواطن العربي من إهانة وتعذيب لانتزاع الاعترافات منه. وفي بعض الأحيان يعترف بجرائم لم يرتكبها خلاصاً من التعذيب الذي تعرض له.
روايات عربية
على سبيل المثال استطاع الكاتب المصري صالح مرسي بذكاء فطري الخلاص من كل تلك المعوقات مرة واحدة بالكتابة عن النشاط الاستخباراتي لأجهزة الدولة وتمجيدها في مصر لدورها الوطني في صراعها مع إسرائيل، فكتب “رأفت الهجان” (1978) و”الحفّار” وغيرهما من الروايات وهي تحمل ثيمات الرواية البوليسية، لكنها تناقش موضوعاً وطنياً. وهذا ما جعل كاتبها في مصاف المدافعين عن السلطة السياسية بشكل غير مباشر، فالعمل يشيد بوطنيتها في دفاعها عن بلادها.
وكتب الكاتبان المغربيان ميلودي حمدوشي وعبد الإله الحمدوشي “الحوت الأعمى” التي صدرت في العام 1997 وفي هذه السنة بالذات بدأت مرحلة جديدة من تاريخ المغرب في فترة سنوات حكم الراحل الملك الحسن الثاني (1929ــ 1999) ، وهي بحق من أفضل سنوات الانفتاح على حقوق الإنسان في المغرب. ممّا شجع الكاتبين على كتابة هذا اللون الأدبي بحرية ومن دون محاذير، إضافة إلى عمل الحمدوشين كرجلي شرطة وهو ما جعل هذا الأمر بالنسبة إليهما كصمام أمان ساعدهما أثناء الكتابة على معرفة ما يضرُّ الجهاز الذي عملا فيه أو لا يضرُّه، فتجنبا الكتابة عن كل ما يضرّ وأبقيا ما ينفع الجهاز فكتبا ونشرا براحة بال.
وفي الجزائر كتبت نسيمة بولوفة روايتها “نبضات آخر الليل” العام 2014 مستمدة طرائق كتابة الرواية البوليسية، محاذرة في طرحها المسّ بطرائق التحقيق مع المجرمين.
وفي تونس كتب كمال الرياحي روايته “عشيقات النذل” العام 2015، مستفيداً من أجواء الحرية والانفتاح المجتمعي بتونس بعد الثورة الشعبية، فيما سمّي بالربيع العربي، وتخلخل القبضة الأمنية المتزمتة السابقة على التونسيين، مما أتاح الفرصة للرياحي للكتابة بحرية عن مجتمع طبقي تتشوه فيه العلاقات الإنسانية وتشتد الصراعات، فتحدث السرقة والرشوة والقتل. وتحقيق كاتب السيناريو، الذي يقود بدوره إلى عذابات إضافية، كمقتل سارة الفتاة العشرينية، الذي يفجر الكثير من الأسئلة، عمّن قتل هذه الفتاة؟ ولماذا قتلها؟
التغريد خارج السرب
الرواية البوليسية العربية تُكتب ولكن لا يضمن كاتبها النجاح لها في واقع بوليسي قلق وغير مستقر. وذلك راجع لما يراه المواطن العربي يومياً من موت وقتل على الهوية وتعذيب على شاشات الفضائيات وما يسمعه من فظائع عن الكثير من المركز الأمنية التي تقبع في الظل في الكثير من الدول العربية، ولا يعرف أحد بوجودها، فهي عادة تختفي خلف مسميات عديدة وأرقام سرية ورموز غامضة.
كذلك لا يجد الكاتب دائماً الجرأة في الكتابة عما يحصل في الزنازين المظلمة، كما أنه لا يُسمح له بالاطّلاع على ملفات الحوادث الغامضة والجرائم في مراكز الشرطة والأمن. وتحاول السلطات الأمنية حجب تلك المعلومات الأمنية عن الرأي العام. كما أن الكاتب العربي لا يستطيع إدهاش قارئه بالجديد لأن الواقع حوله أكثر إدهاشاً للناس من أيّ كتابة عن جريمة لفرد ما.
هذا النوع من الروايات والقص في البلاد العربية يغرّد خارج السِّرْب، فهو يكتب بالأساس لقارئ يبحث عن التسلية والمتعة والدهشة، وحل الألغاز، لقارئ لا يحمل هُمُوم معيشته أو همَّ البحث عن وظيفة، ولا يعرف ما سيحل به أو أحد أفراد عائلته في الغد. ولذلك فلا غرابة في أيّ فشل يصادفه كتَّاب هذا النوع من الأدب إلا إذا توفّرت موهبة جديدة، كبيرة، كموهبة نجيب محفوظ أو صالح مرسي أو غيرهما في وطن معافى يُحترم فيه الفرد ويُعتبر الرقم الأهمّ في جميع المعادلات.




