شرخٌ في صَرح
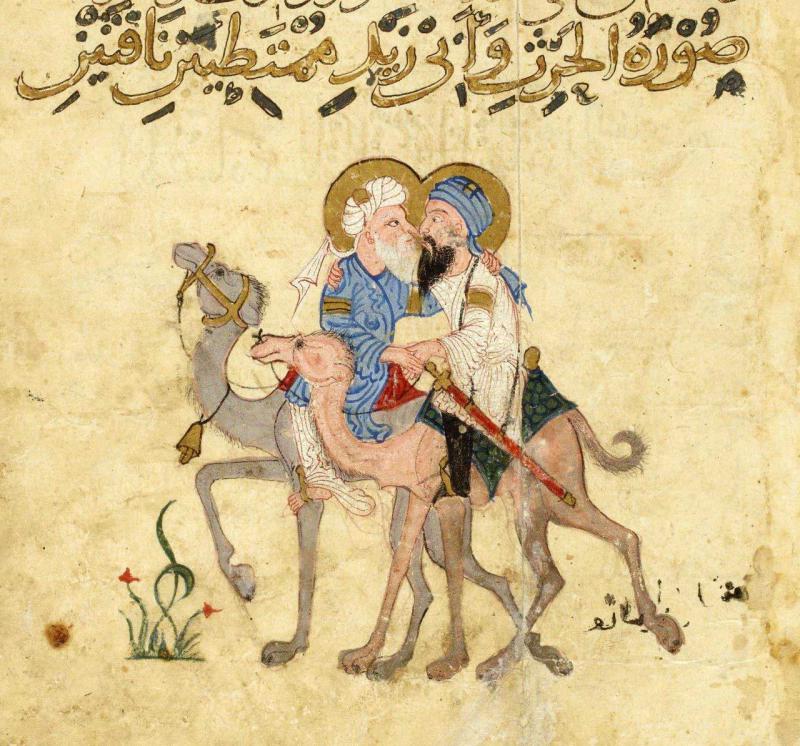
ما جدوى إعادة ترجمة الآثار الأدبية؟ هل مردّ ذلك إلى أن الترجمات السابقة لم تكن دقيقة ولا وفية، وأن أصحابها حادوا بها عن أصولها، فشوهوها عن عمد أو جهل؟ أم أن قراءة النص المترجم لم تعد هي نفسها، والمعلوم أن الترجمة قراءة مرتبطة بلحظتها، تختلف باختلاف زمنها، وأن قراءتنا لعمل ما بعد أعوام هي قراءة مختلفة بالضرورة، ومن هنا جاءت مشروعية إعادة الترجمة؟
راودتنا تلك الأسئلة، مع كثير غيرها، ونحن نطالع كتاب “ديوان الشعر العربي الكلاسيكي”، الذي جمع مادته ووضع مقدمته أدونيس، وتعاون على ترجمته إلى الفرنسية مع حورية عبدالواحد. ولا ضير في ذلك، في رأي لفيف من النقاد، فرغم وجود ترجمات ممتازة للشعر العربي، تظل إعادة الترجمة جائزة، لأن الترجمات كما يقول الفرنسي أنطوان بيرمان يصيبها الهرم.
مدخل ثان
منذ العصور القديمة، أقرّ كتاب ونقاد كبار بأن ترجمة الشعر عسيرة إن لم تكن مستحيلة، فقد جاء في “كتاب الحيوان” قول الجاحظ “والشعر لا يُستطاع أن يترجَم، ولا يجوز عليه النقل؛ ومتى حوِّل تقطَّع نظمُه وبطلَ وزنُه، وذهب حسنُه وسقطَ موضعُ التعجب، لا كالكلامِ المنثور. والكلامُ المنثور المبتدأُ على ذلك أحسنُ وأوقعُ من المنثور الذي تحوّل من موزون الشعر”. أما دانتي فقد كتب يقول في “المأدبة”: “لا شيء من تلك الأشياء التي وضعت متناسقة برابط الشعر يمكن أن ينتقل من لغته إلى لغة أخرى دون أن يقطع رقته وتناسقه، ولذلك ينبغي ألا يُنقَل هوميروس من اليونانية إلى اللاتينية”.
ورغم أن عددا كبيرا ممّن ترجموا الشعر في شتى اللغات على مرّ العصور أثبتوا خطل الرأي القائل باستحالة ترجمة الشعر، فإن ما ذهب إليه الجاحظ ودانتي من جهة تَقطُّع النظم وذهاب الحسن وسقوط موضع التعجب وانقطاع الرقة والتناسق لا يزال في رأينا المتواضع ساري المفعول، لأن لكل ثقافة مقوماتها، ولكل شعر ميزاته، وحسبنا أن نغيّر موضع لفظة، تقديما أو تأخيرا، حتى يفقد البيت الشعري بيانه. ثم لا يكفي أن تحذق لغة الأصل ولغة الهدف إن لم تكن عارفا بالخلفيات الثقافية لكلتيهما، فما يصح في هذا الطرف لا يصح بالضرورة في الطرف المقابل، حتى من حيث البحور والأوزان. فعندما ترجم تيوفيل غوتيي “الليالي المصرية” لبوشكين حولها إلى قصيد كلاسيكي… ولما ترجمت مدام دو ستاييل قصيدة غوته “الصياد” ذات النبرة الدرامية حولتها إلى ما يشبه خرافة من خرافات القرن الثامن عشر.
فلننظر في الكتاب الذي بين يدينا، وعلى رأي أمبرتو إيكو “إن لم نكن قادرين على أن نقول ما هو خير تأويل للنص، فإننا يمكن أن نقول أيّ التأويلات خاطئة”.
في منهجية الكتاب
اشتمل الكتاب على مقدمة وضعها أدونيس (وتولت ترجمتها إلى الفرنسية حورية عبدالواحد) توقف فيها عند المحطات الكبرى في الشعر العربي الكلاسيكي، مركّزا على ما حفل به من صراعات على مرّ العصور بين التقليد والتجديد، بين السائر على خطى الأوائل يجعلهم منارا يهتدي على ضوئه، وبين الساعي إلى التمرد على الواقع لخلق قيم جديدة، معيارية كانت أم جمالية. ثم جاء متن الكتاب موزعا إلى ثلاثة أقسام: العصر الجاهلي والأموي-العصر العباسي- العصر ما بعد العباسي. عقبها تعريف بيوغرافي مختصر بالشعراء المترجَمين، وفهرسٌ بأسمائهم.
الترجمة فهم وتأويل
أول ما يلاحظ في هذا المتن غياب مفهوم طبقات الشعراء الذي عرفه العرب، فلا فضل لمتقدم على متأخر، يستوي الفحول بأصحاب البيت الواحد والقصيد اليتيم، بل قد تغيب قصائد بعض شعراء المعلقات كعمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة والنابغة الذبياني، ويدرج قصيد لأعرابية نكرة. وقد يحتفى بشاعر من شعراء الكدية هو أبو الشمقمق ولا نجد لعنترة العبسي سوى قصيد ذي بيتين: “أُحِبُّكِ يا ظَلومُ فَأَنتِ عِندي/مَكانَ الرّوحِ مِن جَسَدِ الجَبان | وَلَو أَنّي أَقولُ مَكانَ روحي/خَشيتُ عَلَيكِ بادِرَةَ الطِّعانِ”. أو يدرج بيت لقس بن ساعدة الذي عرف كخطيب وحكيم، ويغفل عن ذكر الشنفرى وتأبط شرّا وعبيد بن الأبرص وابن هانئ وابن خفاجة والمعتمد بن عبّاد ولسان الدين بن الخطيب…
قد نجد العذر للمترجم في أن العملية اختيار، والاختيار يغدو ذاتيا إذا توافر العرض، وهو في المدوّنة العربية من الوفرة بمكان، وإن خانه التوفيق في أكثر من موضع، فقد أورد مثلا قصيدا للشاعر الأموي الرقيق عروة بن أذينة “قالَتْ وَأَبْثَثْتُهَا سِرِّي فَبُحْتُ بِهِ/قَدْ كُنْتَ عِنْدِي تُحِبُّ السِّتْرَ فَاسْتَتِرِ| أَلَسْتَ تُبْصِرُ مَنْ حَوْلِي؟ فَقُلْتُ لَهَا/غَطِّي هَوَاكِ وَمَا أَلْقَى عَلَى بَصَرِي”، في حين أن لعروة هذا قصيدًا آخر من تسعة أبيات لا يذكر إلا به، وطالعه “إنَّ التي زَعَمَتْ فُؤَادَكَ مَلَّها/خلقت هواكَ كما خلقتَ هوًى لها”، ويقول فيه “بَيْضاءُ باكَرها النّعيمُ فَصاغَها/بلباقَة فأَدَقَّها وأَجَلَّها | لَمَّا عَرَضْتُ مُسَلِّماً لِيَ حاجَةٌ/أرجو معونتها وأخشى ذلّها | حجبت تحيَّتها فقلتُ لصاحبي/ما كان أكثرَها لنا وأقلّها | فدنا فقال: لعلّها معذورةٌ/من أَجْلِ رِقَّتِها، فَقُلْتُ لَعَلَّها”.
ونقول، رغم ذلك، إنها مسألة ذوق، والأذواق كما يقول الفرنسيون مسألة شخصية لا تقبل النقاش. ولكن كيف نفسر التدمير الممنهج لأغلب القصائد المختارة، حيث يستلّ المترجم الأبيات كيفما اتفق، فيلغي ما يشاء ويبقي ما يشاء. ومن الأمثلة على ذلك حذف نصف أبيات قصيدة أبي الشمقمق التي طالعها ” بَرَزْتُ منَ المنازِلِ والقِبَاب/فلم يَعْسُرْ على أَحَدٍ حِجَابِي”، ولم يحتفظ سوى بأربعة أبيات من قصيد أبي فراس “أَما لِجَميلٍ عِندَكُنَّ ثَوابُ/وَلا لِمُسيءٍ عِندَكُنَّ مَتابُ” الذي يعدّ خمسة وأربعين بيتا، بل حدث أن اختار هذا القصيد لفارس بني حمدان “ما لِعَبيدِ مِنَ الَّذي /يَقضي بِهِ اللَهُ اِمتِناعُ | ذُدتُ الأُسودَ عَنِ الفَرا/ئِسِ ثُمَّ تَفرِسُني الضّباعُ” فألغى البيت الأول وأبقى على البيت الثاني. أو يقنع أيضا بالبيت الأخير من قصيد من ثمانية أبيات لأبي دهبل الجُمحي وطالعه “سقى الله جازانًا فمن حَلَّ وَلْـيَه/فكلَّ فَسيلٍ من سَهام وسُـرْدُد”.
في ثمانينات القرن الماضي، اهتم عالم اللسانيات الروسي إيفيم إيتكيند بمشاكل الترجمة، وألّف حولها كتابا صنف فيه الترجمات الشعرية إلى أنماط تبدأ من الترجمة-الإخبار، إلى الترجمة-المحاكاة، مرورا بالترجمة- التأويل، والترجمة-التلميح، والترجمة-التقريب، والترجمة-إعادة الخلق، ليؤكد الآلية التي صار يخضع لها فعل الترجمة، ومن مخاطرها مثلا تجاهل وحدة القصيد التي لا تقبل البتر. فالمترجم في واقع الحال، ناب عن الشاعر في تخيّر ما يجدر بقاؤه ونشره للناس، ومحو ما عدا ذلك، هذا فضلا عن عدم احترام ترتيب الأبيات كما في معلقة امرئ القيس، فقد جاء عجز البيت الخامس عشر “وَلا تُبْعِدِيني مِنْ جَنَاكِ اُلْمعَلَّلِ” بعد البيت التاسع عشر “أَفاطِمَ مَهْلاً بَعْضَ هذا التَّدَلّلِ/وَإِنْ كنتِ قد أَزْمعْتِ صَرْمي فأَجْمِلي”.
وتلك هي الملاحظة الثانية.
أما الملاحظة الثالثة فتخصّ فعل الترجمة نفسه. وهنا نستحضر ابن عمّنا الجاحظ حين يقول “ولا بدّ للترجمان من أن يكون بيانُه في نفس الترجمة، في وزن علمه في نفس المعرفة، وينبغي أن يكون أعلمَ الناس باللغة المنقولة والمنقول إليها، حتى يكون فيهما سواءً وغاية”. فقد وقفنا على أخطاء لا يرتكبها حتى المبتدئون، وحسبنا أن نقرأ الأمثلة التالية لنتأكد من مدى الإخلال بهذه القاعدة الأساسية التي لا يكون المترجم مترجما إلا بها.
جاءت ترجمة البيت العاشر من قصيد أبي فراس “أما لجميلٍ عندكنّ ثوابُ”: “وَقورٌ وَأَحداثُ الزّمانِ تَنوشُني/وَلِلمَوتِ حَوْلي جيئَةٌ وَذَهابُ” كالتالي:
Je reste sobre bien que les événements me dévorent / Et la mort devant moi ne cesse de passer.
فقد وضع sobre مقابل وقور، والصواب digne, décent لأن sobre معناها قانع، زاهد، معتدل، رصين… وترجم “حولي” بـ “أمامي” devant moi بدل autour de moi. ولو عرّبنا الترجمة لكان لنا ما يلي: “أظل قانعا رغم أن الأحداث تنهشني، والموت أمامي لا يكف عن المرور”.
كذلك البيت الثاني عشر من القصيد نفسه “بِمَن يَثِقُ الإِنسانُ فيما يَنوبُهُ/وَمِن أَينَ لِلحُرِّ الكَريمِ صِحابُ” فقد ترجم كما يلي:
En des temps cruels l’homme rencontre-t-il un appui؟
وتعني حرفيا: في الأوقات العصيبة هل يصادف الإنسان سندًا؟ فاختفت “بمن يثق”، “ومن أين،” و”للحُرّ الكريم”، وتحول “الصحاب” إلى سند، هكذا في المطلق.
أو البيت الثاني والثلاثون من قصيد أراك عصيّ الدمع “وَيا رُبَّ دارٍ لَم تَخَفني مَنيعَةٍ/طَلَعتُ عَلَيها بِالرَدى أَنا وَالفَجرُ” فقد حلت عبارة dès l’aube “منذ الفجر” في موضع “أنا والفجر”:
Des demeures inaccessibles ne m’ont pas effrayé / Mortellement, dès l’aube je les ai attaquées.
والغريب أن عدم الإلمام هذا ليس مقصورا على لغة الآخر، بل شمل أيضا اللغة العربية، حتى لنشكّ صراحة أن أدونيس هو من ترجم هذه المختارات، وأغلب الظن أنه عهد بما اختاره إلى زميلته وائتمنها عليه، ثم وقّع على ما أنجزت دون مراجعة. فالجميع يعرف أن الهودج غير الخدر، والبرنس غير المرط، وعبارة “وليل” في قول امرئ القيس “وليلٍ كموج البحر” ليست منادى كما وردت هنا مترجمة Ô nuit!، ومن عجب ألا يتفطن إليها المترجم وهو ينقل قول امرئ القيس في البيت الموالي “فقلتُ له لمّا تَمَطَّى بصُلْبِهِ”. وليس من المعقول أن أدونيس لا يفهم معنى البيت التالي “تَغابَيتُ عَن قَومي فَظَنّوا غَباوَةً/بِمَفرِقِ أَغبانا حَصىً وَتُرابُ” ليترجمه على النحو التالي:
Auprès de mes gens qui m’ont cru j’ai joué au niais./ Que sur l’ignorant s’abattent terre et cailloux.
ما يعني حرفيا “قرب أهلي الذين صدقوني تغابيت/ فلينهلّ على الجاهل ترابٌ وحصى”. وكأن عجز البيت هنا دعاء والحال أنه جملة إخبارية، تقول ببساطة إن الجاهل هو من في مفرق رأسه حصى وتراب، ولا ندري ما ضرورة تسبيق الحصى هنا، ولا ابتداع فعل لا وجود له في الأصل.
ولا معنى البيت الأخير من قصيد أبي دهبل الجمحي آنف الذكر “فأصبَحتُ مِمّا كانَ بَيني وبَـيْنـَهـا/سِوى ذِكْرِها، كالْقابِضِ الماءَ بالـيَدِ”، كي يترجمه كما يلي:
Hormis son souvenir, je devins / Semblable à celui qui tient l’eau par la main.
أي “باستثناء ذِكرها، صرتُ شبيهًا بمن يمسك الماء بيده”. فقد تغاضى عن “مِمّا كان بيني وبينها”، وغاب عنه أن المقصود بـ”أصبحتُ” هنا أتى عليّ الصبح، جاء في اللسان: “يقال أَصْبَحَ الرجل إِذا دخل في الصُّبْح”. وليس المعنى هنا “صرتُ” أو “تحوّلتُ”.
ولا يعقل ألا يعرف اسم الفاعل من انبجس في البيت التالي “سَقى ثَرى حَلَبٍ، ما دُمتَ ساكِنَها / يا بَدرُ، غَيْثانِ مُنهَلٌّ وَمُنبَجِسُ”، أي متساقط من السّماء، ومتفجّر من باطن الأرض، ولا ندري من أين فهم أن المقصود le don de l’ami (هبة الصديق)، فضلا عن الفاعل المستتر في عبارة il existe (يوجد) الذي سمح لنفسه بإضافته دون مبرر والحال أن الفاعل هنا بيّن (غَيْثانِ، مثنّى غَيْث)، كما جاء في ترجمته:
Que soit arrosée la terre d’Alep tant que tu y demeures / Ô lune, il existe deux pluies : celle qui tombe et le don de l’ami.
كما لا يعقل ألا يفرّق بين “نعم” و”بلى”، على غرار من تداولوا على تلحين قصيد “أراك عصيّ الدمع″، من عبده الحامولي إلى رياض السنباطي، مرورا بالشيخ زكريا أحمد. ولسنا في حاجة إلى تذكيره بأن “بلى” حرف يُجاب به عن سؤال منفيٍّ فيُبْطِل نَفْيَه. قال تعالى “أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى (الأعراف -172). فقال ابن عباس معلّقًا، لو قالوا “نَعَم” لكفروا. أما عبارة certes التي استعملها فتعني “بالتأكيد، طبعا، حقًّا، أجل…” أي عكس ما عناه الشاعر في قصيدته العصماء التي رسختها أم كلثوم في الأذهان، وعَثا فيها أدونيس والتي معه فسادا حتى صارت كالثوب المقدد، إذ أهملا منها سبعة وثلاثين بيتا من جملة أربعة وخمسين، وحولاها إلى كلام منثور خال تماما من إيقاع الشعر.
وحسب القارئ أن يقارن ترجمة هذين البيتين “أَراكَ عَصِيَّ الدَمعِ شيمَتُكَ الصّبرُ/أَما لِلهَوى نَهيٌ عَلَيكَ وَلا أَمرُ | بَلى أَنا مُشتاقٌ وَعِندِيَ لَوعَةٌ/وَلَكِنَّ مِثلي لا يُذاعُ لَهُ سِرُّ” في الصيغة التي وردت في هذا الكتاب:
Je te vois ravaler tes larmes et t’enorgueillir de patience, / Le règne de l’amour n’a-t-il pu de toi triompher ? / Certes, je suis dans la nostalgie et vis dans l’angoisse du tourment, / Toutefois le secret d’une personne comme moi ne peut être divulgué.
وفي صيغة أخرى وضعتها كاتيا زكريا من جامعة ليون:
Je te vois, les larmes rebelles, la constance pour qualité, / La passion amoureuse n’a-t-elle point de pouvoir sur toi ?/ Mais si ! J’ai des passions et des tourments / Mais, un homme comme moi ne peut divulguer son secret.
ومن نافلة القول إن الشوق غير النوستالجيا، وإن الشيمة لا يقابلها التفاخر، وإن عبارة ravaler لا تعني حبس الدموع rétention des larmes ولا كفكفتها، بل هي تعني “بلع أو ابتلع مرة ثانية” مثلما تعني التمليط والتجصيص، وإن الصدر (دون العالمين) الذي عناه الشاعر في قوله “وَنَحنُ أُناسٌ لا تَوَسُّطَ عِندَنا/لَنا الصّدرُ دونَ العالَمينَ أَوِ القَبرُ”، ليس المراد منه البحث عن دوام “البرستيج” كما زعم المترجم:
Du juste milieu nous sommes dépourvus, / Nous recherchons l’exclusivité du prestige ou le tombeau.
وكان عليه أن يترجمها مثلا كالتالي:
Nous ne reconnaissons pas le juste milieu / Nous avons la prééminence sur tout le monde ou le tombeau.
فهل نستجير ببول ريكور حين شبه مهمة المترجم بـ “عمل حِداد”، يتولى فيه إنقاذ ما أمكن إنقاذه ويقبل بضياع الباقي، والحال أن الباقي نفسه لا يستقيم، لا من جهة المحافظة على متانة اللغة الشعرية، ولا من جهة ضمان القيمة الجمالية للمؤثرات الصوتية، وهما في رأي الفيلسوف الفرنسي أسمى ما تطمح إليه ترجمة الشعر.
في نقد الترجمة

تقول كاتارينا رايس في كتابها “نقد الترجمات” إنّ أيّ نقد للترجمات ينبغي أن يستند في الوقت ذاته إلى النص الهدف والنص المصدر، من خلال وضع تصنيف للنصوص المترجمة، لأنها ستكيف تحليل الاستراتيجيات الترجمية الخاصة بكل صنف. بتلك الطريقة ميزت رايس بين النصوص الإخبارية والنصوص التعبيرية، وبين النصوص التحريضية والنصوص الخطية السمعية… حيث كل صنف محكوم بشروط مخصوصة، لسانية وبراغماتية.
والشعر، الذي يعد من النصوص التعبيرية، يستدعي عند الترجمة الحصول على نفس الأثر الجمالي الموجود في الأصل، لا سيما إذا كان المترجم هو نفسه شاعرا، لأن الكفاءة الخاصة التي يتمتع بها كائن ذو طبع فني متأتية من إحساس مرهف بالقيم الفنية والجمالية. والتصورات الفنية والمبادئ الجمالية لهذا الكائن غالبا ما تتبدّى في الشكل الذي يمنحه لـ”ترجمته”. وفي رأيها أنه لا يمكن للناقد أن يحاسب تلك الترجمة ويحكم عليها بكونها “خاطئة” أو “غير مجدية”، حتى وإن قدمت له المقارنة بين الأصل والنص المترجم حججًا وذرائع، لأن مهمة الناقد في نظرها إنما تتمثل في إبراز “المزاج الفني” للمؤلف ونظيره لدى المترجم وتَبيان آثارهما على الصيغة الهدف، أي أن الشاعر الذي يتحول إلى مترجم لا يمكن أن يترجم إلا بالكيفية التي يحس بها أنه مدفوع لقول الشعر، فهو لا يعيد إنتاج آثار فنية، بل يجيب الصوت الذي لامسه من خلال صدى عفوي، ويجيب ردّا على الصورة التي تتراءى له من خلال المشروع الذي يصنعه.
ولكن ما الحيلة يا مدام فايس حين يعجز شاعر عن تمثّل معنى قصيد بسيط كذلك الذي قاله أبو فراس وهو على فراش الموت “أَبُنَيَّتي لا تَجزعي/كُلُّ الأَنامِ إِلى ذَهابِ |أَبُنَيَّتي صَبراً جَميـ/ـــلاً لِلجَليلِ مِنَ المُصابِ (بيت أهمله المترجم هنا) | نوحي عَلَيَّ بِحَسرَةٍ / مِن خَلفِ سِترِكِ وَالحِجابِ | قولي إِذا نادَيتِني / وَعَيَيتِ عَن رَدِّ الجَوابِ | زَينُ الشَبابِ أَبو فِرا/سٍ لَم يُمَتَّع بِالشَبابِ”، فقد ترجمت كما يلي:
Ô fillette ! Ne t’afflige pas, / Tout être est voué à la mort./ Néanmoins, derrière ton rideau et ton voile / Pleure amèrement ma disparition./ Un jour si tu m’appelles / Et que je ne puis répondre, dis ceci : / « Fleur de la jeunesse, Abû Firâs / Qui n’a guère joui de son âge. »
ولنقارنها بترجمة الأكاديمي التونسي جلال الغربي:
Ne sois pas triste, ô ma petite fille, / Tous les êtres doivent partir un jour. / Je te souhaite, ô ma petite fille,/ Beaucoup de patience face aux grands drames / Pleure-moi amèrement derrière voilette et rideau / Et si m’appelant tu venais à désespérer d’avoir une réponse dis alors : / Il n’a pas été donné au fleuron du bel âge, Abu Firas, de jouir de sa jeunesse.
وبصرف النظر عن هزال الترجمة، وعدم جواز إضافة الاسم الموصول qui (الذي)، لِجعلِه اللاحقَ نعتًا، والحال أننا إزاء جملة فعلية في محل رفع خبر، مبتدَؤُها “زينُ الشَّباب أبوفراس″، فإنها جانبت الأصل، فالشاعر يقول “قولي إِذا نادَيتِني/وَعَيَيتِ عَن رَدِّ الجَوابِ”، فصارت على يد أدونيس ومن معه كذا “إن ناديتِني ذات يوم، وعَييتُ (كذا بضمير المتكلم) عن ردّ الجواب…”.
Un jour si tu m’appelles /Et que je ne puis répondre…
ولا يذهبن بالقارئ الظن أن قصور الترجمة يخص القصائد التي ذكرناها وحدها، بل إن الخلل عام، يشمل قصائد الكبار والصغار على حدّ سواء. ولننظر مثلا في قصيدة الأعرابية التي روت كتب الأخبار أن أحد الخلفاء لقيها صدفة عند تجواله بربوع مملكته، فأعجب بها وتزوجها وصحبها معه إلى قصر منيف يليق بزوجات الخلفاء والملوك، ولكن الأعرابية سرعان ما ملت عيشتها وسط الأسوار العالية، فصارت تشكو غربتها وتعبّر عن حنينها إلى نمط عيشها القديم. وفي مرة كانت تشدو بالأبيات التالية “وما ذنبُ أعرابيةٍ قذفت بها/صروفُ النوى من حيث لم تكُ ظنّت | تمنّتْ أحاليبَ الرُّعاةِ/بنجدٍ فلم يقدّرْ لها ما تمنّت | إذا ذَكرت ماءَ العُذَيب وطيبَه/وبَردَ حصاهُ آخرَ الليلِ حَنَّت | لها أنّةٌ عند العِشاء وأنّةٌ/سحيرًا ولَولا أنَّتاها لجُنَّت”. فسمعها الخليفة وقرر إعادتها إلى موطنها، على أن يزورها كلما سنحت له فرصة. فكانت ترجمتها كالتالي:
Quel crime commit une bédouine tourmentée /Par les douleurs d’un éloignement inattendu ?/ La nuit, elle devient nostalgique lorsqu’elle se rappelle / L’eau de ‘Udayb et la fraîcheur de ses pierres,/ Elle a un gémissement à la tombée de la nuit et un autre / Lorsque l’aube scintille. Sans cela, folle elle deviendrait.
أي أنه أهمل البيت الثاني، وجعل لفظة crime (جريمة) مقابل ذَنْب، و”قذفت بها صُروف النّوى” غدت “معذبة بأوجاع البعد غير المتوقع″، وصارت “آخر الليل”، ليلا، وأصبح السُّحير فجرا يلمع.
بصراحة، لا نحسب أن هذه الترجمة حققت ما عناه الشاعر والمترجم الفرنسي إيف بونفوا الذي كان يريد أن تحرك الترجمات النصوص الشعرية في العمق، مثل أوتار آلة موسيقية.
ويبقى السؤال: ما الذي يضيفه أدونيس إلى منجزه، وما الذي يكسبه من ترجمات لا ترقى إلى مستوى ما قدمه مستشرقون أمثال أندري ميكيل وريجيس بلاشير وروني خوام في التعريف بالشعر العربي الكلاسيكي، لا سيما بعد تجربته المتعثرة في ترجمة سان جون بيرس؟




