تأملات في ثقافة السؤال
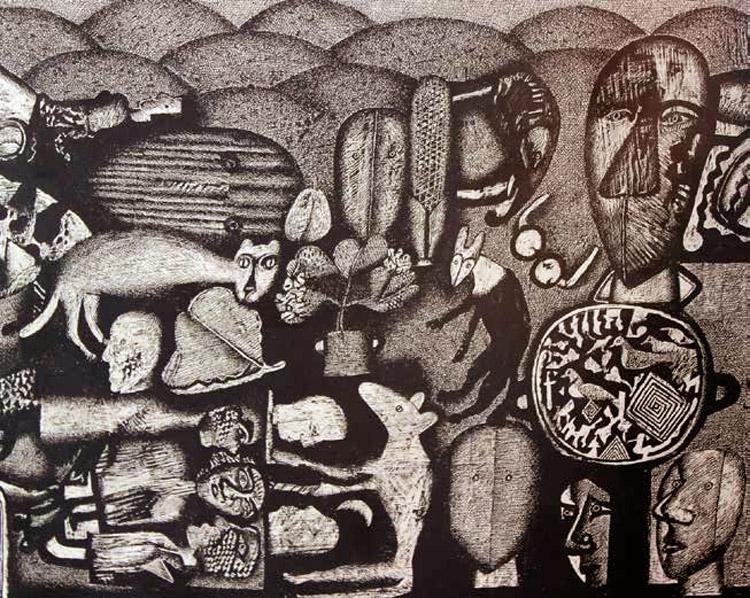
هل يمكن نعت الثقافة العربية بأنها ثقافة أجوبة ومسلّمات، أي ثقافة خضوع وخنوع واستسلام، لا ثقافة أسئلة تطرح نفسها على الفكر، ويصوغها العقل المنشغل بأحوال المجتمع ومشكلات العصر على نحو فاعل، ليجدد بطرحها الفكر وينتج من السؤال حواراً أكثر مما يبتغي أجوبة نهائية، أو يقبل بها؟
هل تجوز المجازفة بمثل هذا الحكم، وفي الإرث الثقافي الحديث، منذ نهايات القرن التاسع عشر وحتى اليوم، عشرات المفكرين والأدباء العرب الذين تصادموا بأفكارهم الجديدة مع البنى الثقافية السائدة، والأفكار القديمة البالية، وطرحوا على مجتمعاتهم طائفة كبيرة من الأسئلة المتعلقة بقضايا العصر وظواهره، وبالمشكلات المجتمعية المعاصرة لهم، من دون أن يكونوا أصحاب أجوبة جازمة تجد مرجعيتها في المسلّمات؟
قبل أن نقول نعم لهذا التصور، لأن الأمر هو حقاً على هذا النحو، أو أن نقول لا، لأن الأمر ليس أبداً على هذه الصورة، فلندفع بالسؤال إلى جهته المقصودة، متجاوزين أهل الفكر إلى أهل السلطة، ولنسأل:
هل حدث خلال الفترة الممتدة من نهايات القرن التاسع عشر وحتى اليوم، أن نشأت ظاهرة الحاكم الذي يجعل من السؤال أداة لإنتاج المعرفة بالمجتمع والسياسة، بالحكم والحاكم والمحكوم، آخذا في اعتباره أهمية السؤال في إنتاج معرفة بالعلاقة بين الأطراف الثلاثة للمعادلة؟
الجواب عن هذا السؤال لم يكن بالإيجاب في أيّ مرحلة من مراحل التاريخ العربي الحديث الذي لم تعرف مجتمعاته من النخب الحاكمة سوى تلك التي فرضت تصوّراتها على الناس فرضاً، وساستهم بمنطق الراعي الذي يسوس القطيع، وقد استمد شرعيته من منظومة أخلاقية متحدرة من إرث تسلطي ما برح يجدد نفسه، فترى لجماعة الرعية ما يصلح لهم، ولا تسمح لهم بأن يروا ما يريدون لأنفسهم. وليس في تاريخ الرعاة راع سأل القطيع ما يريد، ولا قطيع تطاول بأعناقه الخانعة وساءل الراعي، أو قال له: لا. ليس دائما خوفاً من العصى والكلب، وإنما استجابة طبيعية لغريزة الإذعان، المتوافقة والمنسجمة مع القدر الذي صاغ العلاقة، بل وحماية من الرعية المستسلمة للمنظومة التاريخية التي ما فتئت تجدد من عرى العلاقة بين السائس والمسوس، والتي دونها والعصيان أسباب وأسباب.
***
لربما كانت أسئلة الفكر في محطات معينة من التاريخ الثقافي العربي عرضة لمناوشين سبقت أجوبتهم الأسئلة، وصادرت حرية التأمل المجتمعي فيها، وذلك بفعل غلبة الأيديولوجيا على الفكر، وهيمنة السياسي على الثقافي والاجتماعي، وانسحار المجتمعات العربية الناشئة بشخصيات وطنية شعبوية، مالأت العواطف الجمعية الجياشة، وغلّبت اليقين على الشك الغريزة على العقل. لكن ذلك لم يمنع أبداً من ظهور نخب في الهوامش المجتمعية العربية انشغلت بالأسئلة أكثر مما قطعت بالأجوبة، وحاولت أن تفتّت صخرة السؤال بمطارق الفكر، وتنتج من حطام المسلّمات أسئلة جديدة ظلت دائما بلا أجوبة نهائية، لكونها صدرت أساسا عن وعي يرى في السؤال بابا للكشف، وفضاء لحرية الفكر.
وهكذا عرف الفكر العربي أسئلة غطّت جملة واسعة من القضايا والظواهر والمشكلات التي واجهت العرب، وأنتجت السؤال الأكبر: كيف يمكن لنا الخروج من كهوف الماضي واللحاق بالمدنية الحديثة، وقد تناسلت من هذا السؤال عشرات الأسئلة المتصلة به، وشكلت المادة التي ما برح الفكر العربي منشغلا بها إلى اليوم.
لكن المرء يتساءل اليوم، عن الأسباب التي حالت دون تطوير تلك الأسئلة حيث يمكنها توليد معرفة أعمق بالواقع، ورؤى خلاقة توسع من أفق التفكير المجتمعي العام؟ هل إن العلة كامنة في السؤال نفسه، أم في زمن طرح السؤال، أم في صيغ طرح السؤال، حيث تعذّر على النخب أن تحوّل الأسئلة الشاغلة إلى حاضنة حقيقية للوعي الجديد، وموئلا لإنتاج المعرفة الضرورية بحركة التطور، وفضاء حرّا لإرادة التغيير؟
ولماذا ظلت الأسئلة المتعلّقة بالتطور الاجتماعي محصورة بنخب قليلة من أهل الفكر، بينما بقيت جموع المتعلمين عبارة عن أميات مقنعة بالتحصيل العملي، وغارقة بالمسلّمات التي لا تحركها القضايا المنتجة للسؤال، ولا فكيف بها تنشغل بطرح الاسئلة؟
كيف حدث أن استسلمت الجماعة الإنسانية برمّتها إلى يقين الصيغ السائدة وأذعنت بصورة جماعية للمراسيم والتعاليم والأوامر المرسلة من قمة هرم السلطة إلى الأسفل، حيث لا إرادة فردية أو جماعية يمكن لها أن تطرح السؤال المتشكك في طبيعة ما يرسل إليها، ولا خيار آخر لها سوى الإذعان والقبول. فلا سائل ولا سؤال، ولا شبهة حتى في احتمال (لا)، فالـ(نعم) السعيدة هي الجواب المطمئن للمرسل والمستقبل. والغريب في الأمر أن لا تعاقد بين الجهتين، ولكن هناك تواطؤ من قبل المتلقي يلبّي استمرار الصيغة السائدة بين الحاكم والمحكوم، ودوام الحال.
***
وبالعودة على مبتدأ الكلام، أتساءل: هل استنبطت النخب العربية، الهامشية منها والمتحركة صوب المركز، أسئلتها الشاغلة من حركة الاشياء في الواقع، وتفاعل الفكر مع القضايا والظواهر والصراعات المجتمعية المختلفة، وقراءاته للوقائع ومآلاتها، وبالتّالي كانت أسئلتها موجبة الطرح، وواجبة الانشغال بها من قبل مجتمعات الثقافة العربية، وفاعلة في حركة التفكير العام؟ أم أنها نزلت بها من علياء الفكر، ومتونه ومن النصوص الرائجة الصادرة عن تجارب الأمم الأخرى التي سبقت إلى الحداثة، فهي أسئلة لها مرجعياتها في حركة الواقع وحركة الفكر في مجتمعات قادتها تجاربها التاريخية، وحركة الأفكار إلى صوغ الرؤى والخلاصات، في أسئلة كبرى، وأعطتها الفرصة لتجيب عن أكثر تلك الأسئلة إجابات متعددة، أنتجت أسئلة جديدة، فتضافرت مجتمعة ومتعددة، متلاقية ومتعارضة لتشكل معاً منظومة الفكر الحديث وتياراته المختلفة.
***
بالنظر إلى حال الفكر في علاقته بالواقع، لا يبقى أمامنا سوى أن نتساءل بحرقة: هل قدرنا، في هذه البرهة من التاريخ، وقد بتنا في فوات حضاري مريع، أن نكون مستهلكين لأفكار سبقت، وأفكار لحقت، وليس في قدرنا أن ننتج الأسئلة القادرة على إبداع الأجوبة المفتوحة بدورها على شتى الأسئلة والتحديات المطروحة على البشر في الحضارة الحديثة، كيف لنا هذا، ما دمنا متخلفين علمياً وحضاريا (رغم كل ما يصدر عن نخبنا المتشوفة بتاريخها التليد والمتشدقة بالخطب والكلمات الكبيرة) ومنفعلين على الدوام بما تنتجه الأمم المنتجة.
هل قدرنا حقاً أن نبقى مستهلكين بامتياز لكل منجزات العلم والعمل في العالم، من دون أن يترك لنا هذا القدر التاريخي الأليم سوى كتابة المرثيات؟
أسئلة، أسئلة، في عهدة الصادقين مع أنفسهم والقادرين على طرح السؤال والإنصات إلى حركة الأشياء في العالم بعقل حالم، وموضوعية تتفوق على الهوى.
لندن أغسطس/آب 2019




