تحوّلات الشخصية اليهودية في الرواية العربية

ساهمت عوامل تراثية دينية متنوعة، وأدبية عالمية، قبل العربية، إضافة إلى عوامل سياسية في تنميط صورة الشخصية اليهودية، ورسمها بملامح فرضتها سلوكياتهم التي انعكست في مرايا الآخرين. ففي قصص التراث الديني قامت تلك الصورة على غدر اليهود وقتلهم حتى لأنبيائهم، ثم معاداتهم للمسيحية وغدرهم بنبيها، ومن بعدها تفرغهم لحبك الدسائس والمؤامرات للإيقاع بالإسلام والمسلمين. كما أضاف الأدب العالمي ملامح جديدة لتلك الشخصية، تجلت في جعلها الطرف المناقض للخير والإحسان، المفطور على الجشع وحب المال وذلك من خلال شخصية “شايلوك” في “تاجر البندقية” لشكسبير ومربي اللصوص “فاجن” الذي يجمع الشيطانية والشر في “أوليفر تويست” لتشارلز ديكنز. ثم جاء الصراع العربي الصهيوني ليلوّن تلك الصورة بدم الفلسطينيين الأبرياء في مجازر مروّعة، كان دمها كفيلاً بمحو الحدود الفاصلة بين مصطلحي الصهيوني المحتل، واليهودي الموسوي الذي كان يشارك العربي الوطن وأفراحه وأتراحه.
وبذلك انعكست تلك الصورة النمطية لليهودي على الأدب والفن بشكل عام، وعلى الرواية بشكل خاص، حيث تطالعنا ملامحُ تلك الشخصية الإشكالية النمطية منذ أول رواية ظهرت في فلسطين “الوارث” لخليل بيدس 1920 وتبدو فيها شخصية اليهودي انتهازية جشعة متكالبة على المال. وفي “زقاق المدق” لنجيب محفوظ (1947) يأتي وصف اليهوديات على لسان حميدة بأنهن متحللات من العادات والأعراف والتقاليد. ولا تختلف الصورة عند إحسان عبدالقدوس في رواية «لا تتركوني هنا وحدي» (1979) ففيها المرأة اليهودية التي تضحّي بكلّ شيء في سبيل المال.
ونراها كذلك بمظهر المحتقر للآخرين والمستبيح دمهم، في رواية «دم لفطير صهيون» (1971) لنجيب الكيلاني. وتتجمع فيها سمات الخيانة والإرهاب والجبن والنفاق في رواية «أحمد وداود» (1986) لفتحي غانم.
ملامح تحوّل

لم تخلُ بعض الأعمال من التقاط بعض الملامح الإيجابية في تلك الشخصية فغسان كنفاني في روايته “عائد إلى حيفا” (1969) يرينا تلك المرأة اليهودية التي تتألم لطفل فلسطيني يرميه عسكر اليهود في شاحنة وقد ذكّرها بما فعله النازيون بأخيها. وفي مرحلة لاحقة تظهر صورة اليهود بملامح حيادية لا تكاد تميزهم عن الآخرين إلا بمهنتهم كما في “رحلة بالدسار” لأمين المعلوف و”أرض السواد” لعبد الرحمن منيف.
ثم ما لبثت تلك الحيادية أن أخذت تجنح نحو الإيجابية، حين تم تصويرهم كمكون من المجتمع الذي ينتمون إليه ويندمجون فيه، ويتعايشون مع عاداته وأعرافه، حتى إنّ بعضهم يوافقه في مواقفه المعارضة للحركة الصهيونية، وهكذا بدأت شخصية اليهودي تظهر بصفته فرداً ينتمي إلى محيط إنساني أكثر من كونه متقوقعاً في إطار مرسوم له دينياً وتاريخياً كما في «شرق النخيل» (1985) لبهاء طاهر، وفيها تبرز شخصية اليهودي الطيب الذي يرفض المشروع الصهيوني كغيره من العرب، ويرفض الهجرة إلى فلسطين. وتتوضح الصورة أكثر في “يوميات يهودي من دمشق” لإبراهيم الجبين من خلال شخصية “إخاد” الذي ارتبط بدمشق بجذور تمتد لآلاف السنين، رافضا ألا تكون أرضاً مقدسة كأرض فلسطين التي يرفض الهجرة إليها.
ومع مطلع هذا القرن بدأت تلك الشخصية تظهر كنموذج إنساني متداخل العلاقات مع النماذج الأخرى المكونة للمجتمع الذي تعيش فيه، ويمكن قبولها والتعايش والتزاوج منها، فظهرت أعمال تخصّ اليهود بموضوعها، وعنوانها أحياناً، راصدة تفاصيل حياتهم، وعلاقاتها فيما بينهم، ومع الآخرين، ومنها رواية “يهود الإسكندرية” لمصطفى نصر و”آخر يهود الإسكندرية” لمعتز فتيحه وكلتاهما تتناول قضية اليهود المصريين، فنراهم نماذج إنسانية متعددة، شخصيات تتعايش مع مجتمعاتها المختلفة، تعشق وتعمل وتنجح وتفشل، تغدر وتتآمر، تعاني الاضطهاد وتخاف من الحرب وتهيم في بقاع الأرض بحثا عن ملاذ آمن وتنفطر قلوبها حزناً على فراق الوطن وتحلم بوطن يكون أفرادها فيه الأغلبية.
وفي العراق نجد أعمالاً كثيرة ومنها “عاشقان من بلاد الرافدين” لجاسم المطير التي تجمع الصور المتناقضة لليهود، الإيجابية والسلبية، فتأتي على يهود يحبون المال ويتعاملون بالربا، ولكنها في المقابل تأتي على آخرين منهم يقرضون المال للأغيار بلا فوائد. وقد تكون الفتاة شريفة وعمتها بغيّ، وفيها يهود يتجسسون على يهود، وهناك يهوديات يُقوّدن على فتيات. والرواية تأتي على يهود عراقيين يُحبّون العراق ويرونه وطنهم، فكرجي بلا انتماء.. “أنا يهودي الدين والنسب، وطني هو البصرة”
وقد راح اليهودي في تلك الأعمال يتحول من شخصية عارضة ثانوية إلى شخصية محورية وأحيانا لها دور البطولة الإيجابية كرواية “ضفاف بابل” لخالد القشطيني، حيث نستطلع صورة مشرقة لليهودي العراقي في شخصية الطبيب “عبدالسلام ساسون”، وهو الموثوق الوحيد من الحاج نوفل الحنفي، لحسم قضية عذرية ابنته وشرفه، ويجبره بالسلاح على التخلص منها وغسل عارها، ولكن إنسانيته لم تسمح له بقتلها فأوهمهم بذلك، وأرسلها إلى مكان آمن، ثم دخل في كوابيس كادت تفقده مهنته، نتيجة توهمه بأنه ارتكب جريمة قتل.. وراحت زوجته “تفاحة” بعد يأس من الطب تطوف به على مزاراتِ الأولياء والصالحين من اليهود والمسلمين والمسيحيين، ونلمح من خلال ذلك التسامح الديني الذي كان يعيشه العراق، فالحاخام كان يزكّي لها الملا المسلم، والملا ينصحها بأخذه إلى مقام النبي اليهودي ذي الكفل (حزقيال). كما أن عبدالسلام بعد هجرته قسراً إلى إسرائيل، بقي عراقياً وقام بتهريب أحد الأسرى من أبناء بلده الذين جاؤوا متطوعين في جيش الإنقاذ لمحاربة الصهاينة.
انعكاسات الرؤية الجديدة

يتساءل البعض عن سر هذا التحول في رؤيا الرواية العربية للشخصية اليهودية، وينسبه البعض إلى أنه نتيجة لاتفاقية كامب ديفيد واتفاقيات أوسلو وبعضهم يرى فيه دعوة إلى التطبيع مع العدو الصهيوني.
ونرى أن هذا التحول كان أقرب إلى الموضوعية؛ من خلال رصده الشخصية اليهودية الموسوية كمكوّن من مكونات المجتمع العربي، والنظر إلى القاسم المشترك الإنساني الذي يوحده به. مصححة بذلك الصورة النمطية التي اعتمدت نماذج استثنائية، كما كان ضرورةً لها انعكاساتها الإيجابية على الشخصية العربية قبل اليهودية وأهمها:
- أولاً: هذا التحول في النظر إلى الشخصية اليهودية يحتضن ضمنياً تحوّلين آخرين:
أولهما: تحول في طرح الرؤيا العربية لليهود أمام العالم؛ وذلك من خلال التفريق بين اليهودي الموسويّ الذي لم يكن يوماً عدواً بل هو مكون لا يتجزأ من مكونات الأمة، تم التعايش معه عهودا طويلة، وبين الصهيونيّ العدوّ المُحتل الذي أراق الدماء وشرّد الشعب الفلسطيني.
وثانيهما: يتضمن دعوة لتحويل وتغيير رؤيا الآخر للشخصية العربية، في قبولها للآخر، والتي صورتها الدعاية الصهيونية، بدوية همجية متوحشة، تتحيّن الفرصة للانقضاض على نعاج بني إسرائيل من اليهود المستضعفين لإبادتهم. وهذا ما رأيناه في رواية “شيكاغو” (2007) لعلاء الأسواني التي تقدم لنا قصة حب بين “ناجي العربي” و”ويندي اليهودية” التي ترى استحالة حبهما لأن العرب يحلمون بإبادة اليهود فتقول له “علاقتنا رائعة، لكنها بلا مستقبل”، والسبب “لأننا من عالمين مختلفين” و”مهما أحببتني فلن تنسى أبداً أنني يهودية” و”مهما أخلصت لك ستظل ثقتك بي دائماً هشة.. سأظل أول المتهمين في نظرك”.
ويفشل في محاولات إقناعها بوجود روابط تربطهما منذ أيام الأندلس حيث تعايش أجدادهما وبأن عداءه ليس لليهود، بل للصهيونية.
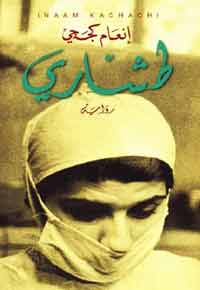
- ثانياً: ساهم هذا التحول المعتمد على التغلغل في أعماق الشخصية اليهودية في فضح السياسات الخاطئة للأنظمة العربية التي ساهمت في رفد الحركة الصهيونية بشريان بشري وذلك بإصدارها قرارات إسقاط الجنسية عن اليهود بعد النكبة، فوجدوا أنفسهم مشردين في أوطانهم، مجبرين وخاصة الفقراء منهم على الهجرة إلى إسرائيل، وهذا ما حدث للدكتور عبدالسلام ساسون الذي رفض مغادرة بلاده في البداية، لكنه يوماً بعد يوم وجد نفسه محاصراً بالعيون التي تتهمه بالصهيونية مهدداً بحياته، فما كان منه إلا أن هاجر إلى فلسطين ليأخذ هناك بيت فلسطيني أُخِذ منه بالقوة كما أُخرِج هو من بيته بالقوة.
وكذلك في رواية إنعام كجه جي “طشاري” التي تتعرض لقانون إسقاط الجنسية وما ألمّ بالطلاب اليهود في الجامعات، حيث لم يقبلوا فيها للدراسة فوجدوا أنفسهم بلا مستقبل.
- ثالثاً: كشف أثر الحركة الصهيونية على اليهود فهم لم يشردوا الفلسطينيين فقط بل شرّدوا أيضاً اليهود من بلدانهم التاريخية، فبإعلانها فلسطين دولة يهودية جعلت كل اليهود صهاينة، فأصبحوا غرباء مهددين في أوطانهم كما رأينا في “ضفاف بابل”.
- رابعاً: من خلال هذا التغلغل في حقيقة مشاعر الشخصية اليهودية نستشرف جريمة الدولة الصهيونية في تشويه النسيج المجتمعي، حيث حكمت بالإعدام على أيّ تعايش بين العرب واليهود سواء في بلدانهم الأصلية كما في “ضفاف بابل” أو في المهجر كما في “شيكاغو”، وحتى في فلسطين وهذا ما طرحه ربعي المدهون في رواية “مصائر” التي يقرر في نهايتها وليد دهمان وزوجته العودة إلى المهجر بعد مارآه من طمس لملامح الهوية المكانية لفلسطين والتمييز العنصري بين العرب واليهود وذلك بعد زيارتهم لبيت أهله في بلدة مجدل عسقلان ورغم الاستقبال اللطيف والمرح الذي استقبلتهم به اليهودية اليمنية التي أصبحت صاحبة البيت.
وخلاصة القول كان لهذا التحول في رؤية ملامح الشخصية اليهودية انعكاساته الإيجابية على القضية الفلسطينية بشكل عام وذلك لما عكسته من رؤى لحقيقة الكيان الصهيوني وجرائمه بحق العرب واليهود معاً، وتصويبٌ لرؤية الشخصية العربية لليهود بعد أن شوهتها الدعاية الصهيونية.




