مصير الأدب في ظلِّ التحولات العاصفة
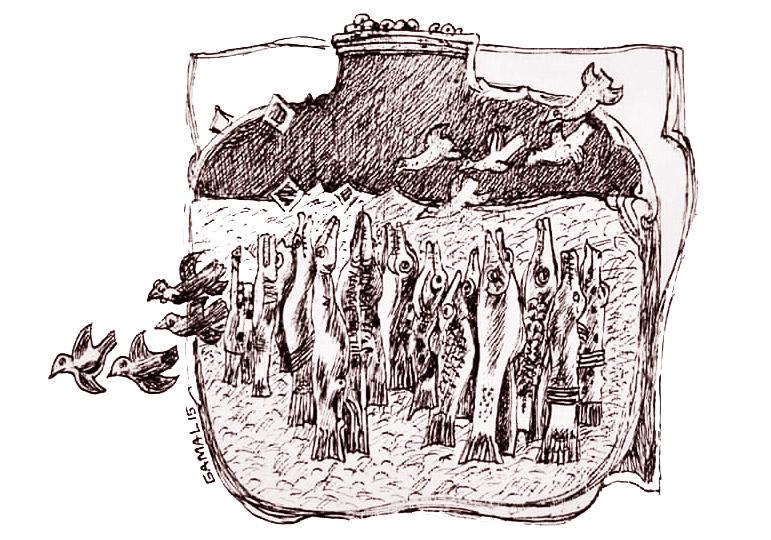
تحدثت في مقالة سابقة عن بعض قضايا الشعر والرواية اليوم، وأثار حديثي بعض الأقلام التي ذهبت إلى الاعتقاد بأنني أفاضل بينهما. والمنطق البسيط يقول إنّ المرء لا يستطيع أن يفاضل بين الطائر والزرافة، ناهيك عن أن يفاضل بين القصيدة والرواية.
وحتى لا أعتبر نفسي بريئاً تماما، فلا بد أن صفة الشاعر الغالبة عليّ كان لها دور في توليد ذلك الانطباع المخالف لوجهة المقالة والمقول.
على أن التباسا كهذا يجعلني أعود إلى المسألة، وإن يكن ذلك من باب آخر.
في صباي وحتى مطلع شبابي كنت قارئا نهماً للروايات. ومولعاً خصوصا بعدد لا بأس به من شخصياتها، بحيث أن روديون راسكولينكوف بطل “الجريمة والعقاب” للروسي ديستويفسكي خرج مراراً من الرواية ورافقني إلى الشارع، والحديقة، واستقلّ معي الباص الدمشقي، قبل أن ينزل ويتوارى مرة أخرى في شوارع بطرسبورغ، وقد قصد مكان جريمته. وآخاب بطل “موبي ديك” للنيويوركي هرمان ميلفل، تجلّى لي مرارا في مغامرته البحرية، بينما كنت أتنزّه قرب نهر بردى، وقد فاض ماؤه وغمر شوارع المدينة ذات شتاء قاس. ولكم سحرتني شخصية جان فالجان في “البؤساء”، ورويت قصتها لكل من عرفت في صباي من الأصدقاء. ولعلّي عشت معها أكثر مما عاش معها فيكتور هوغو الذي ابتكرها وجعل منها أيقونة أدبية خالدة.
وعندما قرأت “الحرية والموت” لكازانتزاكيس شغلتني شخصية العسكري نوري وقد صبّ فيها الكاتب اليوناني كل تناقضات موقفه من الترك المحتلين لليونان؟ تضاربت الصور عندي، بين ما هو إنساني وما هو ثقافي من تصورات كازانتزاكيس عن الآخر العثماني في “لعنته” الشرقية. وظلت تلك الصورة الفظة للشخصية العثمانية علامة وسؤالاً بالنسبة إلى قارئ ينتمي إلى هوية شرقية (ويحتفظ في ألبوم صور العائلة بصورة لجدة تركية الأصل). وقد رافقتني هذه الإشكالية طويلا.
وفي ما بعد عندما سأقرأ “المسخ” لكافكا، فإن جريغور سامسا، الذي استيقظ ليجد نفسه وقد تحوّل إلى حشرة، سوف يعقّد المسألة عندي. سأتقزز طويلا بفعل تلك الصورة وذلك المصير الذي آل إليه بائع متجول فقير في عالم رأسمالي طاحن. ولن تشفع لي تلك الصور الطريفة التي احتفظت بها مخيلتي في وقت سابق لدون كيخوتة وتابعه سانشو، ولم تساعدني في تنحية الصورة المقززة لشخص يتحول إلى حشرة.
ضربت هذه الأمثلة، وهناك غيرها مما تحتفظ بها ذاكرتي كقارئ شغوف بالروايات، لأشير إلى أمر ظل يشغلني طويلاً، وهو ندرة الروايات العربية التي يترك بطلها الصفحات ويلازمك زمنا طويلا بعد الفراغ من قراءتها. أرجو أن لا يفهم كتاّب الروايات من كلامي أنني لا أحفل بالكتابة الروائية العربية، ولكنني حائر حقا من فكرة باتت تلحّ علي، سأوجزها في السؤال التالي:
هل تعلّقنا بشخصيات الروايات التي قرأنا في زمن الشباب مصدره فرادة تلك الشخصيات وقوة تأثيرها، وهو ما لم تعد الروايات المعاصرة تقدمه لنا، أم إن السبب كامن فينا، في اختلاف توقعاتنا وتحوّل انتباهاتنا عما كانت عليه في تلك الأزمنة المبكرة، وقد تشبعنا، من بعد، بأفكار وصور وانتباهات ومعارف أخرى؟
أعترف أنني قلما هزّتني رواية عربية. لا أصدر هنا حكماً على الأدب الروائي العربي، لكنّني أعبّر، بصدق، عمّا يجول في خاطري. ولربما أكون في ذلك ضحية أمثلتي الروائية، وأذكر أنني لما شرعت في قراءة بعض روايات حنا مينة، وهو روائي له كثير من القراء والمعجبين بأعماله، أحالتني أعماله على أعمال روائي شغفت به مبكرا هو نيكوس كازانتزاكيس. وكنت قد قرأت له “زوربا” و”المسيح يصلب من جديد” و”الحرية أو الموت”.. وقلت لنفسي سأكتفي بـ”الشراع والعاصفة”، وبخلاف ذلك، فلأعد إلى صاحب زوربا، فهو الأصل.
وفي وقت من الأوقات شغفت بالقصة القصيرة، وللأسف لم يرضني إلى اليوم قاصّ كما أرضاني اثنان إدغار ألان بو في “الخنفسة الذهبية”، وأنطوان تشيخوف في كل قصصه. وعندما أقارن أعمال كاتبين قصصيين عربيين ذائعَي الصيت ومبجلين هما يوسف إدريس وزكريا تامر، أعود فأفضّل عليهما بو وتشيخوف. مع أنّ كلاً من إدريس وتامر قدم قصصا على تفاوت قيمتها الأدبية، لا بد أنها شكلت حلقة أساسية في تطور الأدب القصصي العربي. لكن الأمر بالنسبة إليّ مرتبط بالذائقة وما يلبّي توقعاتها، وموقفي هذا لا يجعلني أشعر بأيّ حيف نحو الأدب القصصي العربي، فلطالما كانت قراءة القصص بالنسبة إليّ مصدرا لنيل المتعة أولا، ومن ثم تأتي العناصر الأخرى.
ولو كنت سأفضّل قاصاً من اثنين عربيين يحققان لي متعة أكبر في القراءة، فسأختار يوسف إدريس، الذي حافظ في بنية قصصه على الحكاية ولم يفرّط بها.
أن نعترف، هذا فعل في ذاته، وهو شيء آخر غير التبشير. لذلك أنا أعترف هنا كقارئ ولا أبشّر بأفكار. اللهمّ إلا لو استشفّ أحد من كلامي دعوة مبطنة تحضّ على الاعتراف بما يزعج آخرين التصريح به.
وبما أنني أقمت الاعتبار الأول للمتعة مطلباً من مطالب قارئ الأدب، فإنني أعترف، هنا أيضاً، أن من بين أكثر أوقاتي استمتاعا بالقصص كانت ساعات قراءتي لكتاب ألف ليلة وليلة، قرأته في نسخة شعبية مطبوعة بدمشق بحروف صغيرة جداً، وفي سن مبكرة، ومن دون أيّ مقدمات فكرية أو لغوية أو جمالية للكتاب. وقبل أن أعرف بحقيقة أنه ترجم إلى عدد كبير من اللغات. ولكم تحسّرت أنه لن يمكنني أن أعرف أبداً من هو كاتبه.
لا أذكر اليوم متعة تشبه متعتي في قراءة ذلك الكتاب اللهم إلا في قراءتي كتاب دون كيخوتة في جزأين بترجمة من عبدالرحمن بدوي. أجزم أن كتاب سرفانتيس، على اختلاف لغته، كان الأكثر شبهاً بألف ليلة وليلة في قدرته على الامتاع. كتاب تمسك به من صفحته الأولى فيمسك بك حتى الصفحة الأخيرة، ولربما أنساك أصابعك ويديك ومكان جلوسك، بل وأخذك معه إلى زمنه بحيث أنك لا تعود حيث أنت، ولا من كنت. القراءة تغيّرنا، تعبث بهويتنا، تخلخل ما كنّا نعتبره يقينا، وتفتح لنا نوافذ على عوالم لم نكن لنتخيلها، وأبواباً لغرف سرية لم نكن نتوقع أنها موجودة.
أعود إلى مبدأ الحديث، في الشعر والرواية، والخواطر التي سبق وعبّرت عنها انطلاقا من تأمل في مأزقين اثنين، مأزق الكتابة الشعرية الحديثة، في مراوحتها المثيرة للتعجب في فضاء ما يسمى “الشعر اليومي”، وشيوعه على نحو مسفّ جعل الشعر يخلو غالبا من جوهر فكري أو ميتافيزيقي، وهي قضية مستقلة شغلت جزءا من مقالتي، ومأزق الكتابة الروائية في ظل تفاقم نوع من الكتابة الروائية السهلة، واتساع هيمنة السوشال ميديا وميل القراء إلى التعامل أكثر فأكثر مع النصوص القصيرة، والشذرات القصصية، وهو ما يبدو لي تحديا كبيرا لجنس الرواية التي تقع في عشرات الآلاف من الكلمات، وغالبا ما لا تقل صفحاتها عن 200 صفحة. وهو ما يخلق مشكلة في التلقي تتعلق بالزمن، فقراء اليوم يصرفون أوقاتا أطول مع السوشال ميديا مما يفعلون مع الكتب الورقية، ولديهم فرص افضل للتنقل بين النصوص، بما في ذلك الاكتفاء بمقاطع وشذرات من الأعمال الروائية، وقد تنبّه غير كاتب ومفكر في الغرب إلى هذه الحقيقة المستجدة في علاقة القراء بالأدب الروائي.
ما ذهبت إليه عمليا هو التساؤل حول الكيفية التي ستستجيب معها الرواية للتحولات العاصفة التي بدّلت في علاقة القارئ بالقراءة، وعصفت بالأدبية، ولو على نحو جزئي، وهي في سبيلها إلى العصف بالأزمنة؛ أزمنة الكتابة وأزمنة القراءة وأزمنة التواصل، وهو ما يتوقع منه أن يضع الرواية، بالمعنى الفني للكلمة، على عتبة تحولات قد لا نتوقع مدياتها ولا حتى أشكالها، في ظل توافر إمكانات (افتراضية) مذهلة تتيح لهذا الجنس الأدبي الممتع بنية مراوغة وقادرة على تحقيق شكل روائي جديد، يستجيب للتطور.
أما الشعر، فهو، وبفعل طبيعته التي تنتمي إلى الكثافة، وعلى الرغم مما يشهده من اضطراب في الثقافة العربية، يبقى في نظري، أقدر على مواجهة تحديات الزمن وليس في هذا أيّ مفاضلة بين جنسين أدبيين.
لندن - شباط/فبراير 2020




