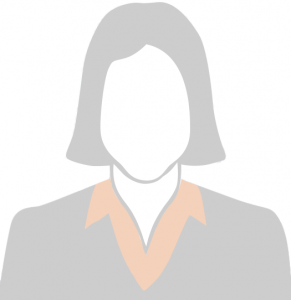ملكة الوقت

عيناه المتورمتان لا تسعفانه لرؤية الطريق إلى الحمّام، يمشي كبطريق متمايلا يمينا وشمالا من شدّة الإرهاق والتعب، يرتطم بالباب، يمدّ يده مرتجفة يمسك بالمقبض، يفتح باب الحمّام، يتوجه مباشرة إلى المغسل، يفتح الصنبور، يغرق وجهه ورأسه الأصلع بالماء، يصله صوت زوجته تصرخ في وجه الأولاد وهي تدعوهم للذهاب إلى المدرسة، تأمرهم أن يقاوموا النعاس، تقول لهم مقولة أصبحت تتردّد في العمارة كلّها: الله غالب.
يدس وجهه في المنشفة، يتأوّه من شدّة حسرته على أبنائه وعلى زوجته وقد حرمهم كلب الجار من النوم، لقد اشتاق إلى شخير زوجته البدينة الذي طالما أزعجه.
لا رغبة لديه في تناول القهوة التي أعدّتها زوجته قبل أن تذهب إلى بيت أهلها في الحي المجاور لتنام على الأقل لساعتين أو ثلاثة كي تتمكن من ممارسة حياتها العادية، وتحمّل مسؤولياتها تجاه بيتها وزوجها وأولادها. بالكاد يغيّر ملابسه، ويغادر لينزل إلى مقهى الحيّ بغرض بحث الأمر مع سكان العمارة الذين قرّروا الاجتماع لدراسة وضعيتهم المزرية إزاء هذا الكلب الذي نغّص عليهم عيشتهم بنباحه الذي لا ينقطع صباحا ومساء، وأكثر من ذلك أصبح يشكّل خطرا على السكان وأطفالهم، إنّها المرّة الثالثة التي يعضّ فيها طفلا، ولا أحد تجرّأ على تقديم شكوى.
كان نباح الكلب لا يزال يصمّ الآذان والأطفال يجرّون أقدامهم من شدّة التعب وهم ينزلون أدراج السلم، يهمس الصغير علي ابن منوّر الحلاق في أذن أخته وهو يمسح المخاط النازل من أنفه بكمّ مئزره بأنّه قرّر قتل الكلب بأنّ يدسّ له السمّ في الطعام، ترتعش أخته من هول الفكرة، تمدّ يدها الصغيرة تضعها على فمه تسده وهي تنظر يمنة ويسرة خشية أن يكون أحد سمعه، تتعثرّ في الدرج الأخير وهي ترى موسى ينزل وهو يدس جسده النحيل في معطف رثّ، تلقي عليه التحية وهي تحاول إخفاء الصغير علي، يتوقفان عن المشي، تهمس في أذن أخيها: ألم تقل لنا أمّي بأنّ سي عبد الجبّار صاحب الكلب قوي، سيكسر أضلع من يقترب من كلبه. يطأطئ الصغير رأسه الملفوف في قبعة نسجتها والدته، تطوقه أخته بذراعها وهي تعرف ما ينتظرها من عقاب إذْ أنّها لم تراجع درس “الكَلَب” عن سبق إصرار من شدّة كرهها للكلاب ولكل ما له علاقة بهم، لقد أبلغت أمّها بقرارها إذا ما أقدم المدرّس على معاقبتها ستقول له: خلّصونا من كلب السي عبد الجبّار أولا ثمّ أعطونا دروسا حول الكلب والكلاب.
يظلّ موسى يتأمّل الطفلين بعينين أرخى جفنيهما النعاس وهما يمضيان بعيدا عن عمارة أرعبها كلب، لقد استحضر فيهما صورة أولاده الذين غادروا قبلهما إلى المدرسة، وهو لا يدري إن كان مدير المدرسة التي يدرسون فيها سيستدعيه مرّة أخرى ليقدّم له إنذارا حول حالة أولاده اللذين ينامون أثناء الدرس.
لم يعد يقتنع بقصّة الكلب. تأكّد له أكثر من أيّ وقت مضى بأنّ هذا الكلب أصبح يهدّد مستقبل سكان العمارة فعلا. تستوقفه لافتة وضعها جاره مسعود المدرّس كُتبت عليها أبيات شعرية في مدح كلب. يبصق على اللافتة، وقد أدرك خيانة مسعود الكلب الذي يدّعي بأنّه من رجال التربية والتعليم.
يقاوم النعاس، ينفخ صدره، ويندفع إلى خارج العمارة، يقطع الطريق مهرولا غير مبال بمنبهات السيارات. يصل إلى المقهى، يلمح تجمهر سكان العمارة، يدخل، يأخذ مكانه بين المجتمعين، يركّز نظره على جاره مروان يرغي ويزبد ويتوعّد كلّ من يخلّ بالاتفاق الذي تخرج به الجماعة للقضاء على مشكلة الكلب في هذا الاجتماع بأقسى العقوبات قد تصل إلى حدّ مقاطعة سكان العمارة له.
يصرخ من أقصى زاوية في المقهى حسين النجار بأنّه سيقطّع بمنشاره هذا الكلب هو وصاحبه السي عبد الجبّار ميسور الحال والذي يملك فيلا ومسكن آخر، منذ تزوّج للمرّة الثالثة، أصبح يقضي معظم أوقاته في مسكنه بعمارتهم التي كانت آمنة قبل وصوله. لقد ترك زوجته الأولى وأمّ أولاده في الفيلا، والزوجة الثانية في مسكن قريب من أهلها، أمّا الثالثة فهي غريبة عن المنطقة ولا أولاد لها لذلك اختار أن يقضي معظم وقته معها، هكذا أخبرهم الجار يوسف صاحب المقهى التي اجتمعوا فيها، وأخبرهم أيضا بأنّ السر وراء إحضار السي عبد الجبّار للكلب هو حراسة زوجته الشابّة الفاتنة والوحيدة، لكن كيف يعقل أن يحرسها وهو فوق السطوح وشقة السي عبد الجبار في الطابق الأوّل؟
يتمتم عثمان الإسكافي بأنّ مصدر أموال السي عبد الجبّار مشبوه، يقال بأنّه يتاجر في المخدّرات، وإلّا كيف يعقل أن صار غنيا بين ليلة وضحاها؟
يشمئز عمّي الصدّيق كبير السكان من هذه الثرثرة التي لا تجدي نفعا، ولا تغيّر من واقعهم البائس شيئا، فيتدخّل ليهدّئ من روع السكان المجتمعين، وليدعوهم إلى اتخاذ إجراء واقعي قانوني بتبليغ الشرطة وهي ستتخذ الإجراءات المناسبة. ينتبه موسى إلى عيسى الخضّار يتسلّل من بين الجموع ويغادر المقهى وهو يسحب الباب خلفه، يفكر موسى في جبن الخضّار الذي أغلق الباب خشية أن يصل صوت السكان الغاضبين إلى الشارع، ثمّ تتبادر إلى ذهنه فكرة تنظيم مسيرة مندّدة بوجود الكلب في العمارة، تعجبه الفكرة لدرجة أن رفع يده وطلب الكلمة ليعلن عن فكرة المسيرة بصوت مرتفع وبحماس منقطع النظير. يسود الصمت للحظات وكأنّ على رؤوس الجماعة الطير، ثمّ ينفجر السكان ضاحكين من الفكرة المجنونة، لكنّ ضحكتهم يقطعها صوت دوي باب المقهى يفتح بقوة ليدخل السي عبد الجبّار والشرر يتطاير من عينيه الجاحظتين وقد كشف عن صدره العريض وعضلاته المفتولة تحت قميص أبقى على أزراره مفتوحة، ينتبه موسى إلى عضلات الذراعين أيضا، عضلات مفتولة لا يكاد يرى منهما لون بشرته من كثرة الأشكال التي وشمها على جلده. يزمجر السي عبد الجبّار كقطار وهو يصرخ فيهم: ما به الكلب؟
يسود الصمت، لا صوت يسمع في المقهى، وكأنّها أصبحت خالية.. يمشي السي عبد الجبّار بين الجموع والشرر يتطاير من عينيه وهو يزمجر: قلت ما به الكلب؟
يتوقف أمام حسين النجار، يرمقه بنظرة غريبة، يفهم عيسى بأنّ الخضّار قد قام بالمهمّة وخان الجماعة، يرفع السي عبد الجبّار يده عاليا ويضربها على الطاولة التي يجلس إليها حسين النجار الذي اعتصر وجهه وهو يقول: “الكلب، الله يكثر خيره يا السي عبد الجبار”.
ثمّ يشرع حسين النجار في شرح مدى سعادة سكان العمارة بوجود كلب قوي ووفي يحرسهم وكيف أنّهم اتفقوا على تكريمه نظير جهده في خدمتهم، فقرّروا إنجاز بيت من حطب يقيه الحرّ والبرد مؤكّدا بأنّه سيتولى إنجازه بنفسه في ورشته.
في اليوم الموالي، كان حديث سكان العمارة حول إلى أين وصلت الأشغال بخصوص مسكن الكلب؟
كمنجات المنعطف البارد
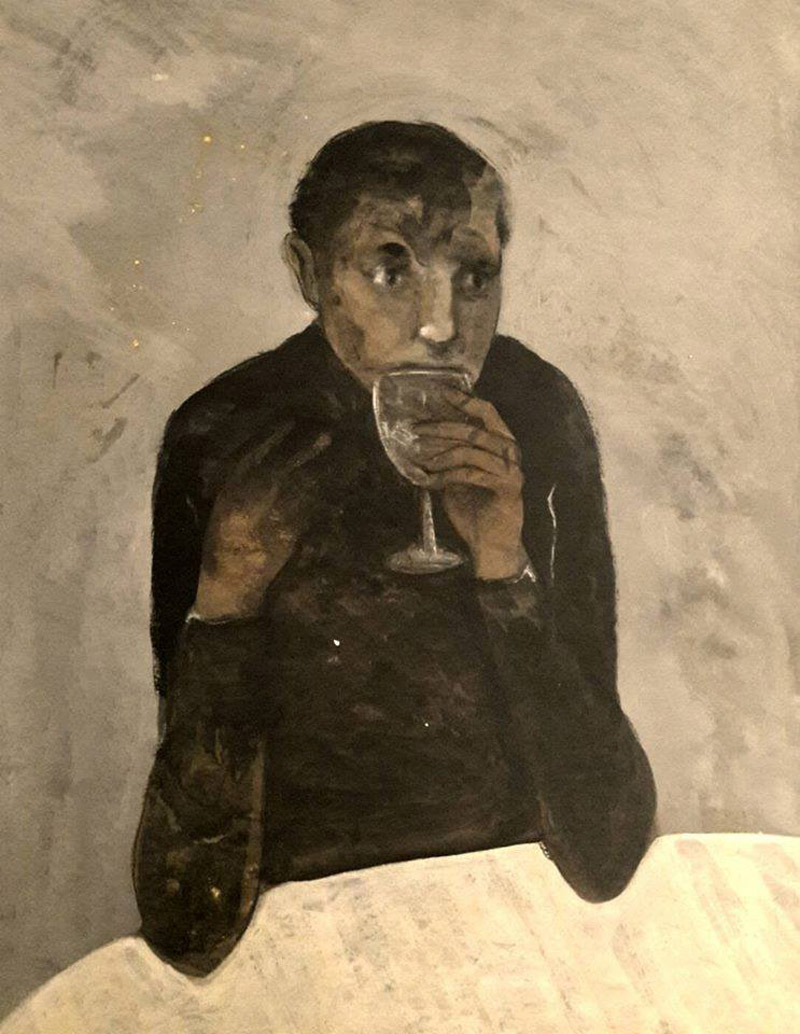
هو أحد صباحاتي الباردة يتكوّم غيمه في روحي، أقف في المطبخ أعدّ القهوة، تربّت رائحتها على شيء بداخلي، تتسارع حركاتي وأنا أضع على المائدة الفناجين، علبة المربّى، علبة الزبدة، تصطدم يدي بيده وهو يضع طبق الجبن، تتغلغل نظراته في روحي، آخذ مكاني في المقعد المقابل له، ينحاز والده إلى المقعد الذي بجانبي، يكسرنا الصمت، ترتشفنا القهوة في غفلة منّا، يحوّل نظراته عنّي وتبقى نظراتي متسمّرة في شعره الكستنائي، في عينيه اللوزيتين، تشدّني أكثر تلك الزغبات تحت أنفه والتي بدأت تتطلّع إلى رجولته، قريبا سيصير رجلا بشارب، كلّها أيام ونحتفل بعيد ميلاده السابع عشر، أصبح رشيد رجلا.
تأنيبي له ليلة البارحة عن الفوضى التي يحدثها في غرفته ذكّرني بما قالته لي أمّي في آخر زيارة لنا للوطن منذ سنتين:
– هذا الطفل يجب أن يعاقب، إنّه مشاكس، لقد دلّلته كثيرا.
قلت لها يومه:
– ممنوع ضرب القصّر في البلد الذي نقيم فيه، قد تنتزع المساعدة الاجتماعية الأولاد من أوليائهم إن ثبت ضربهم لهم.
الدهشة أسكتت يومها والدتي، وصراخه ليلة أمس في وجهي أسكتني، ويا ليت كلامه كان بلغة عربية، قاله بلغة أجنبية:
– هذا شأني، وهذه غرفتي، كفاك تدخلا في حياتي.
عزائي الوحيد أنّه فهم دموعي العربية، واعتذر.
انتبهت من شرودي على أزيز الكرسي وهو يتحرّك، يستعدّ والده للخروج، سيطبع على خدينا قبلة وينصرف، ثمّ ينسى بأنّنا موجودون. فهو مشغول بالعمل في الصباح وبعد الظهر أيضا، مشغول بما قد يحصل عليه من مال إضافي يعزّز الأمل لديه بأنّ الفرج قريب يسقط عناء كبيرا عن كتفيه.
أبقى وجها لوجه مع رشيد، يقف وهو يركز نظراته عليّ، أقف لتقودني قدميّ إليه، أصلح وشاحه، أساعده في وضع قفازاته، الصمت يغزل شيئا لا مرئيا بيننا، إنّه يعتذر لي في صمت وأنا بحاجة إلى كلّ الوقت الذي ضاع منّي هنا ليعتذر لي. حملت حقيبته، ناولته إياها، اقتربت منه أكثر وقلت له بكلمات متدافعة: يوم الخميس عيد ميلادك.
ثمّ رفعت يدي بسرعة لأطبقها على فمه، لم أشأ أن أسمع ردّه، أدرك بأنّه سيكون بلغة أجنبية، ردّ يشعرني بخيبة جيناتي. فهم إشارة يدي، ارتمى في حضني، احتضنته كما كان لا يزال صغيرا، كان فرحتي وتعويضا لي عن خسارتي بغربتي وفراقي لوطني.
انسلّ من حضني وخرج مسرعا ليلتحق بدروسه وبقيت وحيدة على كفّ وقت لم يرحمني. انتبهت إلى أنّ والده لم يشرب فنجان قهوته كاملا، كالعادة النصف يكفيه، هو لا يريد تضييع الوقت، أو كما يردّد دائما: علينا أن نعرف قيمة الوقت، هنا من لا يعرف قيمة الوقت ينتهي.
أرتمي على المقعد، أتأمل نصف الفنجان الفارغ، أفكرّ في الهدية التي أقدّمها لرشيد في عيد ميلاده، أفكر في والده وفي غربتنا. أغيّر ملابسي وأنزل إلى الشارع، هذا الشارع هو أكثر شيء يذكّرني بغربتي ووحدتي ويرسل أحلامي فراشات وأنا أتتبّع خطوات عازف الكمان المندسّ في معطف بال، ينتصب أنفه الدقيق وسط وجه نحيل تتسع فيه عينان زرقاوان بصفاء سماء هذه المدينة.. يقف كعمود كهرباء فأقف وكأنّ الأرض توقفت عن الدوران لتصغي لموسيقاه وهو يذبح شيئا في الوتر ليحرّر سحرا خالدا يتدفق إلى أعماقي.. لا أبالي بالبرد، بل إنّه يزيد من متانة علاقتي بمعطفي الذي اتخذته صديقا وفيا، أتقاسم معه لحظات الاستماع إلى العزف على الكمان حين يتركني وحيدة ليجمع ما يكفي من المال، فقد حفظت ردوده كلّما طلبت منه مرافقتي إلى هذا المكان:
– الغربة صعبة، لم أتغرّب عن وطني لأضيّع الوقت، يجب أن أشعر بالفارق في المستوى المادّي، أنا تركت بلدي لأنّهم كانوا يعطونني مقابل جهدي الكبير دريهمات لا تسدّ رمقي، تحوّلت إلى كائن هاجسه الراتب الشهري وكيف يتدبّر أمر سكن لن يحصل عليه إلا إذا ولج الجمل في عين الإبرة.
قد أكون الوجه الآخر لعملته هاته التي لم تشبع نهمه، أنا امتلأت بالكمان وكبّلتني أوتارها إلى هذه الشوارع المبلّطة وهذه السرج العتيقة وتلك الأشجار التي تعرّت من أفراحها كفيلسوفة تتأمّل ركضنا وقبضنا على الريح.. وكأنّي بها تتقاسم معي أصلي العربي، فهي العربية كانت في الأصل ربابا وجاءت إلى الأندلس لتصير كمنجة وظلت تبكي بنغم شارد عمرا تاه منها ومن الأندلس.
لقد حدّدت هذه المدن هويتها، ولا زلت أنا ها هنا أقف بجذوري على أوتارها بحثا عن وجهي الجديد المنسلخ عن ملح بحرنا الذي نأى عنّي ولم أعد أرنو إليه بعينيّ كلّما مالت الشمس إلى المغيب.
يستوقفني وجهي على واجهة محلّ، وتطلّ أرنبة أنفي وقد ازدادت احمرارا من شدّة البرد، أدسّها في فرو معطفي وأتساءل في أعماقي:
– هل كنت بحاجة إلى كل هذا البرد لأطفئ نارا تتأجّج بداخلي؟
يحتويني معطفي متجاوبا مع نوتات سمعتها أكثر من مرّة، ولا زالت فراشاتها بنفس الألوان تدغدغ روحي وتنطلق عميقا بين ثناياها، تحبس أنفاسي وتستلّني من بلاط الشارع إلى غيمات مسافرة فوق جليد ذلك الجبل البعيد الأبيض الشامخ.
أنزع قفازي لأصفق للعازف، وأضع بعض القطع النقدية في قبّعته التي نزعها عن رأسه ليحيّيني.. أتراني كنت جمهوره الوحيد وقد قضيت النهار كلّه هنا، سمعت كلّ المقطوعات التي عزفها، أم أنّ وجهي صار مألوفا لديه؟
سؤال طالما أتعبني وأخيرا وجدت له إجابة بأنّني قد أكون الأكثر وفاء لبؤسه، مثلما صار معطفي الأكثر وفاء لحزني وغربتي، أو أنّه آريونال ليسبوسي أراد أن ينقذ نفسه من البحارة بعزف لحن وفاته فأصغت إليه الكائنات جميعها، ولما قذف بنفسه في البحر تلقاه الدلفين وحمله على ظهره إلى الساحل.
الفكرة خلخلت شيئا بداخلي أعاده إلى توازنه رنين هاتفي المحمول، سحبته من جيب معطفي، لأجده يطلّ عليّ من هنالك بصوته مستغربا طول غيابي وتضييعي للوقت أو كما يقول لي في كلّ مرّة:
– ما زلت وفية لوقت ممتدّ لا محدود في عالمنا المتخلّف هنالك في الضفّة الأخرى، هنا لعُشر الثانية قيمته اِحفظي هذا جيّدا.
تباطأت في مشيتي، كنت بحاجة لأمتلئ بشعور افتقدته هنا، هو أنّني أنا ملكة الوقت، لا شيء يلاحقني، وأنا مستعدّة لتحمّل تأنيبه لي وتذكيره لي ككل مرّة بأنّنا ممنوعون من تضييع الوقت، الذي يضيّع الوقت هنا سيفشل ويعود إلى بلده خائبا.
أخطو بخطواتي الرتيبة لأعبر عتبة الباب، أدلف البيت، تحتويني عيناه ببريق لا أفهمه، أتوزّع بين رغبة في سرد حكايتي مع الكمان ومتعة أن نسمع ألحانها الشجية التي تشبه دموعنا ولها مذاق ملحها، وبين رغبة في الاعتذار عن حمقي أو الاعتذار عن وضع جعلنا نهرب من اللامحدود الخانق في وطننا إلى المحدود القاتل هنا.