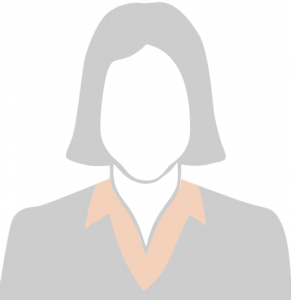تصدّع غريب

خلف حدود السؤال
تمتزج قطرات المطر على زجاج النافذة لتنزل متحدة محاولة في جهد إسقاط صور تتداخل في مخيلتي. أفكار تتناسل بشراهة وتتآكل بعدها، فيعانق بعضها الانتصار فتلتصق بجدار الذاكرة سياطا، والأخرى تنفلت فتتدحرج على جسدي الزجاجي منتصرة كذلك حين ينبعث رنينها كحبات لؤلؤ شارد. جسدي بارد، ورأسي يكبر ويثقل حتى يميل على كتفي، فأفشل في إقامته على الجسد. جسد مشوه منذ البداية.
منذ البدء لم أحس بالبرد يوما. لم يحدث هذا وأنا أجلس على ناصية العمر الطفولي.. أمسح الدمعات بأصابعي الهشة، المنتفخة والمحمرة.
ونحن نجلس طفلين كوكبين في ليل شتاء قارس، على أراجيح معلقة، فتخطف أنت يدي وترميها بين يديك، وتمدها من دفئك المفقود كذلك.. لم أحسّ بالبرد، لكن كنت أحسه الخوف يقطع شرايين القلب ويقطعني نصفين. فأفر من هروبي الدائم، تحت السرير، والحمام وفي خزانة المطبخ. أهز شظايا أعماقي وأنفضها في أعماقك، فتلمّها وترمم داخلي، وتمدني بقطعة من دفء أنخرط في مساحتها وأجلس زمنا. في أعماقك أرمي أعماقي فتفلح دوما في منحي فرحا عجيبا أضحك على إثره طويلا.
هل هي سذاجة الطفولة أم الصدق الحقيقي؟
فرح أخر يتلاشى هنيهة حين تمطر ثورتي. في اللحظة ذاتها أثور وأغرس أظافري فيك. أخدشك، أترك مدنا دامية في كتفك، لكن صوتك يبقى يقلب صفحات الألم ويسقطها ويوقع انتصاره في نهاية مفكرة لا تنغلق.
نعم وحدك كنت تلمس حدود هزيمتي وخوفي.
فهل حقا كنت تدرك حجم تعبي حين تضمني إليك؟
وظل السؤال يكبر معي ومع جسدي الذي كبر بسرعة أدهشتني، ومد الآخرين بحيرة وفزع، حتى جدائلي امتدت وازدادت نفورا، ففضحني طولها الخرافي وسوادها الحالك، لأجدها اللحظة أكثر تمردا تشدني إلى جدران غرفة تقتنص حلمي.. وتذكرني.. وأكثر يذكرني هذا الهمس النسويّ العقيم الذي يصلني متقطعا وأحيانا مملا، فأتعب في الوقوف على معناه وبين تعب وآخر أحصد أكثر من تعب.
عروس جميلة!
لا فقط المساحيق تمنحها هالة.
وأمتص همسهن، نساء بارعات في صناعة الحديث، ألسنتهن أشواط عمر أقطعه، أكره فيهن هذا وأكثر، أكرهه في أمي حين تتحدث مع الجيران والصحون وشجرة تين بري، تتحدث بشراهة وعنف، تتمرد في حديثها، لكنها تكون صامتة بعد الغروب الذي يطبق عليّ حين أجد الغرفة تصغر وتصغر، وقطرات المطر تزداد التحاما ببعضها وجسدي يتناهى في الصغر ويزداد التحاما بثقب الباب، ويعانق صراخ امرأة تمتد على الأرض وتصرخ، وعند الصبح أسألها:
أمي لم يفعل بك هذا، لما يضربك؟
لأنه يحبني ترد.. وتبتسم.
هل كانت صادقة؟ أم ترسم لنفسها دائرة من صمت يبدأ في الاتساع بعد الغروب، بعد عودته مباشرة. وأتعب كثيرا خلف قفل الباب. وأجد أظافري تطول وتكتسب وحشة ضوار وتزداد طولا حتى حدود نعل أبي. وتسقط، تتفتت، وتذوب ومعها يسقط سؤالي على شفتي مهزوما.
لما يفعل بك هذا؟
لأنه يحبني.
وحين يطلع النهار، وتمدّني الشمس بحنوها أفر إليك من وحشة الظلمة والعنف والصراخ، وأغرس أظافري الحافية هذه المرة فيك فتصمت. فهل كنت تدرك حجم تعبي حين تضمني إليك؟
وتمسحها دمعاتي، تبكي معي، وبحرقة طفلة مفككة لا تقدر مرات كثيرة على ترميم الفساد داخلها.
تمزقت مناديلك الورقية، وتمزقت راحتك على وجنتي، فكثيرا ما بكيت تحت الغطاء داخل الخزانة وخلف الباب.
أصرخ بقوة الصمت داخلي:
كفى.. كفى.
وما أصعب أن تصرخ دون أن يدوّن صراخك أحد، يهترئ عمقك دون أن ينهار جدار واحدا وتنفذ منه صرخة واحدة لتغير صورا مرفوضة تحبسني داخل إطار عنيف.
هذه الليلة هل أصرخ، وهل يسمعني أحد؟

لم أعد قادرة على رسم خارطتي ولا حتى مكان تواجدي، فقط حولي نساء بارعات في صناعة الحديث، ووحدي أركن في الوسط. أشغل صدارة المكان، وعلى الجانبين ورد كثير. وأعود أتحسس جسدي. وأطرافي، ساقاي أحاول أن أطرد منها هذا البرد. لم أحس قط بداخلي يرتعش بردا لكنه كان كذلك خوفا، وإني في هذه اللحظة خائفة جدا. شيء ما بدأ يتشكل فيّ، خوف قد يلتصق بالكبد دوما.
عندما رأيته يضربها تقيأت تحت وسادتي، وعندما وجدته بعد ذلك يقبلها تقيأت داخل صدري. وأحسست داخلي معبأ بالقذارة وما عادت فيه ثغرة واحدة لإضافة جديد. ولكنك كنت كلي الذي يلم أجزائي الضائعة في المساحات الباردة، بين خزانة المطبخ والحمام. وأبدا كنا طفلين، قمرين على رصيف العمر الطفولي. نرتب مع النجمات فرحا بعد آخر، ونكبر في فضاء خرافي يتسع لحماقات الطفولة الضائعة.
مبروك، يا عروس.
عيناك قلقتان! تردف المرأة قبالتي، وتظل واقفة، هادئة، وفي يمّ هدوئها تحركت قوارب حيرتي وقلقي.
هل هذه هي؟ امرأة تحرك نبضها القوي نحو ريحك وهوائك حين اصطدمت بك فجأة في شارع منزو من عمر راجف، وجدتك الرجل الوحيد في عالمها الضيق ذات مساء منفرط. عصفت لك بما في الداخل من دهشة وحنين، وفي شارع عبور آخر حزمت حزما للوداع ورحلت عن عالمها. فرممت الداخل وأصبحت هادئة، فقط تتنفس.
حتى أمي أحبت أبي، ومنحته الجسد كله فكان خارطة له، صنع فيه ضياعا، أسقط حصون الطاعة والولاء.
أبقى، وتبقى المرأة واقفة قبالتي، هادئة.
وينطلق همس جديد، وزغردات قوية: يو..يو..يو… وزغرودة حررت فيها أمي كل صراخها الماضي والقادم لكي تصمت بعدها. ويمتزج كل شيء، رائحة عطر، بخور، حناء، طبيخ. وأعطس.
عروس تعطس.. هه.. هه!
أنظري فستانها، أصابعها، أنفها! و.. وهن نساء بارعات في صناعة الحديث، ألسنتهن تعذبني. أكره هذا فيهن، وأكرهه أكثر في أمي.
تزداد الغرفة ضيقا. جدرانها ما عادت بلون الفستق. تزحف نحوي مع الوقت، وتنحدر إلى أعماقي أعمدة إسمنتية جبارة تهشم العمر الطفولي، وتزداد الغرفة ضيقا، وقطرات المطر التحاما، ويغرقني الوقت في نبضه، ودقات ساعة منتصف الليل تماما. دقيقة ودقيقتان، ومع العد يبدأ النبض أيضا. تواقت رهيب تتقلص له أطرافي كلها، وأجد العمر ينتهي في لحظة ما. عمري الآن أعده على الأصابع، فلتكن أصابعي هذه الليلة، ليلتي هذه شموعا تنير لي وحدي.
ما أتعبني من امرأة!
تظل الساعة عطشى في ركضها..تلهث في صحارى زمني تبعثر ماضيَّ وتنشره ملفات: اقرئي.
تصدع غريب يقصم الداخل. تعب رهيب وأطرافي تنتهي في الصغر، وشراييني ما عادت قادرة على الدفع. حتى أظافري أراها تتساقط كأوراق ذابلة تلفظ آخر الأنات، وتأخذني إغفاءة قصيرة كهروب اضطراري لأجد الغرفة بعدها فارغة.
والآن في غرفة مرتبة، حريرية، ورائحة عطر يفوح. أفسد كل ذلك هندسة فوضاي، فحياتي كانت فوضى ووحدي كنت دائما، وهذه اللحظة أكثر وحدة في فراش من حرير وبعمقي صرخات طالما حررتها وظل الكثير منها يشل داخلي ويعيق خطوتي. وخطواتك من بعيد تدق، تدق. ضربات على جليد يتصدع، تصلني شظاياه مدببة تصيب وجهي وكل جسمي. وفي البعيد جدا امرأة، أمي تتمدد على الأرض ألما، وخزانة المطبخ، والحمام، ومن تحت الغطاء أذناي قطة قطبية، وفوضى غريبة تدفعني إلى رفضك في هذه الليلة بالذات. في هذا التوقيت العجائزي أجيء من زمن أبله معتوه، وأرفضك، وأجدك وجها لخرافة صدقتها وآمنت بتعويذاتها المباركة.
تسقط يدك على كتفي. ليست دافئة أبدا. وجهك غريب. فيه عينان تبرقان. لم تكن هكذا عندما كنا نجلس على رصيف العمر الطفولي كوكبين، وقمرين، نرتب فرحا بعد آخر، وفرح يتلاشى عندما تمطر ثورتي رذاذا.
هل تدرك حجم تعبي عندما تضمني إليك؟
كان سؤالي الأخير، وإغماءة طويلة، ومرة أخرى على فراش لكن هذه المرة ليس من حرير أجدني ممدة تزكمني رائحة البنج تنتشر بداخلي، ونزيف حاد تقول الممرضة، عروس ممزقة العمق والقلب والرحم تضيف الثانية.
وحينها وجدت وجهك في البعيد يشبه وجه أبي تماما وسجلت في لحظة فشلي وانتصارك الفاشل وأنك ما كنت تدرك حجم تعبي وأنت تضمني إليك.
ويلفظني البحر
جوزيف.. جوزيف.
نادته امرأته ثم دخلت المتجر. وظل هو واقفا على رصيف الأمس حيث كان هاهنا يلوك الجوع والوجع معا. تدفعه الأجساد العنيفة وتعافه الأخرى الناعمة، وتبتعد عنه، فمنظره يوحي بفوضى غير عادية، وحالة من البؤس الشديد. فقد لفظه البحر مالحا ورطبا، وفي قلبه علقت طحالب بحرية. وقف هاهنا يقتات الهواء، والازدراء. ثم مرميا على الكرسي الحجري، ورغم فوضاه وعريه كانت الأضواء الساطعة تبهره.
باريس الضوء، العطر، الحب والضياع. جميلة جدا يا هذه المدينة، وعيد رأس السنة يحل بهيا عليك كعقد ماسي يحطه – بابا نوال – على جبينك العالي، الرافض. فتغتسلين من كل الخطايا وتغازلين الزمن وتنعمين بدفء مدن الشرق.
كان الثلج يتساقط ليعطي للمكان سحرا، وليزيد كذلك من بؤسه وبرده، ويقرصه في الأماكن العارية من جسده.
“كم هي كثيرة يا أمّا”.
فينكمش أكثر خلف النوافذ. نوافذ البنايات الجميلة، ونظرته تقتنص خلسة صور بهرجة تعج في الداخل، وتصنع فضاء حالما، تشده رغم تعبه المصابيح الصغيرة الملونة التي تشع بريقا، وتتدلى في تناغم رهيب من أغصان شجرة السرو، وإلى أسفلها تراكمت الهدايا وعلب الشوكولا، فيسيل لعابه ويبتلعه.
“أبتلعه يا أمّا”.
يتخيل الشبع والدفء معا، ويمسح شفتيه الباردتين بكم معطفه، ويمسح مع ذلك مكان تسمره حين يفاجئه ضوء سيارة الأمن، ويغوص في أماكن أكثر ظلمة وأقل حركة ككل ليلة يقلب النفايات ويقتات منها.
“كم هي نظيفة يا أمّا”.
يتكوم بعدها إلى الصباح داخل علب كارتون تحت الجسر جسدا ضائعا كباقي الأجساد من حوله. يحتمي بنَفَسها، ويقتل بضياعها خوفه كي يمتطي صهوة الحلم، ويعبر كابوس اللحظات المارقة إلى فيحاء الحنين.
ويحن..
لا ترحل يا ولدي، وحيدي أنت.
يدخل محراب قداستها، يغتسل من خطايا عاق يعفر وجهه بضوء قلبها، ويبكي طويلا بين راحتيها، فتضمه، وتعوذه وتصلّي كثيرا لأجل أن يبقى حتى وان كان يعود كل مساء محملا بالخيبات.. وينسحب من مدنه الحالمة ضعيفا، ويرتمي في الزقاق مع أبناء الحي وحكايات الصبا مع سيجارة يتقاسم الجميع أنفاسها، تطفئ لهيب حرقة لا تنتهي. حرقة عناوينها شاردة، نافرة. الحقرة، التهميش، الهربة، الحرقة، و.. و.. وشاطئ صخري، وقارب يحمله موج هادئ لتكسره بعد ذلك عاصفة المدن الرافضة فيضيع فيه الزاد. ثم يلفظه البحر مخضبا بالذكرى والعذاب إلى شاطئ رملي هذه المرة متوسدا جثث الرفاق.
وتحدّى.
فعضلاته المفتولة، وبنيته القوية كانا جسرا عبوره إلى بساتين البرتقال شتاءا وحقول القمح والذرة صيفا، ليحصد فرنكات تضمن له الخبز والمأوى.. وعيون تطارده، تشمئز من عيونه.. لكن عظمه ظل شديدا وقاوم.
ومرة ثانية تناديه امرأته: جوزيف.. جوزيف.
لكنه ظل واقفا في مكانه، وقدماه مغروستان في الثلج، متطلعا إلى الرصيف حيث الكرسي الحجري ينظر في دهشة وذهول إلى حيث كان يلوك الجوع والوجع معا..
وصوت آخر يصله من بعيد من عمق البيت العتيق:
“يوسف يا أمّا تعال.. تعال”.