صحبة الطير وبريد الغروب

لعلّ القراءة عن طريق البناء أفضل القراءات الكاشفة للخيط الذي يضمّ النهايات إلى البدايات، ويحبك الأجزاء الروائيّة الثلاثة، فتفهم الصراعات الخارجيّة والداخلية، واستطرادًا مقاصد النص. وهو، أي النص، يتبدّى رحلة من دون طريق، مسيرًا بغير مسار أو هدف واضح؛ حيث تلتبس فيه البدايات والنهايات، ولا يؤثثه سوى الحكي والذكريات في سيرة ذاتية لشخصية عبدالجليل الغزال. وعبدالجليل بعكّازه، هو الناجي الوحيد من السجن الصحراوي المدمّر؛ ابتدأت رحلته بالخروج، لتطوى كما صفحات الكتاب. إنما تفترض الثلاثية بنية علاقات مثلّثة في مستويات تتداخل وتتعالق، تجتهد القراءة في تبيّنها، بحكم تتبّع عبدالجليل في هذا المسار-السيرة، في تيهه ونسيانه ودفق ذاكرته وتهويماته وتحليلاته وفلسفته وشاعريّته وجنونه وغنائه وفائض حنينه وحزنه.
للتنسيق الطباعي، وتنظيم السرد في فصول وأجزاء، كما للتصدير دور في تكشّف الرؤية الناظمة. ففي الجزء الأول المعنون «حافة النسيان» لا يتّبع النص خطة تقسيم إلى فصول، أو أجزاء، أو لترقيم ما. إنّما ثمة فراغ طباعي يعلن ضمنًا بدء دفقة جديدة في نصّ متّصل. ليتواصل فيض التذكّر والقصّ والتخيّل رفقة الدرب. أمّا الجزء الثاني «صحبة الطير»، فينقسم إلى جزأين شبه متساويين، مع رصد عناوين جزئية في كل فصل، يحيل كل عنوان إلى حكاية، ليستمر التداخل في ذكريات الأمكنة، وإن لحظت محاولة لفصل تردّد الذاكرة بين قريتي عبدالجليل: وادي الدموع وتلة سليمان. وبالانتقال إلى الجزء الثالث «بريد الغروب»، ثمة تغيّر ملحوظ لجهة هوية الراوي. إذ يجري السرد، في جزء معنون أول، بضمير المتكلم على لسان هدى، حبيبة عبدالجليل، بما يشبه السيرة الذاتية. وتحت العنوان الثاني يعود السرد الذاتي، كما في الجزأين الأول والثاني، ليتدفق على لسان عبدالجليل.
للتصدير مكانة توازي العنونة؛ واللافت اقتباسات من المتصوّفين، النفري وابن عربي، ومن عبدالجليل نفسه، الرواي ذاتي الحكاية؛ ذلك إمعانًا في الإيهام بوجوده المرجعي، وفي أنّ الرواية في أجزائها الثلاثة ما هي إلا سيرته الذاتية. ولئن في التصوّف تأملات حول الذات، واستغراق في الوجود والوجد، يتيح الاتّكاء عليه في التصدير توجيه القراءة لفهم البعد الوجودي في السرد. بهذا الزاد اليسير، تماهيًا بزاد عبدالجليل – كيسه – في ترحاله، أعبر نحو النصوص.
حافة النسيان: حافة اليأس والخروج من ثقب الذاكرة

يبدأ الحكي الذاتي بحدث الخروج، النجاة من قصف السجن الصحراوي، على لسان الناجي الوحيد عبدالجليل، وهو ما يؤكده في تصدير الرواية «بدوت لنفسي فريسة أخطأها الموت فزاولت عرجها الطويل». إنما في خروجه من السجن يعثر على حريّة منقوصة، كأنّما خرج إلى سجن أكبر، إلى خلاء صحراوي يضيّق عليه فرص الفوز بالحياة؛ فيواصل المسير. نخال طيف النفري يوجّهه في هذا التحدّي، حين يقول «إذا ضاقت بك الدنيا، فسر». وفي التيه إسقاط لحالة الضياع والمحو على كل الأشياء من حوله، وشعور بالتخلي، والتشكيك في وجوده، فيناجي نفسه تارة «أنا إله نفسي في هذا العدم»، وتارة أخرى يصف وضعه البيني بأنهّ في برزخ، «على شاكلة فاصلة بين نصّين، بين الحضور والغياب».
إزاء حركة السير للتقدم في عمق الصحراء باتخاذ وجهة واحدة، جهة الغرب، والاستدلال عليها بنجم سهيل، تأتي حركة الذاكرة الاسترجاعيّة المتكرّرة تأكيدًا وجوديًا وعامل يقظة لمواجهة الغياب والسرابيّة. فما الذي يتذكّره عبدالجليل؟
يظهر كلب السجّان ناجيًا آخر، يسمّيه «فرند»، مثلما نبتت شجرة السدر لتؤثث هذا المكان. وسط الصحراء تأملات حول الذات والمصير، وسؤال عن البداية «هل من هذه اللحظة ستبدأ الحكاية؟ لرجل وجد نفسه جاثيًا على ركبتيه وسط خلاء تام صحراوي، ووجد نفسه دفعة واحدة في كهولته؟ قبلها ضياع وبعدها ضياع». لينتبه إلى أنه سجين ناجٍ، مستعيدًا العلاقة المثلثة بين السجين والسجّان والسجن، «كل من جاء إلى هنا، سجّانًا وسجينًا، هو مفقود مبدئيًّا. أمل السجّان بالعودة كأمل السجين بالعفو. فرصة السجّان الوحيدة لمزاولة حضوره في الحياة، هي الانتقام من مسبّبي وجوده في هذا المكان».
ذكرياته ما هي إلّا ومضات ومشاهد لقصص غير مكتملة في السجن وما قبله؛ فيستعيد ذكرى يومه الأول، حيث كان تمنّعه عن إيذاء هيفاء سببًا في انعطاب رجله، ويتذكّر صور رفاقه الذين قتلوا، وجلاده بتفنّنه في التعذيب. والذكرى الأشدّ إيلامًا وتكرارًا، كانت «ليوم النصر»، حين كان في الثامنة من عمره؛ وقتل أخوه مهدي داخل قفص كلاب مسعورة في طقس احتفالي للقائد الحاكم. حدث يأخذه مجدّدًا إلى تأملاته في استيحاش الكلاب، واستذآب الإنسان، وفي تحوّل كلب السجّان، رفيق رحلته في التيه، من الشراسة في مطارد السجناء حيث كان، إلى حيوان دجّنه حبّ البقاء والخشية من الوحدة والضياع. إنما في خروجه هو أيضًا، رحلة عودة إلى ما فطر عليه من وفاء لمن يصاحبه.
بعد مسير ثلاثة أيام يصل عبدالجليل إلى خرائب بيوت يتذكّر أنها لقريته «وادي الدموع». يعود إلى أوّله، لتأتي الإجابة عن سؤال البداية في رحلة عذابه. فالتشتت سلسلة حكايات بدأت مع الأسلاف لتستمر مع الأبناء. من وادي الدموع كان الاقتلاع الجماعي الأول لأهلها عقابًا على مؤامرة انقلابية على الحاكم؛ فجفف النهر وقطعت أشجار النخيل، وأخصي الشاعر فرحان داوود، زوج هيفاء، كما قطع لسان الراعي نعيم السّايب الذي ردّد هذين البيتين لفرحان:
«مين أمّنك ما تخونو ولو كنت خوّان،
هيدا زمن لا رجال فيه هيدا زمن خصيان».
ويتذكّر شتاته الثاني من تلة سليمان، وسلسلة مآس وقعت فيها؛ من مقتل والده على يد والد مريم، حبّه الأول، إلى موتها مسمومة بيد أمّها، والتي بدورها أحرقت نفسها. وفي رحيله الثالث يتذكّر يوم اعتقاله من بيت حبيبته هدى في وادي أبو جميل في بيروت، وهو التحديد المكاني المرجعي الوحيد في هذه الرواية. يتمّ تبادل الأسرى في شاحنتين على حدود فاصلة بين بلدين مجهولي التسمية.
بعد ربع قرن من النفي والسجن والنسيان، ينغلق المشهد على قطار يصفّر في المسافة كأنه جرح الصحراء الأبدي، يمرّ مبتعدًا عن خربة وادي الدموع، ليترك عبدالجليل في حيرة بين بقاء أو رحيل، وهو العائد الوحيد إلى مكانه الأول، إلى هباء «لم يبق منه سوى جسر لم يعد يربط بين ضفتين، ونهر لا نهر فيه». فهل من تأسيس على هذا الخراب؟! محكومًا بالماضي، ومحاصرًا بين ذكريات النفي والترحال والاقتلاع والحاضر الأكثر بؤسا في مدى مفتوح على العدم؛ يزاول عرجه من جديد.
صحبة الطير: مزاولة العرج ، مواصلة الغناء
يبرز المشي ثيمة رئيسة في الجزء الأول، بتحريض حميد وخفي من النفري، ومن تراث الفلاسفة المشّائين والوجوديين. فقد وصف كيركيغارد بأنه ذلك الفرد الذي يمشي، وأرسطو بالمشّاء. ولعلّ السير حركة تنشط التفكير، فكان ولا يزال دليل عبدالجليل إلى ذاته واستعادة لها، بتوسّط الذكريات، مثلما أنّ التوقف عن السير يعدل الهلاك. واللافت في هذه الرواية افتتاحها بالغناء وانغلاقها عليه؛ فمنسوب الغنائيّة والحنين إلى المطارح يزداد. كأنّما حين يشتد بالذات التيه والإحساس بالفجيعة تحضر الأغنية مكانا تسكن إليه وتسكنه. والغناء الذي يتّخذ نوع المواويل والفراقيّات، يستدعي صورة جدّته وصوتها، يشبه التنهيدة والنواح، وقد درّبه الهجر الطويل:

«يا نسيم الصبا سلّم ع البلاد
كبروا اللي ببالي بعدن ولاد
تركتن ع يوم العيد وتيابن جداد
وفرّق ما بينّا النوى وهدّني الحداد».
ويتذكّر عبدالجليل يوم الاقتلاع من وادي الدموع «تلك الهجرة محفورة في بالي كالوشم الذي في ظاهر يد جدتي»، يناجيها ويطلب منها أن تغنيّ له كي يغفو:
«يا نجم الصبح يا غاوي وين الصحاب
ركبنا يوم الشتات أربع دواب…
يا ريت تردّن بعد طول غياب».
يواصل تأملاته وإسقاطاته لحالة الرحيل على قافلة من غيوم تشيّع نهارًا آخر، وعلى سرب طير يواصل الرحيل. كما يتساءل عن سر انبجاس الحكايات من النسيان، ليستدرك مخمّنًا أن المطر سقاها فاخضرّت في باله؛ والحكايات ما هي إلا تفجّر ماء الحياة من جديد وسط هذا الجدب. في هذا الكلام إشارة بيّنة إلى التضادات التي انبنى عليها هذا النص المقسوم في معماريته جزأين لتذكّر مطارح قريتين، إحداهما صحراوية «وادي الدموع» غدت خرابًا، وثانيهما «تلة سليمان»، في مشاهد رعويّة وهناءات عابرة لزمن جميل مضى وانقضى.
في استعارة الصحراء، جفاف النفوس وتشيؤها بالكراهية والعنف، مقارنة مع خصب الطبيعة ومواويل الرعاة، ودعة النفس في حضرتها. وإذا كانت الصحراء تيهًا ونسيانًا ورتابة ومشهدًا واحدًا مكرورًا، فيأتي الخيال حياة بديلة، بمواجهة المحو أو «إكسير الزمان»، بتعبير عبدالجليل. يستعيد حكايات كان قد تذكّر نتفًا منها في الجزء الأول، وبفعل المطر ورائحته تفتّحت تفاصيلها. فيزور مدرسته الخربة في وادي الدموع، حيث لا شيء صامدا فيها سوى صورة القائد، والقبور التي سمّاها «منازل السلالة». كما يسترجع يوم تشييع والده في تلة سليمان، وحكاية بدرية الندّابة. إزاء هذا الكمّ من الحزن والتجهّم، يستحضر مشاهد حبّ مجبول بالغصات أيضًا، «كم هو العالم ناقص يا فرند، بدون حب». تمثُل حكاية الراعي رشيد الذي مات مسمومًا، وهو عشيق نساء القرية لعذوبة صوته. ولوحة في بهاء زينب، المرأة المستحمّة بمياه النهر، ونداءات الجسد الفتي لعبدالجليل، وألم تمزّقه بين الاحتشام ورغبته في النظر إليها؛ يحيل القارئ إلى «ميوزيدورا» رسومات بريشة «وليام إتي» للمستحمّة المنزعجة من حفيف النسيم.
لعلّ القصة الأبرز، وهي غير مستعادة، إنما وقعت لعبدالجليل في الصحراء، هي قصة خطفه على يد جماعة من الملتحين وتعذيبهم لكلبه فرند، وقتلهم شابًا مجهولًا سمّاه عبدالجليل «حامد المقدسي»، بتهمة تكفيريّة. بهذه القصة ينتقل من الماضي إلى الحاضر بعد ربع قرن، ليرى أن لا شيء تغيّر في حقيقة الجماعات العنيفة، وإن تغيّرت التسميات والهيئة والأيديولوجيات، فرائحة الرعب والكراهية واحدة. هذه الجماعة التكفيريّة الغرّة، كما وصفها في حيرة من أمره بين نقمة وحنوّ عليها، لجهلها بما تفعله، تُنبّه إلى قول ابن عربي في التصدير «تحتاج لألف عام كي تصبح مسلما ولألف عام أخرى كي تصبح إنسانًا».
إذا كان السؤال عن البداية مطروحًا في الجزء الأول، فيأتي سؤال النهاية ملحًا في هذا الجزء من الثلاثيّة. فلم يختر عبدالجليل البداية بنفسه؛ إذ كان شتات أهله نتيجة عصيانهم للحاكم، وبتواطؤ من إمام القرية، فتراوده فكرة وضع نهاية لقصته بالانتحار، حينما أغواه وجود الكلاشنكوف، بعد سلسلة تأملات في هشاشة الإنسان وعبثية الموت، «لماذا أنتظر أحدا يصنع لي نهايتي؟» وتطفو وجدانية الشاعر من جديد، ليعلن أنه يحب عكازه ويكره الكلاشنكوف، وأنّ الشعر والرصاص لا يلتقيان، في معرض تذكّره جدالًا مع أحد المقاتلين. ثنائية أخرى تحفّزه، وهو شاعر، على عقد المقارنة بين العكاز والبندقة، النبل والخسران، في إدانة واضحة لكل من الحاكم المستبدّ، والشيخ المنافق، والثورات الفاشلة، في قوله «(أصبح عندي الآن بندقية)، نشيد أدى إلى أعنف الهزائم، وإلى تشتيت من بقي من البشر»، عبارة تختصر الرؤية في إجابتها عن سؤال «البداية» في بعده التأويلي الاجتماعي. يدفن حامد في الصحراء، يفقد أنيسه فرند، ويواصل المسير.
بريد الغروب: المرأة المدينة والصعود الى الأغنية
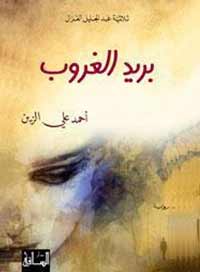
تتواصل اللغة الوجدانية، وإن خفت صوت الغناء ليحلّ مكانه صوت القصيدة على لسان شعراء مرّت أطيافهم في ذاكرة كلّ من هدى وعبدالجليل، الشخصيتين الساردتين، كلّ في قسم من الرواية؛ يتقاسمان معهم الحزن والشعر، كما يشاطرانهم الغربة والحنين. هدى الكاتبة المتخفّية باسم تالة سويحان، وعبدالجليل الغزال، مستعيدًا سيرته – جلجلته، في طريقه إلى البيت، صوب النهاية. يتقدّم الحدث وتتكثف الأفعال السردية في وتيرة أسرع، كما تزداد الفكاهة المرّة، فضلًا عن ميزة التسمية في هذا الجزء من الثلاثيّة. تُسمّى الأشياء والأمكنة بأسمائها ليتحقّق حضورها وانجلاء الذاكرة تمامًا بتعرّيها أمام الحقائق الصادمة؛ فلا مراوغة ولا تكنية. إذ نعلم هويّة كل من عبدالجليل ومعتقليه، عندما يخبر «حين وصل إلى البلاد كان توأم الحزب يفتك بمن تبقى من أهله. حزب بغداد شردني من وادي الدموع وحزب دمشق شردني من تلة سليمان ثم خطفني في بيروت بعد سنين وبادلني على الحدود مع بغداد بسجناء آخرين كالماشية التي تقايض بماشية».
يحضر الحبّ في مواجهة قبح العالم؛ وبالحبّ تعلن هدى انتصارها على الظلم والعتمة، «كنت أهرب إلى عتمتي وأحتمي فيها من بشاعة الخارج … أنا أقيم من زمان على الحد الفاصل». عتمتها كانت نتيجة «العمى الهستيري» الذي أصيبت به جرّاء اعتداء معنوي على جسدها للتيقّن من بكارتها. تترك شمال لبنان لتستقرّ في وادي أبوجميل في بيروت، وتحبّ الشجن العراقي في صوت جارها عبدالجليل الذي يصف من يساوي بين الحب والجريمة بالوغد. «الحب خطيئة، أما الحقد والقتل والذل والظلم فأشياء لا تقع في هذه الخانة». إنما تبصر هدى، «أبصرت حين أحببت. الحب أعاد إليّ بصري كاملا». ذلك في ليلة قصف على بيروت، ومحاولة نجاة بالحب، فيعقّب عبدالجليل قائلًا «حين أبصرت هدى أبصرتُ في عينيها كل أوجاع النساء في بلادي». للعمى والإبصار/التفتّح دلالات رمزيّة تحيل إلى تبصّر المرأة في حقّها في الحريّة والموقف ونفض غبار التغييب عنها. ثمة تماه إذن، بين المرأة والمدينة المنتهكة من قبل الجماعات الميليشياويّة ونظام الحزب القمعيّ الحاكم بالوصاية؛ كما كانت ضريبة الحرية التي دفعتها كلتاهما واحدة.
في لعبة الاستعارات والبدائل، وإزاء جدب الصحراء وتيهها والاستعانة بالخيال بديلًا وجوديًا، يحضر العماء لدى هدى، وعكازها يدها وآلة التسجيل قلمها، مثلما تبدّى العرج لانعطاب الرجل لدى عبدالجليل، واتخاذ عكاز خشبي عونًا على السير والنجاة؛ وفي كلا الحالين العنف والاستلاب هما السبب. ليس هذا وحسب، بل يكشف النص عن معنى الولادة – الانبعاث، ومفارقاته حين ينجب الرجل المرأة. «ولودة بلادي للطغاة» يتحسّر عبدالجليل، وتفصح هدى عن ولادتها بالحب بفضل رجال ثلاثة، «هناك شيء يجمع مثلث حياتي: أبي وشوقي وعبدالجليل. كل واحد منهم سبب في حياتي. الأول أنجبني، والثاني أنجبني ثانية عندما علمني العشق، والثالث أعادني إليّ، عندما أعاد إليّ عينيّ أخرجني من عتمتي. هي ولادات ثلاث من ذكور ثلاثة. كلهم اختفوا من حياتي وتركوا لي أسماءهم وحكاياتهم».
تتشابه حكايا الاغتراب والفقد ونشدان الحرية لدى الشعوب والشخصيات الثانوية التي تحضر لتمثّلها. جدة شمس، صديق هدى، كردية ربّته بعد وفاة أمه وغنّت له كل غناء جبال كردستان وسهول الرحيل. ويذكّر الشاعر الكردي «شيركو بيكس» هدى بأنهم غرباء في عالم غريب «رسمت طائرا/جعلت كلمة رأسا له/ومن نبلة القلم منقاره/من حفنة تراب جسده/من وتر رقبته/من العشب ذيله/ لكنه لم يطر حتى جعلت من فرشاة فان غوغ جناحين له».
يظهر عبدالجليل متعدّد الهويّات، وفاقدها في آن؛ فلا أوراق تثبت هويته. وهو، في واقع الحال، لا انتماء لديه إلا إلى ذاته، إلى قدميه. «الإقامة عدو نائم والرحيل صديق.. لا أحد يحميه إلا رحيله والسير إقامته». وهكذا قال لهدى «احملي في قلبك البلاد وامشي، هي تسعفك على السير والوصول». في طريق عودته من وادي الدموع بالاتجاه المعاكس، يصادف قافلة حافلات هاربة، تنقل حطامًا بشريًّا، ويلتقي برجل يحمل راية سوداء يطلب منه أن يساعده في الدعاء لنصرة الإسلام، كما يساعد الأم مريم على إحضار طفلها الذي نسيته في القرية المنكوبة، ليشعر أنّ له هدفا يسعى إليه، فيرافقه فتى من القافلة يدعى موسى، يخلّصان الفتاة نجاة من اغتصاب جماعي، يمرّان بقرى محروقة وشجرة العراة المذبوحين… يطوي التلال والجبال مع عائلته الجديدة وصولًا إلى دير مهجور، يطلب من موسى أن يقرع جرسه إيذانًا بالوصول. وحتى الآن يقع في الالتباس بينه وبين آخر، ويشكّ في حقيقة وجوده وإمكان توهّم كلّ ما جرى. يوصي موسى بأن يصعد بجسده الضئيل إلى قمة تلّة تشرف على البلاد، ليحرق جثته، فتنطوي إذ ذاك حكايته- مهزلته.
الكلام بنية الثلاثية: تيّار التذكّر والشفاهة
أمام غياب الحدث الفعلي الخارجي أو ندرته بما يشكّل متتاليات سردية تصنع حبكة الرواية، لاسيما في جزأيها الأول والثاني، يتساءل القارئ عمّا يصنع من هذا الحكي عملًا سرديًّا فنّيًّا! كما يحاول إيجاد مخرج فنّي وتعليل للإملال الذي قد يصيبه جرّاء التكريريّة والعودويّة والاستفاضة الوصفيّة إلى حدّ يتوقّف معها الزمن في امتداد لانهائي للحظة. إذ ثمة امتدادان يتكافآن؛ الاسترسال في التأمل في الذات ومناجاة النفس، والتركيز على قصص مستعادة تقبع في ذاكرة شخصيّة وحيدة، هي شخصية عبدالجليل،هي شخصيّة وحيدة رسالته في الوصف – مهزلته.
إلى دير مهجور يطلب من موسى أن يقرع جرسه إيذانًا بالوصول. ينتج تطويلًا في زمن القراءة وينسجم مع امتداد المشهد المكاني للصحراء.
بين التذكّر والذكر قرابة لفظية دلالية تتجلّى في التصادي لموضوعات متكررة، يوحي بتكرار ذهني يتيح للإنسان أن يتفلّت من قيود الزمن والمادة ليتعالى إلى التأمل. «لماذا أستعيد تلك الأيام؟ أظن أن في هذا حالة كثيفة من الحزن ومن الحنين إلى تفجّر ماء الحياة من جديد.. كأني بحاجة إلى إعادة تأليف هذا العالم وأنا في أكثر مطارحه وحشة وتيها وجحودا». هما إذن، امتدادان داخلي وخارجي، عمودي يسبر العمق النفسي المضطرب لعبدالجليل، وأفقي في الحيّز الصحراوي حيث لا شيء غير الهباء والاحتمال. ربما تكون الحقيقة الوحيدة في كل ما يحكيه عبدالجليل الذي بات كيانًا نفسيًّا لا نرى إلا من منظوره، هي هذه الصحراء الخارجة على قانون التحوّلات، إزاء هشاشته وسيره بين كثبانها دائمة التشكّل بفعل الرياح.
يتلمّس القارئ جنوحًا نحو متعة البلاغة الوصفية المكثّفة، وأناقة اللغة الشاعريّة، فضلًا عن تفسير الراوي ذاتي الحكاية وتحليله لما يصيبه أو يبدر منه في استدراك متكرّر بما يشبه التنبيه والتذكير، وهو الشاعر المثقف، بأنّه من عادته تحليل أي شيء، وهي عادة قديمة أو خاصيّة من خصائصه التي ما زال يحتفظ بها على الرغم من ربع قرن من السجن، وملامسته حافة الانهيار العصبي وتراوحه بين التعقل والجنون، «لا أعرف أكنت أحلم بذلك أم هو شطح من خيال.. كأن ما يحدث عبور في منام وغير حقيقي.. البرزخ الفاصل بين الوعي والجنون، بين الصوت والصمت». إنّما جاء «التعليل» بوصفه تقنيّة سرديّة لواقعيّة القصة وفنيّتها كي يبقى القارئ في دائرة التصديق، فيتّضح المخرج الفني، في تناسب اللغة للشخصية، والإيهام بالواقع في استباق سؤال القارئ «لماذا؟».
وفي وجود الشخصيّة الصامتة للكلب «فرند» المروي له في الجزء الأوّل، تقديم حل فنّي لمناجاة النفس باعتماد عبدالجليل ضمير المخاطب في تداعي ذكرياته، وتيّار حكي ما قبل الكلام وفوق النسيان، ووصفه السيكولوجيّ في منظر مضاعف، «أنت تحب الحكايات.. عندما أصيح وأشتم أكون قد أشتم عجزي.. متاهتي، حياتي. هل تفهم؟ أهين نفسي من خلالك، أشتمها عبرك»، كما في تخيّله تارة سيناريو لقائه بزوجة القتيل حامد المقدسي في شارع الست بلقيس، وتارة أخرى سيناريو متاهة فرند في وادي الدموع. ذلك في تناوب أفعال التذكّر والإحساس والتخيّل والتأمّل: أحلم، أتخيل، أشتاق إلى تلك الأيام، أذكر، دعني أكمل لك.. فالكلام منفذ للخلاص لدى عبدالجليل، «تصبح حياتنا خفيفة عندما تتحول إلى كلام.. لكي يعبر المرء هذه الصحراء عليه أن يستعين باللغة. اللغة خيل يعدو بي أو يمشي خببا في هذا المدى». جميعها تقنيات تيّار الوعي، وقد وظّفت لإضاءة حالة التفكّك النفسي والتجربة الإنسانيّة – الوجوديّة للسجين المثقّف على وجه الخصوص، والسخرية من هذا الكم من العنف والكراهية في تاريخ البشر.
ليس غريبًا أن يقترب الحكي من أسلوب الحكواتي أحيانًا في توليد الحكايات، إلى جانب المواويل والاقتباسات الشعرية؛ إذ أنّ الشفاهة – الصوت قضية مطروحة في العمق، «لم أكن معي حين أسير إلا إذا سمعت صوتي يروي شيئا عنّي أو عن غيري»… ليس قصص عبدالجليل وحسب، بل حكايات الجدة، وديوان الحياة القرويّة بخرافاتها وعاداتها، «والحكايات الشعبية وقانونها الحذف والإضافة والخلط لتتسق مع الواقع الجديد والبيئة»، جميعها آثار شفيفة من شوق وحنين وذاكرة رعويّة لزمن خصب لا يمكن تقييدها، «هكذا كنت أخط وأمحو أو أترك آثار كلامي على الرمل تتكفل بها الريح». حال الراوي المنهك كحال شيخ هرم يخشى على ما خزنته ذاكرته من الفقدان، يودّ الإمساك بها قبل ذهاب آخر من بقي من الرعاة ومن ينتمي إلى مكان بكر، يذكّر بالكاتب أنيس فريحة في مجلّده «حضارة في طريق الزوال».
الغناء والارتحال متلازمان لدى الرعاة والمرحّلين على السواء؛ وفي إلحاح الراوي، السائر أبدًا، على الحكي تأكيد لإيجاد بدائل للحياة عندما تصبح الأمكنة جميعها غير قابلة للعيش فيها؛ فأجمل الأمكنة هو ما يحمل في الذاكرة والقلب والأغنية. «الناس في هجراتهم يحملون ما هو حميم وضروري وخفيف.. يستذكرون إن حكوا من رحلوا، والبلاد التي تركوها خلفهم للهباء؛ أما غناؤهم فهو حزين على الدوام». الأمكنة تتقوض، الزمان يتكرر، والحزن باقٍ وثابت، فيحضر الغناء كونه الأقدر على التعبير عن الخيبة والخذلان.
الكتاب الموازي لعبدالجليل:طيف النفري ورسالة موسى وأبوة إبراهيم

«لكي تصبح الأشياء تستحق أن تروى لا بد لها من نهاية»، هكذا ارتأى عبدالجليل، مبديًا رغبته في التدوين، غير مكتفٍ بتجربة الشفاهة؛ كأنه المخاض الأخير لمراحل ينبغي المرور بها على طريقة المتصوفة في التقرب من الله. رأى في خاتمة الثلاثيّة يدًا تطويه ككتاب، لكنه في استعادة مخطّط حياته ومساره، يستلهم قول محمد الماغوط «خمسون عاما وأنا أسير أسير ولم أصل إلى شيء… هل الخطأ في الطريق أم في قدمي؟». إذ بدأ من النسيان الكامل إلى التذكر، إلى صحبة العدم، فالشجر في شجرة السدر، فصحبة الحيوان في الكلب، فالطير الذي كان يرسم له مسار الحنين، فالإنسان الذي في موسى ومريم ورضيعها ونجاة، إلى العشرة الكاملة مع الجديين والخيل؛ فصار عائلة رعوية ترتحل مع الفصول. على التلّة حيث وصل مع عائلته الصغيرة إلى الدير، تمنّى لو يستطيع أن يبدأ من جديد الحياة الأكثر نقاء في هذا العالم، فيبنون بيتًا وحظيرة… عاد إلى أوّله، ولم يكن يتوقع نهاية حياته كما بدأها، أن يعود راعيا.. كما الغابة لدى الماغوط، تتبدّى المراعي لدى عبدالجليل الغزال الفضاء البكر المنشود.
وفي موته أراد جنازة شاعريّة تليق بالفجيعة؛ لكن، ماذا بعد الموت؟! في وصيته لموسى أن يحمل جسده على ظهر الحمار في خرج ويضع ثقله حطبا من الجهة الثانية ويصعد به إلى قمة ليحرق جثته… طلب أن يقف عند رأسه ويقرأ عليه ما يشاء من «الشعر»، متماهيًا مع مشهد حرق كتب ابن رشد، رافعًا الشعر إلى مرتبة القداسة، راسمًا نهاية دوره الرسولي كما يليق بالشعراء؛ وهو في ما مضى على قمة جبل آخر، بدا لنفسه مثل «نبي وحيد سيبشّر نفسه فقط برسالة إلهيّة، وليس من أحد سواه ليتلو عليه رؤياه». وموسى مرافقه كأنه مريده، يبتغي منه أن يكتب التاريخ كما يرى من مآسٍ بغير مجاز، بلغة تقريريّة واقعية موازية تصف الحقيقة كما هي، ولن تكون أشد قسوة مما يرى، وأن يجعل للمسرّات كتابا آخر «أرأيت يا موسى؟ التاريخ لا يكتب بالمجاز والاستعارة، كما أقول الآن فيض مشاعري.. الكتّاب يهربون في الكلام ..لا يكتبون؛ نصف شعراء الأمة مدحوا القاتل، ونصف المؤرخين محوا الجريمة من الكتاب.. اكتب ما تراه؛ ولا تنسَ مدخل الكتاب، اجعله لائقًا بهذا الرحيل».
تطفو من جديد تجربة النفري الذي ينسب إليه القول إنّ «القلب يتغيّر، وقلب القلب لا يتغيّر، والحزن قلب القلب»، وأنّه لم يكن يكتب ما يقول، إنما كان يؤلف كتابه شفهيًّا لمريديه ويكتفي بذلك. ولاسم موسى ودوره، كما لاختيار نهاية مماثلة لعبدالجليل، وإعلان العودة إلى الأصل والبكارة، دلالات تذهب بالقراءة إلى تأويل تاريخ البشريّة بدءًا بالأب المؤسّس «إبراهيم»، أب الكثرة، ورمز الرابطة الروحية والإنسان المؤمن بالرجاء والنجاة في سبيل مغامرة يائسة، «سأكون الأب وأنتم الأبناء تروون سيرتي بعد موتي للأحفاد» هكذا يخاطب عائلته المستجدّة. واستطرادًا، قراءة تفكّك معنى الرسالات التوحيديّة، ودلالة الخروج الروحيّة في حياة الشعب في التحرر من العبودية. فبين عكاز عبدالجليل وعصا موسى قرابة، واستمراريّة في الإشارات المسرّبة، والانزياحات التاريخيّة لرحلة التيه والشتات للعبرانيين في الصحراء لدى خروجهم، وقيادة موسى لشعبه إلى الأمان، وهو الذكر الأوحد الناجي من بطش فرعون، ومن «الضربات» بأعجوبة، وهو كليم الله فوق جبل طور، وشاهد الدغل المشتعل، أو الشجرة المباركة بنور يوجّه العباد والبلاد. وبين فصاحة لسان هارون أخيه وفيض اللغة الشفاهية لدى عبدالجليل طرف شبه إزاء وديعة التسجيل في «الكتاب» بيد موسى.
في العلاقات المثلّثة
في هذا المسير سيرورة ترسم صيرورة ما، تبدو البداية في الخروج، والسعي للعودة إلى الديار، بحثًا عن الأوّل. ونخال النهاية في الوصول إلى الأمان، ربما إلى أرض الميعاد للتأسيس حيث النقاء والحياة البكر في دير مهجور على قمة الجبل. ولعلنا لم نفاجأ باحتراق الجسد الضئيل لعبدالجليل الغزال ليأتي من رماده جيل جديد. إنما الرحلة هي ثلاث رحلات متلازمة: في حقيقة الانتقال، رحلة مكانيّة في الصحراء وبين الخرائب والقرى المنكوبة والجبال، في حركة تقدّميّة؛ وفي مجاز الانتقال، رحلة زمانيّة صوب الماضي، في حركة تراجعيّة. ورحلة ثالثة صوفيّة وجوديّة «لوعي شقي» نحو الذات بحثًا عن أصالة اختبار، وفهم ألم التمزّق بين الداخل والخارج، في تاريخ الجماعات والأفراد.
استعان المسافر إذن، في هذه الرحلة بثلاثة عكاكيز: الذاكرة والمشي وعكاز حقيقي مصطنع بمنزلة معين مادي بديل عن رجل معطوبة، ومعادل فنّي اجترحه الروائي ليكتمل المشهد البلاغي، تعضده تجربة الحلاج بالمحاكاة «رأيت ظل التابوت في الدرب/يمشي/يتكئ على عكاز/ظننته نعشي»؛ لتستمر لعبة التوازي بين الاستعارة والحقيقة داخل النص.
لا يكره عبدالجليل سجانه ولا يريد الانتقام، بل يدين الكراهية والتلذّذ بالتعذيب. يطرح علامات استفهام حول العنف التأسيسي، في تأملاته وحالاته المتراوحة بين الوعي والهذيان، التذكر والحلم، وفي وضعه «البَيني» أمام الشك والتصديق بوجوده. كل شيء ملتبس كما تاريخ البشرية، لكن ثمة حقيقة تُستخلص ممّا يسرد؛ أراد إعادة كتابة التاريخ، تأسيسًا بالكلمة في ميزان الحق، فيشدّد على موسى «المكاييل هي أساس في كل شيء.. هي التي نزن بها حتى الكلام.. اللغة خفيفة كالهواء وثقيلة كالرصاص».. ولا تغرّنّكم التواريخ والتدوينات والبدايات والأطوار!
الثلاثية مرثية غنائية سرديّة للذات الإنسانيّة، في لحظة الواقع العربي، هنا والآن، تستدعي كتاب «الكتاب» لأدونيس الذي اتخذ قناع المتنبي ليهجو التاريخ العربي. كما نشيد «كارمينا بورانا» من العصور الوسطى في مناجاة إلهة القدر «لا فورتونا». وتستحضر تاريخ الشعر العربي التقليدي في تبجيل الوقوف على أمكنة أمست أطلالا، وإلقاء السلام على وجودات كانت فيها، تقديرًا لذاكرة المكان والحنين للأحبة، في غنائية شعريّة ممتدّة في أبيات القصيدة بتماهيها مع الامتدادات الصحراوية زمنًا ومسافة. وعبدالجليل الغزال أراد، في إملائه على تابعه موسى ما ينبغي أن يخطّه في الكتاب، سرد «التراجيديا الإنسانية»، وكأنما في ختام الثلاثية، تبلّغ وبلّغ واستراح!




