التبرع بالخصوصية يعيد رسم مهام الأخ الأكبر

خلع التقدم التكنولوجي المتسارع نوافذ المراقبة المواربة، وألغى دورها، وأحالها إلى التقاعد، وقطع الطريق على الأخ الأكبر الذي لم يعد في حاجة للتحري وتتبع الأسرار في ظل علنية التعري المجتمعي وموت الخصوصية لدى الفرد.
قبل خمسة وثلاثين عاما رصد الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو (1926 ـ 1984) في كتابه “المراقبة والعقاب” تطور نظام معاقبة الإنسان من إيذاء الجسد وتعذيبه إلى عقاب حضاري يبدو أكثر لطفا ويتسم بتقييد حرية الإنسان ومراقبته من نافذة صغيرة وحبسه، لكن يبدو أن هذا النظام تقهقر تحت وطأة التبرع الذاتي بالخصوصية. فكل فرد يمتلك حسابا في “تويتر” أو “فيسبوك” أو “لينكد إن” أو غيرها من التطبيقات. صار كتابا مفتوحا، واضح السمات، سهل الإطلاع. والمثير في الأمر أن ذلك لم يعد أمام السلطة وحدها وإنما أمام الجميع، سلطة وأفراداً ومؤسسات وأجهزة وكيانات عملاقة وعالما يسّوق كل شيء.
في القاهرة، عاصمة النمائم والحكايات الخاصة، كان لدينا مثل شعبي شهير يقول “سرك في بير” للتدليل على خصوصية ما يبوح به شخص ما لأحد أصدقائه، فلا يتجاوز البوح كلاهما. أما الآن فصار من النادر أن تسمع هذا المثل، لأنه لم تعد هناك أسرار أو حكايات حصرية يمكن الاحتفاظ بها لوقت طويل. فتطبيقات وتحليلات صفحات التواصل الاجتماعي وما تحتويه من اعترافات وبوح تطوعي أسقطت الحجب، وأزالت الأقنعة، وقدمت تحليلا تفصيليا لكل شخص.
سقوط السرية
تمثل الملفات الشخصية للمستخدمين ثروة كبيرة لمحللي البيانات، فمن خلالها يمكن أن تعرف كل شيء تريد معرفته. وباتت أجهزة استخبارات عالمية تعتمد عليها بشكل كبير، وتخلت عن جزء كبير من المهام المباشرة للحصول على المعلومات، بما وفّر الوقت والجهد والدقة. وهي عملية معقدة تخلط بين العام والخاص، والمعروف والمجهول، ويمكن من خلال تحليل البيانات الحصول على نتائج مذهلة لتحسين الأداء.
قالت دعاء سليط، الخبيرة في شؤون مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، لـ”الجديد”، إن تصفح حساب أيّ فرد يمكن أن يساعد كثيرا في التعرف على أمور كافية لعمل ملف كامل عنه، بدءا من ميوله الشخصية، مستوى ثقافته، أفكاره الخاصة، فلسفته في الحياة، معتقده الديني، ومرورا بهواياته واهتماماته وتوجهاته ومواقفه السياسية، حتى موقفه من المرأة ودرجة تقبله للآخر.
يمكن التعرف على محيط علاقاته بأصدقائه وأقاربه ومعارفه، والأماكن التي يرتادها، والألوان التي يحبها، والنادي المفضل له، والمطرب المحبوب، وكاتبه الأول، والأطعمة والمأكولات التي يفضلها، وهكذا لم تعد هناك خصوصية بالمعنى المألوف.

أشارت سليط، إلى أنه على الرغم من تباين مستوى الخصوصية المسموح به في التطبيقات المختلفة، إلا أن جميعها تصب في النهاية في صناعة رسومات بيانية تصلح كأدلة ذكية لقراءة مجتمع ما. وإذا كان “فيسبوك” يسمح بمستوى خصوصية أكبر عندما يغلق المستخدم حسابه على أيّ شخص خارج محيط أصدقائه المباشرين، فإن مشاركته في بعض الصفحات والمجموعات الخاصة باهتمامات بعينها تكشف جانبا غير مباشر في شخصيته. كذلك فإن ربط تطبيق ما بآخر يؤدي إلى إسقاط جانب من الخصوصية المفترضة.
وأضافت خبيرة مواقع التواصل الاجتماعي، أن خطورة الأمر تكمن في أن التطبيقات لا يقتصر كشفها على الزمن الحاضر والماضي فقط، إنما يمتد الكشف إلى المستقبل القريب منه والبعيد. فمن خلال تحليل حساب شخص ما على التطبيقات الاجتماعية يمكن التنبؤ بتصرفاته وسلوكياته المستقبلية في العمل والأسرة والحياة بشكل عام. ويصل الأمر إلى إمكانية السيطرة على تحركات عدوانية محتملة له، أو بصورة يمكن عبرها دفعه وتحريضه على أعمال عكسية أو توجيهه نحو تصرفات بعينها.
لم يعد غريبا على إدارات الموارد البشرية في الشركات الكبرى أن تعتمد على صفحات التواصل الاجتماعي للعاملين لديها أو المتقدمين للعمل للمفاضلة بينهم من خلال تحليل بيانات الملفات الشخصية في تلك الصفحات. وطبقا لنظرية عالم النفس الأميركي ميشال كوسينسكي، فإن عناصر الملف الشخصي على تويتر وعدد متابعيه، وعدد من يتابعهم المستخدم وعدد وطبيعة التغريدات كافية لتحديد السمات الشخصية للفرد ومعرفة إن كان محبا للتعاون أم لا، وقادرا على الاندماج في فريق عمل أم هو محب للعمل الفردي، لديه الروح الكافية للابتكار ويحب الحلول غير التقليدية أم يفضل التوجهات المحافظة والنمطية. وغالبا ما تتطابق النتائج الفعلية لذلك التحديد بنسبة 90 في المئة. وتبرهن فكرة التنبؤ على صحة العبارة الشهيرة للسياسي البريطاني وينستون تشرشل (1874 ـ 1965) التي تقول “من يرغب في استبيان ما يضمره المستقبل فلا مندوحة له أن ينظر إلى الماضي البعيد.”
المقاطعة غير واردة
يطرح التكشف والتعري المجتمعي سؤالا منطقيا، مفاده إن كان الحل هو مقاطعة مواقع التواصل الاجتماعي تماما؟ وبمعنى واضح هل من الأفضل تجاهل العروض المتكررة على الهواتف الذكية للاشتراك والربط بين تطبيق وآخر، أو حتى هل البديل هو عدم التورط في استخدام هواتف ذكية والاكتفاء بالهواتف البدائية التي تقتصر على الاتصالات الهاتفية فقط؟ في الغالب ستكون الإجابة بـ”لا”، على الرغم من أن هناك أشخاصا نادرين حولنا اختاروا ذلك.
يرفض الكثير من الخبراء فكرة المقاطعة كردّ فعل وقائي لاعتبارين. الأول ذلك مستحيل، لأن كل شخص تقريبا مرصود ومستباح وخاضع للعيون والرقابة بمجرد دخوله على شبكة الإنترنت، ومن المستحيل مقاطعة الشبكة العنكبوتية تماما. أما الاعتبار الثاني، فهو أن هناك فوائد ومكاسب عديدة لاستخدام صفحات التواصل الاجتماعي، ويصعب التفريط فيها، فمن خلالها يمكن لكثير من الأشخاص استعادة الأصدقاء القدامى، وهناك حركة تجارة واسعة عبرها.

أكد راجي عامر الكاتب الصحافي والخبير في إدارة صفحات التواصل الاجتماعي لـ”الجديد”، أن الخصوصية تنتهي بمجرد الاتصال بالإنترنت، كذلك فإن محرك البحث الشهير غوغل بجانب التطبيقات والمواقع المختلفة تعلم عنك أكثر مما تعلمه أنت عن نفسك، لأن هذه المواقع تعي جيدًا تفضيلاتك واهتماماتك وردود أفعالك بل أنواع البضائع التي تفضل شراءها أو الأماكن السياحية التي تحلم في المستقبل بزيارتها. وجميع البيانات الرقمية تخضع لمستويات مختلفة من التحليل للاستفادة منها، من هنا يصح القول إن البيانات سلعة ثمينة للغاية يتبرّع بها المستخدم لهذه المواقع.
في تصوّره فإن المقاطعة غير ممكنة، لكن نحن في حاجة إلى المزيد من الانضباط الداخلي عند استخدامنا للمواقع الاجتماعية، حيث يفضل أن نقلل من التعبير عن أنفسنا لأن هويتنا مثلما تتكون من ذات عامة تعيش العالم الاجتماعي الحقيقي فإنها تتكون أيضًا من ذات خاصة تحتاج المزيد من الخصوصية لحماية أفكارنا من التشويش والتلاعب بها.
رد فعل مقاوم
يرى البعض من الخبراء أن فكرة التبرع بالخصوصية جاءت كرد فعل مباشر لاتساع نطاق الرقابة الإلكترونية لكل شيء، ما عبّر عنه الفيلم الشهير “سنودين” والمنتج عام 2016، والذي تناول قصة حقيقية بطلها شاب أميركي يدعى إدوارد سنودن عمل كخبير تقني في وكالة المخابرات الأميركية، رجل المخابرات قبل أن يهرب في صيف 2013 إلى الصين ثم إلى روسيا، ومعه ملفات ضخمة تحتوي على بيانات ومعلومات تفصيلية بشأن كافة الأفراد نتاج علاقات التعاون بين شركات الإنترنت والمخابرات الأميركية.
وكشف وولفغانغ كريغر في كتابه “تاريخ المخابرات من الفراعنة حتى وكالة الأمن الأميركية”، ترجمة عباس عدنان علي، والصادر عن سلسلة عالم المعرفة بالكويت في أبريل 2018، أن القوانين الأميركية للدولة تجيز إكراه الشركات على تمكينها من التجسس على ما تقدم من خدمات وعلى ما تخزّن من معلومات ذات أهمية بالنسبة إلى الأمن القومي.
أوضح كريغر أن ذلك ليس قاصرا على الولايات المتحدة فحسب، فالقوانين السائدة في الدول المشهورة باحترامها للحريات المدنية أيضا تجيز للحكومة مطالبة الشركات الخاصة بتزويدها بمفتاح الاتصالات المشفّرة وبنسخ مسجّلة من الاتصالات الهاتفية. وإذا أخذنا في الاعتبار أن أغلبية وسائل التخزين السحابي للمعلومات أميركية بما في ذلك الإيميلات المرسلة على سبيل المثال من هامبورغ إلى برلين، حيث تمر عبر الأراضي الأميركية، فعندئذ يظهر لنا بوضوح أن لدى وكالة الأمن القومي الأميركية ميزة عظيمة الشأن، مقارنة بما لدى الدول الأخرى.

يكفي أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، علق على قضية “سنودن” وقت إعلانها في الصحافة بأن بلاده ستواصل العمل في كل طريق لحماية أمنها القومي، بل وصل الأمر به أن قال في عدم اكتراث بانتهاك خصوصية الأفراد، وإنه لن يعتذر لأحد، لا لشيء إلا لأنهم كانوا أفضل من الآخرين.
هكذا، فإن بناء قناعة ويقين لدى كل فرد في المجتمعات القائمة في العالم بأنه تحت الرقابة دائما، وبأن كل رسالة له، أو حديث، أو مناقشة، أو حتى خاطرة ترد على عقله نتاج متابعة مواقع اخبارية معينة مرصودة ومسجلة، فإن ذلك قد يدفعه دفعا إلى التنازل عن كل خصوصية والتفريط في كل معلومة بلا مبالاة، لأن الأمر لم يعد يختلف، فالرّقابة قائمة مهما حاول الفرار منها. وولّد ذلك شعورا لدى البعض بأن قيامهم بالتعري طواعية أفضل لأنهم يمتلكون حق اختيار إتاحة معلوماته للجميع، ويساوون بين مَن يراقبهم وبين الجميع.
إن الأخ الكبير الذي تنبأ بسطوته الأديب البريطاني جورج أورويل في روايته “1984” التي صدرت نهاية الأربعينات من القرن الماضي، لم تعد له السطوة التي كانت موجودة في الماضي القريب، فالحصول على المعلومة لم يعد صعبا كما كان في الماضي للدرجة التي قد تدفع السلطة أو الجهة المراقبة إلى إيذاء الإنسان أو ممارسة ضغوط بدنية أو نفسية عليه للحصول على تلك المعلومة.
وبحسب قطاع كبير من المهتمين بتكنولوجيا المعلومات، فإن الأخ الكبير الآن تغيرت صورته وأهدافه، وتبدلت أساليبه، ويمكن القول إنه تجاوز نطاق الجهة المحلية التقليدية إلى أخ أكبر عولمي يتجاوز الحدود ويعبر القارات. ويتصوّر هؤلاء أن مهمة هذا الأخ الأكبر لم تعد الرقابة وحدها، كما كان الأمر في الماضي، لأن التبرع بالخصوصية يفي بكشف المعلومات الأساسية دون عناء، لذا فقد امتد دوره إلى توجيه الإنسان وتبديل أفكار المجتمعات والتأثير فيها وتحريكها في اتجاهات تخدم توجهاته.
هناك رأي آخر، يشير إلى أن دور الأخ الأكبر قد يزداد صعوبة مع التبرع بالخصوصية، لأن التدفق اللامحدود في المعلومات يؤدي في بعض الأحيان إلى صور منعكسة، ما يجعل تحليلها أمرا صعبا، وهو ما يتطابق مع مقولة الأديب المصري الراحل جمال الغيطاني الواردة في دفاتر التدوين والتي تقول “القرب بعد، الدنوّ يخفي، النأي يكشف، لا يرى المسافر إلى ما بعد عنه”. يرى أصحاب هذا التوجه، أن المعلومات المكثفة قد تتعارض وتتباين بدرجة كبيرة تدفع إلى القراءة الخاطئة للمستخدمين، ما تنتج عنه قرارات خاطئة. وبشكل عام يعتقد البعض أن هناك تباينا في تعاطي الشعوب مع مواقع التواصل الاجتماعي، فهناك شعوب تحولها إلى أصل ثابت في حياتها، وهناك من يستخدمها كمنصة تعبير فقط.
أوضح الدكتور سعيد توفيق، أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ”الجديد”، أن الإشكالية في المحيط العربي تكمن في أن مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي صارت جزءا لا يتجزأ من الحياة، فالأغلب من مستخدمي تلك التطبيقات يبيحون كل حيواتهم للآخرين، فيتنازلون عن خصوصياتهم بدرجات تفوق ما تفعله الشعوب الأخرى، والاستخدام الأمثل هو ألا تتجاوز استخدامات السوشيال ميديا حدود التعبير عن الرأي في نطاق عقلاني وهادئ، أو الإشارة إلى نشاط علمي، بعيدا عن الحياة الشخصية إلى الجمهور.
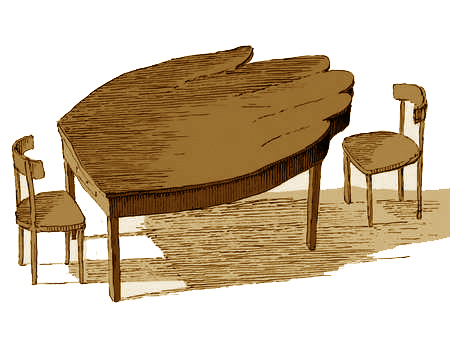
وأكد أن هناك مَن يقضون ساعات طويلة كل يوم يطرحون فيها أمورا تافهة وحكايات ساذجة بلا معنى وكأنهم يتنافسون في ذلك، والاستخدام السّيء لصفحات التواصل الاجتماعي ينتج عنه الكثير من العادات المرذولة التي من أهمها تنميط الاستجابات لنداءات أو مطالب بعينها، ما يُرسّخ فكرة سياسة القطيع. كذلك فإنه يكرس صفة النفاق من خلال محاولة البعض انتزاع الإعجاب من أصدقائه على أي شيء كتبه ولو كان كلاما سطحيا تافها، ما يفضي بدوره إلى تدني القيم الحقيقية وتسييل معايير التقييم، فلا تبدو ثمة فوارق بين الحسن والقبيح.
أشار الدكتور وليد رشاد، الباحث في المركز القومي للبحوث الاجتماعية بالقاهرة، لـ”الجديد”، أنّ تلاشى الخصوصية أدى إلى اتساع المشكلات، خاصة أن الفضاء السحابي يموج بكافة أطياف البشر، وأن جانبا كبيرا من الحسابات الموجودة على السوشيال ميديا مزيفة تستهدف مصالح دعائية شخصية، أو أيدولوجية أو سياسية.
وضرب المثال بعدد حسابات السوشيال ميديا في مصر، فالرقم المعلن هو 40 مليون حساب لكن في ظل الأمية الموجودة فمن المستحيل أن يكون عدد مستخدمي التواصل الاجتماعي تمثل 40 في المئة من السكان، ما يعني أن هناك نسبة قد تقترب من نصف هذا العدد تعبّر عن حسابات مزيفة. وثمة مشكلة أخرى تتمثل في تصور الفرد في العالم النامي بأنه لا توجد سلطة تحكمه عبر الفضاء المفتوح، ما يدفعه إلى استخدام ذلك الفضاء في الإساءة لآخرين أو لقيم أو دول أو عقائد، ومن هنا فإن هناك اهتماما عالميا محموما بوضع قوانين رادعة لإساءة الاستخدام.




