كن كثرة في واحدٍ وتجنب الحشد

رسائل الفيلسوف الرواقي سينيكا رائعة من روائع الفلسفة القديمة، كُتبت منذ حوالى 2000 عام في فترة اعتزال الفيلسوف السياسة مخافة بطش الإمبراطور به في السنوات الأخيرة من حياته، والتي انتهت بإعدامه فعلاً على يدي نيرون عن عمرٍ ناهز السبعين.
بين دفتي الكتاب صورة أخلاقية للعالم الروماني القديم من عيني سينيكا، تظهرُ في قالب شخصي على شكل خطابٍ حميم بين الفيلسوف وصديقه، وهي صورةٌ كثيراً ما تكون مفاجئة، خصوصاً من حيث قناعات سينيكا الدينية حول الإله الواحد، ومزاوجته بين الوثنية والتوحيد خارج إطار المسيحية، وأيضاً من حيث موقفه الأخلاقي السابق لأوانه من معاملة العبيد في عصره.
الرسائل تكثيفٌ لفلسفة الأخلاق الرواقية، فتعالجُ مفاهيم الثراء والبذخ وتأثيرهما في الفرد والمجتمع، والفقر والخوف منه، والسلطة والطغاة، والصداقة والخيانة، والحياة السعيدة والكآبة، والعلم والأدب.
ستصدر قريبا ترجمة عربية فاتحة لهذه الرسائل قام بها الكاتب والمترجم السوري المقيم في القاهرة الطيب الحصني الذي خص الجديد برسالتين منها ومقدمة الترجمة.
الرواقية، ذلك المذهب المتجذر بعمق في الفلسفة والثقافة الغربيتين يعود اليوم إلى التبرعم والإيراق في الثقافة الشعبية في العالم، فما الذي يجعل نصوصاً بعمر الألفيات تصاغ مجدداً، لتساعد الناس في القرن الحادي والعشرين على إيجاد الحياة السعيدة؟
إن سبب ذلك، في جزء منه، يعود؛ ولا شكّ؛ إلى كون الرواقية؛ في متونها؛ فلسفة تفرض على متّبعها مجموعة من الممارسات يوميةً لتجويد الفكر وتحسين الحياة، وإنّ هذا يسمح لنا أن نشبه تأملات أوريليوس أو رسائل سينيكا، إلى حدّ ما، بكُتب المساعدة الذاتية التي كثُرت في عصرنا، مع فارقٍ جوهريّ: إن سينيكا أو أوريليوس أو حتى من سبقهم من الرواقيين اليونان لم يَجمعوا هذه الحِكم والممارسات بغية نشرها ربحيّاً، بل جمعوها عن قناعة إنسانية بقدرتها على التنوير.
ولعل رسائل سينيكا المثال الأوضح على ذلك، إذ كتبها في أواخر حياته – في القرن الميلادي الأول – بعد فقدانه الحظوة لدى الإمبراطور المستبد نيرون، ووجهها إلى صديقه، وقد نقول مُريده، لوكيليوس، فجاءت حوارات على نمط أدب الرسائل، إلا أن الفلسفة والوعظ فيها لا يطغيان على المرح الأدبيّ الذي يملأ رسائل الصديقين، فانظر إلى المدخل الكوميدي السياسيّ الذي يعظ فيه سينيكا لوكيليوس في شأن الصداقة:
“لقد أرسلت لي رسالة مع ‘صديق’ من أصدقائك، على حد تعبيرك، وفي الجملة التالية حذرتني من مناقشة شؤونك معه […] أي بكلمات أخرى: لقد وصفته بأنّه صديق، وأنكرت عليه ذلك في الرسالة نفسها. حسنٌ، إذا كنت تستخدم الكلمة بالمعنى الشائع، وليس حسب معناها الدقيق عندنا، أي أنك تقول عنه ‘صديقي’ بنفس المعنى الذي نقول فيه عن المرشحين في الانتخابات أنهم ‘سادة محترمون’ […] فلا حرج عليك في ذلك. ولكن إنْ كنت ترى في أيّ شخصٍ صديقاً ولا تثق به كما تثق بنفسك فأنتَ تقعُ في خطأ فادح، وقد أخفقت في أن تفهم حقاً القوة الكاملة للصداقة الحقيقية”.
هذه الرسائل التي كتبها سينيكا من معتزله عن السياسة والحياة العامة – أو منفاه عنها، إذ أن فقدان الحظوة لدى نيرون يعني تهديداً مستمراً بالقتل – تشكل خلاصة ما وصل إليه الفيلسوف من نصح للحياة الرشيدة والسعيدة، ولو سمحت لنفسي بأن أعيد صياغة جوهرها بأقصر ما يمكن سيكون على الشكل التالي:
ندري جميعاً أن قسماً كبيراً من المهارات هي فنون، لا يمكن إدراكها بالدرس، فأنت مثلاً، لن تصبح ماهراً في إحراز الأهداف من الركلات الحرّة عبر دراسة المعادلات التي تربط بين وزن كرة القدم وتسارعها وانحرافها بالدوران، ولن تنجح في أن ترسم “بورتريهات” جميلة عبر دراسة المنظور الهندسي والأبعاد، بل عليك أن تمسك القلم وتحاول رسم وجهٍ تلو الآخر، ومن ثم بعد عرضها على من أثبتوا جدارتهم في ذلك الفن، تتبع نصيحتهم لتجويد رسمك، وكذلك كي تتعلم تحقيق الأهداف من الركلات الحرة لا بد لك من أن تقف على الملعب نفسه، وأن تتدرب على عدد كبير منها، حتى تبدأ بالتحسن. والادّعاء الرواقيّ هو أن معظم ما نعاني من الإخفاق فيه في حياتنا: الصداقة، العمل، الحب، الحداد على موتانا، وهلم جرّا، لا بد من إتقانها بنفس الطريقة، وفائدة دراستها نظرياً هي كفائدة معادلات تسارع الكرة للاعب كرة القدم شبه معدومة. وعلى ذلك فإن سينيكا يعطينا توجيهات قصيرة ودقيقة، جارحة وبليغة، ويعدنا بصداقات تدوم، وعلاقات لا تنتهي بأحزان، وأعمال نحقّقُ فيها ذواتنا من دون الانهيار أمام الكآبة.
إن إغراءات هذا المنهج الأخلاقي واضحة، فهو، فضلاً عن وعوده، يبرّرُ إلى حدّ كبير لماذا يكون كثير من الدارسين لمجال إنساني معين مخفقين فيه، أحد الأمثلة القريبة في الذاكرة هو انتحار جريجوري إيليس، مدير خدمات الدعم النفسي في جامعة بينسلفانيا، كما أيضاً الارتفاع الغريب لمعدل الانتحار بين المعالجين النفسيين مقارنة بعامة الناس.
كل ذلك جزء من الدافعة القوية التي ترتكز عليها الرواقيّة الجديدة والتي تزداد قوةً وعدد مريدين منذ أواخر القرن الماضي بكتب جديدة بأقلام فلاسفة كبار، وهناك أسباب أخرى تتعلق بارتباط العلم في الغرب بالمؤسسات الربحية والتعامل الإعلامي مع الفلسفة على نحو عِلمويّ لا متسع للاستفاضة فيها هنا.
علاوة على ذلك، تشكل رسائل سينيكا إطلالة فريدة على العقائد الدنيوية والروحية في روما القديمة والتي كانت مقدّمة لخطاب الكنيسة المسيحية المبكرة، فالغرب قد أسهب في تتبع تأثير المصطلحات والجدالات الرواقية في رسائل بولس الرسول والأناجيل، وحازت أعمال سينيكا على رضا المسيحيين المبكّرين، فأدرجه القديس جيروم ضمن فهرست الكتّاب المسيحيين.
ومع أن لذلك أسباباً تاريخية – إذ اعتمد جيروم على رسائل مزعومة بين سينيكا وبولس الرسول – فإن كتابات سينيكا نفسها تفيض بأفكار توحيدية عن إله عادل مهندسٍ للكون، والروح الخالدة، ويوائم سينيكا بينها وبين التقدير الذي يحافظ عليه لآلهة روما القديمة، إلا أنّه من جانبٍ آخر يرفض الخرافات، فيقول “ليس هنالك حاجة لنرفع أيدينا إلى السماء، ولا حاجة بنا للتوسل لكاهن المعبد ليسمح لنا بالاقتراب للحديث من صورة منقوشة، وكأن هذا يزيد من فرصتنا في أن نُسمَع”.
والحقيقة أن المرء يجد نفسه في شيء من الحيرة عند تقديم سينيكا، ذلك أن خصوبة نثره تستفزُّ كل معارف المرء، ومحال أن يمرّ فيه من دون أن يجد معتقداته تتشذب في مكان كان يحسبه ثابتاً، وتورق في بقعة كان يحسبها جرداء إلى الأبد، وفي مكان ثالث يجرح سينيكا غصنا ثابتاً من معرفتنا بأنفسنا، ليطعِّمَها بفكرٍ جديد.
أسوق على ذلك مثالاً واحداً: اتهاماته للفلاسفة بأنهم “حتى هم انحدروا إلى مستوى تحديد الاستعمالات المختلفة للمقاطع الصوتيّة، ومناقشة المعاني الصحيحة لحروف الجرّ والعطف. لقد صاروا يحسدون عالم فقه اللغة والرياضيات، وقد استحوذوا على كل العوامل السطحية من تلك الدراسات”. إنّ رأيه هذا يتردّد كصدى قديم للاتهامات التي يكيلها الفلاسفة التحليليون اليوم لزملائهم القاريين، حتى إن النصف الثاني من الاتهام تكرَّر حرفيّاً في العقود الأخيرة عدداً من المرات بأقلامهم، وما يحضر في البال مباشرة هو نقد ليونارد جاكسون القاسي لما كتبه ليفي شتراوس في 1952 “إننا نجدُ أنفسنا نحن الأنثروبولوجيين في وضعٍ حرِج بإزاء الألسنيين. فقد اشتغلنا معهم جنباً إلى جنب، ثم […] رأيناهم ينتقلون إلى الجهة الأخرى من الحاجز الذي يفصل العلوم الطبيعية عن العلوم الإنسانية […] ألمَّ بنا من جهتنا شيءٌ من الحزن، كما انتابنا كثيرٌ من الحسد […] ألا يسعنا نحنُ أيضاً أن نطبق على هذا الحقل المعقد الذي تدور فيه أبحاثنا – القرابة، التنظيم الاجتماعي، الدين، الفلكلور، الفن – تلك المناهج الصارمة التي تبرهن الألسنية كلَّ يوم على فعاليتها؟”.
لم تأت شعبية رسائل سينيكا عبر القرون من عبث، ولا انكباب كبار المفكرين والأدباء على قراءتها طبعاً، إنها منهلٌ متعدد الجداول للنّهمين للفلسفة القديمة، والباحثين في تطور الأديان، ولكنها قبل كل شيء رسالةٌ تدعو إلى حياةٍ أفضل.
تجنب الحشد، وحشية الأرينا
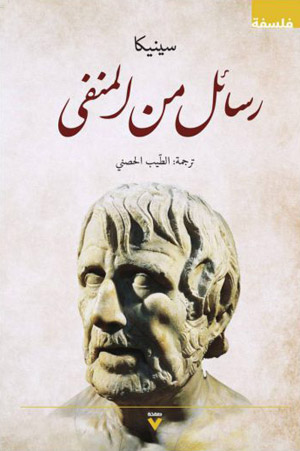
الرسالة VII
إنك تسألني ما الذي عليك اعتبار تجنبه ضرورة؟ جوابي هو التالي: الحشد الكبير. إنه شيء لا تستطيع أن تدخل فيه بلا مخاطرة. وأنا على أيّ حال مستعدٌّ للاعتراف بضعفي في هذا المجال، فأنا لا أرجع إلى البيت بالشخصية الأخلاقية نفسها التي خرجت بها، إذْ يتقلقلُ شيءٌ ما لديّ حيثُ كنت سابقاً قد توصلت إلى سلامٍ داخلي، ويعاودني مجدداً شيءٌ ما من الأشياء التي كنت قد تخلصت منها.
نحن الذين نتعافى من مرض روحي مطوَّل نماثلُ حالة الخاملين الذين تأثروا جداً بخمولهم الطويل بحيث لا يمكن إخراجهم من أبواب البيوت ولو مرة من دون تأثيرات سيئة. إن مصاحبة الناس ضمن أعداد كبيرة شيءٌ مؤذٍ بحق: ليس بينهم واحدٌ لن يُزيِّنَ رذيلةً ما في أعيننا، أو يتركنا حاملين انطباعاً من رذيلته أو ملوثين بها من دون أن نعي ذلك، ولا شكَّ أنه كلما زاد حجم الحشد زاد الخطر.
ولكن لا شيء مدمرٌ للشخصية كإمضاء الوقت في الفرجة على عروض الأرينا، إذْ هناك، عبر وسيط التسلية، تتسللُ الرذائل إلى المرء بسهولة لا تضاهى.
ما الذي تفهمه من كلامي؟ أنني أعودُ إلى بيتي أكثر أنانيةً وأكثر اتباعاً لنفسي وتساهلاً معها؟ أجل، وأكثر من ذلك، أعودُ شخصاً أكثر وحشية وأقل إنسانية لأنني كنت على تواصلٍ مع البشر. ذهبتُ مرةً إلى إحدى تلك العروض في استراحة الغداء، متوقعاً أن تكون هنالك تسلية خفيفة وذكية في ذلك الوقت، وبعض التروّي والرأفة لإراحة عيون الناس من سيلان الدم البشري. ولكن الأمر كان عكس ذلك، فكل ما سبق ذلك العرض لا يعدو كونه عملاً خيرياً إذا ما قورنَ بما شاهدت فيه. فالكلام الفارغ قد انتهى وقته الآن: والآن أمامنا القتل صرفاً وببساطة. المقاتلون لا يلبسون ما يحميهم، وأجسادهم كلها عاريةٌ أمام الضربات، وكل طعنة يلقونها تُصيبُ الهدف. والكثير من المشاهدين يفضلون ذلك على المباريات العادية، وحتى على المباريات الخاصة التي تُنظَّم لإرضاء الطلب الجماهيري. وهذا طبيعي جداً، إذ ليس ثمة خوذ أو دروعٌ تصد الأسلحة. ما المغزى من الدرع؟ أو من المهارة؟ كل هذه الأشياء لا تفيد سوى في تأخير الموت.
في الصباح يُرمى الرجالُ إلى الأسود والدببة: أما في ساعة الغداء فيُرمون إلى المشاهدين. المشاهدون يصرُّون على أن كلّ من ينجح في قتلِ غريمه يجبُ أن يُلقى إلى آخرَ غيره ليُقتل هو بدوره، ويحتفظونَ للمنتصر الأخير بنوع آخر من الجزارة. المَخرَجُ الوحيد للمتنافسين هو الموت. والنار والحديد يبقيان الذبح مستمراً، وكل هذا يحصل بينما الأرينا فارغة فعلياً.
“ولكنه قاطعُ طريق، لقد قتل رجلاً”. وإن كان؟ لو فرضنا أنه قاتلٌ، ويستحق هذا العقاب، فما الذي فعلته أنت أيها الملعون حتى تستحق مشاهدته؟
“اقتله! اجلده! احرقه! لمَ يهربُ من سلاح غريمه كالجبان؟ لماذا ينفرُ من القتل؟ لماذا ليس متحمساً أكثر بقليلٍ للموت؟ اجلده حتى يندفع إلى الأمام ويتحمس! اجعلهما يواجهان بعضهما بعضاً بصدرين عاريين ويتبادلان الطعنات”. وعندما يحين موعد فاصلٍ في العرض “فلنقطع بعض الأعناق حالياً، لكي يكون هناك شيءٌ يحصلُ!”، إني أقول لهؤلاء الناس: اسمعوا، لا بد أنكم تستوعبون – حتى لو لم تستوعبوا أي شيء آخر – أن الأمثلة السيئة تميلُ إلى الارتداد على الذين يضربونها؟ اشكروا الآلهة الخالدة أن الرجال الذين تلقنونهم هذا الدرس في الوحشية ليسوا في موقع يستطيعون فيه استغلاله ضدكم.
عندما يكون العقل قابلاً للتأثر، ولا يملكُ استيعاباً محكماً لما هو صحيح، يجب إنقاذه من الحشد: من السهل عليه جداً أن يذهب إلى الأغلبية. إن سقراط أو كاتو أو جايوس لايليوس، لربما اهتزت مبادئهم لو أحيطوا بكل هؤلاء المختلفين عنهم: إلى هذا القدر نحنُ قليلو الحيلة – حتى ونحن نعمل على إتمام بنية شخصيتنا – أمام تحمل الرذائل عندما تأتي مصطحبةً أعداداً ضخمةً من مُريديها. مثالٌ واحدٌ على البذخ أو الجشع يفعل الكثير من الأذى: شخصٌ مقربٌ يعيشُ حياةً بذخة سوف يدفع برفيقه تدريجياً إلى الرخاوة والترهل، والجارُ الثري يستفزُّ شهوات آخر غيره، ورفيقٌ ذو طبيعة مؤذية يبثُّ بعض سوئه حتى في شخصٍ بريءٍ ومنفتح القلب بطبيعته، فأيّ تأثير تظنهُ سيكون على شخصية الفرد حين يأتي الهجومُ من العالم بأسره؟ إنك في آخر المطاف ستكرهُ العالم، أو تتشبّهُ به. ولكن الصحيح هو ترك الطريقين: فيجب ألا تصير السيئ لأن السيئين كُثر، ولا أن تُعادي الكثيرين لأنهم مختلفون عنك. اعتزل مع نفسك قدر ما تستطيع، وصاحب الذين ربما يستطيعون تحسين حالك، ورحّب بمن تستطيع تحسين حالهم، والعملية متبادلة: فالبشر يتعلمونَ عندما يُعلِّمون. وليس عندك سبب وجيه لأن تترك الفخر بمواهبك في الخارج يجرُّكَ نحو نشرها أمام نظر العامة، فيجعلك تقدمُ قراءات لأعمالك ومحاضرات. سأسعدُ برؤيتك تفعل ذلك لو أن ما ستعرضه يلائمُ الحشد الذي كنت أتحدث عنه، ولكنّ واقعَ الحال أن أحدهم ليس قادراً حقاً على استيعابك. قد تمر هنا وهناك بأحدهم، ولكن حتى هم يحتاجون تدريبك وتنميتك لهم حتى يصلوا إلى النقطة التي يستوعبون فيها تعليمك. “ومن أجل من إذاً تعلمت أنا كل هذا؟”، إن كنت قد تعلمته من أجل منفعتك أنت فليس عندك سببٌ لتخاف من أن جهدك قد ضاع.
ودعني أثبتُ لك أنني لم أكن أتعلم من أجل منفعتي أنا وحدي اليوم، دعني أشاركك ثلاثة اقتباسات ممتازة مررت بها، كل منها يتعلق بما يشبه الفكرة نفسها. واحدٌ منها أدفعُ به ديني المعتاد لهذه الرسالة، والاثنان الآخران اعتبرهما دفعةً على الحساب. يقول ديموقريطس “بالنسبة إليّ، الرجل الواحد حشد، والحشد رجلٌ واحد”. وبالجودة نفسها الإجابة التي قدمها أحدهم أياً كان (فهويته غير معروفة) عندما سُئل: ما الغرضُ من كلِّ الجهد الذي أودعه في قطعة مصنوعة لن يراها إلا بضعة أشخاص؟ فأجاب “بضعة الأشخاص يكفونني، وكذلك الواحد، وكذلك اللاأحد”. والثالث تعبيرٌ جميل استخدمه أبيقور في رسالة لأحد زملائه، يقول “إنني لا أكتب هذا لأعين الكثيرين، بل لعينيك وحدهما، لأن كلاً مِنّا جمهورٌ كافٍ للآخر”. ضع هذه الكلمات في قلبك يا لوكيليوس، حتى تزدري التلذذ بثناء الأكثرية. الكثيرون يتحدثون عنك مادحين، ولكن هل عندك ما يدفعُك إلى الرضا عن نفسك إذا كنتَ من نوع الرجال الذي يفهمه الكثيرون؟ إن شمائلك لا يصح أن تكون متوجهةً إلى الخارج.
الألوهة والطبيعة

الرسالة XLI
إنك تحسنُ صنعاً وتتصرّف بأفضل ما يلائم مصلحتك إذا كنت، كما تقول رسالتك، تجتهد في مساعيك للحصول على فهمٍ سليم. هذا شيءٌ من الغباء أن تصلّي لأجله بينما تستطيع أن تكسبه ذاتُك من نفسها. ليست هنالك حاجة لنرفع أيدينا إلى السماء، ولا حاجة بنا للتوسّل لكاهن المعبد ليسمح لنا بالاقتراب للحديث من صورة منقوشة، وكأن هذا يزيد من فرصتنا في أن نُسمع. الإلهُ قريبٌ منك، معك، بداخلك. نعم يا لوكيليوس، تسكنُ في داخلنا روح مقدسة، تحرسنا وتراقبنا في الشر والخير الذي نفعله. وكما نعاملها ستعاملنا. حقاً، لا إنسان في خيرٍ دون الإله، هل يستطيع إنسانٌ أن يغلب الحظ إلا بمساعدة الإله؟ إنه هو الذي يدفعنا نحو الأعمال النبيلة والرفيعة. في كل إنسانٍ جيد “يوجد إلهٌ… أيُّ إلهٍ لسنا واثقين” [فرجيل، الإنيادة].
لو أنك رأيت مرةً غابةً كثيفةً من الأشجار المعمّرة وقد سمقت إلى ارتفاع استثنائي حتى أغلقت صفحةَ السماء بغشاوة كثيفة من الأغصان المتشابكة، فإن جلالةَ الغابة، وعُزلةَ البقعة، وذهولك من مكانٍ بهذه الظلمةِ المطبقة العميقة في هواء النهارِ الطلق سوف تقنعك بوجود إله. أيّ كهفٍ حيثُ الصخور تآكلت عميقاً في الجبل الجاثي فوقها، فراغها الذي حال كهفاً مبهر الحجم لم تنتجه أعمال الرجال بل نتائج عمليات الطبيعة، سوف يضربُ في روحك لمحةً من المقدس. إننا نبجّل مصادر الجداول المهمة، الأماكن التي يندفع منها فجأة نهر قويّ من مخبئه تُبنى حولها المذابح، الينابيع الساخنة تُعبَد، عُمقُ البحيرات الذي لا يدرك قراره هو الذي جعل مياهها مقدسة. وإذا مررت برجلٍ لا تخيفه الأخطار أبداً، ولا تؤثر فيه الشهوات، سعيدٍ في خصومته، هادئ في العاصفة، يرى البشرية من مكان أعلى والآلهةَ من مكانهم، أليس من المرجح أن شعوراً من التبجيل له سوف يدخلُ قلبك؟ ألن تقول لنفسك “ها أمامي شيءٌ أعظمُ وأروع من أن يعتبره أحدٌ من ذات المادة التي يسكنها جسده”؟ في ذلك الجسد نزلت قوة مقدسة. إن الروح المُرتقية والمنظمة جيداً، والتي تمر بأيّ تجربة وكأنها لا تعني الكثير، التي تبتسم في وجه كل الأشياء التي نخافها أو نصلي من أجلها، لهيَ مدفوعةٌ بقوةٍ مستقاة من السماء. شيءٌ في رُقيِّ تلك الروح لا يمكن أن يقف دون سند إله. ولذلك فإن الجزء الأكبر منها موجودٌ حيثُ تنتمي، بنفس الطريقة التي تلمسُ بها أشعة الشمس الأرض ولكنها موجودةٌ في النقطة التي تنبثقُ منها، كذلك الروحُ المسكونة بالعظمة والقداسة، والتي أرسلت إلى هذا العالم كي نحصل على معرفةٍ أقرب إلى المقدس، تصاحبنا، بالتأكيد، ولكنها لا تفقد أبداً صِلتها بمنبعها. على ذلك المنبع تعتمد، هو الاتجاه الذي تستدير إليه عيناها، والاتجاه الذي تتسلقُ نحوه. الطريقة التي تتدخل بها في أمورنا طريقةُ كائنٍ أعلى.
ما هي إذن هذه الروح؟ شيءٌ له بريقٌ لا تسبّبه صفة إلا من ذاته. هل هنالك ما هو أغبى من أن نمدح في شخصٍ شيئاً ليس جزءاً منه؟ أو أكثر جنوناً من أن نعجب بأشياء يمكنُ في لحظة أن تُنقل إلى كائنٍ آخر؟ ليست الشكيمة الذهبية هي التي تجعل جواداً أفضلَ من غيره. إن إرسال أسدٍ إلى الأرينا بعد أن زُركشت لبدته بالذهب، وهو متعبٌ من المعاملة السيئة التي ترغمه عبر إرهاقه على تقبّل تزيينه وزركشته، لهو شيءٌ مختلف جداً عن إرسال أسدٍ بريٍ روحه غير منكسرة: جريءٌ في انقضاضه، كما أرادت له الطبيعة أن يكون، بكل جماله غير المشذّب، وحشٌ له مجدٌ بحيث لا يستطيع أن ينظرَ إليه أحدٌ دون خوف، إنه في عيون الناس يتخذُ موقعاً أعلى من الأسد الآخر، الطائع، المزركش برقائق الذهب.
يجب ألا يفتخر أحدٌ بشيءٍ ليس منه. نحن نمدح الكرمة إذا حمّلت أغصانها الثمر حتى انحنت دعاماتها تحت الثقلِ الذي تحمله: هل كان أحدهم ليفضل الكرمة المشهورة في الأسطورة التي يتدلى منها عنب وورقٌ من ذهب؟ الإثمار فضيلة الكرمة الخاصة. كذلك في الإنسان: المديح واجبٌ لما هو منهُ وحسب. افرض أنه يملك منزلاً جميلاً وجماعةً كبيرةً من الخدم، وكثيراً من الأرض التي تُزرع وكثيراً من المال الذي استثمره بالفائدة: لا واحد من هذه الأشياء يمكن أن يُقالَ عنه أنه منه – هي مجرد أشياءٍ حوله. امدح فيه ما لا يمكن أن يُعطى ولا يُسلب، ما هو فريدٌ في الإنسان.
تسأل ما هو؟ إنها روحه، وإتمام عقله في تلك الروح. فالإنسان حيوانٌ عاقل. إن حالة الإنسان المثالية تتحققُ حين ينجز الهدف الذي ولد لأجله. وما الذي يطلبه العقلُ منه؟ شيءٌ سهلٌ جداً: أن يعيش وفقَ طبيعته. ولكن هذا يصير شيئاً صعباً جداً بسبب الجنون الذي استشرى بين الرجال. نحنُ ندفع واحدنا الآخرَ نحو الرذائل. وكيف يمكن للناس أن يُستعادوا إلى الصحة الروحية حينما لا أحد يحاول أن يكبح هبوطهم والحشدُ يشجعهم على الاستمرار؟




