رواية ما بعد الاستعمار
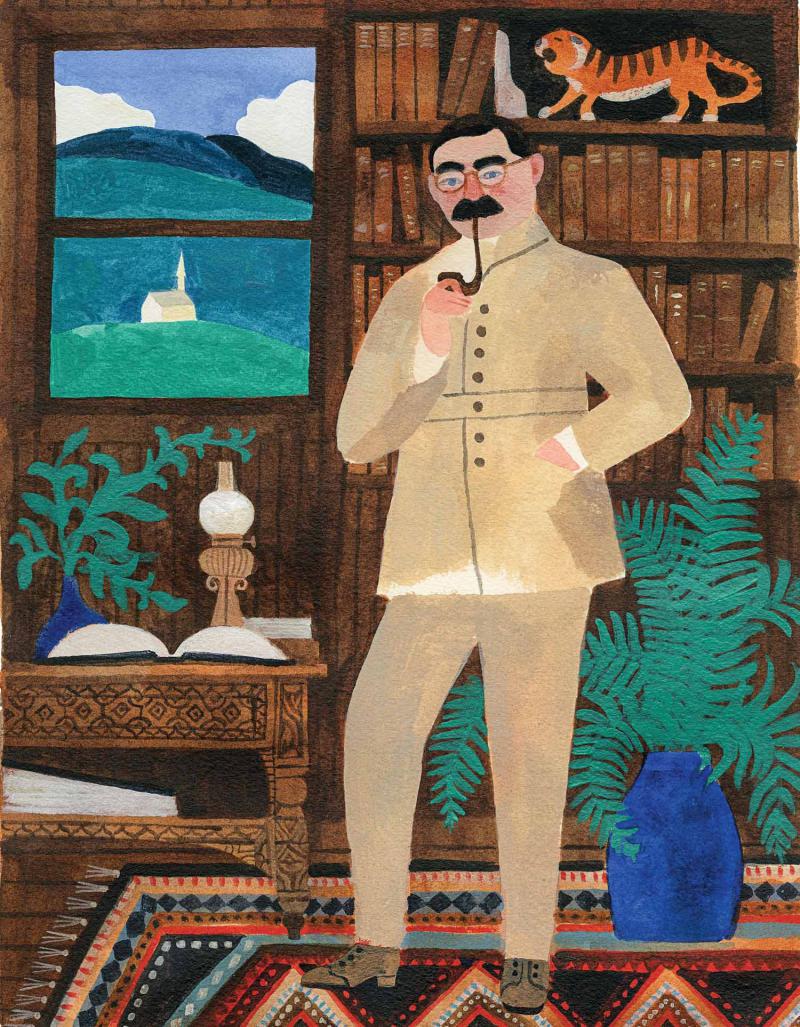
في هذا الكتاب، يجمع الدكتور أشرف زيدان مجموعة مختارة من المقالات والدراسات عن الرواية المكتوبة بالإنجليزية في إطار فكرة الاستعمار وما بعده، وتتناول هذه الدراسات الرواية من زوايا متعددة تضع الاستعمار وآثاره نصب أعينها، وكيف أن هذا الاستعمار لم يكن استعمارًا سياسيًّا وعسكريًّا واقتصاديًّا فحسب، وإنما كانت له آثاره الأدبية والاجتماعية والثقافية التي تركت بصمة لا تمّحي، مما جعل فن السرد يلتحم معها ويناوشها ويؤرخ لها ويفكّكها وينقضها، وما إلى ذلك من أساليب فنية في التعامل الأدبي مع الواقع المعيش.
وباستثناء الدراسة الأولى في هذا الكتاب التي تتناول روايات الحقبة الاستعمارية ذاتها، تتمحور باقي الدراسات حول الرواية في عصر ما بعد الاستعمار. وفكرتا الاستعمار وما بعد الاستعمار هنا فكرتان مزدوجتان: فكل منهما تشير إلى مفهوم أو عصر تاريخي من جهة، وتشير إلى مفهوم ثقافي أو تنظيري يتداخل مع هذا المفهوم التاريخي ويخرج عليه أو عنه في الوقت ذاته. فالرواية الاستعمارية تشير إلى الرواية المكتوبة في عصر الاستعمار أو عن الحياة في عصر الاستعمار، كما أنها تشير إلى الروايات التي تجسّد الرؤية الاستعمارية، سواء أكانت هذه الروايات قد كُتبت في عصر الاستعمار أم قبله بكثير، وسواء أكان هذا الاستعمار يشير إلى المؤسسة الإمبريالية أم إلى أفراد لديهم الرؤية الاستعمارية ذاتها. وكذلك الأمر بالنسبة إلى مفهوم ما بعد الاستعمار، فهو يشير إلى الروايات والقصص المكتوبة في عصر التحرر من الاستعمار العسكري/الاحتلال، كما يشير إلى الروايات والقصص المكتوبة في عصر الاستعمار ولكنها تنطوي على رؤية وتصوير فنيينِ للاستعمار يناقضان رؤية المستعمِر ذاته والصورة التي يرسمها لنفسه في أدبه. أي أن مفهوم ما بعد الاستعمار امتد من كونه مفهومًا يشير إلى فترة تاريخية محددة ممتدة من بداية النصف الثاني من القرن العشرين تقريبا إلى يومنا هذا، إلى كونه مفهومًا ثقافيًّا عامًّا لا يرتبط بعصر تاريخي محدد، وإنما ينطبق على أي نص سردي يقوّض رؤية المستعمِر عن نفسه أيّا كان العصر الذي كُتِبَ فيه.
ولا بد أن أنوِّه هنا إلى أن مفهوم أو مصطلح “الرواية الاستعمارية” أو “رواية الاستعمار” ذاته مفهوم استعماري بامتياز؛ لأنه يقتصر على وصف أو توصيف الروايات التي كتبها الغربيون/المستعمِرون عن الحياة في المستمرات أو البلدان التي تعرضت للاحتلال (بالإضافة إلى المستعمرات بالمعنى الفردي، كما في رواية “روبنسون كروزوي” التي استوطن بطلُها جزيرة وحوّلها إلى مستعمرة خاصة به)، ولا يتضمن بأيّ حال من الأحوال الروايات والقصص التي كتبها أبناء البلدان المستعمَرة، إلا في حالة كون هذه الكتابات مكتوبةً بلغة المستعمِر ذاته وتتماهى مع رؤيته الفنية. وبالتالي، يستبعدُ المصطلحُ أدب هذه البلدان باعتباره غير موجود أو لا يستحق النظر إليه لأنه كتبته شعوب ليست ذات حيثية أو اعتبار.
وأرى أن هذا الاستبعاد متعمَّد، فلولاه لانهارت المؤسسة الاستعمارية ذاتها، واكتشفتْ أن مفهومها عن الإمبراطورية وعن صورة الأنا مفهوم مات في مهده لأن كتابات أبناء هذه البلدان تنقض هذا المفهوم وهذه الصورة وتقوِّضهما، وبالتالي يفقدان الثبات والاستقرار والرسوخ اللذين تدعيهما المؤسسة الاستعمارية. فلو نظرنا إلى الروايات التي كتبها نجيب محفوظ وغيره في مصر على سبيل المثال أو إلى الأفلام التي تم إنتاجها في مصر قبل ثورة يوليو 1952 (وهو عام الخروج الرسمي لبريطانيا من مصر)، لوجدنا أن صورة المستعمِر البريطاني تختلف تماما عن الصورة التي كان يروّجها لنفسه في مصر والهند وغيرها من البلدان التي كانت خاضعة للاستعمار.
ومن هنا نجد أن مصطلح “الرواية الاستعمارية” أو “الأدب الاستعماري” مصطلح استبعادي وإقصائي عن عمد، لأن هذا الإقصاء أو هذا الاستبعاد هو الوسيلة الوحيد لضمان وحدة الأنا الاستعمارية وكُلِّيَتِها، أي سلامتها ككل متحد ومنسجم مع ذاته. وأظن أن هذا يتوافق مع ما ذهب إليه منظِّرو ما بعد الاستعمار من أن هوية المستعمِر هوية غير مستقرة أو هوية زئبقية لأنها ليس لها وجود إلا خارج حدود عاصمة الإمبراطورية: فالمستعمِر ليس له وجود إلا إذا خرج من داره/دولته واستولى على ديار/دول آخرين. وكي لا يقلَّ مقدارُه – إذا واصلنا استعارة المثل المصري “من خرج من داره قلَّ مقدارُه/قَدْرُه” – يتعمّد تجاهُلَ أدب الشعوب التي يستعمرها؛ لأنه قام باستعمارها في الأساس بافتراض أنها شعوب متخلّفة ليس لديها أدب ولا ثقافة ولا حضارة ولا علم ولا أيّ شيء، وجاء هو المتحضر الراقي المتأدب شفقةً بها وتعاطفًا معها كي يُخرجها من الظلمات إلى النور! فالاعتراف بأدب هذه الشعوب يعني عمليًّا تقويضَ فكرة الاستعمار ذاتها ونقْضَها ونسْفَ الأساس الذي تقوم عليه.
وإذا كان مفهوم “أدب الاستعمار” يقوم على الإقصاء وعلى الاقتصار على فكرة المستعمِر عن نفسه، فإن مفهوم “أدب ما بعد الاستعمار” مفهوم فضفاض، على الأقل في الوقت الحالي بعد أن انقضى عقدان من القرن الحادي والعشرين، فمفهوم “الحكايات الكبرى” (grand narratives)، أي الرؤى الكلية المتماسكة التي تستطيع تفسير واحتواء كل الظواهر المدرجة تحتها مفهوم أثبت عدم مصداقيته، ليس على المستويات الكبرى أو التكتلات العالمية فحسب، وإنما حتى على مستوى البلدان والمجتمعات والأسرة ذاتها. ومن الواضح أن الثورة الحالية في الاتصالات والمعلومات والتواصل والإعلام غير الرسمي قد لعبت دورًا في تقويض القناعات الرسمية والمؤسسية والشخصية، وتقويض الصور العامة التي ترسمها الثقافات والكيانات والجماعات عن نفسها، فلا يمكننا الآن أن نقرأ عن شيء أو نتكلم عن شيء إلا ونحن ندرك أن كلامنا أو فهمنا مجرد وجه من وجوه الواقع في أفضل الأحوال.

فمهموم الواقع ذاته صار “واقعات” أو “وقائع”، إذا جاز لنا أن نجمع كلمة الواقع؛ لأن الصورة التي ترتسم في أذهاننا عن هذا الواقع، أو نسعى لأن ننشرها عنه، لا تقوم على أساس يمكننا معاينته أمامنا، كما كان العلم يوهمنا بذلك من قبل (العلم ذاته صار وجهة نظر وليس حقيقة موضوعية)، وإنما تقوم على نظرتنا الشخصية المتشابكة مع مصالحنا وتاريخنا ووجهة نظرنا وتطلعاتنا وإدراكنا أننا مجرد نقطة في كون لا نعلم حدوده، وأن ما نشاهده لا يمثل إلا النظرة الشخصية أو الذاتية إلى أفراد آخرين ومؤسسات أخرى و”علوم” ومجالات معرفة أخرى، وإن هذه النظرة قد تتغيّر أو تتحوّل لدينا في أي وقت. فعلى سبيل المثال، ما كان يوهمنا به عصر التنوير من معايير ومبادئ للحضارة والتقدم، أو ما توهمنا به فلسفات أخرى من معايير ومبادئ مناقضة لها، اتضح أنه مجرد نظرة للحياة لها أسس لا يمكن تعميمها لتشمل حياة/حيوات آخرين/الآخرين. وصار استخدام صيغة التعريف ذاتها – الآخرون، العلم، الثقافة، الأدب – استخداما إشكاليا لأنه يجرُّنا إلى التعميم الذي ينطوي على نظرة كلية أو شمولية ليس لها أساس.
ما علاقة هذا بأدب ما بعد الاستعمار؟ سؤال ربما يتبادر إلى ذهنك أيها القارئ الكريم أو القارئة الكريمة، أو قد يطرحه على نفسه جهازُ الحاسب الكريم الموجود عليه ملف هذه المقدمة أو هذا الكتاب؛ فنحن في عصر الذكاء الاصطناعي على أيّ حال! وربما تنظر(ين) إلى ما قلتُه أعلاه على أنه استطراد في غير محله. بالرغم من أن أدب ما بعد الاستعمار على مستوى الممارسة والتنظير على حد السواء قد نشأ كثورةٍ على مفهوم أدب الاستعمار، وأنشأ التنظيرَ له مجموعةٌ من النقّاد الذين ينتمون في الأساس إلى الدول التي كانت خاضعة للاستعمار، نجد أنه يتشابك في الأساس مع أدب الاستعمار ومع نظرة المستعمر للأدب، حتى لو كان هذا التشابك ينقضُ، في بعض جوانبه، الأدبَ الاستعماري ذاته؛ فهذا التشابك تداخُلٌ وتورُّطٌ، لأن المنظِّر أو الأديب ما بعد الاستعماري عليه أن يلعب دائما دور المتهم الذي يدافع عن نفسه لينفي عنها التهمة التي ألصقها به المستعمِر، كما أن عليه أن يستخدم لغة المستعمِر ذاتها لكي ينفي هذه التهمة، حتى لو كان استعماله لهذه اللغة يقوِّضها أو على الأقل يزعزع ثوابتها من خلال إدخال تعبيرات ومفاهيم لغوية في هذه اللغة تجعلها تنزاح بالتدريج عن موضعها الذي كان راسخًا على سبيل الاقتراض، لتحتل موقع المابين، أي أن هذه اللغة لم تعد نفسها التي كانت ولم تتحوّل أو تصير لغة أخرى.
ربما كان القاسم المشترك الأكيد الوحيد بين أدب الاستعمار وأدب ما بعد الاستعمار – حسب المفهوم الغربي لكليهما – هو اللغة التي يُكتَب بها، وما عدا ذلك فكل شيء مختلف: الكتّاب لا ينتمون لنفس الفئة، فكتّاب الأدب الاستعماري هم الغربيون أنفسهم، في حين أن كتّاب الأدب ما بعد الاستعماري كتّاب ينتمون إلى المستعمرات السابقة (كما لو كانت الدول المستعمَرة لا وجود لها إلا في سياق كونها مستعمَرَات!) وهاجروا – طوعًا أو كرهًا – إلى مركز الإمبراطورية السابقة، أي إلى الدولة الأمّ التي تنتمي لها الإمبراطورية الاستعمارية (مفهوم الإمبراطورية ذاته لا وجود له خارج نطاق الاستعمار أو المؤسسات الاستعمارية).
والموضوعات التي يتناولها أدب الاستعمار تسلّط الضوء على حياة المستعمِر والمشاكل التي يعانيها من “ناكري الجميل”/أهل البلدان المستعمَرَة الذين لا يقدّرون تضحيات المستعمِر/السيد الذي تنازل عن رفاهية العيش في بلده وجاء إليهم لينقلهم من الظلمات إلى النور! في حين أن أدب ما بعد الاستعمار يتناول تجارب المهاجرين أو أبناء المهاجرين الذي استوطنوا في الغرب الاستعماري أو مراكز الإمبراطوريات الاستعمارية، أو الذين ظلوا في بلدانهم التي تخلت عن لغتها الخاصة وتبنّتْ لغةَ المستعمِر لغةً رسميةً لها، واستخدموا هذه اللغة في كتابة أدبهم، وإن كانت هذه التجارب أكثر ثراء من تجارب المستعمِر في أدب الاستعمار، لأنها تتلاحم مع جوانب متعددة من تجارب عصر ما بعد الاستعمار بالمعنى التاريخي للمصطلح، سواء أكان ذلك يتعلق في معظمه بالحياة وسط مجتمع المستعمِر ذاته بعد أن عاد إلى قواعده في مركز الإمبراطورية، أو بالحياة في الدول التي كانت خاضعة للاستعمار والتي هاجر عنها أو منها الكاتب أو الكاتبة، ويرجع إليها على مستوى الحنين أو التخيُّل أو حتى الواقع.
أما بالنسبة إلى الأسلوب، فمعظم روايات وقصص أدب الاستعمار كانت تنتهج الأسلوب “الواقعي،” وبالرغم من أن الواقعية هي التي كانت منتشرة في فترة ازدهار الاستعمار في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين، نجد أن لجوء معظم الروائيين الاستعماريين لها كان أنسب وسيلة لتصوير الحياة في “المستعمرات” بما يلائم نظرة المستعمِر، لأن الواقعية – كأسلوب فني ورؤية فنية –لا تحمل في داخلها بذورًا نقدية، أي بذور تشكِّكُ في أسلوب التصوير الفني ذاته. ومع أن مدارس الحداثة كانت قد انتشرت منذ العقد الثاني من القرن العشرين، وكان الاستعمار ما زال في ازدهاره، لم نجد كتّاب الأدب الاستعماري يستخدمونها في رواياتهم وقصصهم، لأن الحداثة تستجوب نفسها وتستجوب الواقع ذاته من وجهة نظر نقدية ولا يمكنها أن تسلّم بالواقع كما هو، كما لا يمكنها أن تسوِّغ للكاتب أن يستمرئ الصورة البراقة التي يرسمها عن نفسه وعن الفئة التي يكتب بلسانها.
وعلى الجانب الآخر، نجد أن رواية ما بعد الاستعمار توظّف مختلف الأساليب الروائية، وخاصة الأساليب التي لا تستند إلى فكرة واقع قائم بذاته وموجود هناك في الخارج، إذا استخدمنا لغة الفلسفة، فالواقع لا وجود له في الغالب إلا في إطار عينٍ تنظرُ له ويتفاعل مع كل ما يمثله صاحب العين الراصدة، وهو في الغالب يرى هذا الواقع حالة فنية ومادة خامًا قابلة للتشكيل بطرق فنية متنوعة، وكلها طرق تميل إلى النسبية، أي الابتعاد عن فكرة المطلق الفني أو النظرة اليقينية للعالَم والحياة. وبالطبع، يمكن لمن يعشق التفكيك أن يفكك هذه النظرة ذاتها ويبيّن أنها تتبنى نفس المنطق الذي يقوم عليه الواقع المرفوض: فبدلا من الثابت أو اليقين الذي كان متمثلا في الواقع، صار هناك يقين أو ثابت جديد، ألا وهو اللايقين باعتباره مبدأ راسخا في نظرية ما بعد الحداثة وما بعد الاستعمار، وما شابهها من نظريات، في حين أن الحياة تحتمل كافة الاتجاهات والمواقف لأنَّ تنوُّعَها وتشعباتها وثراءها تفوق الوصف والرصد وتتمرّد على الاحتواء.
وهذا من ضمن الثغرات التي يرصدها النقاد في الأدب ما بعد الاستعماري، أو بالأحرى في محاولة التنظير له: فالغالب في التنظير لأدب ما بعد الاستعمار أن يتم تقسيمه إلى كتل جغرافية صمّاء، وكأن كل من ينتمون لهذا التقسيم الجغرافي أو ذاك يمكن النظر إليهم على أنهم جماعة مترابطة ومتناسقة ومتجانسة، وهو أمر يخالف الواقع ويجعلنا نصفه (هذا الأمر) بأنه أغلوطة تجانس أو مغالطة المجانسة: أي النظر إلى الأفراد أو حتى الجماعات على أنهم صورة من بعضهم البعض وعلى أنهم جماعة متجانسة لا توجد فروق فردية بينهم، أو لا تغلب اختلافاتهم على تشابهاتهم.
كما أن هذا التقسيم الجغرافي – الأدب الأفريقي ما بعد الاستعماري، الأدب الكاريبي ما بعد الاستعماري، الأدب الجنوب آسيوي ما بعد الاستعماري.. الخ – تقسيم ينافي حتى الواقع الجغرافي ذاته، ويقع في مغالطة المجانسة على مستويين: المستوى الأول هو أليست هذه المناطق الجغرافية التي كانت خاضعة للاحتلال لها لغاتها الخاصة؟ فلماذا يتم النظر فقط إلى الأدب الذي يكتبه أبناؤها باللغة الإنجليزية؟ وليس كل أبنائها، وإنما أبناؤها الذين يكتبون باللغة الإنجليزية داخل النطاق الجغرافي لمركز الإمبراطورية، في بريطانيا، وليس في الهند أو باكستان أو نيجيريا على سبيل المثال! أما المستوى الثاني، فيتمثل في أنه لا يتم الالتفات إلى الآداب المكتوبة بلغات البلدان التي كانت خاضعة للاستعمار على أنه من صميم أدب ما بعد الاستعمار، كما لو كان منظّر ما بعد الاستعمار لا يعترف إلا بلغات المستعمِر باعتبارها اللغات الشرعية التي يُكتَبُ بها أدب ما بعد الاستعمار! وحتى في هذا السياق أو الإطار، لماذا لا يتم النظر إلى الأدب الذي يكتبه أهل أميركا الأصليون أو أهل كندا الأصليون أو أهل أستراليا الأصليون (وكله مكتوب بالإنجليزية في حالة أميركا وأستراليا، وبعضه بالإنجليزية وبعضه بالفرنسية في حالة كندا) على أنه أدب ينتمي لأدب ما بعد الاستعمار؟!
أظن أنه لو كان لأدب ما بعد الاستعمار أن يكون ما بعد استعماريّ فعلا، فعليه أن يشمل في الأساس الآداب التي تكتبها الشعوب والدول التي كانت خاضعة للاستعمار، وبلغاتها ووفقا لرؤاها وأساليبها في الكتابة ولمفهوم الأنواع الأدبية عندها. كما أن أدب ما بعد الاستعمار لا يقتصر على التعرض للاستعمار بشكل مباشر، فمعظم دول العالم الثالث الآن واقعة تحت استعمار غير مباشر، سواء أكان اقتصاديا (وما أدراك ما البنك الدولي وما الشركات متعددة الجنسيات والعابرة للقارات!) أم فكريا أم ثقافيا أم لغويًّا، أم سياسيا عن طريق عدم استقلال الإرادة السياسية الوطنية في التخطيط وصنع القرار ومجالات التنمية أو عن طريق عرائس الماريونيت.. الخ. فهل يمكن اعتبار الأدب الذي يتعرض للقضايا والآثار الناجمة عن هذا الاستعمار غير المباشر أدبا ما بعد استعماري؟ وهل معنى الاستعمار يقتصر على هذه الأشكال من الاستعمار أم يمكن توسيعه ليشمل سطوة الماضي على الحاضر، وسطوة التفسيرات المتجمدة أو الأصولية أو الاستبدادية في أيّ مجال من مجالات الحياة على التفسير الأكثر اتساعا أو أكثر عصرية أو أكثر استيعابا لمستجدات الحياة ولتغير مفهوم الهرمية الاجتماعية والسياسية والأدبية والدينية والثقافية.. الخ؟
ومن جهة أخرى، هل نُدخل استعمار الإنسان للأرض في هذا الموضوع؟ بمعنى أن استعمار الإنسان للأرض – الذي كان بمعنى العمارة، على الأقل من المنظور الإسلامي الأصلي – زيّن له (للإنسان) أنه له الحق المطلق في التصرف على كوكب الأرض كما يشاء، مما أدى إلى كوارث بيئية تكاد تفتك بالأرض ذاتها؟ فهل يمكن تصنيف الأدب الذي يتناول قضايا البيئة والكوارث البيئة أو حتى الأدب الذي انفتح – عن طريق التخييل – على كواكب أخرى على أنه أدب ما بعد استعماري؟
أظن أن استخدام صيغة الجمع هو الأسلم والأفضل لوصف الحالة الراهنة والمستقبلية: آداب ما بعد الاستعمار، فنون/أنواع/أجناس رواية ما بعد الاستعمار، فنون/أنواع/ أجناس الرواية المصرية على سبيل المثال.. الخ. ونحن الآن في مأزق، فيُفترض أن انتهاء عصر الاستعمار يفتح المجال لظهور القوميات أو الدول القومية/الوطنية والاحتفاء بها وبثقافتها وتاريخها وهويّاتها وما إلى ذلك. وفي الوقت ذاته، ظهور العولمة وثورة المعلومات والإنترنت وتزايد قنوات الاتصال يخلق هويات هجينة تجمع بن مكوّنات متباينة تمثّل الهوية الوطنية أو القومية مجرد رافد من روافدها، لدرجة أن هوية الشخص الواحد تصير في حالة تغيُّر وتشكُّل دائمين على مستوى الأسلوب والرؤية والنظرة للذات وللحياة وللآخر. فمثلا عندما أقرأ تاريخي النصّي المتمثل في كتاباتي في نوع أدب واحد من الأنواع التي أكتبها، أستحضر أغنية المطرب عبدالباسط حمودة “أنا مش عارفني، أنا تهت مني، أنا مش أنا”، ولكن بالمعنى الإيجابي، وليس بالمعنى السلبي الوارد في الأغنية، فأنا عدة رؤى، وعدة أساليب، وعدة أنواع فرعية أو رئيسة داخل النوع الأدبي الواحد من الأنواع التي أكتبها.. الخ، كما أن هذا ينطبق عليّ حتى الآن فقط، ولا أعرف إلامَ سأصير في المستقبل القريب، ودعك من المستقبل البعيد.
وهذا يقودنا إلى مفهوم النوع الأدبي، فمن الواضح أن الأنواع الأدبية، وخاصة السردية منها، تشهد انفتاحا واتساعا لا حدود لهما، وهو الأمر الذي وسّع حدودَ النوع إلى أقصى درجة لدرجة أنها لم تعد حدودًا، وإنما أغشية هلامية مطاطية قابلة للتحرك للخارج باستمرار وقابلة للتقاطع مع حدود أيّ نوع أدبي آخر أو تخومه، لدرجة أن مفهوم النوع ذاته يفقد معناه ويصير مجرد عتبة أو تُخْم أو طرف أو برزخ، فنحن الآن في مناطق المابين نوعية، أو المناطق البرزخية، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا إلى هنا ولا إلى هناك، وكأن كل نوع في محطة ترانزيت لا يستقر إلا ليجد نفسه يستعد للسفر وللانتقال إلى موضع آخر، وهكذا إلى ما لا نهاية.
وأظن أيضا أن مصطلح ما بعد الاستعمار مصطلح فضفاض ومؤقَّت، فهو يدل على كل شيء ولا يدل على شيء، لأنه ليس جامعا ولا مانعا، مع أن فكرة الجمع وفكرة المنع فيما يتعلق بالمصطلحات قد تكون هي ذاتها فكرة تتعرض الآن للاختبار وللتشكيل والتكوين من جديد. فأيّ نص أو عمل أدبي يسعى للتحرر من وضع قائم ضاغط وخانق نص ما بعد استعماري، وأيّ نص يشتبك مع قيم سلبية متوارثة نص ما بعد استعماري، وأيّ نص يسعى لزحزحة حدود النوع الأدبي – وهو نوع موروث عن الاستعمار الغربي في الغالب – نص ما بعد استعماري، وأيّ نص يسعى لاستعمال اللغة استعمالا حيويا بعيدا عن وصاية مقدّسي اللغة – أي لغة – هو نص ما بعد استعماري، وأيّ نص يسعى لكشف سياسات الاستغلال والقمع والاستغفال والإيهام التي تمارسه فئة أو جماعة أو حكومة – حتى ولو في بلد لم يعرف الاستعمار الفعلي في يوم من الأيام – هو نص ما بعد استعماري.. الخ.
في عالمنا العربي، أظن أن السنوات العشر الأخيرة على وجه الخصوص كانت اختبارًا جبَّارًا لجميع جوانب حياتنا، فثورات الربيع العربي كانت سؤالا كبيرًا لم يستطع نمط حياتنا الإجابة عليه، فلقد سقطت الأقنعة التي كنا نتوارى خلفها – أقنعة الهوية، أقنعة اللغة، أقنعة الأدب، أقنعة الثقافة، أقنعة الوطنية، أقنعة الحضارة، أقنعة التجانس، أقنعة الولاء.. الخ – وما زلنا عراة نحاول أن نتدبّر، كلٌّ بطريقته، إذا كان أبصر السؤال الكبير، طريقة “تسترنا”، بالمعاني الفصحى والشعبية لمفهوم الستر، أو حتى تعرِّينا أكثر حتى نصل إلى إدراك جوهر الحياة القائمة على التنوع والتعايش والعمل. وسقوط الأقنعة هذا انعكس بدوره على الأدب لدينا، ولا أريد أن أستخدم عبارة “الأدب العربي”، لأن العبارة صارتْ فضفاضة جدا، أو ضيّقة جدا، الأمر سيّان، في هذا القرن الحادي والعشرين، ويسعى بعض الأدباء الذين يفهمون الأدب بمعنى التفرُّد والهوية اللغوية والرؤيوية ومواكبة مستجدات الحياة إلى أن يستوعبوا سقوط الأقنعة هذا في كتاباتهم، وخاصة في الرواية والقصة، لأن الشعر لدينا متخلف كثيرا في هذا المجال، ولا يدرك معظم الشعراء الآن أن الأقنعة سقطت بالفعل.
وأخيرًا، اعتماد الكثير من المدارس والنظريات والتصنيفات والفلسفات.. الخ، على فكرة “المابعد” يدل على قصور في المصطلح، لأن “المابعد” تدل على الخروج من مرحلة وعدم الدخول في مرحلة أخرى، على خلع هوية وعدم ارتداء هوية أخرى. كما يدل على أن فكرة ما قبل المابعد – الاستعمار مثلا فيما يتعلق بما بعد الاستعمار – هي التي تتحكم في الحاضر، أو أن الحاضر ينشغل بمناوشة آثارها ومجابهتها، دون أن يصل إلى طريق خاص، أو يصل إلى أسئلته وقضاياه الخاصة.
أدركُ أن مقدّمتي هذه طرحت الأسئلة أكثر مما قدمت أجوبة، وربما لم تقدم أجوبة، لأننا الآن لا يمكننا أن نقدم أجوبة على شيء، فعصرنا عصر الأسئلة بامتياز، كما أنه عصر انتقالي بين أساليب ونظرات حياة لم تعد صالحة لما وصلنا إليه في حياتنا المعاصرة في القرن الحادي والعشرين، وفي الوقت ذاته مازلنا نجرّب أساليب ونظرات جديدة، دون أن نستقر على شيء أو نصل إلى شيء محدد. وأخشى أن يأتي أحد ويصف عصرنا – على سبيل التوصيف المؤقت – بأنه عصر ما بعد الأسئلة.
- النص المنشور مقدمة لكتاب “رواية ما بعد الاستعمار” ويضم دراسات ومقالات مختارة لعدد من الكتاب الغربيين. ترجم الكتاب إلى العربية أشرف إبراهيم محمد زيدان.




