الفرد المهمش
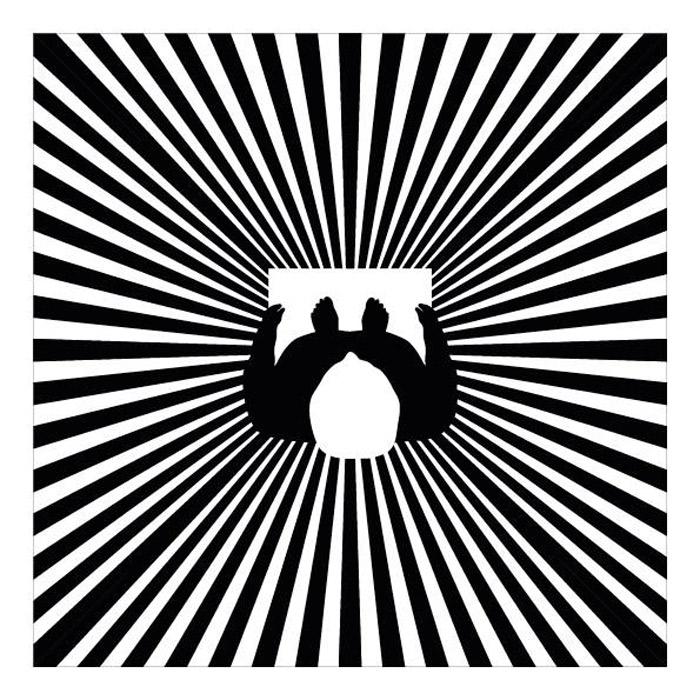
أجفل، ويتعريني القلق عندما أسمع عبارة “دور المثقفين العرب”. ولعل مردّ ذلك هو أنني نفضتُ يديّ، منذ زمن بعيد، من دورٍ مّا يمكن للمثقف العربي أن يؤديه. بدأ هذا الإحساس مع انهيار الأطروحات المؤسِّسة للقومية والوحدة العربية، منتصف القرن الماضي، وتعاظمَ مع الهزائم العربية في مواجهة إسرائيل، التي قضمت وما تزال ساعية بشهية مفتوحة إلى السيطرة على الفضاء العربي برمته، فيما المثقفون، المنذورون لدور مّا، مختبئون في عزلاتهم، وخلف ترسانة أوهامهم.
ولما سقط الاتحاد السوفييتي كورق الكرتون الهش، وتمزّق الشموخ الثوري، بدت النظرية الماركسية، للوهلة الأولى، مليئة بالثقوب، وأضحت الهوة سحيقة بين الخطاب والممارسة. وبعدما انفجرت انتفاضات الربيع العربي، تكشف أنّ غالبية المثقفين الماركسيين انحازوا للطغاة، وخانوا عهدهم القديم مع البروليتاريا، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية مع السفاحين والقتلة، وباركوا أعمالهم، وقبّلوا أياديهم الملطخة بدم الشعب والأطفال، أو الطبقة الكادحة والعمّال والشغيلة، والبشر بصفة عامة.
بل الأنكى من ذلك، أنّ أولئك “الرفاق” تحالفوا، وهم أحفاد المادية التاريخية، مع الأنظمة الثيوقراطية الغارقة في الخرافة والراقدة على جمر ظهور “المهدي المنتظر”.
كانت تلك المحطات كفيلة بسقوط أسطورة “المثقف الماركسي” أو قل “المثقف اليساري”، علماً بأنّ غالبية المثقفين العرب، أو نسبة كبيرة منهم ينتسبون إلى ذلك الخطاب الثوري الذي فجرته الماركسية في صعودها المدوّي في مواجهة “الإمبريالية” وقوى التوحش الاقتصادي في العالم.
واستدراكاً، وخشية التعميم، فإنّ هناك مثقفين عرباً اختاروا الاتجاه الليبرالي الممزوج بنفحة يسارية، وثمة من اختار الاتجاه العلماني، ليطلق لنفسه العنان في تأمل الحرية، بعدما أطبقت الأنظمة الشيوعية والاشتراكية على أنفاس البشر، وحوّلت البلاد إلى كانتونات من عبيد أو ببغاوات تردد ما يقوله الزعيم الخالد الذي أضفيت عليه صفات القداسة أو “الكهنوت”.
هذه التحولات التي عصفت بالقرن الماضي، وغيرها كثير يصعب حصره في هذه المساحة، جعلت الكل منذوراً لخدمة الكل، فسيق الملايين إلى الموت دفاعاً عن الملايين التي تنتظر الخلاص من الظلم والقهر والاستعمار والاستبداد. وقد تسللت هذه الخطابات إلى لاوعي المثقف العربي المعاصر، مع أنها جزء أصيل من الثقافة العربية الإسلامية، ومرجعيّاتها الدينية التي تحض على التئام الجماعة، وتنبذ، بلا وعي أيضاً، الفردية، وترى فيها انشقاقاً، حتى عندما كان يتم الحديث عن الذات العربية، ظل يقصد بها الجماعة، وليس الفرد الذي يتم الاعتراف به، فقط، بوصفه جزءاً من المجموع، أو بُرغياً صغيراً في ماكينة عملاقة، ولا استقلالية ذاتية له، وهذا ما أسهب في شرحه وتفكيكه هشام شرابي.
ويكشف تقرير “التنمية الإنسانية العربية للعام 2016: دور الشباب وآفاق التنمية واقع متغير” الذي أصدرته الأمم المتحدة، معطيات مهمة، تجعل الحديث عن المثقفين العرب ودورهم ضرباً من مفارقة الواقع وإنكار إحداثياته، لأنّ ثمّة مياهاً كثيرة جرت تحت جسر الأفكار الهاجعة في بطون الكتب.
انطلق التقرير، الذي عرضت لنتائجه صحيفة “النهار” اللبنانية، من حقيقة أنّ جيل الشباب الحالي يمثل أكبر كتلة شبابيّة تشهدها المنطقة على مدى السنوات الخمسين الأخيرة، إذ أنهم يمثلون 30 في المئة من سكانها الذين يبلغ عددُهم 370 مليون نسمة. وبإمكان هذه الطاقة البشرية تحقيق طفرة حقيقية ومكاسب كبيرة في مجالات التنمية، وتعزيز الاستقرار، وتأمين هذه المكاسب على نحوٍ مستدام، ولكن مثل هذه النتيجة تستدعي، بحسب التقرير، إصلاحات على ثلاثة مستويات:
الأول: “يرتبط بالسياسات الناظمة للعقد الاجتماعي بين الدولة ومواطنيها، وهيكلة الاقتصاد الكلي، وتوسيع الفرص المتاحة للجميع، بمن فيهم الشباب”.
الثاني: “يركز على السياسات القطاعية، ولاسيما في مجالات التعليم والصحة والتوظيف.. لتوسيع نطاق حريتهم في الاختيار”.
الثالث: “يتناول “السياسات الوطنية المعنية مباشرة بالشباب، والتي ينبغي أن تتجاوز نهج إيجاد الحلول.. لتضمن مشاركة سياسية أوسع في وضع السياسات العامة، ومراقبة تخصيص الموازنات، وتعزيز التنسيق بين الجهات كافة، ومتابعة التنفيذ والتقدم نحو إنجاز الأولويات”.
وما لم يستطع أن يرصده التقرير، أو لم يكن في نطاق بحثه، هو أنّ الصورة الحالية للنظام السياسي العربي أشد تفتتاً مما كانت عليه قبل أربع سنوات، حين أُنجز التقرير الأممي. وها نحن في أواسط العام 2020 (الذي توقع التقرير بحلوله أن يكون ثلاثة من كل أربعة عرب يعيشون في منطقة “معرضة للنزاع”) وننظر إلى الخريطة العربية، فنرى الألغام المتفجرة والمقبلة على الانفجار، في غالبية الدول العربية، ما يؤذن بانهيار عدد من تلك الأنظمة أو تغييره أو تصدّعه، وهذا يعني أن يتوجه المجتمع، وخاصة الشباب الذين يشكلون عصبه، إلى التماهي أكثر مع الدين والقبيلة والمذهب، من تماهيهم مع الدولة.
وأمام كل هذه الحقائق، ماذا يفعل المثقفون والباحثون والمفكرون، ومراكز الدراسات، ومنظرو المستقبليات؟
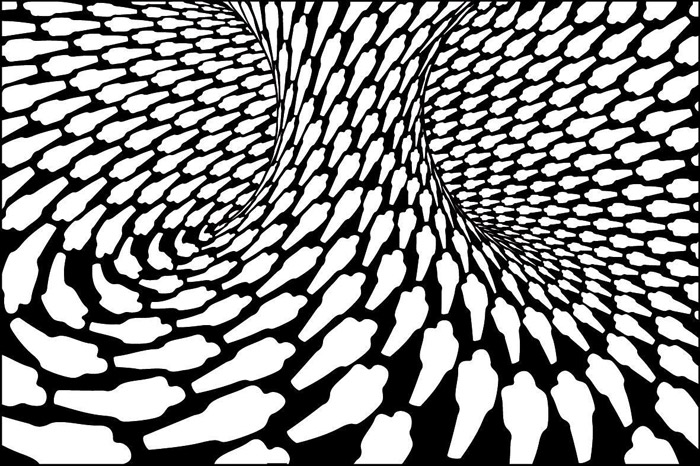
المثقف فقد دوره حينما فقد صوته، واختار أن يسير مع القطيع، بل كثير من المثقفين أصبحوا أبواقاً لأنظمة استبدادية، وجرى تسويقهم باعتبارهم المثال الأكثر تجلياً للتحولات الإيجابية، وللمرونة والبراغماتية، والتأقلم مع الفصول الأربعة. وخُيّر المثقفون العاضّون على الجمر، بين الفقر والتهميش والازدراء، وبين التدجين، وكانت النتائج رهناً بصلابة الإرادة والقدرة على البقاء في بيئة متوحشة طاردة تقودها أنظمة الدولة العميقة، وهي أنظمة ماكرة، لا يتعين على أحد الاستهانة بتأثيراتها اللئيمة والأليمة.
المجتمعات العربية، في جُلّها، محكومة بنظام متوارث، حتى في أكثر الأنظمة الجمهورية التي تحولت إلى “جمهوملكية”، وصار نموذج العقيد القذافي هو ما يدغدغ أحلام الرؤساء “المنتخبين” إلى الأبد.
فماذا في وسع المثقفين العرب أن يفعلوا، سوى أن ينكفئوا على أنفسهم، ويكتبوا في صمت وعزلة، ويختاروا طرق التعبير الأكثر سلاماً، والأقل إقلاقاً للسلطات الغاشمة، لاسيما تلك التي تحكمها أجهزة الأمن؟
الاستبداد زاد في عزلة المثقفين العرب، وشلّ إرادتهم في أن يتوحّدوا في روابط أو نقابات أو تجمعات، لأنّ القبضة البوليسية شديدة، ولأنّ، وهذا أمر مهم، المثقفين أنفسهم ليسوا على قلب رجل واحد، ما يعني بروز الانتهازية سواء بفعل المثقف نفسه، أو بفعل فاعل يؤدي له المثقف “خدمة” تحوله إلى جاسوس، أو إلى مِثقَب مستعد لخرق السفينة وهي في عرض البحر، في أيّ لحظة!
أمر آخر ينبغي التطرق إليه، يتمثل في أنّ الحاجة الآن هي للمثقف الرقمي الذي يشتبك مع فتوحات التكنولوجيا، ويتمتع باللياقة التقنية التي تؤهله لولوج هذا العالم، والتعامل مع قواعده، وبالتالي الوصول إلى المتلقين، وخاصة الشباب، وتنظيمهم في فضاء العالم الافتراضي. فكم نسبة المثقفين العرب القادرين على أداء هذه المهمة؟
ولو أنّ هؤلاء أرادوا أن يمتثلوا لمقولة إدوارد سعيد بأنّ “وظيفة المثقف أن يكدّر صفوَ السلطات”، فإنّ لوائح ما يسمى بـ”الجرائم الإلكترونية” ستكون لهم في المرصاد، وكم من المعتقلين الآن في سجون الأنظمة العربية، يكابدون الويل بسبب منشور لهم على وسائل “السوشيال ميديا”. وقد مر كاتب هذه السطور بمكابدة مماثلة لم تصل حد الاعتقال، لكنها ممضة ومؤرقة وجالبة للجلطة القلبية!
ما العمل، إذن، على رأي الرفيق لينين؟
التغيير من داخل النظام العربي، من خلال المشاركة في الانتخابات، اقتراعاً وترشيحاً يعني الامتثال لشروط النظام وإكراهاته. وأما الثورة الاحتجاجية السلمية أو العنيفة، دون وجود رأس موجّه يتمتع بالحكمة والاتزان والمعرفة واستشراف المستقبل، فمعناها زوبعة في فنجان، سرعان ما تذوي وتتبدّد.
في العام 1902، نشر المفكر الإصلاحي عبدالرحمن الكواكبي، كتابه الأشهر في القرن العشرين؛ “طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد”، وشخّص فيه ما سمّاه داء الاستبداد السياسي، ووصف أقبح أشكال الاستبداد بـ”استبداد الجهل على العلم، واستبداد النفس على العقل”، حيث كتب إنّ الله “خلق الإنسان حرّاً، قائده العقل، فكفر وأبى إلا أن يكون عبداً قائده الجهل”. وقال الكواكبي أيضاً إنّ “المستبد فرد عاجز، لا حول له ولا قوة إلا بأعوانه أعداء العدل وأنصار الجور. وإنّ تراكم الثروات المفرطة، مولّد للاستبداد، ومضرّ بأخلاق الأفراد. وإنّ الاستبداد أصل لكل فساد”.
السؤال الذي يستدعيه طرح الكواكبي، الذي جهر به قبل مئة وثمانية عشر عاماً: ما الذي تغيّر في حال العالم العربي، طوال هذه المدة الزمنية التي بدّلت شكل الكون؟
الإجابة ربما تحيل إلى ما طالب به لينين، في العام ذاته لما دعا إليه ونبّه منه الكواكبي. سؤال لينين أثمر إمبراطورية عملاقة، لنا عليها مآخذ وانتقادات لا تعدّ ولا تحصى، لكنها حكمت العالم طوال ما يقارب القرن، وأوصلت أول إنسان إلى القمر، في حين بقي مشروع الكواكبي الثوري صيحة في واد، لا قمر فيه، إلا إذا تخيّل العربي في سباته العميق أنه شاهد قمراً تتلألأ، في ظلاله، صورةُ القائد العربي الذي قصف شعبه بالسلاح الكيمياوي.
كاتب وأكاديمي من الأردن




