عسر ولادة الفرد
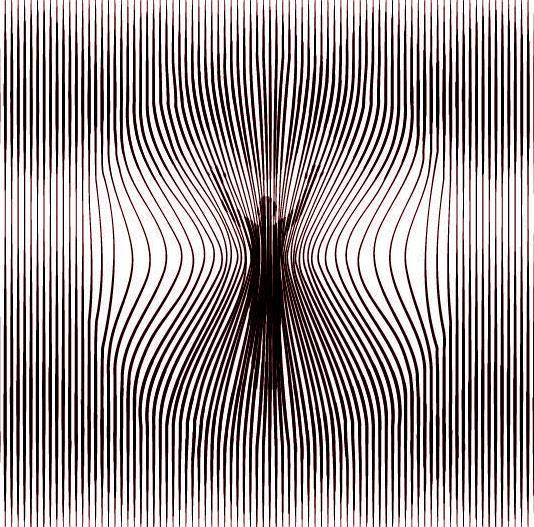
بداية، هل تمكنت الثقافة العربية الحديثة على مدار قرن من الصراع، رغم الاتهام الشائع للمثقفين بأنهم فرديون، من خلق الفرد العربي بوصفه ذاتًا مستقلةً قادرةً على صناعة ماهيّتها، أم أننا نواجه فشلاً حضاريًا حال دون تحقيق مركزية الفرد؟ وإذا كنا فشلنا حقًّا فإلى ما نردّ هذا الفشل، هل إلى طبيعة معاندة مفترضة في الثقافة العربية التي تسري فيها روح القطيع، أم إلى تلك السلط التي قامت على أساس قبلي مناطقي طائفي عسكري، دجّنت الإرادات الإنسانية، فرديةً وجماعيةً، وحكمت بكل أشكال القمع، رغم ما يبدو على بعضها من انتمائها إلى عالم الحداثة والتحديث المعاصرين؟
ننطلق، تأسيساً على أسئلة كهذه، لطرح السؤال حول السبيل إلى مواجهة التناقض بين الحركة الموضوعية للحياة المعاصرة، التي تسير نحو الفردية وانتصار الذات الحرة في السلوك والتفكير من جهة، والقوى النابذة لهذه الحركة من سلط سياسية وظلامية، وأين يكمن دور المثقف العربي المعاصر الذي يعيش هذه الازدواجية بين العوامل الجاذبة والعوامل النابذة للانتصار؟ هل نحتاج إلى مشروع ثقافي في عالم لم تعد المشاريع الكلية تنجب اقتناعًا لدى الفرد، وبخاصة بعد انهيار المشروعات القومية والماركسية والليبرالية، واستمرار الحالة البطرياركية التي تحدث عنها هشام شرابي؟ أليس من الحكمة اليوم، ونحن نعيش في مخاض اجتماعي سياسي وأخلاقي، يدفع فيه المجتمع ثمنًا باهظًا من الأرواح والقوت اليومي والفوضى العارمة، أن نعيش تجربة البحث عن سبل الخلاص، وأن نعود، بالضرورة إلى خطاباتنا ونشبعها نقدًا، وإلى مفكرينا الذين صاغوا رؤاهم ومشاريعهم لنقرأهم من جديد، من أجل صياغة وعي مطابق متحرر من الأوهام الأيديولوجية التي تحولت إلى أيديولوجيات استبداد وتخلف؟
إن هذا السؤال ليس سؤالاً كباقي الأسئلة، بقدر ما هو إشكالية لتحقيق مصيرنا كعرب في حضيرة العالم المتقدم. أنا لا أتحدث عن آسيا ولا عن الإنتاج الزراعي المهيمن حتى على المعامل الصناعية فيها، إنَّما أتحدث عن الخطاب الذي لم نهتد إليه وهو واضح بين أيدينا، ونمتلك مقوماته المادية والتراثية والحضارية، وللمنطقة دور مؤثر ضمن آسيا جغرافيًا ومن حيث موقعها، وضمن أوروبا اقتصادًا وثقافةً.
نعم هو سؤال المعاصرة والإشكالية المعرفية التي تواجهنا كعرب في علاقتنا مع أنفسنا أولًا ومع العالم ثانيًا، ولا بأس من التذكير بالعودة إلى الجذور المعرفية لتأسيسات وعينا النقدي، فالثقافة الإسلامية وجدت بالضد من الثقافة الأنثروبولوجية والميثيولوجية والدينية التي شكلت جذور الأديان السماوية في المنطقة والإسلام من ضمنها، وأرادت تغييرها لصالح ثوابتها الدينية وحصرها بمنطق القومية والجغرافيا، وهو ما جعل الدين الإسلامي غير مدرك لإشكالياته المعرفية كبقية الأديان عندما لم تقطع اليهودية والمسيحية بجذورها الميثيولوجية، ولم تعدّها مجرد أساطير، بل جعلت منها تشكيلات مختلطة لتكوين عجينية الديانات السماوية، دون أن تؤمن بمطلقاتها الميثيولوجية، واعتبرت إنتاجها ضمن المسعى البشري لمعرفه ما يُنتج، وما عليه أن يكون مستقبلًا، وربط سعيها النهضوي من خلال إعادة البحث في الحضارة اليونانية عبر اللغة اللاتينية، التي أصبحت الجذر لكل مفهوم ومصطلح، وعبر نهوض الفعل فلسفيًا، والعلم التجريبي عمليًّا، بينما عمل الإسلام قطيعةً غير معرفية مع جذوره الميثيولوجية، وهو المبكر في نقل الفلسفة اليونانية للعربية والسريانية، ومن ثم نشأت فلسفة عربية إسلامية بمشروع فكري تنويري ابتداءً من الكندي والفارابي وابن سينا، وانتهاءً بابن رشد مع تأسيسات المعتزلة وغيرهم من تصورات العقل الإسلامي التنويري، بينما أقفل الإسلام الدائرة على نفسه قائلًا إنه آخر الأديان، وأن الأساطير والميثيولوجيات الشفاهية ليست إلا خرافات تنتجها القوى الشيطانية ضد الأديان، وعمّق نقص المعرفة حين قام بالفتوحات لتعويض هذا النقص في العلاقات مع العالم القديم والحديث، ملغيًا أيّ حضارة وأيّ جذور لزرع نباتات إسلامية في بيئات مختلفة، لينشئ خطابًا قاصرًا عن فهم ثقافات العالم وأدوارها في صنع إنسانها. أراد الإسلام تغيير كل شيء في هذا العالم عبر الفتوحات، بما فيه تقاليد الشعوب الأخرى وعاداتها، التي تُعدّ أساسًا من تشكيلاته المعرفية عندهم، بينما استوعب التقاليد والأعراف البدوية، وضمّنها داخل البنية الدينية المؤسساتية من أجل استمالة ناس البادية إلى الدين الإسلامي، وهي طريقة ذكية في حماية الدين من أعدائه القريبين من منشئه. ولو عمل مع الشعوب التي احتلها بالطريقة نفسها لاستوعب تلك الثقافات، ولم يلجأ إلى تكفيرها أو نبذها. هذه مهادنة للمعرفة عندما لا يستوعب الإسلام في فتوحاته ثقافة البلدان التي فتحها بحملاته العسكرية وتقاليدها، والتي لا تزال آثارها المأساوية قائمةً إلى الآن.
ما أردت قوله في هذه المقدمة الوجيزة، إن التلاقح الثقافي مجال لديمومة الحاضر، والعكس يؤدي إلى قطائع مهلكة عندما تتأخر أنت ويتقدم الآخر.
هذه ليست نتيجة مباشرة لوضعنا كعرب في مؤخرة ركب العالم المتقدم، مع أننا نمتلك إرثًا علميًا استفادت منه أوروبا في نهضتها من القرن السادس عشر وحتى القرن التاسع عشر، ثم في عصر أنوارها من نهاية القرن التاسع عشر وحتى اليوم، خاصةً في ميادين الرياضيات والفلسفة والفلك والطب واللغة وعلم البحار والتراث والكتابة والقواميس والحكايات والنحت والورق والصناعات وغيرها، إنما في الأرضية الاقتصادية التي لم نتعرف عليها قبل أن ينبهنا ماركس وأنجلز إلى طبيعتها الإنتاجية الأحادية التي لا تؤسس مجموعات متضامنةً ذات هدف مركزي يمكن تطويره، وأعني بها الزراعة والإنتاج الملحق بها والعلاقات الاجتماعية التي لا تؤسس على فائض القيمة لها أيّ تطور، لأنها إنتاج أرضي يتكرّر بفعل مباشر أو غير مباشر، لذلك ليس من يد عملية تنتجه بالكامل، بل تسهم في إنتاجه، وتحصل على ريعه، ومن ثم تعاد العلاقة مع الأرض والسماء بطريقة متكررة لا تجديد فيها ولا استثمار.
لم أجد في كل مناحل التفكير عن سبب تأخرنا غير أننا صيانيّون نصيّون، نقدّس حتى الفاصلة والنقطة في النصوص المقدسة، وندفن رؤوسنا في هذه النصوص التي لا تقبل التفسير والتأويل لأنها أغلقت نوافذها على قول يفيد الطبقات الحاكمة ورجال الدين، الذين ارتبطوا بالسلطة وقدسوها وارتضوا الذل من حاكم ظالم وفاسق مادام يحكم باسم الدين. أيّ تخلف هذا عندما يصادر حق الملايين من البشر ورأيهم من أجل حاكم مستبد ظالم لمجرد أنه يوهم العامة بأنه وريث أجداده القدامى، ومن قبيلة فلان، وينتمي صدقًا أو كذبًا لأولي الأمر من الأئمة والمصلحين. هل بمقدورنا أن نطور علمًا تكون بداياته وتأسيساته بمثل هذه العقلية المتخلفة، التي تُسخّر ثرواتنا لصالح وجود السلطة الدينية دون أن تعمم خيرات هذه الثروات على الناس؟ من حكم على هذه الشعوب بهذه الطريقة المتخلفة التي جعلتهم يكرهون العلم والمدنية والحضارة ليعيشوا في هوامش العالم، ويدّعون أنهم “خير أمة اخرجت للناس”؟ حقيقةً إن الأمر ليس بهذه الصورة، والدين الإسلامي لم يكن بهذه العقلية المتخلفة، لكنهم انقادوا كالماشية إلى أطماعهم ورغباتهم الجنسية، وعطلوا العقل واعتمدوا النقل وضعف السؤال، وكان اعتقادهم أن السؤل عن ظلم غير مبرر مادام الحاكم يحكم باسم الله. لقد مرت الكنيسة الأوروبية بكل تلاوينها بمثل هذه الخزعبلات، إلاّ أن العقل الذي رفض أن يكون منقادًا أعاد تكوين المعرفة عبر أسئلة جذرية لمفاهيم الدين والعلم وعلاقتهما بإنسان فلسفة التنوير.
سأعالج مسألة التخلف في عالمنا العربي بطريقتين مجرَّبتين:
الطريقة الأولى
هي طريقة تاريخية فلسفية، عناصرها البنائية مادية تخص تطور الإنتاج، والكيفية التي تصوغ الشعوب بها رؤيتها لمستقبلها، مصحوبةً بتطلعاتها الثقافية، دون أن تستبدل هذه التطلعات بثقافات أخرى، حتى لو احتلتها دول استعمارية كما حدث في اليابان، وثقافة الاحتلال الأميركي لها، إلا أن اليابان عادت لموروثها الثقافي وطرائقه العملية، وأقامت عليه رؤيتها للمستقبل، دون أن تلغي المثاقفة مع ثقافة المحتل الأميركي. هذه الطريقة هي النهج الماركسي لتفسير التاريخ عبر عملية الإنتاج، وكانت رحلة الماركسية، كأيديولوجيا وفلسفة مادية لتفسير التاريخ، قد وجدت في أرضنا الشرقية بعض مزارعها الملائمة لإنباتها، لكنها اصطدمت بالعقلية الصيانية الثابتة، واعتبرتها معاديةً للأديان، دون الأخذ بنظريتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنفتحة على الميثيولوجيا والتراث، وهذا ما عطّل نموها كما حدث في الصين والهند وأوروبا حيث تمثلوها بأشكال مختلفة حفظت لهم هويتهم، من غير السقوط تحت هيمنة الرأسمالية العالمية وأجنحتها الدينية والفلسفية، وهي البعيدة كليًّا عن الأديان السماوية كما هو معروف في تقديسها للمال والجنس من أجل الهيمنة.
ماذا حدث بالنسبة إلينا عندما رفضنا الماركسية، أو خطوطها الدنيا في التطبيقات الاشتراكية، التي كانت بعض منطلقاتها إسلاميةً دلّت عليها الحركات الإسلامية الثورية، التي كانت ترفع شعار بسم الله الرحمن الرحيم أيضًا، أسوةً بما يفرضه المفهوم الإسلامي على الاختلاف المنهجي في التفسير العقلي للنصوص؟ وكانت النتيجة أن اعتبرنا، نحن الشرقيين، أن القومية والدين هما المقومان الأساسيان لقيام نهضتنا التنموية والفلسفية والعمرانية، وكان الغرض من رفع شعارات القومية والدين ليس من أجل صالح عناصر القومية والدين لمجموع المسلمين، كما تنص عليها أوليات نشوء الأديان والقوميات، إنما للوقوف بوجه الماركسية وكأنها العدو الأول لنهضتها عبر مفهومي الدين والقومية. هل فقدت ألمانيا وأوروبا في القرن الثامن عشر والتاسع عشر أسسها القومية والدينية وهي تقيم نهضتها وأسس عصرها التنويري على الحرية والمدنية، وتحرير السوق من الهيمنة الرأسمالية القديمة؟ لا شك في أن من يقرأ تاريخ هذه الشعوب يفهم أن اللعبة القومية والدينية لم تنفع في مجتمعات العلم التجريبي، والجامعة المنفتحة على الفلسفات والعقلية الإنتاجية العملية في التعامل مع الإنسان والأرض والعلم والثقافة والميثيولوجيا. أما عندنا فقد عطّلوا كل شيء، وجعلوه مرتبطًا إما بالدين أو بالقومية واللغة، أو بهم كرجال سلطة من أجل تعطيل الفكر العلمي كي لا يمتد من المصادر إلى عقول الناس. لذلك بدأ القمع بأشكال مختلفة، وأبشع أنواعه أن مورس القمع القومي والديني واللغوي على حريات الناس، وتفكيرهم، واشتغالهم اليومي، وطرق نومهم وأكلهم وملبسهم، ولسانهم، وأعينهم حتى أغلقوا كل نوافذ الحياة بغربال الإسلام، وشعارهم “الإسلام هو الحل” بعد أن فشلت القومية في تبني ولو الحد الأدنى من الحريات عندما صاحبتها مظاهر القمع والتسلط والتفكير الأحادي. ولدينا تجربة عبدالناصر والبعثيين ماثلة للعيان حين وسّعت من المظاهر الدينية المتخلفة، وألغت فكرة التنوير من الثقافة القومية والدينية واللغوية، وكانت نتيجتها مؤلمةً لأمّة عرفت بتقدمها للعالم. والنتيجة كانت حروبًا موضعيةً في اليمن والسوادان والعراق والجزائر، ثم انتهت إلى الربيع العربي الذي أعاد صياغة الفتوحات بشكل أسوأ، وينتج الحركات الإسلامية التكفيرية التي أتت على أخضر الفلسفة العربية الإسلامية ويابسها.
ماذا حدث في الغرب، وقد رُفضت الماركسية من طرف فئات ومؤسسات واسعة؟ وهنا يكمن جوهر الطريق العلمي في تبنّي أفكار التقدم، دون أن تكون مؤمنًا بالشيوعية أو بغيرها، عندما بحثوا عما يسمى بـ”الماركسية المتكاملة”، ويعنون بها الخطاب الثقافي، أو النظرية الثقافية على ما يقدم من تصور لها “إعجاز أحمد” بوضوح، من أن النظرية الثقافية يمكنها أن تعوض الشعوب المتخلفة، أو تلك المتمسكة بالدين والقوميات واللغة دون تطوير، أن تؤسس لها رؤيةً منفتحةً على التطور، مستفيدةً من مرونة الثقافة في فهم نشوء الثقافات المحلية وتطورها، وطرائق الإنتاج المادي والفلسفي والمعرفي، وهو ما نما متوازنًا في أوروبا الحديثة اليوم من أن طرائق الإنتاج، ونمو الطبقات الاجتماعية، والتفسير المادي للتاريخ، ودور العامل المدني والاقتصادي الحر، وتسخير العولمة، وفتح الحدود على الثقافات الأخرى، واستثمار العقل والعلم. كل ذلك وغيره لم يغيّب الماركسية عن جذورها المادية، ولم يعتمد الرأسمالية المتوحشة بكلية تفكيرها، بل زاوج بين هذه وتلك، معتمدًا على دور النظرية الثقافية والأدبية في تطوير البنى المعرفية، وهذا ما نجده متحققًا في الواقع، من أن الفلسفة، والرواية، والشعر، والحداثة، ومابعد الحداثة، والعمارة، وتنظيم المدينة والأسواق والعمران وحقوق الإنسان تسير بموازاة تطور بنية الفكر بعامة، الأمر الذي جعل من النظرية الثقافية طريقًا ثالثًا لا يغاير الرأسمالية ولا الاشتراكية، وإنما ينهل من معين المعرفة الإنسانية كلها، ليؤلف خطابًا ثقافيًا يمكنه أن ينهض بالأمة وبمشروعاتها التنويرية بموازاة النظريات الرأسمالية والاشتراكية، محاكيةً الطبيعة المادية لهذه الشعوب التي لم تكن زراعيةً بالكامل، ولا صناعية بالكامل، بل تمتلك ثروةً حضاريةً وخطابًا معرفيًّا وفلسفيًّا عريقًا يمكنه أن يؤسس أرضيةً للحداثة في الشرق الأوسط ومن بينها دولنا العربية.
هل بمقدورنا في الشرق أن نتبنى “النظرية الثقافية” كبديل للقومية والدين واللغة المتحجرة؟ بعد ثبوت فشل هذه القوميات والأديان في النهوض بحركة تتوازن فيها خطاباتها مع خطابات الرأسمالية والاشتراكية، ولدينا أرضية أكثر ميلًا للأنماط الاشتراكية من البنى الرأسمالية. أعتقد أن الطريقة الثانية التي سأتحدث عنها هنا كفيلة بأن تجيب على هذا السؤال. وكان من نتيجة النهضة أن العلم المعرفي أنتج عاملين ثوريين لإنتاج التنوير في أوروبا القرن الثامن عشر، هما المطبعة والبارود. طورت المطبعة العلم التجريبي والفلسفي والتعليم الجامعي والإنتاج الثقافي، والإنتاج الروائي والشعري والفني، ووسّع البارود من العلم الصناعي والتقني والعسكري بمحركات السكك والنقل والمعامل والكهرباء والسفن وقوانين الميكانيكا، وفتح طرقًا نحو الشرق: قناة السويس، وطريق برلين بغداد الذي لم يكتمل، وهو جزء من مشروع الفرنسي سان سيمون الاشتراكي الطوباوي، فأنتج الحربين العالميتين وقوى الإنتاج المادي ونشوء الطبقات، وكانت حصيلة أوروبا وأميركا المتوازنة بين العلم والدين، دون أن تفقد قوميتها أو أديانها.
الطريقة الثانية
هي ما نتج عن هزيمة حزيران عام 1967، والتي قُيّمت تاريخيًا بأنها هزيمة أنظمة وليست هزيمةً عسكريةً، فالجيوش العربية ليست إلا غطاءً للسلطات المتحكمة دينيًّا وقوميًّا، ومن تحتها كانت آلية التفسير الديني تهيمن على الإنتاج المعرفي والثقافي عندما أصبح التراث، كل التراث، مسلمات ونصوصًا، دون نقد يفرز بين مفاصله، مادةً دستوريةً ومعرفيةً للهيمنة على العقل العربي التنويري، مع أننا نمتلك ايضًا البارود من خلال مدفع نابليون عندما احتل مصر عسكريًّا، والمطبعة حين جلبها الاحتلال الفرنسي لمصر، أعني مطبعة بولاق، ففي حملة نابليون ثمة أسس تنويرية، لكن العقلية القومية والدينية قمعت أيّ تطور لهذين المرفقين، على العكس مما عملت أوروبا في القرن الثامن عشر، قرن الثورة الصناعية، عندما استفادت من صناعة الورق الصينية والعربية، ومن فلسفة ابن رشد وغيره في تطوير الدرس الفلسفي عندما فسّروا أرسطو وافلاطون تفسيرًا عقليًا.
ماذا حدث بعد هزيمة حزيران 1967 غير أن تنادى عدد من المفكرين التنويرين العرب لنقد التراث الذي تحكم بالعقلية العربية، ومن ثم أدى إلى الهزيمة التاريخية التي غيرت كل السياقات في المنطقة لصالح أوروبا وإسرائيل والهيمنة الأميركية. فكان هنا محمد أركون وعبدالله العروي ومحمد عابد الجابري وأدونيس وهشام شرابي ومطاع صفدي وحسن حنفي ونصر حامد أبو زيد وسيد القمني ومحمد عودة وجورج طرابيشي والطيب تزيني وجلال صادق العظم وهادي العلوي وحسين مروة ومهدي عامل وعلي حرب وأحمد خليل، ومجموعة كبيرة من مثقفي اليسار والقومية والدين، الذين أسسوا مجالات لتطوير العقل العربي وتنويره، لكن مشروعهم كان فرديًا، وبقي فرديًا، وإنتاجهم لم يربطه خيط فلسفي تنويري كمدرسة فرانكفورت مثلا، الأمر الذي تناهبته العقلية المؤسساتية القومية والدينية، وحجرت المشروع التنويري تحت عباءة مؤسساتها الدينية والقومية، ومن ثم تفتيته وإعدامه لاحقًا بمِنح وجوائز إلى الحد الذي لم يعد ردة فعل على هزيمة حزيران الحضارية، بل أصبح مشروعًا للكسب المادي، وهكذا تفتت للمرة الثالثة مشروع نهضوي، كما فتت محمد عبدة المشروع الأول، وفتت القومية بكل صنوفها المشروع الثاني، وها نحن نشهد تفتيتًا ثالثًا أكثر تخلفًا عندما هيمنت الحركات الدينية المتخلفة على تراث الأمة العربية وحضارتها ولغتها ونموذجها المباشر العراق. والحصيلة أن الكل سقط في محفة الدين والقومية ودول الجوار مثل إيران وتركيا، بمباركة إسلامية سلفية ترعاها مؤسسات النفط في دول الخليج، دون أن يمتد المشروع إلى العامة.
لم يقف هذا الانكسار عند حده الأول، بل استمر ثانيةً وبقوة ما يسمى الربيع العربي، الذي بدأ نهضويًا وانتهى قوميًا ودينيًا، لكن بأبشع صوره التنفيذية في العراق وليبيا والجزائر والسودان وسوريا واليمن ومصر، لولا بعض النهوض الميداني في مصر، مما جعل إيران تستولي على مقدرات الربيع بحجة الثورة الإسلامية التي نشأت بمرافقة النهضة الدينية في العالم عند مجيء ريغان وتاتشر والخميني، ومن ثم صدام حسين عام 1979 و بدء سلسلة الحروب التي أغرقت المنطقة بالتخلف. كل هذه الألعاب الرأسمالية كانت تنفذ بإرادات إسلامية وعلى أرض إسلامية وبحجة محاربة الاشتراكية والتيارات المدنية وحركة التنوير والحداثة. والنتيجة؟ لا يمكن تبصر أيّ أفق قريب لأيّ نهضة تقوم على هذا التردي المسند من الرأسمالية والصهيونية.




