لعبة الأزمنة والجوائز
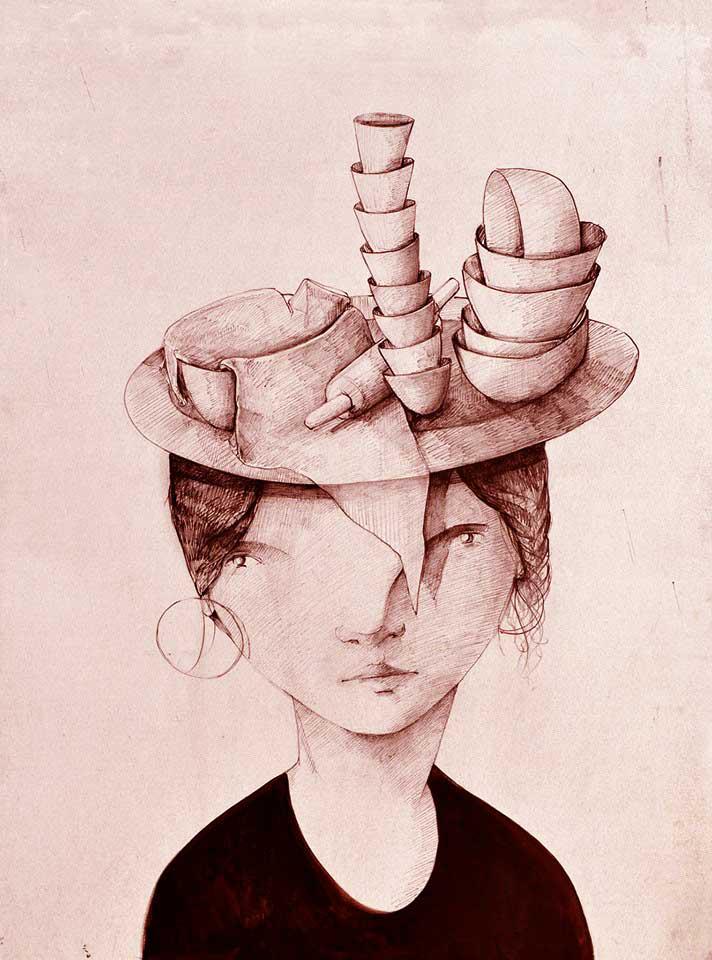
هل يمكن توصيف مسألة تغليب جنس أدبيّ على آخر بأنّها لعبة جوائز، أو بتعبير أقسى؛ خدعة الجوائز؟ ومن المعلوم أنّ الجوائز تلعب دوراً في توجيه دفّة الأدب صوب هذه الوجهة أو تلك، من جهة الاحتفاء بها تباعاً، والإيحاء بأنّ هذا الجنس أكثر حضوراً وتأثيراً فتمّ تكريمه وتتويجه، من دون أن يلغي الآخر أو يعتّم عليه؟
لا أعتقد أنّ الفكرة تُطرح بهذا الشكل، أن يلغي فنّ فنّاً آخر، أو يأتي على حسابه، بحيث يأخذ من حيّزه ليفترش مساحة أكبر من الاهتمام، ويحظى بمزيد من المتابعة والانتشار والجماهيرية..
للشعر زمنه الخاصّ الذي يستحيل أن يزاحمه عليه أيّ فن آخر، وهذا الأمر ينطبق على الرواية، وعلى الفنون والأجناس الأدبية الأخرى، ذلك أنّ القول بموت هذا الفنّ، أو انحساره، أو تبدّل زمنه، وتقهقره وكأنّه في صِدام مع الفنون الأخرى، أو في حالة بحث عن الهيمنة معها، يبتعد عن جوهر الفنّ نفسه، وينساق وراء مقولات فضفاضة بعيدة عن حقيقته وواقعه وتاريخه.
لا أظنّ أنّ أيّ جائزة، مهما بلغت من القيمة والاعتبار، ولو كانت نوبل نفسها، يمكن أن تساهم بتسييد زمن فنّ على آخر، لأنّ الأمر يتعدّى التتويج إلى عالم برمّته، فقد ينصبّ التركيز على الفنّ المتوّج بنوبل هذا العام، أو الذي يليه، لكنّه لا يحدّد معالم تاريخ الأدب ولا خرائطه.
فلو كان الشعر في أزمة، وينازع للبقاء، فلن تنقذه أيّ جائزة، ولن تعيده إلى الصدارة أو تخرجه من أزمته، بل قد تطيل عمره قليلاً وتوقف موته لمحطّة لاحقة..
وإذا كان منح نوبل معياراً لتصدّر نوع من الأدب، فلماذا لم نجد أيّ اهتمام يُذكر، على الأقلّ عربيّاً، بقصائد بوب ديلان الغنائية سنة 2016، ولا أذكر أنّ كثيرين استساغوا قصائده، أو ظنّوا أنّ أسلوبه في الكتابة الشعرية الغنائية سيسود ويصبح سيّد الزمن الراهن أو المستقبليّ، بل كان التتويج ذاته وُصف من قبل بعضهم بأنّه هفوة نوبل، وهذا بالطبع بعيداً عن قيمته الموسيقية والأدبية.
لو كان الشعر في أزمة، وينازع للبقاء، فلن تنقذه أيّ جائزة، ولن تعيده إلى الصدارة أو تخرجه من أزمته، بل قد تطيل عمره قليلاً وتوقف موته لمحطّة لاحقة
لعلّ أزمة الشعر تقبع في مكان آخر، ولا ترتبط بانحسار الاهتمام به في الجوائز، لأنّه ما تزال هناك جوائز عديدة للشعر، بل هي تكمن في طبيعة الزمن نفسه، وفي استراتيجيات الكتابة والتلقّي، ولربّما لم تعد القصيدة لدى بعضهم قادرة على التعبير عن مكنونات قلوبهم، لا لمشكلة بالقصيدة، أو لقصورها عن ترجمة ما يعترك في دواخلهم، بل لأنّه تعقيدات الحياة فرضت إيقاعاً مختلفاً يواكبها عليهم، وملأت الرواية هذا الشاغر وتصدّرته.
وقد توجّه العديد من الشعراء إلى الرواية، ولا أدري هل كان ذلك عن تهافت من قبلهم على ما راج بأنّه زمن الرواية، أو أنّهم صدّقوا مزاعم بأنّ الشعر مات أو يكاد، ووجدوا أنّ عليهم إنقاذ أنفسهم من سفينة الشعر التي شعروا أنّها تغرق وتغدو طيّ النسيان أو تعود إلى الهامش، أو أنّهم أرادوا صيغة تعبير جديدة بالإضافة إلى القصيدة ليوصلوا من خلالها رسائل مختلفة جديدة..
ولا أودّ القول بأنّ الشاعر الهارب إلى ميدان الرواية مسكون بالشكّ بقدرة قصيدته على منافسة الرواية، فتراه رضخ لمقتضيات العصر كي لا يقبع في الظلّ أو يبقى في العتمة، لأنّ الأمر يمكن أن يكون انطلاقاً من إثراء معرفيّ وأدبيّ، وارتحال بين الأجناس الأدبية وتجريبها، وإضفاء لقيمة يجد أنّ الرواية تفتقر إليها وأنّ بإمكانه أن يسبغ عليها بصمته الشعرية الخاصّة.
لا يهدّد الشعر عرش الرواية، كما أنّ الرواية لم تحظِ بأهمّيتها على حساب الشعر، لأنّ لكلّ منهما عالمه وزمنه وجمهوره، ولا يكون الأمر بالحلول والاتّحاد والتنافس بقدر ما يكون بالتكامل والإثراء. والشعراء ينافسون أنفسهم فقط، وكذلك الروائيّون، وحين تُسلّط الأضواء على أحدهم تكون هناك أضواء أخرى بانتظار الآخر في محطة قادمة قريبة.
ويبقى ما أجمل في عالم الأدب أنّه يستوعب الفنون ويتجمّل بها، يكتسي بها حلله وجمالياته، لذلك فإنّ كلّ زمن هو زمن الشعر، وزمن الرواية، وزمن القصّة، وزمن المسرح، والسينما والدراما كلّ الفنون الأخرى.




