ذاكرتنا المتوسطية
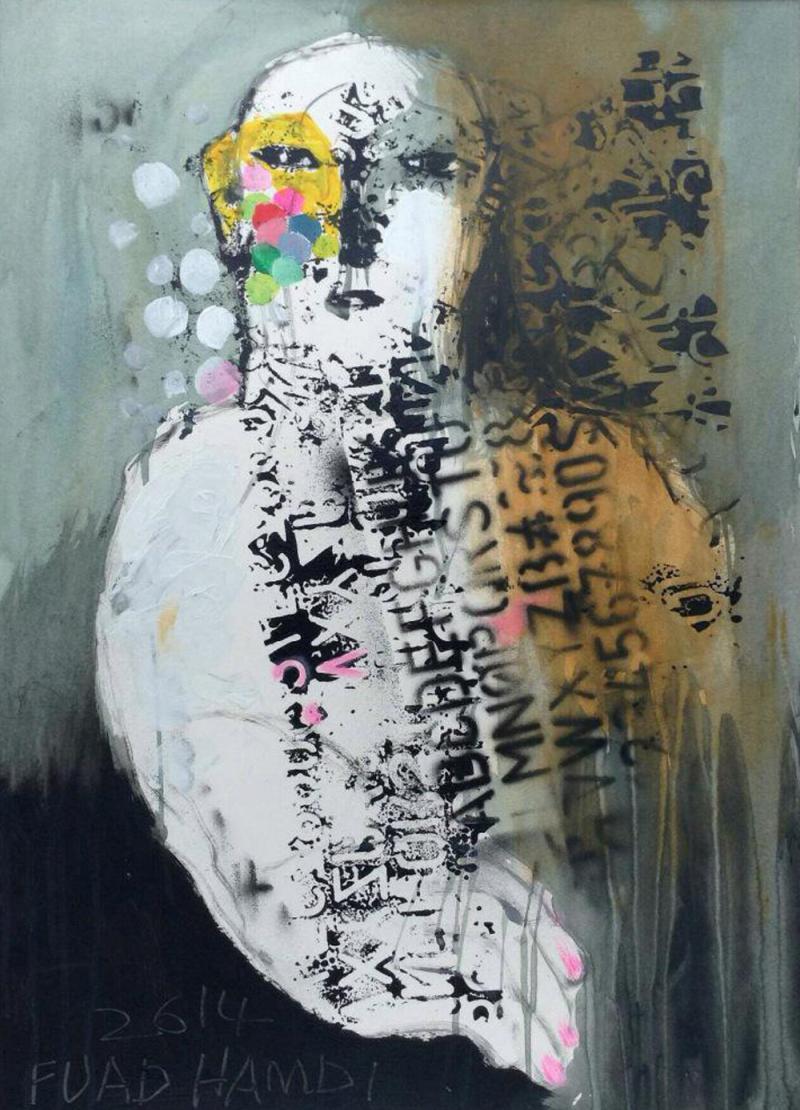
اندلعت الثورة التونسية حين أضرم محمد البوعزيزي النار في جسده للتعبير عن احتجاجه، بعد أن افتكت منه بضاعته ومعداته التي كان ينقلها على متن عربته المتجولة بدعوى مخالفة القانون. حدث ذلك في السابع عشر من شهر ديسمبر ألفين وعشرة.
كان انتحاره إذن ضربا من ضروب الاحتجاج السياسي لوقوعه بالفضاء العام أمام مبنى ولاية سيدي بوزيد بالجمهورية التونسية، مما شجع الناس على تجاوز مخاوفهم والخروج إلى الشوارع للإفصاح عن استيائهم من النظام الاستبدادي للرئيس زين العابدين بن علي فاتسعت رقعة المسيرات والاحتجاجات لتشمل جل مناطق البلاد. وبعد سقوط النظام، اتخذ انتحار البوعزيزي بعدا سياسيا، إذ بات فعلا تحرريا حرّض الشعب بجميع أطيافه على أن يثور ليطالب بالعدالة والمساواة والحرية. كان لا بد إذن أن يحاط ذلك الفعل بمعاني النضال والبطولة وأن تسند إليه مرجعية ثقافية تجعله لحظة فارقة في تاريخ تونس.
تعددت التأويلات والمرجعيات في تلك الفترة، ولم يكن من السهل أن يستند ذلك الانتحار إلى مرجعية ثقافية مّا، في وضع سياسي واجتماعي متأزم، لكي لا يتحول إلى ظاهرة اجتماعية مؤهلة للانتشار وهو ما حدث بالفعل في مرحلة لاحقة. وما يهمنا في هذا المضمار هي المرجعيات الثقافية التي اعتمدت لتفسير المسألة التالية والتي طرحت آنذاك: كيف تحول انتحار البوعزيزي حرقا بالنار في الفضاء العام إلى شعلة انطلقت منها الثورة؟
لم تكن من الهين الإجابة عن مثل هذا السؤال لصعوبة فهم وتفكيك دوافع ومبررات الثورات في جل المجتمعات على امتداد التاريخ الإنساني، لعدم جواز إسناده إلى الثقافة العربية الإسلامية التي تحرّم الانتحار، لذلك كانت جل الأجوبة المطروحة بمثابة الفرضيات ومن بينها إمكانية ارتباط ذلك الفعل بالإرث القرطاجنّي بما يحمله من قصص وأساطيره باستحضاره قصة الملكة عليسة مؤسسة قرطاج، حين ألقت بنفسها في النار وفاء لزوجها ورفضها الزواج من هيرباس الذي قيل إنه ملك السكان الأصليين. كذلك ما روي حول زوجة أستروبار قائد الجيش القرطاجني حين انهزم في الحروب التي شنتها روما على قرطاج في ذلك العهد، فما كان منها إلا أن ألقت بنفسها في النار بعد أن أطلقت صرختها الشهيرة قائلة “النار ولا العار”، إذ كان حرق النفس بالنار في كلتا الحالتين احتجاجا بل رفضا لوضعية سياسية معينة غيرت مجرى التاريخ.
ومع ذلك لم تكن السردية القرطاجنية هي السردية الطاغية لتفسير اندلاع الثورة التونسية، مما يحيلنا إلى حقيقة تاريخية ما انفكت الثقافة الرسمية تتجاهلها ألا وهي تأثير الثقافات السابقة لانتشار الثقافة الإسلامية العربية (القرطاجنية، اليونانية، الرومانية الفرعونية المصرية، وغيرها) على القيم السائدة وما تركته من تقاليد وعادات تشمل جل مظاهر الحياة اليومية.
كيف غيّبت مثل هذه السردية القرطاجنية خلال المسار الثوري في تونس إثر غلبة الخطاب “الهووي” الذي طغى في ما بعد، باعتبار أن المرجع الأساسي لكل تشريع، لا بد أن يكون بالأساس عربيا إسلاميا وما أثاره هذا الجدل من خلافات أيديولوجية، استغرقت وقتا ثمينا أثناء مداولات المجلس التأسيسي، أي أثناء صياغة العقد الاجتماعي الذي على أساسه وضعت ركائز السلطة ومؤسساتها.
ألا يمكن الحديث عن ثقافة إسلامية متوسطية لها خصوصيات قادرة على إدماج واستيعاب الثقافات السابقة والاستفادة منها؟ أولم يقم الدين الإسلامي على مبدأ التوحيد الذي استطاع أن يكون جامعا ومستوعبا لجل الثقافات السابقة له من وثنية ويهودية ومسيحية، أو لا يعتبر هو أيضا من ضمن الثقافات المتوسطية؟
إنها أسئلة أساسية، لأنها كفيلة بأن تخرجنا من بوتقة الهوية اللغوية العقائدية الأيديولوجية إلى أفق الاندماج في المسار التاريخي وما أنتجه من تراكمات ثقافية وحضارية مختلفة، بما يجعلنا نتجاوز وضعية التدهور والانحطاط التي نعاني منها منذ قرون.
وهو ما يؤدي بنا إلى طرح السؤال الآتي: هل توجد ثقافة متوسطية جامعة بين الشرق والغرب؟
إذا عرفنا أن البلدان الواقعة على حدود البحر الأبيض المتوسط تنتمي إلى ثلاثة أفضية وهي: الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط والمغرب العربي، كان الجواب بالنفي لاختلاف اللغة والنظام السياسي والاجتماعي والدين وتفاوت النمو الاقتصادي لتلك البلدان، رغم مواجهتها للمشاكل نفسها مثل مقاومة الإرهاب، التطرف الديني، الهجرة السرية، وتلوث البحار.
إلا أن إرثها التاريخي لم يستثمر بعد لخلق علاقة تواصل حقيقية وعميقة، تحدّ من بعض خلافاتها وصراعاتها وتجعلها حاملة لثقافة متوسطية من شأنها تغيير وجه العالم. وهذا يحتاج إلى مباشرة حوار ثقافي واسع داخل ثقافتنا العربية فليس من الطبيعي أن ننسى أو نتناسى أن هذه المنطقة شكلت مهد أكبر الحضارات الإنسانية على امتداد العصور.




