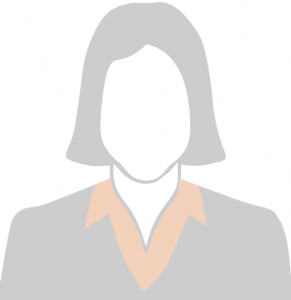ضد سلطة الذكورة

لقد استشعرت الباحثة باتريس ديديي صعوبات الكتابة النسوية عند قولها “إن خصوصية الكتابة النسائية لا تلغي مشابهتها للكتابة الرجالية” وهي، تبين في هذه المفارقة، أن هناك صعوبة التفريق بين الكتابتين والعكس صحيح. فإلى أيّ مدى تنطبق مقولتها على الخطاب النسائي العربي؟ وهل استطاعت الكاتبة العربية أن تمنهج خطابها، وتستدعي لغة خاصة بها بغض النظر عن جنسها؟ لنعود بذلك إلى الواقع الحياتي، والتاريخ الجمعي، إذا سلمنا أن الشعر والنثر خاضت فيهما المرأة العربية منذ قرون خلت.
لقد ظلّت الحركات النسائية في الوطن العربي أسيرة خطابات سياسيات حتى وقت قريب، ولما كان ذلك ضرورياً في مرحلة التحرّر من الاستعمار وتأسيس دولة الاستقلال، أصبح يشكّل قيداً وعبئاً على التيارات التي تدافع عن قضايا المرأة، فلم تستطع أن تحقق اختراقاً بارزاً على مستوى تغيير الدستور والقوانين وثقافة المجتمع رغم ما أصابه. فحين تلامس الكتابة المرأة ووعي قلمها لإبراز قضايا وجودها في المجتمع يصطدم قلمها بعدة عوائق، حتى تنسحب بعض الأقلام أو تعتزل. ثمة هيمنة ينطوي عليها مثل هذا الخطاب؛ الأولى هيمنة دينية/إسلامية، والثانية مجتمعية/عالمية، أو هكذا نقرأ في مفاصل الحدث اليومي إثر سماعنا عن إصدار رواية جديدة بقلم أنثى.
وأمام هذا المكتوب والمنطوق من صنع المسكوت عنه في الحياة تتراءى لنا زاوية الندية بين مؤيّد ومعارض للأنا الأنثوية التي لها ذات حاضرة في مجتمع ينادي بالإنسانية. فهل استطاعت المرأة أن تؤسس خطابها الثقافي الخاص، بعيداً عن النسق الذكوري المهيمن؟ وإذا كان الأمر كذلك؛ فما هي مميزات ذلك الخطاب، هل أبدع سمات أنثوية خاصة أم ظل يتحرك في أفق جنس الخطاب المنتمي إليه إبداعيًا؟ ثم هل لذلك تجليات على مستوى الخطاب النّسوي العربي، بصفة عامة والعربي بصورة خاصة؟
عند تناول الخطاب النسوي الحديث المعبّر عن أفقه الجديد، ثمة نقاط ارتكاز أساسية لا بدّ من التأكيد عليها، كونها تشكل في مجملها مهيمنات أو نقاط ارتكاز يتأسس عليها تقدم صورة شبه عامة عن الطريقة التي ينظر بها إلى الخطاب النسوي، أو السرد الذي تكتبه النساء. يدفعنا إلى مجموعة من الإشكالات التي تدركها، بل تتبناها قضايا الأدب النسوي العالمي بشكل عام، والعربي بشكل خاص، وما يتولد عنها من مفاهيم وقضايا تظل عرضة للالتباس والإبهام ما لم نعمل على تدقيقها، وإعادة صياغتها. وفي هذا الأساس سنحاول وضع مفهوم “الأدب/السرد النسائي” في سياق العديد من المفاهيم بغية الوقوف عند “الرواية النسائية العربية” لمعاينة إلى أيّ حد يمكننا الحديث عن تجربة روائية متميزة تجاوزت المعتاد؟ ولمقاربة التجربة الروائية في مختلف مستوياتها وتجلياتها؛ خاصة إذا أدركنا أن هناك أكثر من كاتبة حاولت الخروج من قالب الشعر إلى السرد، وأخريات من قالب القصة القصيرة إلى الرواية، بل وهناك العديد منهن كتبن عن تجربة حياتية مررن بها.
لا شك أن التعارض الأجناسي بين نسقين كبيرين (الشعر والسرد)، وما يندرج تحت النسق الثاني/السرد (المتخيل والمرجعي) حاصل مهما كان بإبراز أشكال تعبيرنا عن ذواتنا أو وجودنا بين المتخيل والواقعي. ولعل الكثير من الكاتبات كانت بداية أقلامهن معبرة عن الذات والوجود مما حدا بكثير من المهتمين بهذه الذات إفراد مجلة أو عمود في صحيفة للحديث عن هذه الذات وإيلائها اهتماما خاصا، لإبراز أقلامهن من جهة، أو تمكين فكرهن من جهة أخرى للغوص في أعماقهن وما يفكرن به. ونذكر على سبيل المثال ما ذهب إليه نوري الجراح عند تصديره للعدد الخامس من مجلة “الكاتبة” – التي لم يكتب لها الاستمرار – عندما أطر مقاله بالسؤال التالي “هل يصح الوقوف باستمرار ضد تصنيف الإبداع نسبة إلى جنس مبدعه؟” معبرا ملخصا عن “ثقافة الخوف من الأنوثة”. التي كان لها صدى كبير في التجليات عن المسكوت عنه في مجتمع عربي محافظ، لكنه مشحون بالمتناقضات حيال العلاقة بين الذكورة والأنوثة؛ حتى عند أبرز المتعلمين والمثقفين في ظلاله.
إنّ قضايا الرواية العربية بشكل أو بآخر هي قضايا المجتمع العربي. إنها متعددة ومتنوعة ومتشعبة تشعب قضايا الإنسان العربي وتنوعها. غير أن الرواية النّسوية لها وجودها الخاص. وجود يرتبط ببعض القضايا في ذاتها، أي الوجود الذاتي، ومنها ما يتصل بموضوعها الذي تتجلى فيه قضايا المجتمع العربي المهزوم وتحولاته بأمكنته وأزمنته وثقافته وفكره، أو ما يطلق عليه سعيد يقطين “الوجود الموضوعي”. وكما هو معروف تكمن قضايا الوجود الذاتي في الكتابة الروائية وتاريخها وأنواعها وتقنياتها وأساليبها وأشكالها عندما تقارب أطروحاتها مفاصل فكرية أو اجتماعية أو سياسية أو مذهبية؛ تتحقق من خلالها صرامة تفكيك الحدود بين الذاتي والوجودي. فتتشكل العلاقات والموضوعات داخل الجنس السردي بسبب الانتصار للقضية المطروحة حسب الجنس الأدبي الذي تختاره الكاتبة ليقارب الأيديولوجيا التي تأنس في تجلي ذاتها ووجودها في آن من خلاله. فقد تميل إلى الشعر، وقد تأنس إلى السرد؛ فيغدو القاسم المشترك بين رؤاها وقلمها مشروعا كتابيا لانتقاء نوع كتابي دون آخر؛ والانتصار لجنس سردي دون غيره للتعبير بحرية مطلقة، تحرر فكرها بأيديولوجية قلمها.
ولأننا نعيش عصر الرواية بكل ما يحمله هذا الجنس السردي من أنواع مكّن الكاتبة العربية من خوض غمار معاناة مثيلاتها، وقضايا مجتمعها. وحاولت الكاتبة العربية من خلال تعليمها التحرر بالكتابة، والتمرد بتصدير اسمها على عناوين مقالاتها، وأغلفة مؤلفاتها؛ مما منحها ومكنها من تشكيل هوية قلمية وكتابية ولوحات فنية تعينها على إزالة اللبس بين مصطلحين يحددان جنسية الخطاب النسوي أو نوعية السرد النسائي باعتبار أطروحاتها الخاصة التي تشكل اليوم تيارا هاما له روافده وخصوصياته تمكنها من تشخيص همومها المجتمعية، ومشاركتها السياسية في إطار مجتمعي ينظر إليها دوما على أنها ناقصة عقل ودين مهما وصلت من رتب علمية وفكرية وثقافية وسياسية.
فإذا سلمنا أننا نواجه إشكالية منهجية مصطلح قبل إشكالية قلم يحرر نصا، وإذا سلمنا بأن مصطلحي “الأدب النسائي” أو “السرد النسائي” غائمان، يبقى كل ما تحرره المرأة من خلال علاقة وطيدة بين الذات والكينونة هو تعبير صادر من ذات كاتبة هي أنثى. بهذا نستطيع استجلاء خصائص خطاب السرد النسائي لبيان موقع الذكورة في أدب تكتبه المرأة من جهة، وموقع الأنوثة المتحررة في سرد تمتلكه ذاتها للحصول على حريتها؛ دون حاجة إلى موقع ذكوري لإعادة اعتبار المرأة.
من هنا يحضر سؤال هام، هل تكتب المرأة عندما تريد سبر ذاتها الوجودية، والانتصار لقضاياها الاجتماعية عن الضّد الموازي لها أم عن الند المساوي لها؟
لو تأملنا نصوصا روائية حديثة أفرزتها الألفية قرابة عشرين عقدًا من الزمان، يؤكد لنا ما تذهب إليه يمنى العيد عند حديثها عن أن “الخطاب المضاد هو خطاب صراعي تحقق تاريخيا بين الذكورة والأنوثة” فالمرأة لا تكتب عن ضدها بمقدار ما تكتب عن الهيمنة السائدة التي جسدت التقليد والتجديد، الجمود والتطور، والحرمان والاكتفاء؛ لأجل تفكيك سلطة السائد في المجتمع باعتباره مجموعة قيم ثقافية سائدة وثابتة، علاوة على ثورانها ضد كل تدمير لإنسانيتها، وحقها في الحرية والحياة.
لو استذكرنا أبرز الروايات التي لاقت رواجا في الأدب العربي الحديث، لوجدنا أن المرأة لم تكتب ضد الذكر/الإنسان في منتجها الروائي/الإبداعي عند حديثها عن علاقة الأنوثة بالذكورة؛ بل كتبت ضد السلطة الذكورية التي عززتها الهوية المجتمعية في أيديولوجيا قوامها كائن ضعيف مقموع، وآخر قويّ متسلط. وهناك العديد من أسماء كبيرة صاحبة منتج روائي جدير بالنظر من الخليج إلى المحيط، فقد جسدن في كتابتهن هذه العلاقة، وأصبح قلم المرأة يتجاوز غبن المجتمع عليها إلى ثيمات إنسانية أرحب مع ما بعد الثورات العربية عام 2011 التي لا تزال آثارها التدميرية باقية. وأصبحت المرأة تعرّي مجتمعها الذي ينادي بالإنسانية والتسامح والتعايش، وهو لا يحمل في واقعه إلا التزييف والضلال. وأصبحنا كقراء ننظر إلى قلم المرأة، وتجسيدها لفكرها من زاوية أخرى، وعندما نقرأ عملا لها تحضرنا مجموعة أسئلة قبل القراءة لها: هل تشكلت لدى الكاتبة العلوم الخاصة بهندسة بناء الرواية أم أن ما تكتبه مجرد بوح؟ وهل تشكلت لدى الناقد التقنيات لدراستها والإمساك بأهم خصائصها؟ وكيف تعي الكاتبة/الروائية هذه القضايا؟ وما حدود هذا الوجود الذي يدركه الكاتبة والناقد؟ وكيف تفاعلت الرواية مع هذه القضايا، بأيّ وعي؟ وأيّ تصور؟
ومع سيرنا في قراءة العمل، أو انتهائنا من قراءته ينبثق السؤال الكبير: ما التجاوزات الرهينة بوعيها وحدودها الفنية والاجتماعية؟ وما هي الحدود التي تقف دون وعيها بذاتها وبعلاقتها بموضوعها، بالكيفية التي تجعلها نوعا سرديا له مكانته الخاصة في الوجدان والوجود، وبلا حدود؟
إن تسليط الضوء على دور المرأة كونها مبدعة ومنتجة للخطاب الثقافي والإنساني لهو موقف منح المرأة قوة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية والإعلامية وغيرها. كما يستجلي موضوعات عدّة، من بينها: النظري والتاريخي، والمرأة في مواجهة العنف، والخطاب النسوي والإعلام، والسياسة في الخطاب النسوي العربي، والخطاب النسوي في الفن، وتمثلات العائلة في الخطاب النسوي، والمكان في الخطاب النسوي، والخطاب النسوي والعلوم الإنسانية، وقراءات في الفكر النسوي، واتجاهات الخطاب النسوي في الأدب. حتى بدأنا نتساءل عن الخطاب الذي تكتبه امرأة في الوطن العربي إلى أين هو سائر أمام الخطاب الذي ينتجه الذكر بصوت أنثى؟
فالأدب الذي تكتبه المرأة وبهذا الزخم الذي نجده اليوم ظاهرة لم يشهد لها التاريخ مثيلا، ليس فِي الوطن العربي حسب، بل وفي العالم بأسره، مما يحيلنا إلى أمور جوهرية حافزة خارج العملية الإبداعية أدبا وفنا ونتاجا عاما، أمور تتصل بعلاقات اجتماعية واقتصادية وسياسية وشيجة مع هذا الإنتاج، فما أن انفتحت أمام المرأة مجالات العلم والعمل والمعرفة حتى وجدنا الكثير من المبدعات اللواتي أكدن قدرات ومهارة فِي الميادين التي فتحت الأبواب أمامهن مما دفع إِلَى نهوض حقيقة جديدة تدحض ما أشاعه الفكر الذكوري عن قصور المرأة وضعفها وعجز قدراتها عن اللحاق بالرجل، حقيقة تؤكد أن غياب المرأة عن الحضور فِي قلب الحياة كان بسبب ما لحق بها من غبن وقمع فكري وقهر نفسي، وبسبب حجب حقوقها فِي العلم والتدريب على العمل والإسهام فِي دفع عجلة التنمية وإقصائها عن المشاركة فِي صنع القرار وليس بسبب عجز فكري أو نفسي أو قصور عقلي فيها، حتى صار الأنثوي طاقة وسلطة وفيضا شعوريا تقوم عليه أركان الحداثة بما هي نسق ومنجز وخبرة للإنسان الجديد كون الكتابة النسوية تصاعدت مع تصاعد روح الحداثة وما بعدها، وأصبحت ظاهرة عالمية لها تبعاتها الإنسانية، ولذلك فهي تقع فِي قلب الحياة وليس على سطح الورقة البيضاء. فما برح وضع النّساء العربيات في مجتمعات تنشد التّحديث والانفتاح على جميع الأصعدة وتتشبّث بمنظومة العلاقات التقليديّة بين الجنسين وضعا مثيرا للجدل وجديرا بالتّحليل والنّقد.
هذا كله يقودنا إلى أن حقبة الألفية، تُمثّل مرحلة التأسيس للرواية النسوية العربية بشكل عام، بوصفها جنساً أدبيّاً، وقد كانت شحيحة، بفعل الأوضاع التاريخيّة التي عاشتها بعض الدول تحت سيطرة الاستعمار والعزلة، ممّا أثّر على حركيّتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية. كما أنّ فعل الكتابة، كان حكراً على الرجل، واعتُبرت المرأةُ، حينها، تابعة له؛ فعاشت تهميشاً من طرف العُرف الاجتماعي المُحافظ.
ثم أطلّت حقبة ما بعد منتصف الألفية بأسماء روائيّة أكثر تحرُّرا مع مطلع القرن الحادي والعشرين، بفعل زوال العديد من العقبات النفسية والاجتماعية، ما أدّى إلى تطوُّر كمّيّ في الرواية النسوية العربية، وهو ما مثّلته مرحلة الانفتاح والانتشار، حيث تمكّنت الروائيّات من التعبير عن ذواتهنّ بكلّ أريحيّة، وترجمة أفكارهنّ أدبيّاً، دون أيّ حواجز أو منغّصات. وقد مثّل هذه المرحلة العديد من الروائيّات اللاتي شكّلت أسماؤهن علامة مضيئة في الأدب العربي بل العالمي الحديث. وكتبن نصوصا سردية عبّرت عن قدرة الرواية النسويّة في الوطن العربي على استيعاب قضايا الراهن، والتعبير عنها.
ورغم إجماع مختلف الباحثين على صعوبة تناول هذه الخصائص النسائية في الكتابة، والعمل على تجسيدها دون التفكير في مقارنتها بما هو متوفر في الكتابة الأخرى، فإننا نذهب مع من يذهب إلى التشديد على خصوصية هذه الكتابة، واختلافها عن نظيرتها عند الرجل. نستطيع أن نوجز أبرز خصائص ما وجدناه عند الروائيات العربيات من تركيز على، الجنس، إدراك الجسد، التجربة الحياتية، اللغة الموظفة والتي تجلت ملامحها في الآتي:
• الكتابة الأنثوية تعتمد على التواصل، وتفجير الكلمة المتحررة في الصمت.
• العفوية والمباشرة والاستعمال التلقائي للكلمة.
• البعد الحميمي وممارسة الاعتراف والبوح.
• انعكاس الطبيعة الداخلية للمرأة، لذلك نجد النص والشخصية الرئيسة/البطلة والأنثى في امتداد نرجسي للمؤلفة أحيانا.
نخلص إلى أنّ الروائية العربية، اتّجهتْ نحو منحى كتابيّ جديد بُغية إيجاد جنس أدبيّ قادر على ترجمة هموم العصر؛ فلجأت إلى تهجين الشّكل الروائيّ عن طريق انصهاره مع الأجناس الأدبيّة وغير الأدبيّة، ومنه تلاقح السردي مع المسرحيّ والشّعري والسينمائي والتاريخي. وقد ولّد هذا الانفتاح الروائيّ على الأجناس المختلفة، شكلاً هجيناً وجديداً، أدّى إلى بلوغ نضج فنّي خلال فترة وجيزة.
كما أنّ تداخل الأجناس أحدث أيضاً تعدُّدًا لغويّا داخل النماذج الروائيّة المدروسة. وقد رفضت الروائيّة النوع الأدبيّ، وسعت إلى خلخلته، وتمكّنت من ذلك باستعمال طرائق وأشكال فنيّة متعدّدة، أسهمتْ في إيجاد تجريب وحوار فاعل وخصب مع النّص الروائيّ.
إن ظاهرة إقدام الكاتبة العربية على خوض مغامرة التجديد والتنوع في الكتابة الروائية، يستحق الالتفات والدرس، كونها تبرز بجلاء حضور قلمها وتطوره؛ خاصة القلم النقدي الذي يتزايد بتميز في مختلف مجالات الأجناس الأدبية، خاصة في الجنس الروائي؛ مما يشير إلى إسهامات الفكر النسوي إبداعا ونقدا؛ إلا أنها بحاجة إلى إعمال فني أكثر قدرة على تجاوز الحدود، ورصد التحولات الكبرى التي تعينها على خوض غمار تجريب جديد مفتوح أكثر على المستقبل، لأنه في حاجة إلى إعادة قراءة منجز الوسائط الجديدة التي تسمح لها بتوظيف واقع آخر هو الواقع الافتراضي الذي يؤهلها إلى سبر قضايا أخرى يمكن طرحها وتعميق وعيها بها، من أجل تجاوزها والعمل على فتح آفاق أخرى أرحب من خلال منظور فكري يقرّ بالاختلاف، ويقارب التنوع لأجل رواية عربية ناضجة، ومؤثرة لا يستكين فيها صوت المرأة، ولا يهدأ قلمها عن المسكوت عنه من قضايا تقارب واقعها العربي والإنساني.
ناقدة من عمان