أيديولوجيا القتل
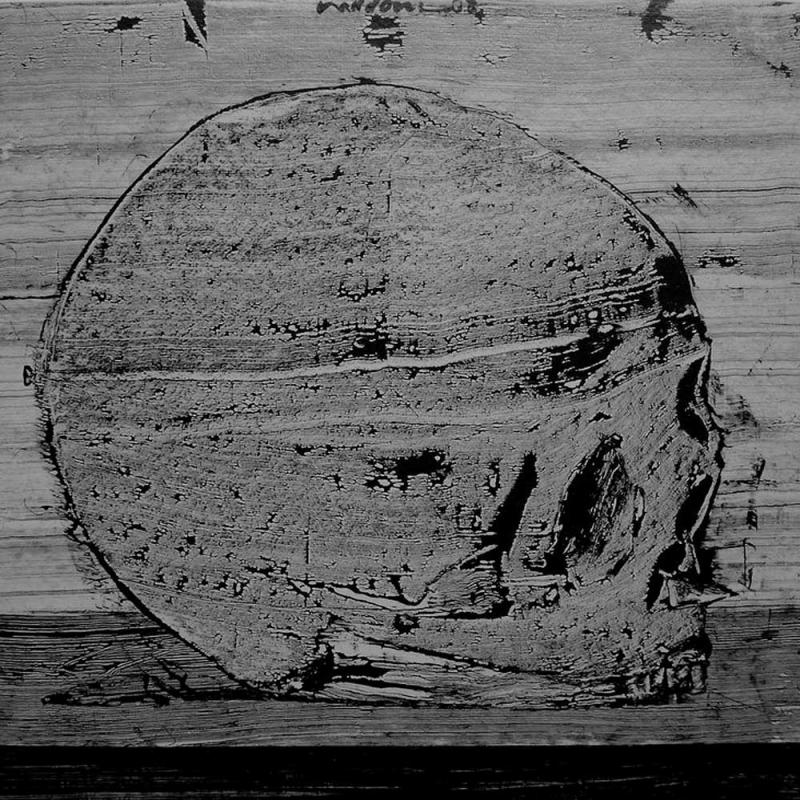
في الرواية البشرية وقائع لا تحصى عن القتل والتعذيب والتمثيل بالجثة، وتضم كتب التاريخ بين دفتيها حروب بني الإنسان وما خلفته من مآس هي للخيال أقرب، والشاشة الصغيرة في عصر ثورة الاتصالات تضعنا كل يوم أمام مشاهد ألفنا رؤيتها دون أن تثير فينا إحساسا بالفجيعة، وبخاصة إذا كانت المشاهد لا تعنينا مباشرة. جرائم القتل في فلسطين والعراق التي يمارسها الصهيوني والأمريكي تمر عين المتحضر عليها وبالكاد تنتج شجبا كلاميا. التقنية – ثمرة العلم الإنساني – أبدعت وتبدع آلات القتل التي تزهق أرواحا لم ترتكب ذنبا لتعاقب عليه، فالقاتل إنسان والمقتول إنسان.
في عام 1914 كتبت جريدة التايمز اللندنية في مقالها الافتتاحي قائلة: ليست هناك أمّة متحضرة، على وجه الكرة الأرضية، ترضى بأن تقصف المدن المفتوحة بالقنابل من الجو ولم تمض عقود قليلة من الزمن حتى كانت العواصم التاريخية الكبرى لأوروبا – باريس ولندن وبرلين وموسكو تترنح تحت قصف القنابل، ولم تمض بضعة عقود من الزمان حتى قضت قنابل ذرية، تسقط من الطائرات، على الحياة في مدينتين من مدن اليابان. ترى هل قتل الآخر وتعذيبه خصلة متأصلة في الإنسان إلى الحد الذي لا يمكن استئصالها، هل هي صفة غريزية ثابتة فيه؟. إن (ساد) الذي اشتقت من اسمه اللذة في تعذيب الآخر، قد بيّن في قصصه جانبا من المتعة التي يشعر بها المعذب أو القاتل. وقد أشار فرويد إلى وجود غريزة للتدمير عند بني البشر إلى جانب غريزة الحب. وقيل قديما إن الظلم من شيم النفوس. وفي كل الأحوال فإن ظواهر القتل والتعذيب والقسوة والاستبداد والاحتقار والسخرية والإذلال والحرب فضلا عن الانتقام والثأر والجرائم الفردية، ظواهر ما زالت حاضرة، بل ويزداد حضورها في كل المجتمع دون استثناء وتجهد العلوم الاجتماعية لفهم هذه الظواهر من علم الاجتماع إلى علم النفس إلى الأنثروبولوجيا… إلخ.
شرعنة القتل
لكن المشكلة التي نحن بصدد فضها هي أيديولوجيا القتل، أي التبرير الأيديولوجي لفعل القتل – قتل الآخر -. فأيديولوجيا القتل هي تلك التي تشرعن فعل القتل، هي التي تقدم لهذا الإفناء للآخر المبررات التي تصل حد وصفه بالفعل البطولي. وبالتالي يجب أن نميز بين القتل جريمة فردية وبين القتل الذي تقف وراءه أيديولوجيا تدعو إليه وتبرره. فقتل اللص صاحب البيت بدواعي السرقة فعل يلقي الاستنكار العام إذ أن دوافع القتل واضحة لا لبس فيها. يقتل الأب ابنته بسبب الشرف، يرفع الأب رأسه مختالا ومفتخراً، ويشاركه جمهور كبير من الناس شعوره، ويولّد لديهم استحسانا، لهذا الفعل نوعان من القتل: الأول جريمة في العرف، والآخر فعل حسن، الأول ليس وراءه أيديولوجيا والآخر الأيديولوجيا تدعو إليه.
والحق أن القتل الذي تشرعنه الأيديولوجيا هو الأخطر، والأكثر مدعاة للاشمئزاز في التاريخ، ولو دققنا في مصدر أيديولوجيا القتل لوجدنا أنها ليست مجرد تبشير مفكر ما لهذه الأيديولوجيا إنما المساهمون الحقيقيون في صناعتها هم الجماعات الإنسانية والمؤسسات: القبيلة، الشعب، الأمة، الحزب، التنظيم السري، سلطة الدولة. ويظل السؤال مطروحا: هل كان لأيديولوجيا القتل أن تغدو عامل تأثير على البشر لو لم يكن الإنسان ينطوي، بالأصل، على نزعة عدوانية تجاه الآخر؟
القتل: قاتل ومقتول والأيديولوجيا تمجّد وتستنكر، القاتل يحمد قتله والمقتول يستنكر قتله، فحين قذف الأميركي هيروشيما وناجازاكي بالقنبلة الذرية وأزهق أرواح الآلاف من البشر في دقائق مجد الأميركي، هذا الفعل الذي قامت به الأمة الأميركية ونظر إليه بوصفه انتصاراً فيما الياباني ما زال يحيى ذكرى هذا الفعل على أنه جريمة نكراء بحق الإنسان.
والعنصر المحرك لأيديولوجيا القتل هو قتل من أجل، قتل من أجل، وقتل من أجل في كلا الحالين نحن أمام الموت من أجل تنطوي هذه الـ”من أجل” على نتيجة هي في نظر القاتل والمقتول أثمن من الإنسان أثمن من المقتول فالذاهب للقتل قد يقتل هو الآخر من أجل التضحية بالأنا وبالآخر والغاية تتعالى على الأنا والآخر. لنحدد من أجل أس أيديولوجيا القتل وبخاصة أيديولوجيا الحرب التي هي الشكل الفاقع لأيديولوجيا القتل، تنقسم من أجل إلى قسمين ظاهر وخفي، الظاهر هو الأهداف المعلنة الزائفة والخفي هو الأهداف الحقيقية وبالتالي نحن أمام أيديولوجيتين معا: واحدة تضفي على الحرب دلالات أخلاقية وعقلانية وحقانية – وهي الأيديولوجيا العلنية – والأخرى هي الملوثة بكل الأهداف الدنيوية. الأولى موجهة إلى الجمهور، إلى البشر العاديين الذين يجب بث الحماسة فيهم، والسيطرة عليهم بقيم ينظرون إليها على أنها ما تستحق أن يموت الإنسان من أجلها: الله، الأمة، العرق، الحرية، الخطر الخارجي.. أما الثانية فهي التي يعرفها حق المعرفة من خطط للحرب ودبّر لها، إنه يبقيها في السر لأنها لا تفعل فعلها في نفس المحارب. في الـ26 من كانون الثاني 1095 ألقى البابا أوربان الثاني خطابا أمام الجموع المحتشدة دعا فيه إلى حمل السلاح ضد قبيلة الأتراك الفارسية التي ذبحت وأسرت كثيرا من المسيحيين، وإلى تحرير قبر السيد المسيح في القدس ولتحرير الأخوة العائشين هناك (أنا أقول هذا للحاضرين وأتكلف بإبلاغ الغائبين – هكذا أمر يسوع المسيح) ولم ينس البابا أن يقول للجموع إن الرب سيغفر جميع خطاياهم إن هم قاتلوا الكفار المسلمين، وسيثيبهم في الجنة الأبدية في السماء… كان الفرسان والإقطاعيون الفرنجة يعرفون ما وراء هذا الخطاب وراحوا يقاتلون من أجل بلاد العسر والثروة، فيما الجنود كانوا ينفّذون إرادة المسيح. المسيح رمز المحبة والتسامح والأخلاق، المسيح الذي جاء ليخلّص البشر من خطاياهم عبر فدائهم، المسيح يتحول إلى مبرر للقتل.

تستعير إذن أيديولوجيا القتل من المقدس عناصر لتزييف وعي البشر ودفعهم لإفناء الآخر من أجل ما هو دنيوي. في حالة كهذه يتحول المقدس الديني – بفعل تأثيره الأخاذ على المؤمنين- إلى خطاب تحريضي: تحرير قبر المسيح، تحرير القدس، تحرير الأخوة، والانتقام من الكفار. ويتحول الصليب من رمز للفداء المسيحي من أجل البشر، إلى دافع لقتل البشر.
حروب نابليون في الشرق العربي تمت تحت نشر مفاهيم الإخاء والمحبة والمساواة، الاستعمار تم تحت دواعي مساعدة الشعوب على التطور، الحروب التي خاضها هتلر تحت اسم العرق الآري السامي ورسالته العالمية، الاحتلال الصهيوني – اليهودي لفلسطين جرى باسم الدكتاتورية ونزع أسلحة الدمار الشامل التي تهدد الجيران. تاريخيا تبدو الإمبراطوريات التوسعية هي مصنع أيديولوجيا القتل، لكن الإمبراطوريات التوسعية لا تخاطب البشر بأهدافها في التوسع والثروة والسرقة والهيمنة، بل باسم القيم السامية يجب شحن الجيوش الغازية بمفاهيم لا علاقة لها بأصل العدوان، وعد إلهي، مجد الأمة، رسالة الشعب، تحرير الآخر. أيديولوجيا القتل هي أيديولوجيا الأقوياء ضد الضعفاء، أو هي أيديولوجيا القوة العمياء، أيديولوجيا الطغاة والغزاة. والمفاهيم تقريبا واحدة، فخطاب الطاغية لتبرير طغيانه هو الآخر يقوم على الإعلاء من شأن الوطن والشعب والحرية بتوحيد غريب بين كل هذه المفاهيم وشخصه. إذّاك فإن أيديولوجيا الطغيان تقسم المجتمع إلى: من مع الطاغية وبالتالي مع الوطن، ومن ضد الطاغية، وبالتالي ضد الوطن. من هنا تأخذ أيديولوجيا القتل صيغة الدفاع عن الوطن ضد أعدائه، أعداء الوطن هم أعداء الطاغية. فالطغاة لا يقولون إننا نعدم ونسحق دفاعا عن السلطة، بل سحقا للخونة والمتآمرين فكل المحاكمات التي أجراها ستالين والتي انتهت بإعدام رفاقه إنما تمت تحت عنوان خيانة هؤلاء للوطن، وأصبح بوخارين – الذي سماه لينين محبوب الحزب – عميلا ألمانيا وأعدم بكل برود.
إن القوة سواء أكانت عائدة لإمبراطورية توسعية أم نظاما مستبد أم حزبا فاشيا يبعث كل الأخلاق الغريزية النافية للآخر، وتعلن انهزام القيم الإنسانية التي تعلي من شأن الإنسان، فتتوحد أيديولوجيا القتل مع الأخلاق الغريزية ويصبح قتل الآخر السمة الأرأس لمثل هذه الوحدة، فتنهار قيم التسامح، ينهار الإحساس بحزن الآخرين على ذويهم المقتولين ولا تعود أشلاء الأطفال تثير أيّ إحساس بالحزن أو الذنب فأيديولوجيا الحرب تدفع الأبناء للقتل، هذه الأيديولوجيا التي غابت عن قاموسها مفاهيم الترمل والتيتم والفقد والحزن، بل وتدفع الغوغاء الذين تمكنت منهم أخلاق الغريزة لعقد حلقات الرقص زهوا بالقتل رغم أن الموت قد طال الجميع فأيديولوجيا القتل هي في النهاية التضحية بالآخر، صاحب قرار القتل يدفع البشر للموت في أتون الحرب، ويطل على البشر متلذذا بالدماء التي سالت من أبناء جلدته أو من الأغراب، خذ مثلا حالة فقدان الأب لابنه في الحرب الابن الذي ذهب ليقتل أو الابن الذي قتل بفعل القاتل القادم إنها أعظم حالة تراجيدية يعيشها الأب فعاطفة الأبوة والأمومة أصدق عواطف المرء إذ أن الأب أو الأم وحدهما قادران على التضحية عن رضى مطلق من أجل الأبناء. فالأب الذي رفع صورة لابنه الذي قتل في حرب أميركا العدوانية على العراق خاطب بوش قائلا: افرح أيها الرئيس لقد أفقدتني ابني الوحيد من أجل حربك لامتلاك النفط، والأم العراقية فقدت وعيها حين فقدت فلذة كبدها، مثالان يدلان على حجم المأساة التي لا فوقها مأساة، لكن المأساة الأكبر أن يقتل الابن في حضن أبيه كما محمد الدرة، والقصة الدينية حول إبراهيم وابنه شاهد على قداسة الابن، تقول القصة: إن إبراهيم طلب من الله أن يهب له غلاما، فلما نزل به ضيوف من الملائكة المرسلين، بشروه بغلام حليم فقال إبراهيم لما بشر به، هو إذن ذبيح الله فلما ولد الغلام وبلغ معه السعي قيل له أوف بنذرك نذرت تقربا إلى الله تعالى وكان هذا هو السبب في أمر الله خليله إبراهيم بذبح ابنه، وتضيف القصة أن إبراهيم رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل فقال لابنه خذ الحبل والمدية ثم انطلق بنا إلى هذا الشعب لنحتطب فلما خلا إبراهيم بابنه في شعب كبير أخبره بما أمر به، وقال يا بنيّ إني أرى في المنام أني أذبحك فقال له ابنه يا أبتي اشدد رباطي حتى لا أضطرب، وكفف عن ثيابك حتى لا ينتضح عليها دمي، فينقص أجري وتراه أمي فتحزن، واشحذ شفرتك وأسرع بجر السكين على حلقي ليكون أهون للموت عليّ فإن الموت شديد فإذا أتيت أمي فأقرئها مني السلام فإن رأيت أن ترد قميصي إليها فافعل، فإنه عسى أن يكون أسلى لها عني… ففعل إبراهيم ما أمره ابنه ثم أقبل عليه يقبله وقد ربطه وهو يبكي… ثم إنه وضع السكين على حلقه لكن السكين لم تعمل شيئا وتقول القصة إن الله قد ضرب صفيحة من النحاس على حلق إسماعيل. فقال إسماعيل عندئذ يا أبت كبني ففعل إبراهيم ذلك ثم إنه وضع السكين على قفاه وانقلبت ونودي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، هذه ذبيحتك فداء لابنك فاذبحها دونه وهكذا كان.
كثيرة هي الدلالات الرمزية لهذه القصة الدينية فالإله أراد أن يختبر إبراهيم بأصعب اختبار ممكن ألا هو ذبح الابن، أجل إنه أصعب اختبار على الإطلاق أن يذبح أب ابنه فالإله يدرك ولا شك علاقة التوحد المطلقة بين الأب والابن أو الأم والابن، الابن بدوره يدرك هذه الحقيقة ويدرك أن أباه لا محالة متردد في تنفيذ أمر الإله، كما أنه يعرف ما الذي سيحصل لأمه فيما لو عرفت أنها فقدته، أي أن إسماعيل على وعي بأن حب إبراهيم له أقوى من أمر الإله له، ولهذا ساعده على تحمل الأمر الإلهي وما إن نجح إبراهيم بالاختبار حتى تدخل الإله، وعدل عن أمره، لأن الإله يعرف ما قيمة الابن، فقرر أن يفديه بكبش من السماء، أي بحيوان هو بالأصل موضوع ذبح، ترى أيّ أمر يدفع مؤدلجي الحرب لدفع الأبناء إلى القتل: ليقتلوا ويقتلوا؟ من ذا الذي أعطى الحق لهؤلاء أن يضحوا بما لا يملكون من الأبناء ثم يرفعون نخب النصر جالسين على جماجم الأبرياء؟ كيف يقتلون الابن في حضن أبيه أو أمه ثم يبتسمون؟
أيديولوجيا القتل قتل الآخر، التضحية بالآخر، من أجل وفي مقابل أيديولوجيا القتل تبرز فلسفة المقاومة، لماذا قلنا فلسفة المقاومة ولم نقل أيديولوجيا المقاومة؟ لسبب بسيط أن المقاومة فعل عار من أيّ كذب، من أيّ حمولات أيديولوجية خفية، لأنه ببساطة موقف من العالم، وبالتالي فلسفة المقاومة فلسفة بمعنى الحياة المليء بالكرامة والحرية قل المقاومة فلسفة في المعنى.
غورو ويوسف العظمة: رمزان ساطعان

الأول رمز لأيديولوجيا القتل والثاني رمز لفلسفة المقاومة، غورو جاء بجيوش من خلف البحار في مرحلة الاستعمار الاحتلالي يتحرك باسم الأمة الفرنسية – كإمبراطورية توسعية – غورو يحمل معه صك انتداب مشرعن من عصبة الأمم، لكنها شرعية القوة المنتصرة. جاء بجنود ومدافع وطائرات، جاء ليستبيح، ليسطو، ليسيطر، ليسود ليقتسم الغنائم مع حليفة فرنسا، بريطانيا، غورو يناقض الأيديولوجيا في زيفها المعلن وفي حقيقتها الخفية، السلوك صادر عن الخفي غير المعلن، يوسف العظمة: ابن الوطن، يدرك هذا الوزير الأرستقراطي أنه لا يملك من القوة المادية ما يلاقي به غورو المدجج بأحدث الأسلحة، لكنه ذهب ليلاقي جيش المستعمر وهو يعرف مصيره. قاتل العظمة غورو حتى قتل وبالمفهوم الوطني – الإسلامي استشهد، نص قبل العظمة يظهر أنه مسكون بمفهوم الوطن الحر مسكون بمفهوم الكرامة، مسكون بمفهوم الاستقلال، مسكون بالثقافة المتمردة على الذل كل هذا يشكل معاني الوجود التي دونها لا معنى لوجوده إذا هو ضحى بنفسه حرا من أجل وجود ذي معنى سام أو من أجل وجود سام هو بهذا الإطار فيلسوف مقاومة لكنه كتب النص بدمه.
غورو يتلقى الأمر بالزحف على سوريا، يوسف العظمة يستجيب لنداء داخلي حر التضحية بالأنا حرا، هي ذي فلسفة المقاومة ليس هناك فعل قسري في فلسفة المقاومة، هي كما قلت نداء داخلي، نداء معنى للوجود لهذا، تختزن الذاكرة الشعبية العظمة بوصفه رمزا للتضحية وللبطولة، ودبجت من أجله القصائد الصادقة، فعل حر ووعي بمعنى الفعل، يفضي بالتضحية بالذات، فيما أيديولوجيا القتل تضحية بالآخر من أجل قتل الآخر، من أجل أن يحقق القتل مصلحة لا علاقة لها بالقاتل المدفوع للقتل.
وقائل يقول: إن فعل المقاومة هو قتل للآخر، أيضا هذا صحيح لكن المقاوم لم يطلب من الآخر المعتدي أن يأتي إلى دياره ليقتله، إنه ببساطة يدافع عن نفسه، إنه يمارس حق المقاومة، حق مواجهة العدوان، دفاع عن وجود أو عن نفس لا قيمة لها إلا في وجود يرتضيه الأنا. من هنا ندرك مدى ترابط المقاومة بالحرية، الحرية بوصفها قيمة داخلية ونمط الوجود، ما الذي دفع عزالدين القسام لمقاومة الإنكليز في فلسطين: لا أحد سوى النداء الداخلي، سوى فلسفة في الحياة مرتبطة بفلسفة للوطن، لم يكن الهدف مزورا أو ملتبسا أو خفيا، الهدف واضح: التحرير.. فالمقاوم إذن ليس قاتلا والمفهوم الدال على فعل المقاومة هو الفداء ومنه الفدائي. في فعل الفداء تعود مفاهيم الوطن والأمة والكرامة إلى حقيقتها التي زيفت في أيديولوجيا القتل، وآية ذلك أنها حاضرة في السلوك. ومتعينة بفعل هو من طبيعتها فالمقاومة بوصفها فداء تنطلق أصلا من فلسفة في الحياة كما قلنا، ذات بعد أخلاقي – قيمي وأهم عناصرها هو التحرر من كل ما هو مبتذل في الحياة، أي الزهد، فالفداء تضحية بالأنا من أجل الآخرين، لأن المعنى الأعمق لفعل مقاومة الفدائي هو الاتحاد بالآخر والنظر إليه بوصفه أنا، الآخر هنا أبناء الوطن الذي ينتمي إليه أيضا، من هنا تبدو فلسفة المقاومة فعلا خلاصيا مطلقا، تخليص العالم من شرور أخلاق الغريزة وأيديولوجيا القتل، وفعل القتل المرتبط بهما، فضلا عن ذلك هي إعلان صريح للتمرد قولا وفعلا وتشيعها “اللا” بوصفها الرد الحاسم للقتل وأيديولوجيته، فلسفة المقاومة هي في أصلها فلسفة جديدة للجسد، فالروح المقاوم لا ينفصل عن الجسد المقاوم، وذروة فلسفة المقاومة الاستشهاد، إنه لذة الجسد الزاهد بالحياة.
أيديولوجيا القتل تنظر إلى فعل المقاومة – الاستشهاد على أنه فعل إرهابي، ذلك أن المعتدي يواجه بشرا لا يخضعون لقواعد حربه، إنه يريد موت الآخرين ويخاف من موتهم، إنه يخاف من طريقة موتهم التي تودي به، حيث فعل التحرر تضحية فداء. إن المعتدي المسلح بالآلة وأيديولوجيا القتل لا يملك فكرة التضحية، بل أقتل الآخر من أجل، إنه يواجه أنا تعلن أنها تموت من أجل..، فالأنا التي تعلن موتها من أجل وجودها الحر تعلن في الوقت نفسه موت الآخر الغريب الغازي الذي يخاف الموت. من هنا نفهم لماذا تظهر الحرب العدوانية، والحرب عدوانية بالأصل – في أشد أشكال الإفناء للآخر – قتل أبرياء، مجازر بحق، تمثيل بالأجساد إنها وهي منطلقة بالأصل من إفناء الآخر، من ضرورة الانتصار عليه، فهي لن تعدم أيّ وسيلة لهذا الإفناء. وفي اللحظة التي تظهر فيها فلسفة المقاومة فعلا متعينا تزداد همجية المعتدي حيث تحضر فكرة الإفناء الكلي (سلوك فرنسا في الجزائر، سلوك الصهاينة في فلسطين، سلوك أميركا في فيتنام والعراق)، ويظهر القاتل المسلح بأيديولوجيا القتل كلّ مخزونه من السادية والتدمير، ويتحول إلى وحش كلي يفقد أيّ علاقة بالحياة الثقافية بالمعنى الأنتروبولوجي للكلمة، الثقافة التي تؤسس للعلاقات المعشرية بين البشر، إنه وقد أخرج كل مخزونه التدميري ضد الآخر تحول الآخر لديه إلى موضوع ليس إلا الآخر – لم يعد إنسانا وهو أيضا تحول إلى أداة أي فقد صفاته البشرية -، إنه زناد وزناد فقط، ومن أكثر المفاهيم زيفا في أيديولوجيا القتل مفهوم البطولة، فهذه الأيديولوجيا تمارس طقوس تمجيد القاتل بمراسم يحضرها سدنة هيكل القتل وتعلق الأوسمة على صدور القتلة بوصفهم أبطال الأمة والمدافعين عن أمنها ورفعتها. البطولة هنا لا تحمل أيّ قيمة أخلاقية سامية، بل هي مكافأة للمقاتل الذي نفذ أوامر القتل، لم تعد البطولة سلوكا أهم سماته التضحية بنداء داخلي دفاعا عن قيمة عليا، ذلك أن بطل الحرب هو في الأساس وحش الإفناء والذاكرة الشعبية لا تختزن أيّ رمز من هذه الرموز التي يأتي عليها الزمن، فيما تختزن ذاكرة الشعب المقاوم البطل الحقيقي، رمز المقاومة إنه بطل شعبي، ضحّى من أجل الوطن والشعب دون أن يغادر وطنه وشعبه، ضحى على أرضه في صد العدوان، ولهذا فإن طقوس تمجيد البطل الشعبي حاضرة في الأغنية والنشيد وكتب التاريخ وإحياء الذكرى، القسّام نموذجا حاضر في اسم شارع، مدرسة، وناد.. إلخ، يتحول البطل الحقيقي – الشعبي إلى جزء مكون من ثقافة الشعب سرعان ما يستحضره الشعب المقاوم طريقة لتعزيز الانتماء إلى فلسفته في المقاومة حيث مفهوم الحرية هو الحاضر دائما.
ويتساءل الفيلسوف ترى كم مرّ على البشرية من حروب ومجازر وقتل للإنسان؟ ولماذا لم تبرأ البشرية من هذه الظاهرة، من هذه الطقوس من القتل؟ يتساءل: كم كتب الحكماء والأنبياء والأدباء في تعظيم قيمة الإنسان، ودعوا إلى نبذ قتل الإنسان ألمانيا التي أنتجت كانط القائل لو أن سعادة البشرية كلها كانت وقفا على قتل طفل بريء واحد لكان هذا الفعل لا أخلاقيا، ألمانيا هذه بلد كانط: قتلت الملايين من الناس باسم ألمانيا ورفعتها وعرق بنيها. هل نكتفي مع فرويد قائلين: إنها غريزة القتل المتأصلة في النفس البشرية، أم أن المصالح والطمع في الثروة هي التي تفسر لنا الحرب على الآخر، هي التي تفسر لنا استمرار أيديولوجيا القتل، أم أن الإمبراطوريات بما تحمله من نزعة توسع واحتلال واستغلال الآخر هي التي تفسر لنا استمرار أيديولوجيا القتل، أم أن الإمبراطوريات بما تحمله من نزعة توسع واحتلال واستغلال الآخر هي الأصل في شرور الحرب وأيديولوجيا القتل أم الاحتفاظ بالسلطة والخوف عليها يدفع الحاكم للإعلاء من شأن القتل؟ أم ترانا ما إن نحس بالقوة، أيّ قوة، حتى نسعى لإظهارها – عبر نفي الآخر – وكأن القوة لا تستطيع أن تسجن نفسها داخل حاملها؟ أم هي هذا كله؟
حسبنا القول: ليس هناك أخطر من القتل إلا أيديولوجيا القتل، الأيديولوجيا التي تشرعنه وتتغزل به.




