النكوص التاريخي
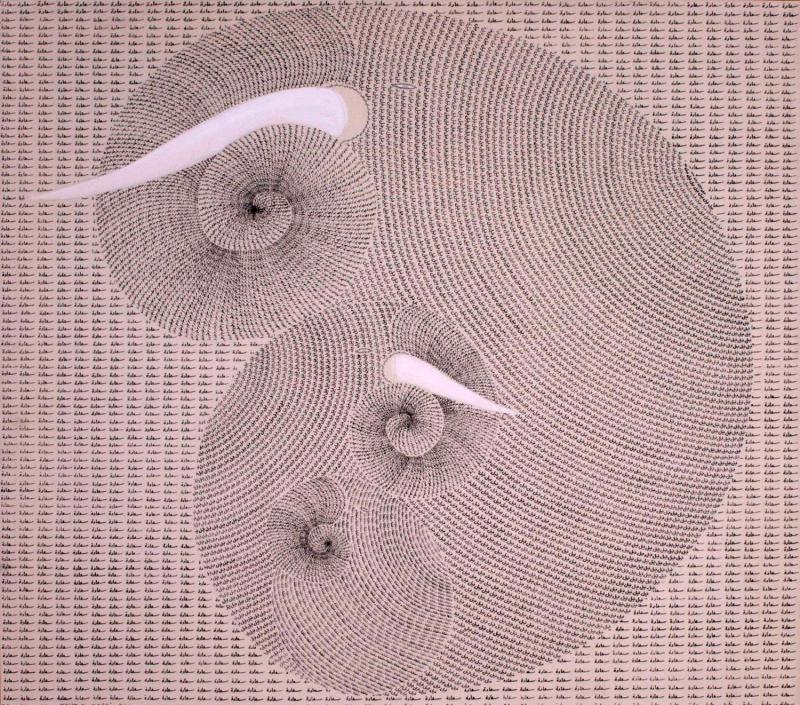
تحتل النخبة الفكرية، في كل تاريخ المجتمعات، مكانة مؤثرة في حياة الأفراد ووعيهم. وذلك لأنها تنشغل بهموم الناس ومستقبلهم دون أن يكلفها أحد بذلك كما يرى جان بول سارتر. والنخبة العربية لم تكن استثناء من هذه المهمة، ولقد أدى انشغالها بما يجب أن يكون، بالعالم المأمول، بالنقيض التاريخي لما هو واقع إلى طرحها كل الأيديولوجيات الكبرى التي عرفها العرب المعاصرون، بل إن الفلاسفة والمفكرين الذين استعاروا من الغرب أفكار التقدم والحرية والحداثة، والعلمانية والعلم والمواطنة والديمقراطية، وحاولوا توطينها في بلاد ما قبل الحداثة تكاد تغيب أفكارهم عن ساحات الصراع الراهن، ويجب ألا تغيب.
في مصر، الحاضنة الأهم لاستيراد الأفكار وإعادة صياغتها وإلباسها لبوساً محليا، لا أحد يذكر الآن زكي نجيب محمود الذي بُحّ صوته، وثُلمت ريشته، وهو يدعو إلى العلم وأخلاق العلم وترك الأوهام واستخدام العقل. وعبدالرحمن بدوي صاحب العشرات من كتب التراث الذي اعتنق الوجودية ودعا إليها، لم يترك أثراً في وعي شباب مصر، وقس على ذلك.
ومحمد عابد الجابري الذي قتل التراث بحثاً عن عقلانيةٍ نقديةٍ توحد بين ابن رشد والشاطبي وابن حزم، مات ولم يترك خلفه من يحمل “وهمه” التراثي، ككل التراثيين الذين راحوا ينبشون القبور بعد هزيمة حزيران، مستنجدين بها علهم يجدون حلا للعلاقة بين الوعي القديم والوعي الجديد.
حاول ماركسيو ذلك الزمان أن ينتسبوا إلى واقعهم عبر الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد وعبر “مركسة” ما لا “يمركس”
ولم تترك البيروسترويكا ماركسية العرب دون أن تقلل من شأنها إلى الحد الذي صارت فيه غريبة عن الحقل الثقافي العربي، ولم يعد محمود أمين العالم وسمير أمين شاغلين الناس.
وشخصانية محمد عزيز الحبابي بتأثيرٍ من الفيلسوف الفرنسي مونيه، التي أرادها الحبابي إسلامية، لم تترك ندبة ما في الوعي العربي والغربي. ومات حسن صعب، صاحب تحديث العقل العربي، وترك وراءه عقلاً عربياً شعبويا.
أجل بعد ثورة شباب مصر كان هناك حذر شديد في استخدام مصطلح العلمانية، واستخدام مصطلح “المدنية” عوضاً عنه. وينبري بعض الأصوليين الذين تعلموا في الغرب أصلاً لمهاجمة كل من يتحدث بخطابٍ عقلاني، ويتحول مثقف كهذا إلى مشروع قاتل.
العراق الذي كان أكثر المستهلكين للكتاب، واليوم لا همّ له سوى عاشوراء، ومداواة الآلاف من الذين يتعرضون لتفجيرات الجسد. لبنان الذي كان واحة إنتاج الكتاب والصحافة يتحكم به حزب أصولي باسم الممانعة، ما الذي جرى؟
مصر والعراق وسوريا والمغرب ولبنان وتونس بلاد النهضات العربية المبكرة في القرن التاسع عشر تعيش نكوصاً تاريخياً فاجعاً وتفكر خارج ذهنية التجاوز نحو الأعلى؟
أين هي العلة؟ هل العلة في واقعٍ عصي على التغيير، أم في أفكارٍ لا علاقة لها بواقع المنطقة أو تاريخها أم تعود إلى الأمرين معا؟ وكيف نفهم الثورات الراهنة في ضوء هذه الأسئلة؟
تكمن المشكلة كما أعتقد في المكنسة التاريخية التي لم تستطع أن تتحرر من الوسخ التاريخي نفسه، تعلقاً بالسلطة الرعناء، ولم تستطع أن تنجز مهمة تنظيف الطريق أمام التاريخ لانتصار الأفكار وتحويلها إلى نمط حياة ونظرة إلى الوجود والإنسان.
أقصد بالمكنسة التاريخية، الفئات الاجتماعية التي انتدبت نفسها لمهمة التغيير الاجتماعي.
فلقد كان تأسيس “الدولة الوطنية” في المستعمرات العربية حادثاً جديدا، وكانت حاجات الدولة الوليدة كي تصل إلى شكل الدولة المعاصرة كبيرة؛ حاجات اقتصادية وثقافية ومؤسساتية.
والسلطة التي آلت إلى أرستقراطية مدينية وفلاحية أخذت الطابع الديمقراطي الغربي ودون تاريخ تحولات عميقة في المجتمع، سياسياً واقتصادياً، بل أخذت تعمل على إنجاز هذه التحولات دون تاريخ، وكان هذا أهم عقبة تاريخية أمام التحول الحداثوي وأمام مكنسة التاريخ. فبدلاً من أن تكون ثمرة تاريخ، وتطور المجتمع الرأسمالي، ومهمة برجوازية متكونة، أرادت السلطة أن تنجز ما أنجزه تاريخ أوروبا.
ولهذا كانت السلطة الوليدة، بوصفها مكنسة التاريخ، ذات ملامح من التاريخ الذي تسعى لكنسه. الفئات الوسطى التي نمت بسرعةٍ هائلة، والتي تحولت إلى بديل للأرستقراطية المدينية والقروية، وبعض الفئات البرجوازية الوليدة لم تنجز تحررها الفكري الحداثوي، فحملت هي الأخرى نظرات المجتمع التقليدي إلى الحياة. وما إن آلت السلطة إليها حتى حاولت إنجاز حداثة بعصبية تقليدية، وتلك كانت أكثر المفارقات مأساوية في التاريخ المعاصر للعرب. “هذا التحليل لا ينطبق على بلدان شبه الجزيرة العربية، وينطبق على اليمن جزئيا”.
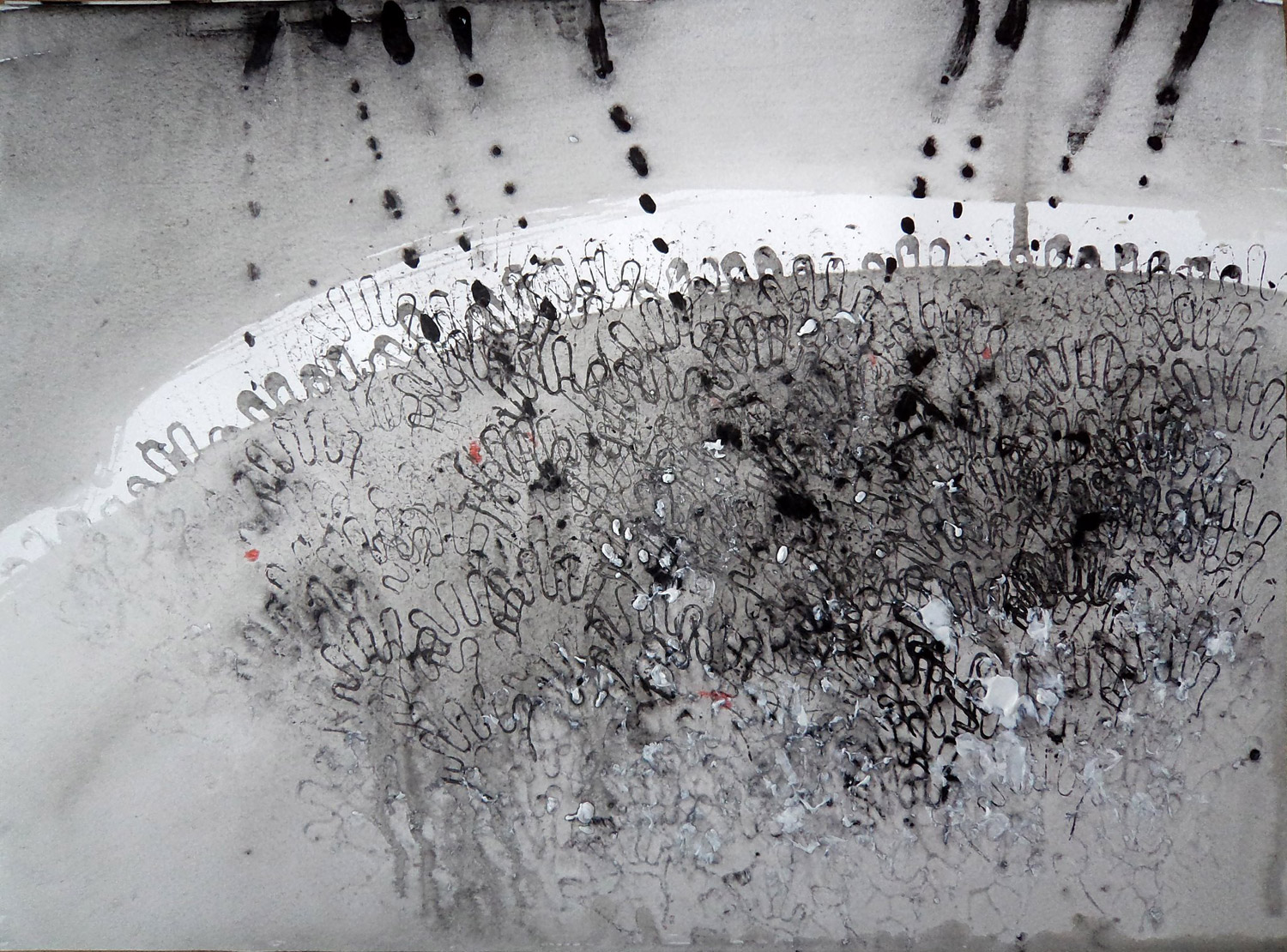
ففي الوقت الذي نشأت فيه السلطة الأرستقراطية، شبه البرجوازية المدينية والريفية، ونجحت في تكوين الفئات الوسطى – قلب المجتمع – المتكونة من المعلمين والأساتذة والمحامين والأطباء والمهندسين والموظفين والعسكر وما شابه ذلك من مهن، وساعدت على تكوّن نخبة فكرية ذات نظرة إلى مستقبل حداثوي بكل الأفكار التي يعج بها الغرب، وموت الفئات الوسطى ذاتها بعد استلام جزء منها للسلطة، وفي الوقت الذي أسست الأرستقراطية المصرية والسورية والعراقية للحياة السياسية، وتكوّن الأحزاب، فإن الفئات الوسطى التي يفترض أنها تريد إنجاز ما عجزت عن إنجازه الأرستقراطية (المسماة جدلا برجوازية)، قد دمرت الحياة السياسة، ودمرت قدرة الأفكار على تشكيل الوعي الروحي الحداثوي والمعاصر.
وذلك أنها، أي الفئات الوسطى ذات الأصل الطبقي الفلاحي، لم تحصل على تربية مدينية بالأصل، ولم تتشرب إنجازات برجوازية ثورية بالمعنى التاريخي، ولهذا وجدت نفسها نقيضا للأرستقراطية المدينية والريفية لا من موقع طبقي، بل من وعي شره باستلام السلطة، وعي معزز بأيديولوجيا سرعان ما تحولت إلى خرق بالية تلهو بها الريح ويمر الإنسان من أمامها دون أن يلتفت إليها.
عبدالناصر الشخص الوحيد الذي كان قادراً على إنجاز تكنيس قويّ للتاريخ بحكم مشروعه وقوته وجماهيريته، لكنه أراد التحديث والحداثة بلا مجتمع سياسي، بلا ديمقراطية، فحرم المجتمع المصري من إرثه التاريخي الحديث، ولهذا ما إن قضى نحبه حتى عادت مصر إلى ما قبل الناصرية، ولكن في صورة كاريكاتورية وفي حالة الدولة الفاسدة.
ومع تحول الفئات الوسطى إلى عقبة أمام التحول الحداثوي الديمقراطي لم تعد لأفكار النخبة وظيفة عملية واسعة وفاعلة. وتقوقعت في حقل ضيقٍ من جماعاتٍ محدودة تتحاور في الندوات والغرف المغلقة، دون أن ترى ما يجري تحت سطح الواقع، حيث عاد الناس ليحتموا بإرثهم التقليدي من تغوّل سلطة مغتربة عن الواقع المحلي والتاريخ العالمي.
وعندي أن الثورات الراهنة ستؤسس لصراع الأفكار مرةً أخرى، وقد يستعيد المفكر العربي دوره الذي لعبه في عصر النهضة وما بين الحربين. غير أن دوراً كهذا مستحيل دون غربلة الأفكار من جهة، وزعزعة اليقينيات من جهةٍ ثانية، وشجاعة في طرح الأقصى من جهةٍ ثالثة.
وعندي أن ولادة الأنا أهم نتيجة من نتائج السيرورات التاريخية الحديثة. وبالتالي فإن الدعوة إلى انتصار الأنا والكفاح من أجل تحوّلها إلى ذات، أي إلى الفعل، هي الآن مشروع الفلسفة إذا ما أريد لها أن تحقق ماهيتها في الواقع المعيش.
القول الفلسفي في “الأنا” هو وعي حقيقي لمشكلة الإنسان في الوطن العربي، وقد يراه البعض قولًا فلسفيًا مجردًا، وهو كذلك، لكن هاجسه الأساس هو الإنسان في علاقته بالتاريخ والواقع، فلا يصنع التاريخَ إلا “أنَوات” واعية لدورها في هذا العالم، لا يصنع التاريخَ إلا إنسانٌ يعي قيمته الفردية في هذا العالم.
الإنسان في الوطن العربي لم يمُت، لأنه لم يعش كي يموت، ولم ينتهِ، لأنه لم يبدأ كي ينتهي، ولم يغب، لأنه لم يكن حاضرًا كي يغيب. والانتصار للأنا دعوة إلى ولادة الإنسان، دفاع عن الإنسان بوصفه “أنا” ضد هذا الـ“نحن”، ضد القطيع الذي يسلب الكائن البشري أهم عناصر وجوده: أناه التي تميزه عن غيره.
عندما تنتصر “الأنا”، بوصفها وعيًا ذاتيًا بالتفرد، يصبح تعدد “الأنوات” دافعًا لها باتجاه صنع تاريخها الواعي، لماذا؟ لأنها، إذ تصل إلى مرحلة الكائن الأنا، تكون قد وعَت حريتها في الفعل والممارسة والقول، دون أيّ مخاوف على وجودها الذاتي.
و”الأنا” لا وجود لها خارج فعل الحرية؛ إذ أن الكائن خارج حقل الحرية مجرد شيء، وكلمة شيء تشير إلى انعدام الفاعلية، لا يمكن للـ“أنا” أن تنتقل إلى ذات فاعلة إلا في حقل الحرية.
كيف لنا تخيّل إرادة تنهض بكامل وعيها، دون أن تكون إرادة حرة، إرادة أنوات حرة! لكن حرية الأنا شعورٌ يقود إلى الممارسة، شعور لا يتولد إلا إذا وصلت الأنا إلى الوعي بالعبودية المعيشة. والأنا لا تنفصل عن الذات.
ما الفرق بين الـ“أنا” والذات؟ الذات هي الـ“أنا”، وقد تحولت إلى صناعة العالم: فهي، إذ تصنع العالم، تصنعه وفق رؤاها الحرة، وفق تحررها من غريزة القطيع. لذلك عالم الأنوات الحرة هو عالم “الأكباش” فقط، وليس عالم “الكبش والأغنام”، ولذلك قال الفيلسوف البريطاني قولًا قويًا: “الحرية هي التوزيع العادل للقوة”، وبناء على قولٍ كهذا؛ فإن “أفضل المجتمعات هي مجتمعات الذئاب، حيث كل أنا ذئب، وليست ذئابًا”.

هل من أفقٍ لظهور هذه الحرية في مجتمعاتنا العربية؟ هل من أفقٍ لظهور “أنوات” فاعلة؟ وما الذي يحول دون ظهور وولادة الـ”أنا” في عالمنا العربي؟ ما يحول دون ولادة الأنا ما أسميه النظام المتعالي على الـ“أنا”، هو نظام قامع لظهور الـ“أنا”، ويتكون من:
النظام السياسي الذي قام على الاستبداد العسكريتاري المتخلف الذي لا يرى المجتمع إلى في صورة “كبش وحملان”، وحول هذا “الكبش” مجموعةٌ ممن فقدوا أيّ قيمة ترتبط بمكانة الإنسان وحق الآخر، ليس لديهم سوى العنف وسيلة للحفاظ على بنية “الكبش والحملان”. العنف الذي يحطم الكرامة الإنسانية، للحيلولة دون أن تدافع عن نفسها.
يضاف إلى هذه السلطة السياسية السلطةُ الدينية المتمثّلة بأولئك الذين يزيّنون للسلطان “حكمته وعظمته”، أو أولئك الذين يُحصون سكنات الأنا وحركاته، ويقيمون عليه حدود جهلهم. وحين يرتبط الدين بالسياسة؛ يخلق سلطة أشد فتكًا من تلك السلطة العسكريتارية، وبخاصة العسكريتارية الريفية.
النظام القيمي الاجتماعي، التقاليد المتوارثة قامعة لظهور الـ“أنا”، وهو نظام متوارث يفرض على الأنا الانصياع لقيمه التقليدية، من دون النظر إلى تغيّر الأحوال والأزمان.
ولتجاوز هذا النظام المتعالي؛ لا بد من ظهور فئاتٍ وصلت إلى مرحلة الوعي الذاتيّ بقدرتها على تجاوز العالم، بقدرتها على تحطيم العالم القديم، وهذا ما فعلته الثورة البرجوازية في أوروبا، وهذا ما كان قابلًا أن يحدث في الخمسينيات والستينات في عالمنا العربي. لكن النكوص التاريخي، منذ سبعينات القرن الماضي حتى الآن، حال دون أن تستمر حركة ولادة الـ“أنا”، والسبب الأعمق أنّ الفئات الوسطى، التي تشكل وعيها بذاتها، لم تستطع أن تكون راديكالية إلى الحد الذي تكنس فيه التاريخ؛ فانهزمت، وبانهزامها، انهزم شرط ظهور الـ“أنا” وولادته، وهذا يعني أن نعمل جاهدين، كي تنشأ هذه الفئات الواعية لذاتها، بوصفها “أنوات” وليست قطيعًا. القول في “الأنا” قولٌ في السياسة وليس في الفلسفة فقط، في فلسفة السياسة، فأنت لا تستطيع أن تتحدث في السياسة إلا انطلاقًا من الفلسفة، لأنك تقدم قولًا عامًا.
هل هناك إمكانية لانتصار “الأنا”؟ نعم. هذه الإمكانية تواجه سلطة قامعة بالمعنيين: السياسي والأخلاقي للكلمة، لا تريد للـ“أنا” أن تنتصر في هذا العالم. لذلك، أنْ تعممَ الوعي بذاتك وبعالمك، على نحوٍ يكشف هذه العلاقة المتناحرة بين السلطة والـ“أنا”، أمرٌ في غاية الأهمية؛ لأن وجود السلطة وبقاءها رهن بالقطيع، ولهذا تخاف السلطة من الـ“أنا”، لأنها (السلطة) تخاف الحرية، ولأنها تخاف الحرية؛ فإنها تخاف الإنسان الذي يمكن أن يصبح فردًا أو “أنا”.
يجب أن تعيش الـ“أنا” اغترابًا؛ كي تتجاوز العالم. التجاوز عبر مفهوم الاغتراب الضروري للمثقف وللفاعل الاجتماعي عن واقعه المعيشي، لأنك لن تستطيع تجاوز عالمٍ لا تشعر باغترابك عنه. أما إذا كنت منسجمًا مع عالمك ومتصالحًا معه، فلماذا تغيّره؟ لذلك فإن المثقف غير المغترب عن واقعه المعيشي ليس مثقفًا بالمعنى السارتري للكلمة. فحين يكون المثقف قطيعيًا، أنّى له أن يصبح “أنا” فاعلًا، إنه لن يكون في هذه الحال إلى الصورة المكثفة للقطيع وعيًا وسلوكًا.




