الرواة يتعاقبون

في أحد اللقاءات التي تجمع بين لورين، وميران، خاطبت الفتاة المسلمة ميران المندائي (أو الصابئي) قائلة: "أنتم إذن لستم من عشاق الماء فقط، أنتم أبناؤه أيضًا". ومن هذه العبارة اشتق المؤلف عواد علي عنوان روايته "أبناء الماء" (الصادرة عن منشورات الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق 2022)، التي تروي على ألسنة عدد من الشخصيّات الروائية وقائع مؤلمة من حياة نفر من المشردين واللاجئين العراقيين في أمكنة متفرقة من العالم: أوتاوا، مونتريال، وينزر (في كندا)، هولندا، فنلندا، تركيا، ديترويت (في الولايات المتحدة)، سوريا، الأردن، اليمن، وغيرها.. ولم تفته الإشارة إلى لاجئين سوريين، ولبنانيين، كما لم تفته الإشارة لمعتقل غوانتنامو الذي قضى فيه والد أيهان، ولورين.
أشقاء، وأقارب، أو أصدقاء، تقطَّعت بهم السبل، وتفرقوا أيدي سبأ، وباعد بينهم الشتات، لا لأنهم سائحون يبحثون عن أمكنة يقضون فيها عطلاتهم الصيفية، أو عن فضاءات دافئة يهربون إليها من برد الشتاء القارس وقرّه. لكنهم في الغالب، والأعمّ، والأرجح، هاربون من عسف الاحتلال الأميركي (سجن أبوغريب أنموذجًا)، ومن البلاك ووتر، وعملاء إيران من أمثال مهدي أنصاريان، ومن المتطرفين الجهاديّين من مذاهب متعددة، شيعة، وسنّة، ودواعش، ومن عسف النظام السابق، وجوره، ومحاكماته، وحملاته المسعورة في “الأنفال”، وغيرها. وعلى رأس القائمة ميران المندائي – الصابئي – الذي لا يملّ ترديد قوله – تعالى – في سورة البقرة “إن الذين آمنوا، والذين هادوا، والنصارى، والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر، وعمل صالحًا، فلهم أجرهم عند ربهم، ولا خوفٌ عليهم، ولا همْ يحزنون”.
وهذا الصابئي، هو، الوحيد، من بين الشخصيّات الكثيرة التي تقوم عليها هذه الرواية، الذي نعرف شيئًا غير قليل عن طفولته، تلك الطفولة التي كان لها أثرها الكبير في مستقبله. ففي صغره قابل الأم تيريزا، في أثناء زيارتها إلى بغداد عام 1991 ومسحت شعره براحتها، وهي تقول له “أنت صبيٌّ وسيم، ولكنك تبدو حزينا” (ص 9). فكأن تلك القديسة، بفراستها تلك، تنبَّأت لميران أن يظل حزينًا طوال عمره، وهذا ما كان.
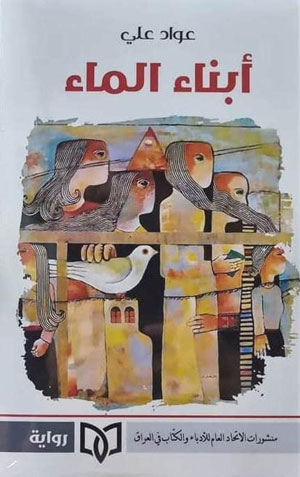
فجع أول الأمر بفراق حبيبته سليمة ابنته عبدالكريم النجار جار الأسرة، فقد علمت من نزيهة ابنة الجيران أنه ليس مسلمًا بل هو صابئي (مندائي). وفي العام 2006، أي بعد الاحتلال بثلاث سنوات، خطفت جماعة مسلحة أباه، وتحت التهديد بالسلاح عرضت عليه، وعلى زوجته، أن يغادروا العراق، وإلا مصيرهم القتل، ومثلما أخبره شاب ثلاثيني مثقف متنور أن تلك الجماعة تريد إفراغ العراق من هذه الطائفة، فهي تحل دم الصابئي، وتحل ماله، وعرضه، وتدعي أن قتل الصابئي يسهل للقاتل دخول الجنة، ولو زنى ولو سرق. ولم تفلح المحاولات لإنقاذه، فقد قتلوا الابن، والأب، وكانت تلك هي المرة الأولى التي يشهد فيها ميران طقوس الدفن على ديانة المندائيين.
وكغيره من العراقيين، اضطر ميران للنجاة بترك بغداد، والسفر إلى عمَّان، ليقابل في مفوضية اللاجئين تيريزا التي هي خطيبة أفرام جبرائيل، ومنهما تتألف نواة لثلة من الأصدقاء الذين يتآلفون في أوتاوا بكندا، بعد أن جمعتهم الغربة بعيدًا عن وطنهم العراق، إلى جانب آيجون، وسامان، ويوسف، وجورج، وأيهان، ولورين، وغيرهم.. ممن ينطبق عليهم قول الشاعر (كلنا في الهمِّ شرقُ). فلكل منهم، بالطبع، طريقته في التغلب على مرارة اللجوء، فتيريزا – مثلًا وهي التي ذكّره اسمها بالقديسة – وخطيبها أفرام، يعملان في مطعم هي عازفة، وهو مشرف صالة الزبائن. وسامان، الذي هو من الكرد، وكان قد فقد جده، وأباه، وأخته الصغرى، في حملة “الأنفال” التي شنها الجيش بمعونة مرتزقة الأكراد، وفقد أيضًا حبيبته شيلان، ذات الواحد وعشرين ربيعًا، التي فضلت الانتحار بسبب اغتصابها على يد أحد أفراد “الجاش” واسمه هوشنك، وقد ترك العراق مغادرًا إلى أيّ مكان يمكنه القبول به لاجئا، فانتهى به الأمر إلى أوتاوا، متحسرًا لأن صديقه فرهاد لم يأت إلى كندا، فقد وقع عليه الاختيار للجوء إلى هولندا، حيثُ أسرة خالته. وأما أفرام جبرائيل – زوج تيريزا – وهو مسيحي موْصِلي، فقد روى لنا فضلًا عن حكايته، حكاية أخته ميرنا، وزوجها جورج، فقد فرا بعد تهديدهما من المتطرفين، إلى سوريا، مع طفليهما إلياس، ومريم، ومن هناك طارا لاجئين إلى ديترويت في الولايات المتحدة. ويوسف البكري، صحافي يعمل في “طريق الشعب” اضطرَّ هو الآخر للهجرة، وواجه في الأشهر الأولى من اللجوء، والإقامة، في كندا، صعوبات شتى، كتلك التي تواجه غيره. ومنها العثور على عمل مناسب؛ فهو لا يستطيع أن يتحول من صحافي إلى عامل في محطة وقود، أو مطعم، أو بائع في سوبر ماركت. وغير ذلك من الأعمال التي تُعرض على اللاجئين، فيقبلون ممارستها على مَضَض. على أنه، وبمحْض الصدفة، تعرف على فتاة يهودية من أصل سوري (من حمص) أيهان ساسون، وكان والدها قد طُرد من عمله عام النكبة 1948 ليهوديته، فغادر إلى لبنان، ومنه غادر إلى الولايات المتحدة. وقد تخلى عن ديانته اليهودية ليتم زواجه من امرأة مسلمة أحبها في بيروت، ولقي حتفه في سجن غوانتنامو. وكانت أيهان قد عملت راقصة في أحد الملاهي بعد وفاة الأب، ثم تزوجت من أحد زبائن الملهى (خليجي) زواجًا عرفيًا استمر خمسة أشهر فقط، طلقها بعد عودته إلى بلاده. وقد عثر يوسف على عمل بصفة مراسل لصحيفة بيروتية، وتزوج من أيهان، وظل يتتبع أخبار شقيقيه زهير وأصيل ومكتبهما العقاري الذي يتعرض هو الآخر لاعتداء مسلح.

وليست آيجون، التي تنحدر من أسرة زرادشتية عريقة، بأحسن حالًا من سائر الشخوص، فقد عانت هي وأمها أيضًا من ظروف صعبة جدًا في كندا، وانتهت علاقتها الشرعية بميران للطلاق، مما زاد من محنتها بعد أن وقعت ضحية خداع المخرج المسرحي الذي أوهمها أنه سيتزوج منها إن هي انفصلت عن زوجها ميران، مستغلًا عشقها للتمثيل المسرحي. واكتشفت بعد ذلك حجم الخسارة التي تعرضت لها جراء الثقة بذلك المخرج المأفون. وقد سعى كل من يوسف وأيهان لإغراء ميران بالزواج من لورين، لكن تيريزا تحاول إعادة المياه إلى مجاريها بينه وبين آيجون، وقد أبى ذلك بعد تأكيده لتيريزا أن آيجون تتعاطى نوعًا من المخدرات، وهو الحشيش، وتسأله عن ديانة لورين، وحين تعرف أنها مسلمة تخبره أن ذويها لن يسمحوا بزواجهما إلا إذا أسلم وتخلى عن مذهبه المندائي، فيؤكد لها أنهما من هذه الناحية متفاهمان، وأن اختلاف الدين لن يعيق الحب عن المضي في مجراه. وهذا ما وعدت به أيهان، وهو أن تقنع والدتها بالتخلي عن هذا الشرط، وتجاوزه، قبل الزواج، حرصًا على مشاعر شقيقته سولاف المتعصِّبة لدينها المندائي.
قد يكون في تكثيفنا هذا لحوادث الرواية ما يضع القارئ في أجواء المعاناة التي يعيشها عراقيون في المهجر. وقد جاء اعتماد الكاتب على تقنية زوايا النظر (Point of view) بتعدّد الأصوات، واختلاف الراوي المشارك من فصل إلى آخر، موفقًا، إذ بغير هذه الطريقة لا يستطيع الكاتب أن يروي كل هذه الحوادث بما فيها من تفاصيل تتعلق بالشخوص، مع الحفاظ في الوقت ذاته على صدق الراوي. ولذا نجد الرواة يتعاقبون على المحكيّ الروائيّ مرارًا ، فميران مثلًا يتسلم إدارة السرد في نحو ستة فصول، وتيريزا في فصلين، وأفرام في فصلين، ويوسف في فصلين، وأيهان في فصل واحد، وآيجون كذلك، وسامان الكردي في فصلين اثنين… إلخ. وفي كل فصل نسمع من الراوي جديدًا في مُتخيَّله السردي يضيء ما عتم من الأحداث، وادلهمّ من الوقائع، ويرصد ما يتوالى على الشخصيّات من تغيير. وهو لا يفتأ يلجأ للتلاعب بترتيب الحوادث، فما يذكره على سبيل الإشارة هنا يعود ويذكره على سبيل التفصيل في موقع آخر، وما يذكره في موقع على سبيل الاستباق يذكره لاحقًا على سبيل الإلحاق، وما يذكره في موقع على أنه حافز، يستتبع أحداثًا، يذكر في موقع مّا أحداثًا هي وليدة ذلك الحافز. فالخبر الصادم الذي يتلقاه ميران عن اختطاف أبيه يمهد لهجرته من بغداد. وما يذكره سامان عن وقعة “الأنفال” يمهد لتركه العراق، والبحث عن ملاذ. وما يذكر في موقع عن ترسيم صموئيل أسقفًا يتبعه التفصيلُ في الاعتداء على الكنيسة، ومغادرة أفرام جبرائيل خطيب تيريزا للموصل، والبحث عن ملاذ آمن في كندا. أما البحث عن شيء مّا يشغل يوسف، فيقوده للتعرف على أيهان. فثمة شبكة من الحوادث الصغيرة المحفزة لحوادث أكبر، وبذلك تبدو حبكة الرواية شديدة الإتقان، وهذا شيء يعد من الأساسيات التي تعتمد عليها الدراسات النقدية في التفريق بين الرواية واللارواية.
ولا تخلو الرواية مع هذا من تجانس في اللغة، والحوار، مصدره أن شخصيّات الرواية معظمها من شريحة المثقفين. فأكثرهم من خريجي الجامعات في تخصصات متعددة: فلسفة، أدب إنجليزي، لغات، موسيقى، مسرح، صحافة وإعلام. وبعضهم مترجم من الإنجليزية إلى العربية، أو العكس، أو الألمانية، وبعضهم شاعر، وبعضهم كاتب مقالات، ويصدر صحيفة إلكترونية باسم “أمواج”. والبعض الآخر يمارسُ التمثيل، ويتابع دراسته العليا… إلخ، ولهذا نرى الحوار يجري على مقاس واحدٍ إلا من مواضع يقوم فيها الراوي باستخدام كلمات مندائية، أو كردية، مثل: “الجاش”، وهي تسمية أطلقت على مرتزقة من الأكراد “الجحوش”، و”المصبتّا” وتعني “التعميد”، والكنزاربا وهو الكتاب المقدس عند المندائيين، و”المسخثة”: تطهير الروح، و”رستة”، وهو شيء يشبه الكفن. و”الدرفش”: راية النور، و”الترامذة”، وهم أشخاصٌ يشبهون القساوسة، والرهبان. و”المندا”، وهو اسم يقابل اسم الله لدى المندائيين. و”الطماشة”: الاغتسال. ومن يتتبع مثل هذه الكلمات، في الحوار، يجد عددًا غير قليل منها، وهي التي تضفي لونًا خاصًا على الرواية لا نجده في روايات أخرى تروي قصصَ العراقيّين في المنفى.
على أن القارئ، بلا ريْب، يشكو من صعوبة الرواية، نظرًا إلى وفرة الأسماء غير المألوفة لديه. وهذه الأسماء يتعاقب ذكرها كثيرًا في الفصول، وفي الحوارات، مما يشتتُ الذاكرة في بعض الأحيان، لاسيما لدى القارئ العادي الذي لا ينشد في قراءته للرواية إلا التشويقَ، والمتْعة.




